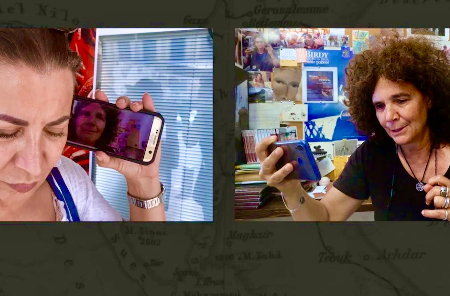يتوزّع ما يناهز مليون عامل سوري أرجاءَ لبنان، فرض الأهالي على بعضهم منعَ التجول ليلاً، وأنجز عنهم المخرج السوري زياد كلثوم فيلمه الأخير «طعم الإسمنت».
وطأة الصمت في الفيلم أدهى من الواقع. إنه امتحانٌ مستفزّ لدقّة العين. نرى شباناً سُمْراً كتومين داخل برجٍ يبنونه. قد نفكّر بما يضمرون، أو ما لا نسمعه من لهجاتهم وحيرات عذاباتهم. قد يخالُ المتفرِّج إنه مقبِلٌ على سماع قصصهم، ملتقطاً لمحة في تدفق الصور البديعة تشي بأن أحدهم آتٍ من الحسكة أو إدلب أو حلب أو مدن وأرياف سورية أخرى، بدواً وفلاحين وأكراداً... هؤلاء الشبّان الفقراء، في هذا الوجوم الذي لا يرأف ولا ينتهي، هؤلاء "المحرومون من النساء سيّئو التغذية"، يرتدون السترات الفوسفورية ويعتمرون الخوذ ويصعدون عالياً إلى سماء لبنان، ساكتين في قفص مصعد أحمر، ويرون في بيروت ما لا تطاله أيديهم، بينما البواخر في الميناء تلوح وراء سلاسل الرافعات وشرارات المجلخ وخيطان الرمل الذي يهمي ناعماً من بين أيديهم حين ينخلونه. القضبان تُلوى قبل أن تصدأ في هواء البحر، ثم تسكب الخراطيم الضخمة إسمنتاً غامقاً يسيل داخل مربعات الحديد، المضفورة كسجادة في بطن الحوت الذي ابتلع يونس، مثلما ابتلع حيتانُ المستثمرين المدنَ.
شاحنة الإسمنت تجوب الطرقاتِ والأنفاق في نهاية الفيلم، والجبّالة تدورُ كعَينِ الدوّامة ومعها تدور عدسة الكاميرا وينقلب العالم الذي نراه. العمّال السوريون يرتقون مبنى لم ينهوا تشييده، كبرجٍ لُعِن بالصمت لا ببلبلةِ الألسنة، واحدٍ من أبراج الفردوس الذي يروّج له المقاولون في الدعايات، سجن شاهق أسّس عمّالهُ أقبيتَه أولاً ليقطنوها مثل ضحايا في أقبية المعتقلات. مثلهم مثل سجناء غوانتانامو، يسمعون هدير البحر ولا يستطيعون الوصول إليه. هبوب الريح أشدّ صفيراً في الأعالي. هنا الصمت هو النطق، وهو أولى من القصص، الصورة فيه واضحة كالفولاذ، والمثاقبُ وضربات المطارق تدوّي كدقّاتِ الساعة في رؤوس المحكومين بالإعدام.
سأفترض متفرِّجاً يفكّر، بعد انبهاره بالصور، إن إيقاع الفيلم مضجر، لأن الجمال وحده لا يكفي، لأنه أدرك، قبل انتصاف الفيلم، مفارقةَ البناء والهدم لدى الهاربين من دمارِ بلادهم ليبنوا بلداً آخر دمّرته حربٌ أخرى. فكرة الفيلم ومقدمته مدهشتان، ولكن ماذا بعد التقاط التناقضات وإبرازها عبر الصمت؟ أين الحوارات مع العمال، وأين أصواتهم الحقيقية؟ شتائمهم، مرحهم، نكاتهم، آمالهم، أي بصيص في هذه الحياة الكامدة المستباحة؟ لماذا لم يُذكر اسمُ كلّ واحد منهم؟ هل انتحر منهم أحد، أو هوى من شاهق لأن دُوار المرتفعات داهمه، أو فكّر بالمشنوقين الأكراد الذين عُلِّقوا من أذرعِ الرافعات في ساحات طهران؟ لأن مثل هذا المتفرّج يريد أن يسمع قصصاً واقعية، يريد الكلمات ليعرف من أين أتى هؤلاء الشبّان، ولماذا أتوا وكيف... إلخ، وقد يفكر لماذا لم يُذكَرِ العمال السوريون الذين قُتِلوا بعد اغتيال رفيق الحريري 2005، أو بعض المعلومات التي تضيء شيئاً من قتامة حياتهم في لبنان، أجورهم، أحوالهم القانونية... إلخ. أيُعقل أن هذا المجتمع أخرس بأكمله؟ بمضيّ الفيلم سيكتفي هذا المتفرّج المفترَض خائبِ الظن بقسوة الوصف، وكأن الفيلم ظلَّ عالقاً في التمهيد، كمقدمةٍ لقصص لن تأتي. ستتكرر المشاهد وتطول المراوحة على المسرح نفسه. قد تدفع هذه الخيبة بالمتفرّج إلى توصيف الفيلم بالمغرق في الشكلانية والإسراف في الصقل والتكثيف، أو إيلاء الاهتمام الأكبر للجماليات بعد دفن قصص الناس المهملين، أو قد يقول بحلول الرمزيِّ الجمالي محلَّ الواقعي، لينقلبَ الفيلم بالتالي ضد الشخوص الذين يتناولهم، مضاعفاً خنقَ العمال، متحولاً إلى إضافة جديدة في حرمانهم؛ أو قد يُقال إن البحث عن الفرادة الجمالية أفضى إلى تضييع جوهر الفيلم، وكأن العمال شخصيات ثانوية دورها الأساسي بناء هذه القصيدة البصرية المبهرة والثرية بالتفاصيل، أو إن السعي إلى جمال المشاهد، الصارخ أحياناً، قد جوّف هذا الجمال من عاديّته، وصنع مسرحاً الدمى فيه هم معذَّبون ساكتون حزانى، مُستعبَدون مجهولون، مُسْتَغَلُّون مُذَّلون "ببشراتهم الوسخة"، أو "أنصاف أمّيين"، مُسْتَضْعَفُون راضخون لا يحتجّون، منكبُّون على رتابة العمل كالآلات أو التماثيل. الفيلم لا يرحمهم أيضاً، يكتم أصواتهم، يفضح كآباتهم وأرَقَهم.
أفترض فيما تقدّم شططاً لا أرجّحه ومبالغاتٍ عاطفية الأسباب. أعتقد أن لالتزامِ العمال بالسكوت في الفيلم وقعاً أشدّ، ما لم نستعجل الفهم، وما لم نستسهل التوصيف لحصر المخيلة في التقريرية والتوثيق والمباشرة وإيصال الرسائل. علينا أن نحدس ما لا يُقال. هيمنة المشاهد البطيئة أو شبه الساكنة، بعد انتقائها بعناية، يحيل إلى فكرة أخرى أساسية هي اللامرئي. نحن لا نرى هؤلاء العمال عادة؛ مُهدِّمو البيوت والمجرمون في حروب سوريا ولبنان لامرئيون أيضاً، ومثلهم المشغّلون أصحابُ المشاريع ومالكوها، وجميعهم يستوون عند هذه النقطة في شكل فظيع من المساواة. أما العمّال فهم اللاأحد الموجود في قلب الصمت، لا أحدٌ كثير ومشجوبُ الاسم، يتقاسمون مهجعاً واحداً، يعيشون مثل رجلٍ واحدٍ يوماً واحداً يتكرّر، يضعون إبريقَ شاي على سخّان غازٍ نقّال ويفتحون علبة سردين ويلمع زيتها على رغيف لبناني مفرود على الأرض ولُقَمهم الكبيرة مغمسة بمذاق الإسمنت، يتفقّدون الأخبار العاجلة على هواتفهم الجوّالة، يدخّنون وهم يسمعون موّالاً على ربابة، يفكُّون المصباحَ الساخن بمنشفة قبل أن يناموا وسط الأشرطة الكهربائية الممدودة في الرطوبة والمطر، ثم يسرحون شعورَهم أمام مرايا صغيرة في الفجر ويرتدون قمصان نادي برشلونة أو أرسنال، ويطوون البطانيات الصينية التي يتدثّرون بها والكراتينَ التي يفرشون عليها إسفنجةً وسّدوها أحجار بلوك أو ألواح خشب. غير بعيد عنهم، تصوّر الكاميرا دبابات ومدرَّعاتٍ تجتازها الأسماك، بعد أن أغرقتها الحربُ الأهلية اللبنانية في مياه المتوسط.
يزخر الفيلم بتقابلاتٍ مجازية قد يُستغرب تكرارها، مثل الطباق بين رافعة البناء التي تدور كمسدس هائلٍ مسدَّد على بيروت وبين مدفع الدبابة التي بدت مثل لعبة فيديو تجوب خرائب مدنٍ سورية، شأنهما شأن الأشكال القضيبية العملاقة للبرج وأعمدته. في جوِّ الرجال الخالص هذا، يثقِلنا الصمت والبطء ورتابة الأيام، وتشارك مخيلاتنا في تأليف الحكايات، هذا إن استطعنا تخيل سيرة أي عامل وماضيه، لعلهم لا ينطقون بخباياهم لأنهم يخشون الاعتداء عليهم والاشتباه بهم والترحيل إلى سوريا ومن ثم منع الدخول إلى لبنان وخسارة عملهم، يخافون أن يطردهم المشرفون على الورشات أو عناصر الأمن العام.
العامل الراوي، الشابّ الناجي، تعيده رعودُ العاصفة وبروقها فوق البحر إلى الغارات الجوية على بلدته حين أوشك حطامُ بيتهم يدفنه حياً. في المعاجم، القاصف هو "الرعد"، وإذا مددنا المجاز قليلاً قلنا إن قصف الرعود أشبه بضجة براميل فارغة تتدحرج في السماء التي تضخّم الأصداء. صوت الراوي حبيسٌ داخل جسده، وقصته المسرودة من ذكريات الطفولة، حول أبيه الذي كان بدوره عامل بناء في بيروت، تتوازى مواربةً مع مشاهد الفيلم، ذكرى مستعادة أشبه بقصة رمزية أو منام بينما غبار المنازل التي هدّها القصف يزوبع كالثلج. يرسم الراوي بقلم الرصاص أمَّهُ الميتة، شبيهة بالطفلة في أحد المشاهد الأخيرة من فيلم «المتعقّب» لتاركوفسكي، ولعل في التفاصيل "الشعرية" لهذا الفيلم ما يذكّرنا بالمعلم الروسي، ولكننا هنا، في «طعم الإسمنت»، أمام سرد جافّ لا يرحم، مجتزأ من واقع لا يرحم، له خشونة قفازات العمّال الذين أكل الإسمنت أيديهم ومحا بصماتِ أصابعهم. يتذكر الراوي البحر حين كان مجرد صورةً في طفولته، بينما بحر بيروت الآن معلَّق أمامه كصورة أخرى أضخم، وهو مجبَرٌ على السكنى حيث يكدح من الفجر إلى الغروب ولا يستطيع الخروج: شوارع المدينة القريبة المكتظّة بالسيارات بعيدة عنه رغم كل هذا القرب.