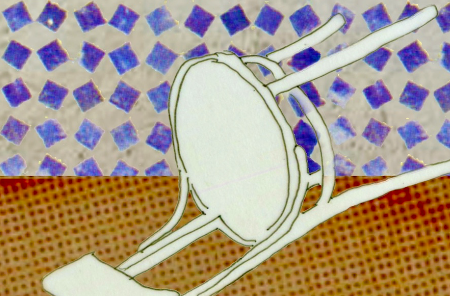هناك، وجدت شاباً لا يتجاوز عمره ثلاثين عاماً قال لي تفضلي بالجلوس فجلست على مقعد بجوار مكتبه المتواضع لكنه طلب مني أن أجلس مقابله! فتعجبت وشعرت كما لو أنني تلميذة تطلب مني المدرّسة أن أغير مقعدي. وكان المحقق لبقاً ومهذباً وكنت أكظم غيظي وإحساسي الفظيع بالذل. وأعطاني
منذ أيام، في الثامن من هذا الشهر، كنت جالسة أستمتع بالفطور وجبنة اللاذقية (المسنرة) اللي لا تعادلها كل أجبان فرنسا وكانت الساعة حوالي العاشرة صباحاً، وكنت -لحسن الحظ- بمزاج مرتفع ربما لأن الشمس الحنونة ( الشمس وحدها حنونة في سوريا ) تغمر صالون بيتي، تلقيت إتصالاً من رقم مجهول وصوت شاب مُحايد يطلب إلي أن أراجع فوراً جهاز أمن الدولة قسم 4 غرفة 3. وعلقت لقمة الجبنة في حلقي واحتجت لشرب عدة كؤوس من الماء لبلعها ووجدتني عاجزة عن بقائي في وضعية الجلوس فوقفت وأخذت أتوه في المكان غير مستوعبة شحنة الذعر التي دبت فجأة في جسدي روحي كتيار كهربائي صاعق.
وجدتني أتصل بالرقم إياه وأسأله: خير ما الموضوع ؟ لماذا تستدعونني إلى أمن الدولة ؟ فقال: لا أعلم أنا دوري مجرد التبليغ. فقلت له هل يمكن أن أتحدث إلى الضابط إياه؟ فقال: لا. فوجدتني (وأنا بالمناسبة سريعة الانفعال) أجيبه بعفوية: أختي طبيبة في باريس تتصل بوزيرة العدل وتكلمها ببساطة ووزيرة العدل تستمع لها بكل احترام. فرد علي: هذا ليس من شأني. وخطر لي أن أؤجل ذهابي حتى اليوم التالي لكن خيالي صفعني للتو بصور من فيلم ”الخوف“، بطولة سعاد حسني ونور الشريف رحمهما الله، وكيف ماتا من الخوف قبل أن تداهمهما أجهزة المخابرات. لبست ثيابي على عجل ونسيت أن أمشط شعري، ولم أخبر إلا إثنين من أعز أصدقائي، هذين الرائعين الذين لم ينفضا عني كما انفض عني الكثيرون من مبدأ (ابعد عن الشر وغني له)، أحقر مثل في العالم (برأيي)، ومررت بشوارع اللاذقية القذرة وأكوام القمامة في كل زاوية.
نظر إلي سائق التاكسي نظرة ارتياب فما الذي ارتكبته امرأة لتذهب إلى أمن الدولة! بالتأكيد أنا امرأة خطيرة ولم يستطع أن يقمع فضوله فسألني بلهجة أهل الصليبة: خير أختي شو عاملة! فقلت له: لا أعرف. ووصلت الحواجز الحديدية الثخينة العملاقة ووجدت حفنة من شباب بلادي يلبسون البدلات المبرقعة ويحملون البواريد بدل القلم والكتاب. واستقبلوني بلطف حقيقي وأحسست بحب لا يوصف لهم لأنني واثقة بأنهم مجبرين على هذا الدور. ومشى معي أحدهم حتى قسم 4 من مبنى المخابرات ودلني إلى الغرفة 3.
هناك، وجدت شاباً لا يتجاوز عمره ثلاثين عاماً قال لي تفضلي بالجلوس فجلست على مقعد بجوار مكتبه المتواضع لكنه طلب مني أن أجلس مقابله! فتعجبت وشعرت كما لو أنني تلميذة تطلب مني المدرّسة أن أغير مقعدي. وكان المحقق لبقاً ومهذباً وكنت أكظم غيظي وإحساسي الفظيع بالذل. وأعطاني عدة أوراق بيضاء مطبوع عليها أسئلة واستفسارات معينة وطلب مني أن أملؤها بينما يعود، وكنت كل لحظة أنظر إلى ساعتي وأعتقد أن الزمن توقف. وأذعنت لطلب الشاب وبدأت أملأ الأوراق: الاسم والكنية واسم الأب والأم والأخوة والأخوات وأولادهم وكان بجانب كل اسم أكتبه عبار ”هل هو موال أم معارض“ وكنت أكتب طبعاً بأن الجميع موال. والحق أقول أن في كل أسرتي لا أحد معارض وكلهم يلومونني لاهتماماتي الإجتماعية والسياسية ويخشون علي. ولكن مهزلة المهازل بأن الشاب (الضابط) وكان يلبس لباساً مدنياً سألني بتهذيب ولباقة لماذا تركت بعض المساحات فارغة فقلت له لأن زوج أختي فرنسي ولا يعرف العربية وزوج ابنتي إيطالي ولا يعرف العربية ، فكيف أعرف إن كانا مواليين أم مُعارضين للسياسة السورية، وكل مواطن يهتم بقضايا وطنه. فقال: لا يجوز يجب أن تكتبي. فكتبت بأن صهري الإيطالي وزوج أختي الفرنسي مواليان للنظام في سوريا. وفجأة غمرني شعور طافح بالمرح وتأكدت أنني ذات يوم سوف أستثمر تلك اللقطة في رواية أو قصة قصيرة. ولم أنتبه إلى أن الشاب عاد إلى الغرفة وفي يده أكداس من الأوراق هي مقالاتي كلها وبدا لي أن ثمة سطوراً في المقالات ملونة باللون الأخضر الفاقع مما يشير لخطورتها.
سألني: لماذا تغيرت! أنت طوال عمرك كاتبة مرموقة وأنا شخصياً حضرت لك عدة محاضرات ثقافية في مراكز ثقافية عديدة في اللاذقية ودمشق وحلب، ووجدتني أقول له وفي المركز الثقافي في مخيم اليرموك هل تذكر! فلم يرد. بالتأكيد كانت وظيفته كتابة ملخص عن محاضراتي وعن محاضرات كل الكتاب. وسألني هل تعتقدين أن ما حصل ثورة! وكما لو أن كلمة ثورة هي تهمة وجرم لا يمكن الخلاص منه. فقلت له: في سوريا كمعظم العالم العربي كنا نملك مقومات الثورة مثلاً الفساد والمدراء اللصوص الذين لا يُحاسبون ويسرقون المال العام! والفقر وانعدام حرية الرأي والسجون التي تغص بمعتقلي الرأي وقسم كبير منهم مات تحت التعذيب! ألا ترى معي أن هذه مقومات للثورة، فانتفض محاولاً كبت غضبه وقال: والآن إلى أين أودت بنا هذه الثورة ؟ قلت ببرود: الثورة فشلت وخُطفت وسُرقت وسوريا تدمرت. فقال: يعني أن ما تسمينه ثور لم تعد ثورة. أحسست بتشوش أفكاره فقلت له: ماذا تريد مني! ماذا تريدون من طبيبة عيون خدمت سوريا أكثر من ربع قرن وبراتب الاحتقار ومن كاتبة تعرضت مراراً لإزعاجات الأمن ومُنعت من السفر، لولا تدخل إنسانة رائعة (من الطائفة السنية الكريمة) وذات منصب سياسي عالي لما تمكنت من السفر لأنها ألغت قرار منع السفر عني! فقال لي: يعني أنت واصلة! سألته ماذا تقصد بواصلة! وتخيلت سلماً يصل حتى السماء! قال: يعني ثمة شخصيات مهمة تساعدك فقلت له الحمد لله أن في هذا النظام بعض الشخصيات التي تُعد على أصابع اليد الواحدة تحترم المثقفين. قال لي: لما تركت الكتابة بجريدة الثورة السورية بعد بداية الثورة!! فقلت له مازحة: على أساس أنت ضد كلمة ثورة فكيف تستعملها. وكنت أكتب كل خميس في جريدة الثورة مقالات عن كتب قرأتها أو عن مشاكل بيئية وإجتماعية.
لم أجد عذراً (خاصة أنني لست سريعة البديهة) غير أن أقول له: والله في تلك الفترة تعرفت بالأستاذ طلال سلمان رئيس تحرير جريدة السفير وابنته هنادي الحاصلة على دكتوراة في الإعلام من جامعة جورج واشنطن، ووجدتني أتقن حماية نفسي وأنا أقول جملتي المعترضة التي ستنقذني ن كل أذى مُحتمل: على فكرة الأستاذ طلال سلمان يحب حسن نصر الله حباً جماً، وشعرت وأنا أقول هذه العبارة أنني رفعت حبل المشنقة عن عنقي. فسألني بإلحاح: لكن أما كان باستطاعتك أن تستمري في الكتابة بجريدة الثورة. فقلت له: لا. لأن الكتابة تتطلب جهداً كبيراً وقراءة مكثفة الخ. فأخذ يقلب في أوراق مقالاتي ويقول لكنك كتبت في العربي الجديد وفي جيرون وفي الحياة. فقلت أجل. وأكتب أيضاً في جريدة نزوى والدوحة والعرب اللندنية الخ. فقال : لكنهم أعداؤنا. فقلت الثقافة تلغي العداوات وأنا حرة أن أكتب ما أريد، أنا شاهدة على الحقيقة. فسأل: أية حقيقة؟ قلت وقد بلغ غيظي أوجه: حقيقة أنك (وجهازك الأمني المصون) تشحطاني من بيتي وقت ما تريدون ولا تحترمون أنني إنسانة ذات مستوى كاتبة وطبية أي أنني أجمع أرقى مهن إنسانية في العالم وذكّرته بيوم اتصل بي أحد عناصر جهاز الأمن في الواحدة ليلاً ليبلغني بضرورة شرب فنجان قهوة مع الرائد الفلاني صباح اليوم التالي . وطبعاً لم أنم وطلع الفجر وأنا مهدودة القوى ومحطمة من شدة التفكير في الإحتمالات الممكنة لاستدعائي واعتقدت أن السبب كوني أكتب في جريدة العرب القطرية وكنت أكتب كل يوم إثنين مقالاً ثقافياً فيها.
حدقت في عيني الشاب المحقق وقربت وجهي من وجهه وقلت له: أتعرف السؤال الأول الذي سألوني إياه لما طلع الفجر ورحت إلى جهاز أمن الدولة ؟ قال: ما السؤال؟ صرخت: السؤال كان: هل نمت!!! هذا ما كان يهمهم ألا أنام وأن أقضي ساعات الليل الأبدية حتى طلوع الفجر وأنا مُروعة من الذعر والخوف. لم يعلق بكلمة. فألححت عليه أن يعلق. فلم يرد وعاد ليقلب في أوراق مقالاتي. وانقلب الوضع، قلت له أنا من يجب أن يسأل: لماذا لم تعرضون فيلم «هوى» المأخوذ عن روايتي «هوى» والذي اشترته المؤسسة العامة للسينما والذي كلف المال العام أكثر من 30 مليون ليرة سورية حين كان الدولار بـ 50 ليرة سورية؟ مع أن البطلة سلاف فواخرجي هي من أشد الموالين للنظام. لم يجب ثم طلب مني أن أرافقه إلى غرفة المعلم، أي الذي يفوقه رتبة وفي الواقع أنا لا أعرف ثقافة تلك الرتب فالكل أسميهم ضابط أو أستاذ (ولا أعرف لماذا تغيظهم كلمة أستاذ) . وللحق أقول أن رئيسه الضابط كان رجلاً لبقاً جداً وأحسسني بالاحترام والتقدير وبدا واضحاً أن ثم جهة ما (في حكومة الظل) طلبت منه شحطي إلى جهاز الأمن ودار حديث قصير جداً بيننا، حديث إنسان لإنسان وسألني لماذا لا تعيشين في باريس مع أسرتك.
قلت له لأنني عاشقة لسوريا، وخانني صوتي واختنق بالدم كما أحسست وليس بالدمع، بدم السوريين الذين ماتوا. نظر إلي بتقدير وقال لي: يمكنك الانصراف. وخرجت من جهاز أمن الدولة وسط دعاء وفرح المجندين الشبان الذين كان أولى بهم أن يكونوا في الجامعة. أحسست أنهم فرحوا لي كوني لم أعتقل. ولم أطلب تاكسي، تسكعت في شوارع مدينة يخنقها الحديد والحواجز الحديدية والاسمنتية ومع ذلك تتجرأ أشجار زهر الليمون أن تُزهر وتتحدى الحديد بشذى الحرية. كنت مهدودة القوى ولا أتبين مشاعري. وفكرت أنني أحب وطني لكن وطني يكرهني. ولست واثقة إن كانوا سيستدعونني بعد نشر هذا المقال. لكنني مصرة على نشره لأن لا ولاء لي إلا للحقيقة. ولأنني لا أتغذى إلا من الحقيقة وشرف الكلمة أما هؤلاء الفئران الخائفة التي تخلت عني خوفاً مني لأنني ”صوت الحق“ فلتعش آمنه في المجارير. لكن ما إن وصلت إلى المقهى إياه في ساحة الشيخ ضاهر حتى انطويت من الضحك وأنا أستعيد لقطة كيف كتبت أن صهري الإيطالي وزوج أختي الفرنسي مواليان للنظام السوري. يوم جديد، أمل جديد، أحبك سوريا.