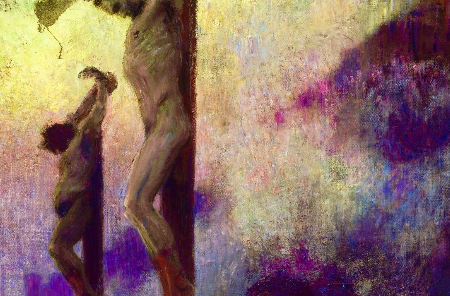أحلامٌ بحياة يعيشها العاديون، أولئك الذين يرتاحون قليلاً على أعتاب العقد الرابع، كي يبنوا على ما أنجزوه. أما أنا، فلم أنجز شيئاً: لا مال، ولا بيت، ولا جواز سفر محترم، ولا صديق يصدُقني، ولا اسم يلمع، ولا خطة للمستقبل، ولا حتى عمل يسد الرمق. لا شيء على الإطلاق: معلق بين السماء والأرض بمشكاة نور لا أستطيع حضنها في قلبي.
أنظرُ إلى الوراء
ها!
لا أثر للجبل الذي هبطتُ منه.
أين أنا؟
يهُب نسيم خريفي ثم يذوي
كجِلد حيةٍ مُنسلخ.
الشاعر الكوري كو أون. قصيدة زن.
(1)
في مراهقتي، كنت أخشى أن أصبح في الأربعين: اعتقدتُ أن المرء يصبح عجوزاً مملاً متحجراً، لا يعجبه شيء ولا أحد يُعجب به.
كنت مصيباً تماماً في مخاوفي: هذا بالضبط ما حصل لي.
في الأربعين، يصبح المرء ملولاً، متوحداً، عاجزاً عن فهم التطورات في التكنولوجيا، يخشى على جسده الذي يبدأ بالتداعي بوقاحة تافهة: أسنان صفراء وكرش يصغر ويكبر، وأمراض جديدة وغريبة تطفو على الجلد وتتمرّغ في اللحم؛ حتى الشهوة تبدأ بالتراخي قليلاً. شعر رمادي على الرأس واللحية وفي الصدر، ونظارات سميكة لنظر لا يرى البعيد بعد الآن، وتعب يتسرب إلى الأكتاف والرجلين والعينين من أزقّة طبيعية وضيعة غير مرئية.
مضى نصف العمر، ولم أفهم منه الكثير، كأنني كنت في واحدة من تلك المغامرات التي يقضيها المرء على الطرقات، علّه يصل إلى نهاية مفهومة، إلى خاتمة مُرضية، إلى تلّةٍ يشرف منها على المعاني. ولكن مغامرتي تشبه مغامرات المخرج الألماني فيم فاندرس في ثلاثيته عن الطرقات، أو رحلات الكاتب الصيني "غاو شينغجيان" في "جبل الروح"، أو أسفار المعري في الجحيم والفردوس: رحّالة يبحثون عن شيء ما: لا يجدونه، ولا يجدون ما يعوضهم عنه. رحلة مُربكة مرتبكة مثيرة متعرجة تسعى إلى هدف، ولا تصله: هذه كانت حياتي اللاهية العابرة الغابرة اللقيطة.
كان حلمي الشخصي الوحيد أن أصبح قاصاً. أحب القصص والنصوص الأدبية، وأعيش معها. لا أعيش لها، لا أبالغ في معنى الأدب وأهميته. الأدب وجه واحد من وجوه الحياة البشرية المتعددة المختلفة: الصداقة، المال والبنون، المدينة، النوم، الانفجار العظيم، "حلاوة الجبن"، البحر والغجر والشجر، "الشوارع الحواديت"، الركض، البطيخ والبرتقال، ثرثرة فارغة مع أصدقاء قدامى، وأشياء أخرى كثيرة لا حصر لها.
ولكنني أخاف الأربعين، بسبب القصص وأصحابها. معظم القاصين الذين أتتلمذ على أيديهم ماتوا قبيل أو بُعيد الأربعين: أكوتوجاوا انتحر في السادسة والثلاثين، تلميذه ومريده أوسامو دازاي انتحر في التاسعة والثلاثين، تشيخوف مات مريضاً في الثانية والأربعين، موباسان مات مجنوناً في مشفى الأمراض العقلية في الواحدة والأربعين، صادق هدايت انتحر في الخامسة والأربعين، سعيد فايق عباسي مات مريضاً في السادسة والأربعين، سعادات حسن مانتو مات فقيراً مريضاً نصف مجنون في الثالثة والأربعين، إسحق بابل مات مقتولاً في الرابعة والأربعين، ريموند كارفر مات في الثامنة والأربعين. هؤلاء شيوخ الطريقة. بالطبع لدينا آخرون عمّروا طويلاً، بورخيس وإبراهيم أصلان، على سبيل المثال. ولكن هذان لا ينتميان إلى عشيرتنا: رجلان يتمتعان بهدوء نبيل، وعمق فلسفي وميتافيزيقي أصيل، وفهم حاد لكل ما يدور حولهما وفيهما. كلا، القُصّاص الذين ماتوا مبكراً لم يفهموا الكون، لم يدركوا ما حدث، أو ما الذي يحدث: وكتبوا كأنهم يموتون غداً. وماتوا. كتبوا عن حياة فيها شر وجهل، وعن تائهين وحائرين ومهزومين، بعضهم متمسك بالمعنى وبما لا يُمسك وبعضهم لا يُمسك شيئاً. تنوعت أساليبهم جداً وتناسلت وتفاوتت، ولكنهم جميعاً عاشوا حيوات بائسة مريضة، انتهت بموت مبكر مؤلم حزين.
أنا أيضا أكتب لأنني لا أفهم الكون، ولأنني لا أعرف ما الذي يمكن فعله على وجه الأرض. أشارك أساتذتي الجهل بالحياة، والارتباك في فهم أبسط الأمور، والتلجلج أمام اليومي العادي، والتوق -غير الصادق تماماً- إلى الماورائي: التوق الذي يعرف جيداً أن الماورائي متعال وغير ممكن، بالضبط كاليومي العادي المتفلت من الفهم. وأشاركهم الخوف من الموت، والقناعة بأنه قريب جداً: منذ مراهقتي، وأنا أحدس بأنني سأموت في الأربعين. ليست نبوءة عرّافة، بل كشفاً صوفياً خصّني به إله أزرق، ولم يفتح بصيرتي على كشف آخر قط. وأشاركهم الشعور العجيب الخارق الصاعق بالوحدة، وباكتئاب هو ربيب الوحدة وقرينها. ومثلهم، أكتب كي أتخلص من وحدتي، مؤقتاً على الأقل، قبل أن يأتي اليوم الذي قد يكون بداية العزلة الأبدية.
المراهق في داخلي لا يصدّق أننا في الأربعين، وكذلك الطفل والشاب الذَين كنّاهما: طفل ما زال يخاف الناس والوحدة والظلمة ومواجهة النفاق والعلاقات العامة، والشاب الذي رأى أحلامه تتصدع وتتفرفط وتتناثر كفقاعات صابون ضخمة يلهو بها مهرجون متعبون يكسبون عيشهم بإضحاك الناس.
أحلام ضائعة، تتكاثف فوقها أحلام جديدة عملية، تلائم الكهولة: أن أشتري "جلاية صحون" كهربائية، وأنقص وزني إلى 78 كيلوغرام (الأمر الذي أعمل عليه بجدية منذ ما يقارب سبع سنين)، وأزور أهلي الذين يكبرون بعيداً عندما يمرضون، وأطمئن قبيل نهاية الشهر على ما بقي في الجيوب؛ وبالطبع، أن أعيش في مكان أدفأ قليلاً، في القلوب وفي الجلود.
أحلامٌ بحياة يعيشها العاديون، أولئك الذين يرتاحون قليلاً على أعتاب العقد الرابع، كي يبنوا على ما أنجزوه. أما أنا، فلم أنجز شيئاً: لا مال، ولا بيت، ولا جواز سفر محترم، ولا صديق يصدُقني، ولا اسم يلمع، ولا خطة للمستقبل، ولا حتى عمل يسد الرمق. لا شيء على الإطلاق: معلق بين السماء والأرض بمشكاة نور لا أستطيع حضنها في قلبي.
ولكن، ما الذي كان علي تحقيقه وإنجازه، كي أُرضي الكهل الذي دخل في الأربعين؟ لست واثقاً تماماً. البيت؟ السيارة؟ اكتئاب أقلّ، أرقٌ أرقّ، ألفة أمتن؟ أن أصلح خطيئة انتقالي إلى مملكة الدنمارك الفاشية، وما نتج عنها من انهيار عالمي الشخصي؟ هذا غير ممكن، فحياتنا قاسية، كقسوة قلوب الخوارج والمعتزلة: لا تُغفر خطايانا، لنقضي العُمر كالكفرة والفاسقين في نار خالدة.
يقول الشاب إن الخسارات جمعية: ثورات مهزومة وحروب أهلية ومجازر بالسلاح الأبيض وبالكيماوي. ربما؛ ولكنني، الآن، أقل نزقاً وثقةً وتفاؤلاً بالمستقبل منه: هل ستكون الدنيا أرحب، لو عشتُ في بيت صغير في دمشق، أكتب وأقرأ على ضفاف بردى الهزيل الشاحب، قصصاً عن أولئك الذين لم يفهموا ما يحصل؟ أليس هذا بالضبط ما أفعله اليوم، في أقصى الشمال البارد؟
الرواقيون والبوذيون يدعوننا إلى قبول الواقع، بعد أن يصوّروا العالم المادي والشر والهزائم على أنها وهمية. هذا أمر لم أقتنع به يوماً. أفضّل فلسفة مختلفة تماماً، تعرف الألم وتعترف به، ولكنها تتجاوزه، بمزيج من التأمل الهادئ والسعادة، وبالقليل من الأسى. ربما متأثراً بعمر الخيام، لخّص أحمد رامي هذه الفلسفة في قصيدة "يا دنيا ياغرامي"، التي خالفت الغناء العربي الرومانسي الممل المكرّر، وأدخلت معان جديدة على فقه الطرب الشعبي، يهتف فيها محمد عبد الوهاب الهادئ الرزين، وهو على أعتاب الأربعين:
" يلا اقطفها، قبل أوانها، ده العمر خيال…"
(2)
ما الذي أذكره، من العقود الأربعة الماضية؟
أحداث متناثرة متداخلة، لا تحكي قصة مترابطة ولا تقدّم عظةً ولا تشير إلى ما ورائيات؛ أحداثٌ تكاد تكون بدون تواريخ فعلية، حفرت في الذاكرة لأسباب متعددة: لأن كل وجودي الفردي الشخصي الخاص تكثف فيها، أو لأنني كنت عاجزاً أمام الحزن الذي جسدته، أو لأن فيها فرحاً حسياً أكد لي أن حياتي القصيرة لم تكن عبثية كلياً: قائمة قصيرة بسيطة واضحة، كطعم الليمون الحامض (كتمتُ منها القليل هنا، كتمتُ تلك البقع المتخثّرة كتجلّطات في الروح):
-
على باب مدير المدرسة الابتدائية وأنا في الصف الثاني، باكياً يأكلني الذعر، بعد أن وشت بي الطفلة التي عشقتها: قبلتها في فمها ثلاثاً.
-
بيرة غينيس السوداء، للمرة الاولى أتذوقها، في "القرية الإيرلندية" في دبي.
-
رحلة مدرسية إلى شلالات تل شهاب.
-
شهور بدون أوراق نظامية في إسطنبول: أكثر أيام حياتي سكينةً وسلاماً وتأملاً.
-
أشعار دو فو وأورهان والي وإيميلي ديكنسون.
-
سعيد حورانية يتبادل السلام مع فاتح المدرس، فيما الجيران يتهامسون: "شيوعيون كفرة."
-
شوارب محمود في "أيام شامية".
-
شباط 1995، مساء ماطر عاصف في دمشق، وأنا أنتظر فتاة لم تأت ساعتين ونصف: لم يسمح لها أهلها بالخروج.
-
أول الخريف في "نوريتش".
-
ناظم الغزالي يغني المتنبي "لياليّ بعد الظاعنين شكول"، ويوسف عمر يغني أبا نواس "والله ما شرقت شمس"، وصباح فخري يغني جرير "إن العيون التي في طرفها حور".
-
صبية روسية، بعد نقاشات جادة عميقة عن الكوكايين وأبيها السجين وتورغينيف وحادثتي اغتصاب جماعي تعرضت لهما وعشيقها المدمن وخالتها التي ربتها ومحبتها للأميرة ديانا، تهمس بجديّة أخويّة: "أنت طيب جداً يا ولد، ووحيد بالفطرة. لن تعيش حياة سعيدة، أؤكد لك." تقبّلني على جبيني، وتمضي إلى عملها القبيح الليلي اليومي.
-
خطط مؤجلة للانتحار.
-
"رقّ الحبيب" و"طلعلي البكي".
-
تكبيرات العيد تطن في رأسي، وأبي تائهاً في مقبرة "الدحداح" المزدحمة، بعد أن زرنا قبر جدي، باحثاً عن قبر جدته لأبيه: قبور على مد النظر، وشواهد كثيرة، وفروع نبات "الآس" تملك المكان: قبور صغيرة وكبيرة ومتوسطة الحجم تتراكم فوق بعضها البعض بفوضى عجيبة تشبه البلد ومشاعرنا، وعمي يمسك كتفي بقسوة، ثم يعتذر: "انتبه، كدت ان تطأ ذاك القبر الصغير".
-
فتاة بولندية تتنبأ بالمستقبل بدقة مذهلة: "عندما تقرأ شيمبورسكا، ستفهم أخيراً ماهيّة الشعر."
-
شريهان، أول من عشقتهن في التلفاز، بعدها آثار الحكيم في "ليالي الحلمية"، ثمّ "كرّت المسبحة" أيام المراهقة: غرباً وشرقاً وشمالاً وجنوباً، سمراوات وشقراوات وطويلات وقصيرات وممتلئات ونحيفات… إلخ، لا أتذكرهن جميعاً الآن.
-
جدتي تضمني باكيةً، فيما صوت صارخ بغضب وحقد من وراء الباب المغلق: "الطفل المسلم لن يدخل بيتنا أبداً!"
-
عمال هنود يغازلون فتيات من جنوب الصين ونادلات من الفيلبين وسكون على بحر العرب الهادئ الصامت في بار غريب وديع في "عجمان"، وصديق العمر الفلسطيني المرح وأنا، وحدنا عرب في هذا البار الذي لا يرتاده العرب أبداً، هذا المكان الموحش المعتم كبرزخ بين العوالم: يشرب كثيراً، ويثرثر قليلاً، ويتأمل فقرنا وفقرهم وسكون البحر في موجه.
-
ديفيد هيوم و"نقد العقل المحض".
-
أبي يعلمني كيف أحلق لحيتي: "جدّك علمني ذلك. لا تستخدم تلك الماكينات الكهربائية أبداً، ليست مناسبة لنا، بكثافة شعرنا هذه."
-
أمي تشتري عشرات الدفاتر والأقلام بالجملة، كي نوفر بعض المال قبيل بدء السنة الدراسية، من مكتب توزيع قرب الجامع الأموي، قبل أن ندخله سويةً، لنزور قبر "يوحنا المعمدان" ورأس الحسين.
-
محاولات فاشلة لفهم تفاصيل الزمكان من نظرية آيشنتاين النسبية العامة.
-
حفلة عرسي الصغيرة الحميمة، التي لم يستطع والديّ حضورها.
-
الحرافيش والثلاثية وميرامار والصداقة الصدوقة في قشتمر.
-
ضباب كثيف على طريق بلودان.
-
في محطة قطارات "ليفربول" في لندن، جالساً على الأرض، أضمّ حقيبتي الضخمة، أكذّب عينيّ، غير مصدّق، والشاشة الكبيرة تنقل صور اقتحام "الجيش العربي السوري" لمدينتي حماة ودير الزور، في الأول من آب 2011: يوم وصولي إلى لندن، مغادراً دمشق للمرة الأخيرة.
-
فتاة سورية محجبة متعبة لاجئة في العشرين من العمر، في "إزمير"، تقول بصفاء الأولياء: "أعرف أنك علماني، ولكن كل هذا العذاب الذي نزل بنا ليس مجانياً: يجب أن يكون هناك عدالةٌ ما، أو شيء كالعدالة، في النهاية.
أليس كذلك؟"