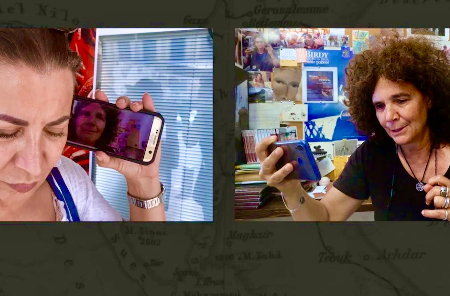في هذه الأفلام الثلاثة نحن أمام امتداد الأمل بالحياة المكررة المملة دون أن تكون مفتتة بسبب جدارٍ أو حصارٍ أو حاجزٍ أو أيدولوجيات، فنرى كيف يعيش الفلسطيني حيرة البقاء، ورغبة في تغيير وضعه، وانسحاقه في نظام استعماري أكبر منه، وفي حكم سلطة وطنية لا تجد حلولًا لمصيره بل تزيدها تعقيدًا.
لم يحذّرني أحدٌ أنني حين أشاهد فيلم "200 متر" سأشعر بهذا التناص بينه وبين فيلم "غزة مونامور"، وبعدها بأسابيع سأشعر "الديجافو" نفسه مع فيلم "الهدية"، على الرغم من أن الأعمال مختلفة وبمدارس إخراج وحكايات متباعدة عن بعضها البعض.
إلا أن التفاصيل الحميمية، والحوار التلقائي، وديكورات المنزل البسيط، والمشاكل اليومية للطبقة العاملة العصامية التي تكاد تكون فقيرة، ومع ذلك تتابع برنامج ناصر اللحام السياسي، وهي اللقطة التي ظهرت في فيلمين منها على الأقل... أليست هي حياة ملايين الفلسطينيين، الإنسان الذي لا يريد أن يكون بطلًا بل يريد أن يعيش حياته اليومية، لكن القضايا الكبيرة تدخل حياته بالرغم منه.
ويتحول على الرغم منه، من إنسانٍ إلى فلسطيني، نعم هكذا ببساطة، ويصبح معرّفًا بالتشتت، وجدار الفصل العنصري والتنقل الذي يكاد يكون مستحيلًا، بعد أن كان كلّ ما يحلم به ساعاتٍ يختلي بها مع زوجته كما في "الهدية" و"200 متر". أما في "غزة مونامور" فيتلبّس الإنسان هناك الحصار والانقسام وإشكالية الهوية الاجتماعية بسبب الاحتلال بشكلٍ أساسي الذي يتواجد في الفيلم كمهيمن على مسار الحياة وشكل القدر الذي يتحكم بالفلسطيني دون أن يتواجد بالشكل التقليدي من حربٍ ورصاصٍ واعتقالات.
وهذا ما يجعل "غزة مونامور" و"200 متر" و"الهدية" أفلامًا تؤجل الفلسطيني قليلًا لتظهره لنا كائنًا غير مقدس للمعاناة، عبر تفاصيل يومية روتينية من حياة الأبطال التي لعب أدوارها باحترافٍ وخفة سليم ضو في "غزة مونامور" وعلي سليمان في "200 متر"، بل إن سليمان حمل الفيلم على ظهره أحيانًا، وصالح بكري في "الهدية".
ولا يمكن تجاهل أن العديد من الأفلام التي تمت صناعتها مؤخرًا اختلف فيها خط الوعي الدرامي، فغدت كاشفة أكثر عن عيوب هذا الفلسطيني، وعبثت بصورته الأيقونية في ذاكرة وخيال المتلقي، أي خارج الصورة النضالية تمامًا، فلا كليشيهات أو شعارات رنانة أو اشتباك مباشر.
ما يحدث هو مغامرة جريئة من أفلامٍ طويلة أو قصيرة تقدم ما هو غير متوقع من السينما الفلسطينية، فإما تنجح تمامًا أو تفشل تمامًا، وغامرت هذه الأفلام الثلاثة، خاصة "غزة مونامور" و"200 متر"، بينما فيلم "الهدية" توجه إلى الجانب الآمن أكثر في مواجهة قصيرة وحاسمة ومتوقعة بين الجندي المحتل والأب الذي يعيش تحت الاحتلال، إلا أن الثلاجة أبقت السرد خارج المألوف وحثّت الإثارة في الفيلم، لذلك نرى عناصر الإيقاع المتوازن والتشويق والحسم توافرت في 20 دقيقة أطلقت الفيلم مباشرة إلى القائمة القصيرة للأوسكار، وجائزة أفضل فيلم قصير بافتا للمخرجة الفلسطينية البريطانية فرح نابلسي.
إن كسر "الستريوتايب" لصورة الفلسطيني ومعاناته المثالية وإيقاع المأساة المتكرر، ومخالفة المتفق عليه لملامح شخصيته وحكايته في السينما والأدب، والاكتفاء بمشاهد بسيطة حقيقية من الواقع لكن تحكي قصة كبيرة، وتحطيم صورة البطل بعد أن كان يظهر ثبوتها من ثبات قضيته، واستبداله بالكائن الهش الذي يعيش على تناقضاتٍ كبيرة، سر نجاح العديد من الأفلام الفلسطينية في آخر عقدين.
وقد حصدت هذه الأفلام جوائز عديدة، ولاقت جماهيرية واسعة في العديد من المهرجانات، آخرها مهرجان سينما فلسطين في تولوز "سينيبالستين تولوز" في دورته السابعة، والذي استغل عودة الحياة إلى صالات السينما في فرنسا ليعرض نماذج من هذه الأفلام.
إذن نحن نشاهد سينما عن حياة هذا الإنسان العادي اليومية والمنزلية، ونراقب رغباته ومخاوفه بإيقاعٍ كوميدي أحيانًا، ويصبح هذا الإنسان يشبه إنسان البرازيل والمكسيك وفرنسا، لولا شيء واحد سيكبر كلما مرت دقائق الفيلم ويتضخم في الصورة، فيتحول هذا الكائن إلى الفلسطيني، لتشعر أنك الآن أمام خصوصية ما تتعلق بالحكاية، وفي لحظة ما قد تتعلق بتكنيك الفيلم خاصة إذا كان المخرج إيليا سليمان. وهذا أعظم شيء من الممكن أن يقدمه الفيلم الفلسطيني الآن.
في هذه الأفلام الثلاثة نحن أمام امتداد الأمل بالحياة المكررة المملة دون أن تكون مفتتة بسبب جدارٍ أو حصارٍ أو حاجزٍ أو أيدولوجيات، فنرى كيف يعيش الفلسطيني حيرة البقاء، ورغبة في تغيير وضعه، وانسحاقه في نظام استعماري أكبر منه، وفي حكم سلطة وطنية لا تجد حلولًا لمصيره بل تزيدها تعقيدًا.
وترمزت هذه الحيرة لتكون معادلاً موضوعياً في مشاهد قوية محددة في الثلاثة أفلام، ففي "200 متر" نجد المشهد المصيري حين تعلق ثلاث شخصيات من الفيلم في حقيبة السيارة الخلفية في محاولةٍ للمرور عبر حواجز المحتل فيبدأون بضرب جدران السيارة، ما يذكر باللحظة الشهيرة للدق على جدران الخزان في رواية غسان كنفاني "رجال في الشمس". وفي فيلم "الهدية"، يتجلى المشهد حين يُلقى الفلسطيني في الحر بينما يمر الآخرون، منتظرًا السماح له بالمرور، وابنته خارج السياج تنتظره. في فيلم "غزة مونامور" تتجلى حيرة حين يقف أمام المرأة التي يحب، في متجرها، لكن لا ينطق بكلمة، خائفًا من شقيقته ومن المجتمع ومن الشرطة ومن رفضه المفترض.
وهذا لا يعني أن هذه الأفلام لم تخلُ من كليشيهات، كالمشهد الذي يغني فيه أحد ركاب السيارة الأجرة في فيلم "200 متر"، ومشهد غضب الأب وصراخه بالجندي في فيلم "الهدية" وهو المشهد الذي من الصعب أن يحدث في الواقع، لكن بعض الكليشيهات بمحلها، مثل لقطة الصواريخ المعلقة في الهواء التي بدت كالقضيب لكنها مكسورة بشكلٍ أو بآخر ما يشي بالكثير، في فيلم "غزة مونامور".
وتبقى الطبيعة الجبلية بين الطرق في مدن الضفة الغربية الخلفية الأبرز في فيلمي "200 متر" و"الهدية"، على عكس البحر الذي له الغلبة في فيلم "غزة مونامور"، وكأننا حين نفكر بالمنطقتين نستدعي عنوان كتاب سليم تماري "الجبل ضد البحر"، لكن مرة أخرى هذا الاختلاف لم يجعل إحساس أن الأفلام متقاربة يصبح أقل، كما لم ينقص من واقع الأشياء المشتركة يوميًا بين المنطقتين، أهمها مصير الإنسان، مصير الفلسطيني.