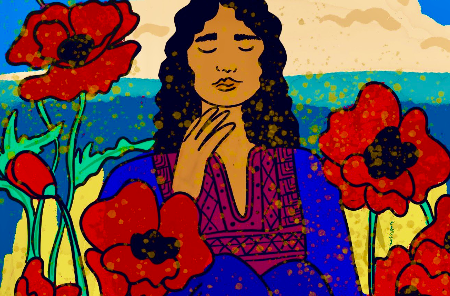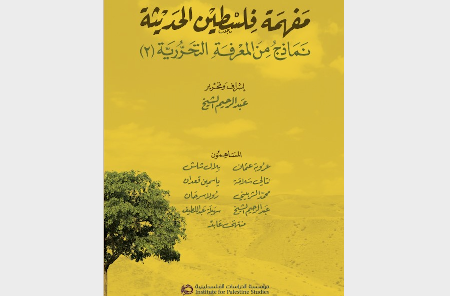قبل الانتقال إلى تناول تجربتي المسرحي سعد الله ونوس والناقد فيصل دراج، ترى كسّاب أن النهضة شغلت موقعًا مركزيًا في النقاش السوري كما هو الحال في مصر، فقد كان كل ما يتعلق بتراث النهضة من مسائل مختلفة في سبيل الوصول إلى تنوير حقيقي موضع نقاش ساخن في الحالة السورية، وكانت "الأسئلة تتمثل في ما إذا كانت النهضة أيديولوجيا يستخدمها القوي ضد الشعب، أو كانت مشروعًا واعدًا أعاقه النظام".
تتناول الباحثة إليزابيث سوزان كسّاب في كتابها "تنوير عشية الثورة: النقاشات المصرية والسورية" الصادر نهاية العام الفائت عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات للمترجم محمود محمد الحرثاني النقاشات التنويرية التي أثارها المثقفين في مصر وسوريا خلال العقدين السابقين اللذين استبقا اندلاع الثورات العربية ما بين عامي 2010 – 2011، وهي إن كانت في هذا البحث تضع النقاشات التنويرية في سياقها التاريخي والسياسي والفكري، فإنها أيضًا تقدم قراءة مغايرًا للحالتين نتيجة اختلاف النظامين الحاكمين في تعاطيهما مع الحالة التنويرية محليًا.
نقاشات التنوير العلمانية والحكومية والإسلاموية المصرية في التسعينيات
تفتتح كسّاب الفصل الأول من بحثها باستعادة تاريخية سريعة للحالة التنويرية المصرية التي جاءت بعد اغتيال الرئيس محمد أنور السادات (1918 – 1981) ردًا على الهجمات الإسلاموية، والتي كان من ضمنها الهيمنة الإسلامية الثقافية في رقابتها الشديدة على المنتجات الثقافية، وهو ما انعكس في الدعاوى القضائية المرفوعة ضد المثقفين المصريين، كما حصل مع الدعوى الشهيرة ضد نصر حامد أبو زيد التي حاولت تفريقه عن زوجته على سبيل لا الحصر، وهو ما دفع المفكرين المصريين لتنظيم عدد من التجمعات والتنظيمات المضادة.
قبل أن تبدأ النقاشات التنويرية المصرية بالصعود إلى واجهة المشهد الثقافي – الفكري في تسعينيات القرن الماضي، كان مراد وهبة قد افتتح نقاشها قبل ذلك بنحو 20 عامًا مقدمًا قراءة مستقلة للحالة التنويرية بانطلاقه من واقع التخلف الذي كان يعيشه العالم الثالث على وجه العموم، والعالم العربي الإسلامي على وجه الخصوص، فهو يؤكد في كتاباته على أنه يرجع الفضل في التقدم الذي حققته المجتمعات الأوروبية إلى إمكانية ممارسة الفكر النقدي بحرية في المرحلة اللاحقة للإصلاح الديني التي تأثرت بفلسفة ابن رشد المنبوذ في منطقة الشرق على عكس الغرب الذي رحب بكتاباته.
عند المقارنة ما بين وهبة والناقد الأدبي جابر عصفور الذي كان من أقوى المنادين بالتنوير، وأشد الناقدين للأصولية الإسلامية، بيد أنه كما تقول كسّاب كان "موظف مدني مخلص لدولة مبارك"، نجد أنهما يتلاقيان في تأكيدهما على ضرورة إحلال فلسفة ابن رشد مكان فكر ابن تيمية، لكنهما يختلفان في منهجهما السياسي، إذ بينما وقف وهبة على خط مستقل عن نظام مبارك، قبل أن يذهب إلى تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي بوصفه "يحمي الحضارة من التهديدات الإسلامية"، فإن عصفور الذي يعتبر أكثر شخص شغل منصب وزير الإعلام ما بين عامي 1987 – 2011، كان يرى أن مشروع التنوير المصري يحتاج إلى السيسي "للشروع في هذا التجديد، لأن الفكر الديني أصبح قضية من قضايا الأمن القومي".
يمكننا هنا أن نقدم لمحة متخصرة عن رؤية وهبة وعصفور للتنوير، إذ يرى وهبة أن التنوير "بوصفه إعمالًا مستقلًا للعقل النقدي" ليس "سوى أحد مكونات الديمقراطية"، يضاف إلى ذلك "الليبرالية، ونظرية العقد الاجتماعي، والعلمانية وهي أخطرها" لأنها "حجر الزاوية في الديمقراطية"، موجهًا نقده بشكل أساسي للإسلاميين بعيدًا عن "الدولة الاستبدادية" التي برأها من "الأضرار البعيدة المدى التي ألحقتها بالمجتمع المصري"، في حين دائمًا ما كان عصفور يبيّن في "تحليلاته للوضع القائم في مصر التأثيرات التدميرية للاضطهاد السياسي واستبداد الدولة"، لكن هذه الأفكار كما ترى كسّاب لم تمنعه "من أن يشارك في الدولة ويساهم في خدمتها وهي التي نشطت في تقويض مبادئ الديمقراطية وعرقلة شيوعها ومحق الثقافة المستنيرة".

على الطرف الآخر من النقاشات التنويرية المصرية، تفرد كسّاب مساحةً لمناقشة الباحث الإسلامي محمد عمارة الذي رأى بأن التنويرين المصريين لم يأتوا "بجديد سوى فهمهم القاصر للإسلام"، وهو في هذا المعنى يرد على كتابات وهبة وعصفور معًا، لذلك نجد أن خطاب الدولة والعلمانيين التنويري الذي أراد استعادة أفكار وبواعث "التنويرية الأساسية لنصرة حملتهم التنويرية الراهنة"، قوبل برد إسلامي يصر على الطابع الديني للحملة التنويرية، كما الحال مع عمارة الذي وجد أن "القرآن يمثل المرجعية النهائية للنور والعقل" بمعنى أنه "المرجعية النهائية لأي تنوير حقيقي"، وهو ما يعطينا صورة عن طبيعة النقاشات التنوير المصرية في تسعينيات القرن الماضي، والتي كان عنوانها الأساسي الدين والأصولية الإسلامية والعلمانية.
تفكيك وتحليل النقاد المصريين لنقاشات التنوير المصري
في موقع مختلف قوبل هذا الخطاب التنويري الحكومي والإسلامي معًا بنقد تفكيكي من قبل أسماء عديدة عملت على تحليل الخلفية التاريخية الاجتماعية للمثقفين المنخرطين في كلتا الحملتين، وهم رؤوا في الواقع أن أنصار كلا الحملتين "كانوا محافظين مذعنين لا شأن لهم ولا هم إزاء أفكار التنوير التحررية"، إضافة لما اعتقد الفريق الثالث أن كلا الحملتين كان "سطحي أُنتج على عجل ليواجه الخطر الإسلاموي من دون تحليل جاد للواقع الذي أسفر عن هذا الخطر، ومن دون إفاضة في التصورات النظرية لأفكار التنوير".
في مقدمة الأسماء التي تتناولها كسّاب من جانب الفريق الناقد للخطابين السابقين كانت الباحثة منى أباظة التي كرست جزءًا من دراستها لتحليل الخطابين عينهما، في قراءتها لكلا الخطابين ترى أباظة أن المعسكر الإسلامي أعاد "الاستحواذ على تراث التنوير الذي ينادي به العلمانيون ويضعونه في خدمة اتجاهات سياسية وثقافية تناهض ما عليه العلمانيون"، في حين اعتبرت التحالف بين العلمانيين والدولة لم يمارس أي من تعاليم التنوير، إنما على العكس فقد أضر بنزاهة أولئك المثقفين، ونال كذلك من سمعة قضية التنوير، وتؤكد عليه في إحدى مقالاتها عندما تفرد جانبًا منها للحديث عن سير حملات التنوير الحكومية على مدى عقد من الزمن حنبًا إلى جنب مع حملات القمع التي استهدفت المعارضة المصرية.
تنتقل كسّاب بعد أباظة للحديث عن المفكر نصر حامد أبو زيد الذي أصر على أن لا تنوير من دون مثقفين مستقلين لديهم القدرة على الوقوف مسافة من السلطة مهما كان شكلها "سياسي أو اجتماعي أو ديني"، لذلك نجده يشدد في غالبية أعماله البحثية على أن ترسيخ العلمانية في المجتمع يحتاج إلى "إصلاح ديني جذري"، وهو ما يرى أنه لم يحصل في العالم الإسلامي، كما أكد على أهمية العلمانية البالغة في العالمين العربي والإسلامي "حيث يرى المرء التداعيات المأساوية لامتهان الدين ليس فقط بأيدي الجماعات الراديكالية أو الإسلامويين، بل بأيدي الدول منذ منتصف القرن العشرين".
يختلف المؤرخ المصري شريف يونس في موقفه السياسي عن أباظة وأبو زيد، فهو من الأسماء البارزة التي رحبت بالإطاحة بالرئيس محمد مرسي، وتحول بعدها خصمًا صريحًا لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، لكنه في تحليله للخطاب العلماني توجه لقراءة التجربة الناصرية والإخوان المسلمون من حيث المحتوى الإيديولوجي نظرًا لشعبيتهما، معتبرًا أن كلاهما بنى خطابه وصمم سياسته متكئًا على هذا الكيان الهوياتي، الذي عرفه الناصريون بأنه الأمة المصرية العربية، بينما عرفه الإخوان بأنه الأمة المصرية الإسلامية، لكن مع خلاف أن الأولى ذات صلة وثيقة بجهاز الدولة، بينما كانت الثانية تسعى إلى الحلول محل الأولى بالوظيفة نفسها.
نظرة سريعة على التنوير الألماني
تقدم كسّاب قبل انتقالها لمناقشة مرحلة التنوير السورية فاصلًا اعتراضيًا مرتبطًا بالتنوير والنخبوية التي شهدتها ألمانيا في القرن الـ18، وتعتبر فيها مقالة "ما التنوير؟" للفيلسوف إيمانويل كانط (1724 – 1804) "بيانًا كلاسيكيًا بشأن التنوير الذي تعرفه بأنه قدرة المرء على استخدام عقله وإرادته لذلك على نحو مستقل دون وصاية"، حيثُ كان يحكم ألمانيا خلال تلك الفترة فريدريك الأكبر (1740 – 1786) الذي يوصف بأنه "المستبد المستنير"، ومن المعروف عنه أنه سمح للجمعيات الفكرية الحرة بالنشاط، ولو أنها كانت مرهونة بحكم ملكي مطلق، إلا أنها كانت بديلًا من التجمعات وألوان النشاط السياسية الحقيقية.
شهدت تلك الفترة نقاشات وتبادل للآراء بين أنصار ومناهضو التنوير كان يتابعها فريدريك الأكبر، وهي من النقاشات التي كانت تشغل أيضًا التنوير العربي، بما في ذلك مواضيع الإلحاد والسلطة والرقابة والتعليم والحكم المستنير والتقاليد والعنف وحرية الإعلام..إلخ، لكن هذه الحرية انحسرت مع وفاة الملك "المستبد المستنير" واستلام ابن أخيه المحافظ فريدريك وليام الثاني الذي يقال إنه كان ميالًا للصوفية المسيحية، فقد شهدت فترة حكمه تغيير مسار التوجه الليبرالي النسبي الذي ساد خلال فترة فريدريك الأكبر، وقام مستشاره يوهان كريستوف ولنر بإصدار فرمانًا يعيد إرساء دعائم الأرثوذكسية الدينية، وتبعه بفرمان آخر يمنع نقد الفرمان الأول.
ما يهمنا من هذا السرد السريع الذي تقدمه كسّاب أن الفرمان الديني الذي صدر أثار "المزيد من النقاشات حول أهمية الاعتقادات المعرفية في الدين ودورها في الحفاظ على التماسك والسلم في المجتمع المدني"، لذا نجدها تصل إلى فكرة تقول إنه بمجرد أن تحدى التنوير الألماني السلطات الاجتماعية والدينية والسياسية ظهرت الأسئلة المرتبطة بالنخبوية والصحافة وحرية الإعلام والدين والتعليم، وهي ذات النقاشات التي ارتبطت بالتنوير العربي على ما فيها من التواءات كما يظهر في الحالتين المصرية والسورية.
اللحظة السيزيفية في نقاشات التنوير السوري
في تناولها لحالة التنوير السورية تجد كسّاب أنها تختلف عن الحالة المصرية في مجموعة من النقاط، أولها أن الإسلام السياسي لم يكن الخصم الرئيس في نقاشات التنوير السورية إنما "استبداد الدولة وفسادها ووحشيتها"، وكان ثانيها خضوع المجال العام الذي كان يُدار فيه النقاش السوري للقيود أكثر بكثير مما تعرض له النقاش المصري، أما ثالثًا فإن "الحكومة السورية، وبخلاف نظيرتها المصرية، لم تكن تعنى في ذلك الوقت بخطاب التنوير"، وأخيرًا لجوء معظم الذين كتبوا أو ناقشوا التنوير السوري إلى لغة عامة كانوا يشيرون في كتاباتهم إلى "المجتمع العربي، الدولة العربية، الأنظمة العربية".
لفهم الحالة التنويرية السورية بشكل أوسع تعيدنا كسّاب بجردة تاريخية سريعة إلى المرحلة التي استبقت الوحدة المصرية – السورية (1958 – 1961) عندما كانت تسود حالة من الحياة البرلمانية على الرغم الاضطرابات السياسية التي كانت تعاني منها، لكنها ما لبثت أن انتهت بعدما ألغى الرئيس جمال عبد الناصر الأحزاب السياسية، وانتهت معها جميع الجوانب الديمقراطية، كما الحال في التجربة المصرية إبان حكم عبد الناصر، وبحسب كسّاب فإن المفكرين السوريين رؤوا في الوحدة المصرية – السورية أنها كانت "لحظة مؤسسة لما جاء بعد ذلك من أنظمة سورية استبدادية".
على عكس التجربة المصرية التي حددتها كسّاب في مجموعة من الكتاب، فإنها في نقاشها للحالة السورية استشهدت بالعديد من الكتاب الذين لا يسعنا التطرق إليهم جميعهم، فهي ترى أن المقالة التي نشرها المفكر أحمد برقاوي في مجلة الطريق اليسارية بعنوان "ما التنوير" تصلح أن تكون "مدخلًا ملائمًا للمشهد السوري فيما يتعلق بالنور والظلمة"، فقد شدد برقاوي في هذه المقالة على ضرورة "الحفر في الظلمة التي نعانيها"، وفي قراءته للمشهد السياسي العراقي بانعكاسه على الواقع العربي رأى المجتمعات العربية تتراجع من "أجسام سياسية قومية إلى مجتمعات مصغرة أولية كالقبيلة والجماعات الدينية"، وهو الأمر الذي أثر سلبًا على المجتمعات العربية.
وبينما ذهب المفكر ميشيل كيلو في طرحه للإقرار بوجود مؤامرات ضد الشعب السوري، والتي يسوق من ضمنها "غياب الحريات والحياة السياسية الناجمين عن الوحدة مع مصر"، ويضاف إليها "حرمان الشعب من الحق في الانتخاب"، فإن الشاعر ممدوح عدوان في كتابه "حيونة الإنسان" عالج "ظاهرة التوحش والقمع واعتياد القمع والتعذيب" التي استلهمها من الأدب العالمي وبعض الدراسات العلمية الاجتماعية، كما أنه تحدث في الكتاب عن "العنف والفساد بلغة توحي أنه يتكلم على سوريا تلميحًا لا تصريحًا".
إذ أنه على الرغم من اعتقاد المفكر ياسين الحاج صالح – كما ترى كسّاب – أن النظام عندما رأى مواجهة تلوح بالأفق مع الإسلاميون سعى للفوز بدعم المثقفين العلمانيين أو غير الإسلاميويين، والذي توقع منهم أن ينحوا اللوم عليهم في الأزمة التي كانت تمر بها سوريا في نهاية سبعينيات القرن الماضي، فإن مثقفين من أمثال عدوان وكيلو عملوا على "دحض أي شكوك قد تشي بتوافقهم مع النظام على ما يفترض أنه نظام قيم علماني مشترك بينهم وبينه"، وهنا يرى الحاج صالح أن أهم ما منع من ظهور معارضة حقيقية في الحالة السورية كان "الالتزام الإيديولوجي" على مختلف أشكاله المعروفة لأنه "حرم المثقفين من الالتزام الفكري والسياسي اللازم للمعارضة الحقيقية".
إن الجهد الأكبر لدى المثقفين السوريين تمثل حول تركيزهم على عصر النهضة العربية، والذي رأى فيه المفكر برهان غليون أن النخبة حاولت التوفيق بين التقليد والحداثة وبين الفكر الديني والمناهج الحديثة، وهو يقول عنها إنه كتب عليها الفشل فكريًا واجتماعيًا وسياسيًا، بمعنى أنه "بني جهد النهضة خطأ على النجاح الموعود نتيجة لهذه الاستراتيجيات التصالحية"، فقد اعتقد غليون أن القضية لا تكمن في غياب الأيديولوجيا إنما في طبيعة دولة الطبقات النخبوية في إسقاطها على الواقع العربي، ويعتبر هنا أن النخبة مارست "ثقافة استهلاكية مستعارة من الغرب الذي لا تتحاور إلا معه واتخذت من النهضة أيديولوجيا لها".
في هذا الجانب بختلف الكاتب عبد الرزاق عيد مع فكرة غليون حول عصر النهضة، وذلك من باب عدم اعتقاده أن رواد النهضة الكبار كانوا "ينادون بالعلمانية لتمكين المستبدين" فيما انتقد الكثير منهم الاستبداد وحاربه، ورأى أن رواد النهضة حوربوا من النخبة لا من الشعب، فهو يضيف في هذا السياق أنه "منذ النهضة وُوجه العلمانيون بسيف النخبة الحاكمة الأوتوقراطي كما ووجهوا بسيف المؤسسة الدينية الثيوقراطي"، وكلا القوتين تتشاركان معًا بالفكر المحافظ والمقلد والتقليدي، لكن الخلاف بينهما لم يكن يومًا "نزاعًا ثقافيًا وإنما نزاع على السلطة والشرعية الدينية".
قبل الانتقال إلى تناول تجربتي المسرحي سعد الله ونوس والناقد فيصل دراج، ترى كسّاب أن النهضة شغلت موقعًا مركزيًا في النقاش السوري كما هو الحال في مصر، فقد كان كل ما يتعلق بتراث النهضة من مسائل مختلفة في سبيل الوصول إلى تنوير حقيقي موضع نقاش ساخن في الحالة السورية، وكانت "الأسئلة تتمثل في ما إذا كانت النهضة أيديولوجيا يستخدمها القوي ضد الشعب، أو كانت مشروعًا واعدًا أعاقه النظام".
كان من بين هذه التجارب مجلة "قضايا وشهادات" التي أصدرها ونوس ما بين عامي 1990 – 1992 في ستة مجلدات، ولعل أبرز العوامل التي ساهمت بتوقفها – وفقًا لما يرى دراج الذي كان من بين المساهمين الأساسيين فيها – غياب القراء المؤازرين إضافة إلى الرقابة الظاهرة والخفية على المجلة في عدد من الدول العربية، نظرًا لما تضمنته من مواضيع تدور في سياق العقلانية والديمقراطية والحداثة والتحديث والنهضة والثقافة القومية والتبعية والتراث، وترى كسّاب هنا "كان ثمة بلا ريب عنصر بروموثيوي في هذه الحركات السيزيفية التي ظهرت في تسعينيات القرن العشرين، وكان ثمة مساع ثقافية جريئة نحو التحرر من اليأس والاستعباد ونزع الإنسانية عن الإنسان"، لكن لم يكتب لها النجاح كحال التجارب التي جرت محاولة التأسيس لها خلال العقدين السابقين نتيجة القمع السائد.
الحالة السورية من التنوير إلى ربيع دمشق
تفرد كسّاب في بحثها فصلًا كاملًا لما عُرف مطلع القرن الـ20 بربيع دمشق، وهي الفترة التي تولى فيها بشار الأسد الحكم بعد وفاة حافظ الأسد في حزيران/يونيو 2000، وتنقل كسّاب هنا عن الكاتب فولكر بيرتس أن الأسد الابن لم يقم بشيء في النصف الأول من دورته الرئاسية "سوى تحديث السلطوية"، وقد أولى المزيد من الاهتمام للمهارات التكنولوجية "ما أضفى على السلطوية شكلًا مؤسسيًا ومظاهر عقلانية وأصول إجرائية سليمة"، كما روج لشكل من اقتصاد السوق الاشتراكي على غرار التجربة الصينية، وهو "اقتصاد تحكمه سياسات ليبرالية جديدة، ولا تهمه شبكات الأمان الاجتماعي ولا إعادة توزيع عادل للثروة".
تحدد كسّاب الفترة الزمنية لربيع دمشق ما بين تموز/يوليو 2000 – أيلول/سبتمبر 2001 التي بدأ فيها اعتقال المثقفين والنشطاء البارزين، لكن قبل حملة الاعتقالات كان قد صدر حينها بيان الـ99 الذي توسع لاحقًا إلى بيان الـ1000، وتوسعت مع البيانين النقاشات والموضوعات التي تتطرق المثقفين السوريين كان ثمرتها الإعلان عن مواقف وطنية عامة جاء في مقدمتها المطالبة بإيقاف قانون الطوارئ، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتأسيس حكم القانون والحريات والتعددية السياسية، لكن هذه النقاشات التي انخرط فيها المثقفون السوريون، بما في ذلك الجدال حول المجتمع المدني، وأيهما أسبق الدولة أم المجتمع، رأى فيها أنطوان مقدسي أنها كانت "محصورة في حلقات المثقفين ولم تتحدث إلى الناس، ولهذا كان جليًا استحالة ظهور دولة قوية دون مجتمع مدني مُمَكن وحر يستطيع تنظيم شئونه [شؤونه] العامة ويراقبها".
تختم إليزابيث سوزان كسّاب هذا البحث مؤكدة على أن الكتابات المصرية والسورية المرتبطة بالتنوير كانت واضحة وجلية، فهي "ناقشت ظلمة أزمانها التي انتشرت جراء تطور أنظمة المرحلة التالية للاستقلال"، وترى أن هذه الظلمة التي ناقشتها هذه الكتابات "ملموسة ومحسوسة" لكن "مستقبل مؤلفيها ومستقبل مواطنيهم هلك بحكم دول عنيفة فاسدة"، مشيرة في النهاية إلى أن تحليلها للتنوير المصري – السوري ليس إلا "مساع فكرية للتوصل إلى حل بشأن هذه الظلمة، وللاشتباك معها وتشخصيها ومن ثم اقتراح الإصلاحات، حتى حين كان واضحًا لدى رواد التنوير استحالة تطبيق هذه الإصلاحات".