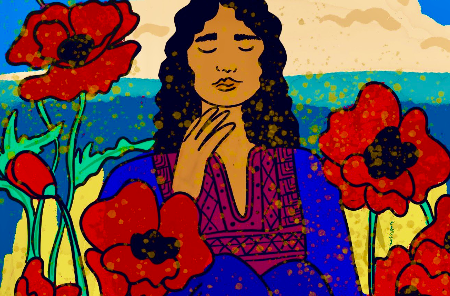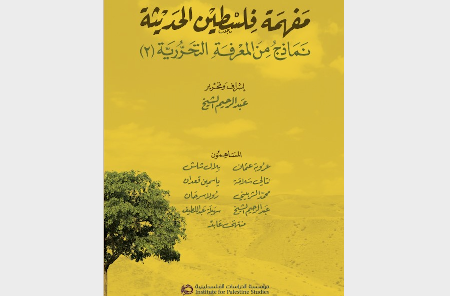أثناء اعتقال زوجها، كانت هي الدرع الحامي؛ شديدة البأس، حاسمة القرار، لا تخشى الملوك ولا السلاطين، فعندما اشتد المرض على القائد عبد القادر الحسيني وهو معتقل في العراق في إثر قضية اغتيال فخري النشاشيبي، أصرت على مقابلة نوري السعيد، الرئيس العراقي وقتذاك، في مجلس رئاسة الوزراء حيث كان مجتمعًا مع وزرائه
دور المرأة في الحركة الوطنية الفلسطينية قديم بقدم القضية نفسها، غير أنه لم يكن يلحظ تقسيم للأدوار الثورية وغير الثورية جندريًا، فكل يتخذ دوره في كل الأماكن دون النظر إلى جنسه.
إن التفكير في سؤال "المرأة" أصبح سابقًا وحديثًا في آن، والإجابة عليهما ما هي إلا محاولات للتفكير في أدوات جديدة تعيننا على استكمال التفكير القديم الحديث. قبل عام من الآن أجريتُ مقابلة مع غازي عبد القادر الحسيني، وكنت كلما سألته عن أبيه، ولكنه قال أمي وبكى! من هي أمه؟ لمَ لم يكتب عنها مؤرخو الثورة؟ إنها وجيهة موسى رضى الحسيني، ولم أكن أعلم أن امرأة تربي أبناءها وحدها، تنتقل بهم بين العراق ومصر والحجاز، تخبئ المجاهدين في كنفها، تؤويهم، تجعل بيتها مأوى لهم أينما حلت وارتحلت، مأكلًا ومشربًا وملبسًا ومأمنًا. يوعز إليها زوجها فترسل للثوار أن دقتّ الساعة، فإذا غاب، حلت مكانه؛ تخبئ السلاح، وتحفظه وتنظفه وتشرف على نقله. جسورة شجاعة جريئة، تدق باب الملوك والسلاطين وتنقذ زوجها غير مرة، تخرجه من المعتقل وترفع عنه ظلم السّجان، غير آبهة بالظروف الخطيرة المحيقة بها وأطفالها. عُرفت بشخصيتها القوية المستقلة، المرحة الجريئة. طلبها عبد القادر الحسيني من عمّتها التي ربّتها بعد أن توفي والداها، أصرّت عليه وتزوجته رغم عدم التكافؤ المادي بين العائلتين. فقد ورثت عن والدها ثروة ضخمة. في نيسان/ إبريل عام 1936 حين بدأ إضراب فلسطين، لم تتوان وجيهة وقتذاك عن مدّ الثورة سلاحًا وعتادًا، فأعطت زوجها 60000 ألف جنية فلسطيني ليبتاع السلاح والعتاد اللازم. وعندما يُعتقل ترسل له احتياجاته واحتياجات رفاقه في الأسر من ملابس وطعام. باعت وجيهة أراضيها قطعة قطعة لتمد زوجها بالمال والسلاح والعتاد، فكانت تقول: "من باع نفسه لله، فالله ناصره ومؤيده". بعد أيام من إعلان عبد القادر الحسيني الجهاد في 12 تشرين أول 1936، سمعت أنه أصيب بجروح بليغة، فلم تجزع شأن بقية الأهل والأصدقاء، بل قالت: "إنما نذر نفسه للموت في سبيل الله، وليس من الغريب أن يستشهد في أي وقت".
بادرت للذهاب إلى غرفة السجن في مستشفى الحكومة حتى تراه وتعرف منه ما يريد، فأوصاها زوجها بوجوب إسعاف الجرحى من إخوانه وتخبئتهم من الإنجليز، وطلب منها إخفاء الأسلحة في مكان أمين. كما كان يسر إليها تعليماته العسكرية للمقاتلين حتى يشنوا عمليات عسكرية، وتقوم هي بنقل الرسائل لهم، فينفذون.
وفي أثناء المعارك عندما يصاب أحد المجاهدين وعددهم بالعشرات، فيقبض عليهم في جراحهم البالغة، ويتعرضون للحقن والتعذيب حتى يعترفوا أو يستشهدوا. فكان لا بد من مكان آمن يحتويهم، يواريهم ويخفيهم عن أعين العدو حتى يتماثلوا للشفاء. بالطبع، كانت هذه إحدى مهمات وجيهة الحسيني، كانت تحوّل بيتها إلى مستشفى، لم تكن تنام بالليل أو ترتاح بالنهار في سبيل خدمة هؤلاء الجرحى وعلاجهم؛ تحضر لهم الأطباء، وتمدهم بخير أنواع الغذاء، وتغسل لهم ملابسهم، وتنظف لهم جروحهم، وتضمّدها بنفسها.
في خريف 1939، حينما غادر عبد القادر الحسيني فلسطين إلى العراق، استأجرت أم موسى بيتًا لم يخُل يومًا من الضيوف. ولما انتهت ثورة الكيلاني في عام 1941 وأخذت السلطات تتعقب الفلسطينيين وتطاردهم، لجأ 29 مجاهدًا إلى بيت عبد القادر الحسيني، وبقيت هذه المجموعة مختبئة أكثر من شهر، كانت تقوم فيه أم موسى بخدمتهم جميعًا، وتقدم لهم المأكل والمشرب، وتغسل ملابسهم.
في تلك الفترة، نفد كل ما لديها من مال، فأصبحت تبيع من أثاث البيت وما تمتلك من حلي ومصاغ. ولم يبق من حليها إلا أسورة واحدة كانت تحتفظ بها وتقدسها، لأنها خير هدية من والدتها، فقالت لزوجها: "لم يبق إلا هذه، فخذها وارهنا، لنصرف من ثمنها". سرّ عبد القادر سرورًا عظيمًا، وأخذها ورهنها بمبلغ (30) دينارًا، وراح يصرف من المبلغ عليه وعلى المجاهدين الذين بلغ عددهم (55) مجاهدًا.
أثناء اعتقال زوجها، كانت هي الدرع الحامي؛ شديدة البأس، حاسمة القرار، لا تخشى الملوك ولا السلاطين، فعندما اشتد المرض على القائد عبد القادر الحسيني وهو معتقل في العراق في إثر قضية اغتيال فخري النشاشيبي، أصرت على مقابلة نوري السعيد، الرئيس العراقي وقتذاك، في مجلس رئاسة الوزراء حيث كان مجتمعًا مع وزرائه
دخلت بقوة، فوقف الجمع مبهوتين متسائلين عن سبب وجود هذه المرأة، ثم قالت: "أنتم تعرفون جميعًا أن عبد القادر بريء من كل ما نسب إليه، ومع ذلك، وضعتموه في المعتقل رغم اعتلال صحته، فهل تمانعون يا سيادة الرئيس في خروجه من العراق؟ فأفرج عنه ورُحّل إلى السعودية، حيث التحقت به وأولادها إلى هناك لمدة عامين، ثم رحلت معه إلى القاهرة، مرة أخرى.
كما أنني أقوم حاليًا بالاشتغال على مذكرات انتصار الوزير، وأعرّفها، بعكسها، بمعزل عن هوية زوجها وابن عمها خليل الوزير، الرجل الثاني في حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، ونائب القائد العام لقوات لثورة الفلسطينية. انتصار كانت شريكة الثورة في باكورتها، وخصوصًا بعد حرب 1967، وهي مولودة في غزة، وشهدت التغريبة الفلسطينية الثانية بكل تفاصيلها؛ فنقلت الرسائل للثوار، وخبأت الأسلحة، وطبعت المنشورات، ووزعتها، ولم تكن تتجاوز الثامنة عشر من عمرها. وبعد أن انتقلت إلى الكويت مدرّسة، شهدت النقاشات الأولى لتأسيس حركة فتح في الكويت، وكذلك الأمر عندما تزوجت بابن عمها، وافتراقها عنه تسعة أشهر لذات الأسباب الوطنية، ومن ثم استكمالها لدورها في الجزائر بعد أن تحول بيتهما مقرًا للحركة إبان انطلاقها. ثم بعد ذلك في بيروت ودمشق، حيث ساهمت بشكل أساسي بتأسيس القطاع النسائي ومعسكرات التدريب العسكرية والمخيمات. وكان لها دور على الصعيد السياسي أيضًا؛ فأصبحت رئيسة جمعية الأسرى والشهداء في عام 1967، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني في عام 1973، وعضو اللجنة المركزية في عام 1989، ووزيرة الشؤون الاجتماعية في عام 1994، ثم عضو المجلس التشريعي الفلسطيني في عام 2006.
وهنا، أذكر نموذجًا آخر لامرأة الكفاح لمسلح، في مرحلة عام 1967، وهي رندا النابلسي، وقد أجريت معها مؤخرا مقابلة شفوية. استثارتني ذاكرتها، وزواياها المخبئة التي تذكرتها في جلستنا معًا، امتلأت عينانا بالدموع غير مرة! ما الذي يجعل طفلة لم تتجاوز السادسة عشر حمل قنبلة ونقلها، ومحاولة تفجير كمائن العدو؟ سألتها بإصرار. "هكذا، دون تفكير، حملت طفلة فارقت الحياة بين يدي بعد أن قتلها المحتل. ركضت تلقائيًا إلى مستشفى نابلس للمساعدة في إسعاف الجرحى". هكذا تشكّل الوعي، ليس بهذه البساطة، وإنما بتلك التلقائية التي صنعها هول الحدث. طالبة مدرسة، انتمت للجبة الشعبية، هكذا أيضًا دون تعقيدات تنظيم حزبي، لا تعلم لمَ، "فأيًا كان من يدربني على السلاح يكون حاضنتي، هكذا كنا، كل من يعلن الثورة هو حزبي". دربتها شادية أبو غزالة التي استشهدت لاحقًا أثناء تحضيرها لقنبلة. خرجت في مظاهرات، ووزعت المنشورات. اعتقلت أول مرة وخرجت بكفالة، ثم اعتقلت ثانية وحكمت 10 أعوام، وخاضت إضرابًا كبيرًا لتحصل على استحقاق استكمال الثانوية العامة. خرجت بعد قضاء أربعة أعوام في السجن مبعدة إلى القاهرة، لتستكمل تعليمها الجامعي، وتتزوج هناك من الدبلوماسي والسفير الفلسطيني عصام كامل. وانتمت إلى حركة فتح لأنها تلبي طموحها الوطني كما تقول. عملت دبلوماسية في جامعة الدول العربية ومكاتبها في كوبا وألمانيا برفقة زوجها الذي فارقها مبكرًا وأطفالها، لكنها استمرت سفيرة في البرتغال والمكسيك لاحقًا، وهي الآن المديرة العامة لمؤسسة الشهيد ظافر المصري في نابلس.
وبالرغم من أنني لم أقابلها أو أسمع منها شفاهة، إلا أنني سمعت عنها، ومن لم يسمع عن "خنساء فلسطين"، المناضلة أم المناضلين، أم نضال فرحات أو مريم محمد محيسن، المولودة في غزة عام 1949، وهي التي سلكت درب الكفاح المسلح إلى جنب أولادها الثلاثة الذين استشهدوا عنها، وبقيت هي صامدة. آوت أم نضال المجاهدين في بيتها، ومنهم عماد عقل الذي اغتيل في منزلها في غزة في عام 1993. هُدم بيتها أربع مرات، وكانت تقيمه في كل مرة. خاضت مريم الحياة السياسية بعد ترشيحها عن قائمة الإصلاح والتغيير عن حركة حماس في الانتخابات التشريعية في عام 2006.
لقد أصبحنا اليوم ننظر إلى تغير دور المرأة بالنظر إلى مشاركتها في المنظومات الهيكلية للمؤسسات السياسية، والرسمية، والوطنية، من الحزبية، والمواقع التي تفرزها صناديق الانتخابات، وفي الوظائف التي تخولها اتخاذ قرارات حاسمة وحساسة، فمن الذي يقرر هذا إذن؟ من الذي يهبها هذا الحق بعد أن كان لها دون حاجة للاجتهاد في اكتسابه، أو يدع لأحد الحق في وهبه لها!
كما أنني لا أتوقع أن يطرأ تغير جذري في مواقع المرأة التي يهبها إياها "الآخرون"، إذ تضمن حقها من خلال نظام الكوتة، ولا زيادة على ذلك! وما أعنيه هنا أن الورشات والحملات التوعوية الموجهة لعموم الشارع الفلسطيني، لم يتسع وعيها حتى اللحظة، أو على المدى القريب، لضرورة مشاركة المرأة السياسية لأنها ببساطة كائن بشري مكلف، لها حقوق وعليها واجبات، وقادرة على اتخاذ القرار وإحداث تغيير، أو تسيير مشاريع ومؤسسات.