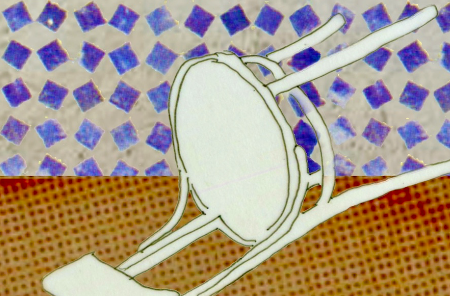في صباحِ النكبِة السبعين، لا أجِدُ سوى عقابٍ جماعي يشبِه ُ كلّ ما يتعرّضُ له الفلسطينيون الذين تتعاطفونَ معهُم في الداخلِ وضمنَ أراضي الـ67. ألم يكفِ كلُّ هذا العقابِ؟ ألمَ يشفِ كلُ هذه العقابِ غليلَ قلوبكِم؟ ألَمْ يَحِنِ الوقتُ لنصبحَ راشدينَ في نظرِكم؟ ألَم يأتِ الوقتُ للكفِ عن الاعتقادِ أنّ وظيفةً جيدةً أو بيتاً أهمُ عِندَ الفلسطينيين من أرضِهم وقضيتِهم؟
مقدمة لا بدّ منها
في المقهى الهادئِ الذي يقعُ في شارعِ الحمرا الشهيرِ في بيروت، تجلس على الطاولةِ الموازيةِ لي ثلاثُ فتياتٍ، إحداهُنّ تتكلمُ عن فشلِها في علاقتِها مع أحمد الذي يُصّرُ على عدم دعمِها في موضوعٍ لا أفهمُه تماماً، كوني دخيلةً على الحديثِ، أريدُ أن أغرقَ في أحاديثهنّ، وألا اضطر لأكتبَ كل هذا.
منذ مدّةٍ حلمْتُ أني نسيتُ أن لي بيتاً استأجرْتُه في القنطاري، وكم كانَ ذلكَ البيتُ في حلمٍ يشبهُ البيتَ الذي استقريْتُ به مطولاً في سنواتِ العشرين المرهقةِ في بيروت، وغادرْتُهُ على مشارفِ الثلاثين إلى بيوتٍ أخرى كأنها لم تكن سوى إقامةٍ مؤقتةٍ، إلا بيت القنطاري.
لم أكن في بيروت حين استيقظتُ من هذه الحلمِ، وكانت أطولُ مُدةٍ تقريياً أمضيها بعيداً من هذه المدينة. كنتُ نشرتُ قبل أنْ أغادرَ قصةً، على أملِ أن أعودَ بعدها إلى بيروتَ أخرى. لا أُعرف كيف تحصلُ الأشياءُ، ولكن أحداً ما قال لي، أو ربما قرأتُها على صورةٍ نُشرَت على الفايسبوك، إننا لا يمكِنُ أنْ نلمس نفسَ النهرِ مرتين، وأنّ المياهَ الجاريةَ تُغيّرُه. ربما كنتُ أحاولُ أن أعودَ إلى مدينةٍ أخرى، وقد كانَ الأسهلُ لي أنْ أقولَ إني تغيّرتُ كثيراً في السنواتِ الخمسِ الأخيرة. لا أدري لِمَ أطيلُ في المقدّماتِ، أو لماذا أريدُ أن أسرُدَ كلّ هذه التفاصيلِ قبلَ أنْ اكتبُ كلّ هذا، والذي كانَ رسالة مطولةً ستُكتَبُ لجُمانة ولميا ستساعدُني في إعادِة ترتيبِ حياتي كما كانَت قبلَ أنْ ألتقيهما، وربما قد تساعِدُ أُخرياتٍ في هذه المدينةِ على طقوسٍ تنفَعُ في أيامٍ يخرُج فيها السؤالُ الذي لا يُسألُ، يخرُجُ عن الحدودِ المسموحِ بها، فينهارُ كل شيء.
بيروتُ عادةً، إن لم تزوريها
قد تكونُ النهارات بمجملِها عبارةً عن غضبي من زحمةِ السيرِ، وهي كارثيةٌ في هذه المدينةِ، أو إنقطاعِ المياهِ في الحيِ الذي أسكنُه، أو بطئي في إقامةِ أشياء لا تحصُل كما رأيتُها في عقلي، لكني غالباً ما أنسى السببَ ويبقى الغضبُ ويصبحُ ضدَ كُلِ شيء، ولا أدري كيفَ يختفي لاحقاً، ولكني أعلمُ أنه لا يذهبُ تماماً، يختبئُ في عضلاتِ ظهري، أو عضلاتِ معدتي ويصبحُ ألمُ الجسدِ بديلاً من الغضبِ، فألتهي في العلاجِ ولا أُشفى دائما.
قد تكونُ النهاراتُ أيضاً العيشَ في أحياء لا تشبهُني ولا أشبهُها، ولكن السكنَ الرخيصَ يدفعني لأرتكبَ معاصيَ، مثل أنْ أدّعيَ إني من جبالِ لبنانَ الكثيرةِ الأسماءِ، وأنّ هويتي وجوازي في طورِ التجديدِ، وأضطرَ أن أستعملَ هويةَ رفيقتي التي سندّعي أنها "إبنةُ خالتي" لأسكنَ في البيتِ الذي لا أحبُه كثيراً ولكنه يشبهُ بيتَ "ستي" التي كان لديها، دوناً عن بيوتِ جيرانِها مرآةً كبيرةً تضعُ عليها صورَنا، من أحفادٍ وأبناءٍ بلاصقِ شرائطِ الكهرباءِ الأصفر. جدتي كانت تؤمنُ بأن إطاراتِ الصورِ هي للذين يرحمُهم الله.
بيروتُ عادةً تكونُ يومياتٍ إما مملةً أو ثقيلةً، فأزحفُ إلى تختي مثل صرصارٍ يرفضُ تماماً أن يقبلَ أنه قُتل، هكذا أحياناً يقتلُني التعبُ فأنامُ ولا أجدُ سوى السلوى في تلكَ الصورِ التي تبهرُني وعجوزٍ دائماً تقطعُ في أحلامي، غالباً ومنذُ سنينَ طويلة أجدُ نفسي معها على ناصيةِ شارعٍ أبحثُ عن بيتٍ لي، لا أعرفُ الطريقَ له بتاتاً، وغالباً ما أستيقظُ لأخافَ أنْ يحصلَ ذلك، أنْ أنسى عنوانَ بيتي وأحاولَ أن اسلك طريقاً واحدةً للبيتِ.
ألعبُ ما بينَ الثقلِ والخِفةِ، ما بينَ الأصلِ والتماهي، وشعورٍ بالذنبِ دائمٍ، يرافقُني كظلّي الذي أخافُه. كيفَ تفاوِضُ على بيتٍ لتسكنَه في فرنِ الشباك أو عينِ الرمانة وأنت لستَ غريباً فحسب، أنتَ ما بقيَ من العدو. فأقعُ في دائرةٍ من العبثِ، في أنْ أكونَ وفي أنْ أضعَ الجوهرَ جانباً، هويةً مطبوعةً على كرتونةٍ زرقاء، أقفُ في الدورِ الطويلِ مع لاجئينَ غيري لنحصلَ عليها ويضعونَها في مغلف بلاستيك، لانَ الكرتونَ دونَها يتفتتُ، فنحصلُ عليها لنتذكرَ دائماً أنّ قيمتَها معنويةٌ لدينا، ورخيصةٌ جداً عند الدوائرِ الرسمية. كل هذا وأعلمُ أنّ ثمنَ السكنِ في المدينةِ يبقى أغلى مِنَ الانسلاخِ عن بيئةٍ صديقةٍ في الأيامِ التي يكونُ فيها التوترُ السياسيُ قليلاً في المدينة، ويبقى إني الاستثناءُ في بُعديَ عن المخيمِ والأحياءِ الملاصقة به والتي نسكنُها أيضاً ولكننا نبقى السببَ في شعبيةِ وفقرِ هذه الأحياء. أدفعُ بدَلَ إيجارٍ رخيصٍ ولكنه مكلِفٌ يومياً.
بيروتُ عادةً هي تمارين تعلمتهُا عن أنْ تبنيَ شيئاً ما في مكانٍ لا يُحبك. لا يحبني. بيروتُ عادةً هي السؤالُ الذي لا يمكنُ أن تسألَه، لمَ لا تحبونَنا؟ لمَ لا تفهمونَ أنّ هناكَ ألماً لا نريدُ أنْ نعتذرَ عنه.
قاعُ العالم
ربما لو كنتِ تحملينَ الهويةَ الزرقاءَ اللبنانيةَ يكون الاحتمال الأكبرُ أنكِ لم تري البلادَ إلا من بوابةِ فاطمة، لكني أعلمُ أنكِ بكيتِ عندما نظرتِ إلى كلِ شيءٍ خلفَ السياجِ وكانَ أجملَ من أيِ شيءٍ رأتْهُ عيناكِ، لأنها كانتْ حقيقةً. هل رأتْ عيناكِ الأرضَ عندما بكيتِ أم رأيتِ كلّ تلكِ الوجوهِ التي جلستْ في غرفةِ الجلوسِ لأنّ أخاكِ لم يحصلْ على العملِ، وحين قالَ لكِ شخصٌ عن ضرورةِ إبادةِ اللاجئينَ في المخيمِ لأن الشعبَ كلهُ لا يستحقُ الحياةَ، وهل اضطريتِ لأن تنكُري بؤرَ الارهاب التي تؤرقهم، كم مرةً صاحَ الديكُ وقتها؟ هل تذكرتِ عندما قرأتِ عن "نضالِ الشعبِ الفلسطيني وهو يقاتلُ بحجرٍ" وأنت لم تستطيعي أنْ تقولي "وأنا أيضاً أقاتلُ". هل تذكرتِ إنهم يواجهونَكِ بصورةٍ أنتِ لستِ فيها، من أين يأتونَ بشرعيةِ رغبتِهم في أن نخجلَ مما نحنُ وما نكون.
ربما بكيتِ لكل هذا، لأنكِ وحدَكِ في هذه التجربة. لكن هذا يتغيرُ حين تنظرينَ إليها مِنَ الضفةِ الأخرى للبحرِ الميتِ. سوف تقولُ لكلِ التلالِ أنها أيضاً هنا، وربما يضربُكِ الجنونُ وتعتقدينَ أنكِ لوْ لمسْتِ المياهَ ستقعُ على وجهكِ نقطةٌ كانت هناك، فتلتقينَ بها، فيصبحُ كلُ شيءٍ على ما يرام. لكن يشاءُ القدر، وتُرسِلُ إليكِ البلادُ نسوتَها، فتلتقينَ بنفسك فتحبينَ مَنْ أنتِ أكثرَ. تخيلي معي، في قاعِ العالمِ، 814 متراً تحتَ سطحِ الأرضِ، تُرسِلُ لكِ البلادُ أخواتٍ فلا تضطرين لأن تبرري غضبَكِ الدائمَ وسخطَكِ على كل شيء. تخيلي في قاعِ العالمِ تكتشفينَ أنكِ لستِ وحدَكِ، يخرُجُ شيءٌ من قلبِكِ دافئاً يقولُ لكِ، ليسَ ضرباً من الجنونِ أنْ تكوني فلسطينيةً من بيروت، ولكِ فيها مثلُ أخواتِكِ وهنّ كثيراتٌ ولم ينسينَكِ، ولكننا لم نعرِفْ لبعضِ طريقاً، أن يقلنَ لَكِ إنّ البلادَ لم تنسَك، وأنّ لكِ مكاناً ينتظرُ لما قد يكونُ لأنهنّ يحرسْنَ الذاكرةَ، لكنهنّ كالرّباتِ الساحراتِ تماماً يشفينَ كل تلك الآلامِ، فتخرُجُ لهجتُك خجولةً في البدءِ، ويخرُج صوتُ أبيكِ من وسطِ كلِ هذا وتفهمين أنهُ كانَ يتألمُ حين لا يسمعُ صداها من فمِكِ، فتبكينَ لتشفي، ولتفهميَ أن شفاءَك في أيديهنَ، فتبوحينَ بكل هذا الألم.
الاسئلة التي تظهرُ
بعدَ كُل هذا، تحبينَ فلسطين أكثرَ، لكنك لن تستطيعي الهروبَ من تلكَ الأسئلةِ المُلحةِ، والتي تجعلُ من العودةِ إلى المنفى أصعبَ، فتترددين قليلاً ولا تسعِفُكِ الخياراتُ، وتعرفينَ أنك ستودعينَ كل هؤلاءِ النسوةِ، لأن وجودهنَ ضروريٌ في البلادِ، ويخفِفُ من وقعِ صوَرِ الاحتلالِ عليكِ وأنت تحاولينَ أن تري كيف تبدو البلادُ، ولا تستمتعينَ بها، لأنها صورتُهم، وصورةُ بلادِك، هي أبسطُ من كِل هذا. بلادُكِ هي ألا يكونَ لديكِ سردٌ آخرَ للحياةِ لا يفهمُه الكثيرون. تودعينهن ويحملنَ معهن وسطَ كِل الكراهيةِ التي يعشنَ بها، حقيقةَ أنّ هناكَ من تحبهُنّ بشغفٍ، وبهذا الحبُ ستحيا أجسادُهنَ وستُزهرُ. بعد كل هذا، تمشينَ نحو الطائرة وتعلمينَ أنها ستغُطُّ في منفىً قسريٍ لأنك لم تختاري كلّ هذا، فترتاحين قليلاً، لكنكِ لن تتخلصي من الأسئلةِ التي تسبُقُ العودةَ، كيف تعودينَ إلى مكانٍ لا يحبُ مَنْ أنتِ بعدَما كنتِ في فضاءٍ لم يعطِكِ سوى الحبَ لأنكِ مَنْ أنت. كيف تعودينَ إلى كلّ هذا؟
صباحُ النكبة السبعين
قرأتُ ما يكفي اليومَ من مقالاتٍ عن خياراتِ الفلسطينيينَ والتوجهاتِ السياسيةِ لما يجدُرُ به أنْ يكونَ أو ما يكون، رأيتُ الكثيرَ مِنَ الصورِ وكماً هائلاً من التضامنِ. قرأتُ مئاتِ الجُمَلِ التي تشجِعُ الفلسطينيينَ وتشرْعِنُ حقَهم في المواجهةِ. وكلُ هذا كانَ ينافِسُ صورَ الشهداءِ والاشتباكاتِ والدمِ، كلُ هذا ولا أدري كيفَ يمكِنُ أنْ تنظَمَ مسيرةُ عودةٍ في قلعةِ الشْقيفِ دونَ أنْ يقفَ أحدٌ ويتساءلَ، كيفَ تتصالَحُ دعوةٌ مشروطةٌ للفلسطينيينِ للمواجهةِ المحتملةِ في الجنوبِ مع عودتِهم في آخرِ اليومِ إلى مخيماتٍ تفيضٌ بهم، وقوانينَ متعلقةٍ بتنظيمِ عملِهم والتراخيصِ الباهظةِ إذا تمّت الموافقةُ عليها، ومنعهِم مِنَ الحقِ في التملك. كيفَ يتصالحُ كل هذا مع خطابِ كراهيةٍ مسكوتٍ عنه وتشرّعُه القوانين.
في صباحِ النكبةِ هناكَ مَنْ يعتقدُ أن حياتَنا صعبةٌ نتيجةَ التاريخِ القاتلِ بين شعبَينا، أو أنّ السياساتِ هذه هي انتقامٌ وعقابٌ عمّا اقترَفتِ السُلطةُ الفلسطينيةُ، ويُصِرُّ على الاعتقادِ هذا برغمِ خروجِ السلطةِ الفلسطينيةِ مِنْ بيروتَ، وعنوانُها في سفارةِ فلسطينَ في بيروتَ معروفٌ، ولا أدري لمَ لا تعاقَبُ هي إذاً. وهناك من يُصِر على الاعتقادِ بأنه أمرٌ مفهومٌ، برغمِ انتهاءِ الحربِ الأهليةِ وصدورِ قانون "العفو" العامِ. ولا أدري إذاً لو كانت المحاسبةُ هي الهدفُ، ولدى الناسِ كلَ الحقِ لتحاسِبَ، فلمَ لا يُعفى كلُّ من وُلِدَ في أواخِر السبعينياتِ إلى يومنا هذا؟
في صباحِ النكبِة السبعين، لا أجِدُ سوى عقابٍ جماعي يشبِه ُ كلّ ما يتعرّضُ له الفلسطينيون الذين تتعاطفونَ معهُم في الداخلِ وضمنَ أراضي الـ67. ألم يكفِ كلُّ هذا العقابِ؟ ألمَ يشفِ كلُ هذه العقابِ غليلَ قلوبكِم؟ ألَمْ يَحِنِ الوقتُ لنصبحَ راشدينَ في نظرِكم؟ ألَم يأتِ الوقتُ للكفِ عن الاعتقادِ أنّ وظيفةً جيدةً أو بيتاً أهمُ عِندَ الفلسطينيين من أرضِهم وقضيتِهم؟