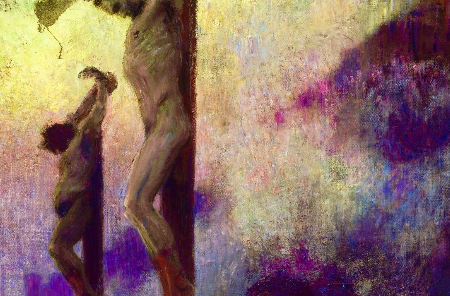الآن، رغم التقنيات الكثيرة، والإمكانيات التي تُسهّل الحصول على كتبٍ عبر الإنترنت، ومواقع تُقرصن كتبًا مختلفة، تبقى المكتبة لي أساس منزلٍ، أستكين إليه بعد عملٍ أو سهرةٍ. فإلى جانب أشرطة الدي. في. دي.، هناك كتب أرنو إليها وأستريح، وأنظر إليها وأهدأ، وأقرأ فيها وأفرح. فالعالم خارج المنزل والمكتبة يزداد هولاً وعنفًا،
1
ليس سهلاً استعادة اللحظة الأولى، الشَاهِدة على بداية تأسيس مكتبة خاصة، يسبقه (التأسيس) عيشٌ في منزلٍ عائلي، له مكتبته التي يصنعها والدٌ، يعمل موظّفًا في مؤسّسة رسمية في بيروت، قبل ظهر كلّ يوم، ويُدرّس اللغة العربية وقواعدها في مدرسة خاصّة، بعد الظهر. والكتب، في مكتبة المنزل العائلي، في منطقة الدورة (الضاحية الشمالية لبيروت)، مجلوبة من الإسكندرية، حيث يُمضي الوالد عمرًا من حياته، يتخلّله زواجٌ من سيّدة (ذات أصل لبنانيّ، لكنّها مولودة في الإسكندرية) وإنجاب ولدين، هما الأكبر في العائلة، وتدريسٌ للّغة العربية في إحدى مدارس المدينة، قبل بدء مرحلة "التهجير القسري"، لكن "غير المباشر"، لجاليات عربية وأجنبية، بسبب سياسات "التأميم الناصري"، والتهجير يشهد نهاية الفصل الأخير من المجد التاريخي للإسكندرية.
"التهجير القسري" هذا، الذي يُصيب أبناء الجاليات العربية والأجنبية من دون رحمة، يطال أيضًا العائلة الصغيرة للوالد، مطلع ستينيات القرن الـ20، فيغادر الوالد فورًا، حاملاً معه صندوقًا من الكتب، تاركًا لزوجته مهمّة التوجّه إلى بيروت رفقة ولديها الإسكندرانييّن الاثنين، جالبة معها حقائب عديدة، تحتوي على ما يُسمَح للوالدة أنْ تأخذه معها، وهذا ليس كلّ مقتنياتها وأغراضها.
2
لكنّ مغادرة الوالد، وبالتالي عائلته الصغيرة وأهله وأهل زوجته، في أوقاتٍ مختلفة في تلك المرحلة نفسها، منبثقة من حدثٍ مباشر، سيؤثّر فعليًا في ذاته وروحه. فهو -الأستاذ المتبَحّر في الأدب العربي، لغةً وقواعد وصرفًا ونحوًا، أولاً وأساسًا، وشعرًا ونثرًا ونقدًا أيضًا- يتمكّن من إيصال أحد تلامذته، ذات عام دراسيّ، منتصف الخمسينيات الفائتة، إلى المرتبة الأولى في عموم الإسكندرية، في مادة اللغة العربية وقواعدها. هذا دافع إلى احتفالٍ، سيتعطّل لاحقًا بعد اكتشاف السلطات التربوية، حينها، أنّ أستاذ التلميذ الأول ذاك مسيحيّ، فيتساءلون (بتوتر ممزوج بغضب): كيف يُعقل لمسيحيّ أنْ يُدرّس اللغةَ العربية؟ وفوق ذلك يتبوّأ تلميذٌ من تلامذته المرتبة الأولى في هذه المادة، والمُدرّس مسيحيّ، ولغة القرآن حكرٌ على المسلمين؟
هذه حكاية أخرى. لكن سردها هنا متأتٍ من رغبةٍ في فهم جانبٍ منها. فالوالد، المتعطّش للأدب، لغةً وقواعد وصرفًا ونحوًا، أولاً وأساسًا، وشعرًا ونثرًا ونقدًا أيضًا، سيُعوّض هزيمته وخيبته وقهره، وإنْ بعد حين، بمزيدٍ من الكتب، بل بمزيدٍ من الانغماس في الكتب التي لديه، ومن شغلٍ يوميّ على دفع أولاده -وله، بعد المولودَين الإثنين في الإسكندرية، مولدان آخران في الدورة- إلى التعمّق في الكتب، كسبيلٍ إلى وعي ونضج ومعرفة، وهذا ينبثق من مكتبته، الحريص عليها حرصه على عزلةٍ يعيشها طويلاً مع كتبه، وبين أبنائه وعائلته.
والمنزلٍ العائلي، في منطقة الدورة (وهي منطقة شعبية يُقيم فيها، قبل زمن بعيد، أبناء طبقة متوسّطة الحال، اجتماعيًا واقتصاديًا)، ممتلئ بكتبٍ، تتوزّع على اللغة والشعر والرواية والدراسات النقدية، إلى جانب «القرآن» الكريم و«المُصحف المفسّر» و«نهج البلاغة» و«ألفية ابن مالك«، وديوان أبي الطيّب المتنبي، وأشعار أبي فراس الحمداني وابن الرومي، وملاحم مختلفة، وروايات قليلة لمصطفى لطفي المنفلوطي، وكتب لسيبويه وطه حسين، وغيرها.
الولادة في مناخٍ كهذا، التي يلحقها نمو وعيش واحتكاك يومي بالمكتبة وبما فيها، أمور كافية لزرع رغبة ذاتية في تأسيس مكتبة شخصية، لن تولد قبل الانتقال إلى منزلٍ خاص، ولو متأخّرًا، فحينها يُصبح المجال أرحب لفعل ما يرغب المرء في فعله، وبين تلك الأفعال المرغوب فيها إنشاء مكتبة، لن يتذكّر منشئُها تكوينَها الأول وكتبَها الأولى.
لكن العيش في منزلٍ عائليّ، بمكتبته هذه، لن يحول، رغم هذا كلّه، دون البدء بشراء كتبٍ، ثم بسرقتها، عندما تُتاح أية فرصة، من مكتبة "كلية الآداب والعلوم الإنسانية" (الفرع الثاني، أي في المناطق الشرقية، الخاضعة لسلطة "القوات اللبنانية"، اليمينية المسيحية، زمن الحرب الأهلية) في "الجامعة اللبنانية"، منذ الانتساب إليها في العام الدراسي 1983 ـ 1984. شراءٌ وسرقة يفرضان، بشكلٍ أو بآخر، على الوالد، إتاحة متّسع من المساحة لتلك الكتب في مكتبته، في المنزل العائلي، وتلك الكتب ستكون نواة مكتبة خاصّة، بمؤلّفاتها العربية والفرنسية، التي يغلب عليها الشعر والرواية، تأليفًا وترجمة. لكن الوالد، حينها، غير مُدرِك أنّ بعض الكتب مسروق، وأنّ السرقة حاصلة في مكتبة جامعية. فالسرقة أولاً، ثم السرقة من مكتبة جامعية، هما أسوأ المصائب بالنسبة إليه، وإنْ يكن المسروق كتابًا، وهو يُقدّر الكتاب ويُثمّن مغريات اقتنائه.
الانتقال إلى منزلٍ خاص، ولو متأخّرًا، كفيلٌ بإنشاء مكتبة، بدءًا من تصميمها وتنفيذها، بمشورة نجّار فلسطيني شاب وجهده، والشاب يُتقن صنعته حدّ الدهشة، فتكون المكتبة، كشكلٍ، مدخلاً إلى تضمينها كتبًا، تُنقَل من المنزل العائلي. والكتب تلك "منهوبة" من مكتبة الكلية، ومُشتراة من باعة الأرصفة، وبعضها مُصطفٌ على جدار منزل السفير الفرنسي، القائم في خطّ التماس بين المتحف والبربير، أي بين المنطقتين الشرقية والغربية، المتناحرتين قصفًا ومعارك وخطفًا وقتلاً وتدميرًا، زمن الحرب الأهلية اللبنانية (1975 ـ 1990)، وطبعًا، يحتل الباعة تلك الأرصفة وذاك الجدار في لحظات الهدوء الملتبس والمؤقّت؛ أو في شارع الحمرا؛ أو بفضل من يُصبح لاحقًا صديقًا، واسمه عصام عيّاد، بدءًا من نهاية ثمانينيات القرن العشرين، وهو بائع كتب مرصوفة في "فان" صغير، يوقفه أمام كنيسة الكبوشية في شارع الحمرا نفسه، قبل انتقاله الأول إلى الشارع الخلفي لمقهى "ويمبي"، وهو الآن في شارع جاندارك، في منطقة الحمرا أيضًا.
3
هذه أمكنة تضخّ في المكتبة الخاصة مؤلّفات وترجمات، تتعلّق بالرواية والشعر أولاً وأساسًا، وبالنقد الأدبي، خصوصا التحليل الاجتماعي للأدب وكتب رينيه جيرار، بسبب دراسة جامعية، يُتاح فيها، بفضل القاضي غالب غانم، قراءة مؤلّفات عبدالله العلايلي وصبحي الصالح، وبفضل الدكتور موريس أبو فاضل، قراءة دراسات يمنى العيد تحديدًا. دراسة جامعية تتعطّل سريعًا، لانغماسٍ ذاتيّ في اللهو والتسلية في الكافيتريا وخارجها، المُرافِقَين لقراءة حرّة، ومتابعة حرّة، وكتابة حرّة، أي بعيدًا عن الإطار الأكاديمي المُتعِب.
الأجمل حينها كامنٌ في تلك الإمكانية الرحبة لـ"سرقة" الكتب من مكتبة الكلية. فالشراء يحتاج إلى مالٍ، والمال يتوفّر غالبًا، لكن جزءًا كبيرًا منه يُخصّص بسهرٍ وخمر، والباقي يُصرَف في شراء مؤلّفات وترجمات، من دون اكتفاء مطلوب. وهذا غير منفضٍ عن المجلات، ومعظمها صادر في بيروت، كـ"الفكر العربي" و"الفكر العربي المعاصر" و"الطريق" و"مجلة الدراسات الفلسطينية"، ومجلة "شؤون فلسطينية" أحيانًا، وغيرها من مجلات، لن يكون شراؤها وقراءتها بشكل دائم ثابتًا وأكيدًا. والكتب أيضًا، وبعضها صادر في الكويت، في سلسلتي "المسرح العالمي" و"عالم المعرفة".
4
أما بداية شراء كتبٍ سينمائية، فغائبة عن البال. أيعود هذا إلى عام 1983؟ لا أؤكّد ولا أنفي. فذاك العام يشهد "فتح" الطرقات بين البيروتين، لعامٍ واحد فقط من سلم ملتبس ومؤقّت، في تلك "الحروب الصغيرة" في لبنان. حينها، ستكون أول خطوة باتّجاه شارع الحمرا، بمكتباته و"بَسْطات" الكتب المنتشرة على جانبيه، وفي أزقّة متفرّعة منه أو موازية له، بالإضافة إلى مقاهيه وصالاته السينمائية (المختفية حاليا بشكل كامل، منذ سنين مديدة) ومحلاّته التجارية، وصحف يومية تصدر فيه أو في محيطه الجغرافي، كمجلات أسبوعية أيضًا. يومها، تبدأ العلاقة -التي ستكون طويلة جدًا وعميقة جدًا وحميمة جدًا، رغم اضطرابات وقلاقل منبثقة من أحوال المهنة وانقلابات البلد وحروبه المتنقّلة- بالصحيفة اليومية "السفير". ومع بعض أجمل من ألتقيهم فيها، كالروائي الياس خوري والشاعر محمد علي فرحات والناقد السينمائي محمد سويد والصحافي والكاتب السياسي باسم السبع، سأنتبه أكثر فأكثر إلى مؤلّفات وترجمات ومجلات، لن يكون لي مستقبلٌ مهنيّ في الصحافة والأدب والمسرح تحديدًا، والسينما لاحقًا، إنْ أبقى غريبًا عنها. هذا إلى جانب تدريب يومي، غير مباشر وغير تلقيني، على مبادئ مهنة الصحافة، وكيفية الكتابة والتعليق، وإنْ يأتي هذا بعد تجربة أعتزّ بها كثيرًا، على مستوى القراءة والمتابعة والمهنة أيضًا، أخوضها مع الشاعر والصحافي أنسي الحاج، في "النهار العربي والدولي".
5
أيّ كتاب سينمائيّ هو الأول؟ يستحيل تذكّر ذلك. أهذا مُرتبطٌ بمجلات سينمائية، فرنسية تحديدًا؟ يستحيل تذكّر ذلك أيضًا. لكن، هناك ما هو مؤكّد: شراء كتاب «هيتشكوك/ تروفو، أو السينما بحسب ألفرد هيتشكوك» (الطبعة الأصلية عام 1966) مُترافق وشراء أسطوانتين اثنتين كبيرتين، الأولى بعنوان «الجدار» لفرقة Pink Floyd، والثانية لفرقة Led Zeppelin، لن أتذكّر عنوانها الآن. أما الرابط بين الأسطوانتين والكتاب، فيصعب عليّ تبيان سرّ تذكّري إياه، وسرّ تذكّري شراء الأسطوانتين والكتاب في وقتٍ واحد. لعلّ هذا حاصل في منتصف ثمانينيات القرن العشرين. بينما اختياري كتاب «هيتشكوك/ تروفو»، فمتأتٍ، بالتأكيد، من مرحلة، وإنْ متواضعة، أُتيح لي فيها مشاهدة أفلام متنوّعة، في الأشرفية وجونية (المناطق الشرقية المسيحية، بلغة الحرب الأهلية اللبنانية) والاطّلاع، في "مكتبة أنطوان" في شارع الحمرا، على كتبٍ سينمائية، سأتابع عناوينها في أمكنة مختلفة، وسيُطلعني عصام عيّاد على كل ما لديه من كتب سينمائية، عربية وأجنبية ومُترجمة، وعلى كل ما يحصل عليه تباعًا، وبعضها صادر عن "دار الطليعة" مثلاً.
كتب سينمائية كثيرة، تتناول شتّى المواضيع والقضايا والأسئلة والأفلام. مسائل ومسائل تبدو كأنها لن تنتهي. هذا مفيد، إذْ بفضل اتقاني اللغتين العربية والفرنسية، أتمكّن من إغناء وعيي بأساليب مختلفة في النقاشات النقدية والتحليل والحوارات. وهذا لن يُفيد إنْ يبقى منزّهًا عن المُشاهدة، والمُشاهدة متوفّرة، فالصالات عديدة، والأفلام، رغم الحرب وانشقاقات البلد ونزاعات أهله، كثيرة ومتنوّعة. وهذا، أيضًا، غير منقطع عن قراءتي كتبًا أخرى، أميل فيها إلى الرواية بشكلٍ أساسي.
أحيانًا، يغلب اهتمامي بالرواية على اهتمامي بالكتاب السينمائي، حينها. لاحقًا، يتساوى الاهتمام بهما معًا في المتابعة والاطّلاع. بعد النهاية الملتبسة والمعلّقة للحرب الأهلية اللبنانية، بأعوامٍ مديدة، ستُثيريني كتبٌ متعلّقة بالحرب يضعها لبنانيون وأجانب، وأخرى لمقاتلين مسيحيين، يُصدرون مذكّرات ذاتية عن تجارب وانفعالات وانكسارات وتبدّلات وأفكار ونزاعات.
6
بيروت، في ثمانينيات القرن العشرين، مستمرّة -رغم كلّ شيء- في إنتاج الكتب، تأليفًا وترجمة. المكتبات زاخرة بكتبٍ مختلفة، ودور النشر عديدة ومهمّة، والمطابع تكاد لا تتوقّف عن المشاركة الفعلية في صناعتها، رغم القصف والصراعات الدموية بين "الإخوة الأعداء"، في المناطق السكنية، والشوارع الآهلة بالمدنيين، ورغم ما تُفرزه هذه الصراعات وذاك القصف من دم وجثث وخراب.
كتبٌ وصالات سينمائية ومقاهٍ ومراكز ثقافية وصحف ومجلات: هذه بيروت، المنقرضة كلّيا في راهنٍ غارقٍ في جفافٍ شبه مطلق للقراءة والمُشاهدة وإعمال العقل والتفكير، وتفعيل الحوار والسجال. فدور النشر غير معنيّة، كما في ماضيها، بإصدار كتبٍ سينمائية عربية ومترجمة، إلا نادرًا؛ والمكتبات أقلّ عدد بكثير، ما ينعكس سلبًا على تسويق الكتاب السينمائي الأجنبي، الذي يُغريني شراؤه، خصوصًا عند زيارتي الـ FNAC، وما يُشبهها، في بلجيكا وفرنسا تحديدًا. فالقراءة تُثير لذّة تُشبه لذّة المُشاهدة، وهذا كافٍ لي.
7
الآن، رغم التقنيات الكثيرة، والإمكانيات التي تُسهّل الحصول على كتبٍ عبر الإنترنت، ومواقع تُقرصن كتبًا مختلفة، تبقى المكتبة لي أساس منزلٍ، أستكين إليه بعد عملٍ أو سهرةٍ. فإلى جانب أشرطة الدي. في. دي.، هناك كتب أرنو إليها وأستريح، وأنظر إليها وأهدأ، وأقرأ فيها وأفرح. فالعالم خارج المنزل والمكتبة يزداد هولاً وعنفًا، ومع أنّ كتبًا وأفلامًا تعكس شيئًا من الهول والعنف هذين، إلاّ أنّها (الكتب والأفلام) أرحم من عالمٍ خارجيّ مقيت ومُتْعِب.