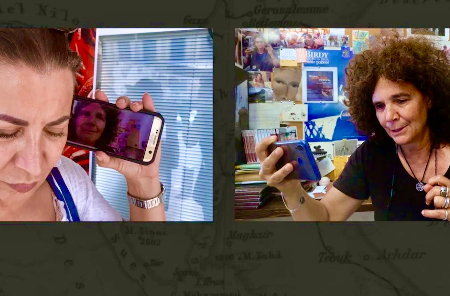فيما أنتهي من متابعة القناة الثانية، أدركُ أن الوقت أصبح متأخراً، لكن هذا شيء عادي، فلا حدود للوقت أثناء الاحتجاز ولا رغبة لديّ في تخييب آمال جيمس بوند. لا أريد أن أخلد إلى النوم قبل أن يتمكن شون كونري من إحباط كل خطط المكيافيللي وGoldfinger السمين ونجاحه في إنقاذنا جميعاً.
الرحلة الطويلة حتى حلول المساء
كنتُ رفضتُ ممارسة الكتابة حتى الآن، لأنني لم أرغب في ترك أي دليل على المشاعر التي أيقظتها فيّ هذه الأيام القليلة من العزلة. قد يكون السبب الأول في ذلك اكتشافي غير السعيد بأن الوضع الحالي لا يختلف كثيراً عن روتيني اليومي، فأنا معتادٌ على العيش وحدي والبقاء في حالة من التيقّظ. رفضتُ خلال الأيام التسعة الأولى كتابة أية ملاحظات، حتى قرأتُ هذا الصباح عنواناً إخبارياً بدا لي وكأنه من مجلة مخصصة للكوميديا السوداء "تحولت حلبة تزلج في مدريد إلى مشرحة مؤقتة". يهيء إليّ أنه عنوانٌ مكتوب بأسلوب جيالو الإيطالي، بيد أنه يحدث في مدريد، ويشبه العناوين التي درجتْ في برنامج تلفزيونيّ يسردُ أكثر أخبار اليوم شراً.
اليوم هو الحادي عشر من أيام الحجر الصحي الذي بدأتُ بالالتزام به يوم الجمعة التي صادفت الثالث عشر من مارس آذار. بدأتُ من ذلك الحين بترتيب أموري لأتمكن من مواجهة الليل وما يجلبه من ظلام. فأنا أعيش في مكان يبدو وكأنه وسط غابة، وأتتبع الإيقاع الذي يدلني إليه النور الساطع عبر الشرفة والنوافذ. لقد بدأ فصل الربيع والطقس ربيعيّ فعلاً. هذا أحد أروع المشاعر اليومية التي كدتُ أنسى وجودها. ضوء النهار ومسيرته الطويلة حتى يحل المساء، ولا أعني أن هذه المسيرة شيء مروّع، بل على العكس، فهي تبعثُ على البهجة. (أو أن هذا ربما ما أحاول التركيز عليه متجاهلاً عذابات الأخبار التي تَرِدُ باستمرار.)
توقفتُ عن تفقد ساعتي، ولا أنظر إليها إلا لأعرف عدد الخطوات التي قطعتُها مشياً عبر الممر الطويل في منزلي، الممرّ الذي عاتَبتْ فيه جوليتا سيرانو أنطونيو بانديراس لعدم كونه ابناً جيداً فيما أشارت إليّ. يخبرني الظلام في الخارج أن المساء قد حلّ بالفعل، لكن ليس الليل ولا للنهار جدول زمني. توقفتُ عن الاستعجال. من بين كل الأيام، اليوم هو الثالث والعشرون من مارس وتخبرني حواسّي بأن اليوم قد أصبح أطول أي أن بإمكاني الاستمتاع بضوء النهار لمدة أطول.
لستُ في مزاج سعيد بما يكفي لأبدأ بكتابة عمل مسنود إلى الخيال. يحدثُ كل شيء في وقته، بالرغم من قدرتي على التفكير بعدد من الحبكات لبعضها طبيعة أكثر حميميّة. (أكاد أجزم أننا سنشهد طفرة في المواليد بنهاية هذا الوضع، كما أنني متأكد من أن حالات الانفصال ستكون كثيرة، فكما قال سارتر، الآخرون هم الجحيم. ستضطر بعض الأسر لمعايشة الواقعين في آن: الانفصال وولادة فرد جديد لأسرة تفككت للتوّ.)
كان ليسهلَ فهم الواقع الحالي لو كان أدباً خيالياً أكثر منه كقصة واقعية. إذ يبدو وكأن العالم والفايروس الجديد أجزاءً من قصة خيال علمي من الخمسينيات أو من سنوات الحرب الباردة. وكأن الواقع فيلم رعب يمتلئ بالبروباغندا القاسية المناهضة للشيوعية. أو أنه فيلم أمريكي جيد من الدرجة الثانية، خصوصاً تلك الأفلام التي استندت إلى روايات ريتشارد ماثيسون مثل “The Incredible Shrinking Man,” “I Am Legend,” “The Twilight Zone”، على الرغم من سوء نية منتجي هذه الأفلام. بالإضافة إلى هذه الأسماء، أفكر أيضاً بأفلام “The Day Earth Stood Still,” “D.O.A.,” “Forbidden Planet,” “Invasion of the Body Snatchers”، وأي فيلم يظهر فيه سكان المريخ.
لطالما جاء الشرّ من الخارج، فهناك الشيوعيون واللاجئون وسكان المريخ، وشكلت هذه ذرائعاً خدمت الشعبوية القاسية. (مع ذلك، فإنني أنصحُ وبحماسة بالغة بمشاهدة كل الأفلام التي ذكرتُها، فلا زالت ذات جودة عالية). في الواقع، لا يدّخر ترامب جهداً ليضمن أننا نعيش في فيلم رعب من الخمسينات، وهو يطلق على الفايروس اسم الفايروس الصيني. ترامب هو الآخر مرضٌ عضال نعيشه في هذا العصر.
أقررُ الحصول على بعض التسلية. عادةً ما أرتجلُ شيئاً (لكن هذه ليست عطلة نهاية الأسبوع التي أسخرها عادة لعزلتي)، لذا فأنا الآن أخطط برنامجاً يتكون من مشاهدة الأفلام والنشرات الإخبارية والقراءة بهدف ملئ أوقات الفراغ خلال اليوم. أصبحَ منزلي بمثابة معهد وأنا ساكنُه الوحيد. أضفتُ مؤخراً بعض التمرينات المنزلية كذلك. كنتُ أشعر بإحباط شديد حتى الآن، فلم أكن أقوم بأي تمارين سوى الاستيقاظ والسّير عبر ممر في منزلي، شاهدتم كلاً من جوليتا سيرانو وأنطونيو بانديراس يسيران عبرهُ في فيلم “Pain and Glory”.
أقوم باختيار فيلم الظهيرة “Dirty Money/Un flic” للمخرج جان بيري ميلفلي، وأفاجئ نفسي باختياري لفيلم المساء إذ أقرر اختيار أحد أفلام جيمس بوند "Goldfinger". اعتقدتُ أنني في يوم كهذا بحاجة إلى نوع من أنواع التسلية الصرفة، أو الهروب التام.

أسعدُ فيما أشاهد فيلم "Goldfinger" باختياري، فبدلاً من أن أقوم أنا باختيار الفيلم، اختارني هو. التقيتُ شون كونري حين جمعتنا طاولة على عشاء في كان. تفاجئتُ حينها بمعرفته السينمائية وخصوصاً فكرة اهتمامه بأيّ من أعمالي. كان ذلك بعد رحيله عن مدينة ماربيا، فيما لم يتوقف عن حب إسبانيا من ذلك الوقت. انتهى ذاك اللقاء ببدء صداقة بيننا حتى أننا تبادلنا أرقام هواتفنا التي كنتُ متأكداً أن أياً منا لن يستخدمها أبداً. بالرغم من ذلك، وبعد عدة شهور بين عامي 2001 و2002، هاتفني بعد أن أنهى مشاهدة فيلم “Talk to Her”. لستُ ممن يولعون بشيء ما ولا أؤمن بالأساطير، لكن الاستماع لحديثه عن أحد أفلامي ترك فيّ أثراً كبيراً لا يقل عن تأثير كونه ممثلاً متميزاً جذاباً وذا صوت عميق. فكرتُ بكل هذا فيما كنتُ أشاهد فيلم "Goldfinger" في ذلك المساء. تنافستُ أنا والحجر الصحي والمساء وشون كونري على أفكاري بما في ذلك ما شابها من انقطاعات.
أسترقُ لحظات لتشغيل التلفزيون بين فيلم وآخر لأعلم أن إعصاراً لا نعرف عنه سوى اسمه قد أودى بحياة لوسيا بوس، لأذرف أولى دموع اليوم. كنتُ مفتوناً بلوسيا بصفتها الفنية وصفتها الشخصية. أتذكرُها من فيلم “Story of a Love Affair” لأنطونيوني، إذ كانت امرأة بجمال لا مثيل له، غريبة بالنسبة لزمانها وذات مشية حيوانية عجيبة تجمع بين أسلوب الرجال والنساء، وهي مشية ورثها عنها ابنها ميغيل بوس إضافة إلى أشياء أخرى. سأُدرِجُ فيلم أنطونيوني على برنامج الغد.
كنتُ واحداً من الكثير من أصدقاء ميغيل الذين ذُهلوا ووقَعوا تحت تأثير التعويذة القوية لهذه المرأة التي بدا أنها خالدة. مثل جين مورو وشافيلا فارغاس وبينا باوش ولورين باكال، كانت لوسيا جزءاً من ظاهرة مرموقة جمعتْ نساءً أحراراً مستقلات أكثر رجوليّة من الرجال في محيطهن. أعتذرُ عن سلسلة الأسماء التي ذكرتُها للتّو لكنني حظيتُ بلقائهن جميعاً وكنتُ قريباً منهن. هذه إحدى سلبيات أن تكون عالقاً من المنزل، تصبحُ فريسة سهلة للنوستالجيا.
أتمكنُ من التواصل مع ميغيل في مكسيكو سيتي ويستغرق حديثنا وقتاً طويلاً. مرّت سنوات عدة على آخر حديث بيننا، وبالرغم من الحدث المأساوي، كنتُ أرغبُ في التعبير عن شكري له على كل أزهار الأوركيد البيضاء التي لا يزال يرسلها إليّ في عيد ميلادي على مدار العقود الثلاثة الأخيرة. بغضّ النظر عن مكان تواجدي، وهو مدريد في أغلب الأحيان، تصلني في الخامس والعشرين من سبتمبر من كل عام مزهرية من أزهار الأوركيد البيضاء التي تدوم لأشهر عدة، وتُرافقُ كل منها بطاقة كبيرة موقّعة بالحروف الأولى من اسمه.
من فوائد عدم وجود جدول زمني أثناء الاحتجاز أن تتخلص من الشعور بالعجلة والضغط والتوتر. أنا بطبيعتي كثيرُ القلق، لكنني أكاد لا أشعر بشيء منه في هذه الأيام. نعم، أدركُ أن الواقع مروّع ومليء بالغموض خارج حدود نافذتي، ولهذا فأنا متفاجئ من عدم شعوري بالقلق. أحاولُ جاهداً التشبّث بهذا الشعور الجديد الذي يساعدني في التغلبِ على خوفي وشكوكي. فأنا لا أفكرُ في الموت ولا في الأموات. مهمتي الرئيسية هي الردّ على كل رسالة وصلتني لتسأل عن حالي وعن عائلتي، وهو أمرٌ جديد أقوم به بكل الأحوال إذ أنّ من عاداتي السيئة أن أتجاهل الرسائل أو معظمها. للمرة الأولى، أشعر أن لهذه الرسائل معنى حقيقياً غير مبتذل. أتعامل مع الرد على هذه الأسئلة بجديّة كبيرة وأقوم بالرد على جزء منها كل ليلة، لأتعرف بشكل أكبر على ما يقوم به أفراد أسرتي وأصدقائي.
عندما يغيب النور عن نافذتي، أبدأ بمشاهدة فيلم "Goldfinger". ومرة أخرى، أشعر بإعجاب شديد تجاه شيرلي باسي وشيرلي أخرى تظهر لمدة قصيرة، وهي الممثلة الجميلة شيرلي إيتون التي دفعت ثمناً باهظاً لوقوعها في قبضة بوند. يُعدّ المشهد الذي يظهر فيه جسدها بلون الذهب ملقى على السرير دون أن تبقى أي من خلاياها على قيد الحياة، واحداً من أقوى المشاهد التي تم تصويرها في سلسلة الأفلام، وهو تعبير عن الرغبة والجشع والإثارة الإيروتيكية وجنون الأشرار شديدي القوة الذين لا يطمحون لشيء سوى تدمير العالم بحيث لا يتمكن من النجاة سوى أتباعهم.
عليّ أن أتوقف عن متابعة الفيلم لأجيب على مكالمة هاتفية من شقيقتي تشوس التي تخبرني بأنها تشاهدني ضمن وثائقي يُعرض على القناة الإسبانية الثانية، وقد انقضى نصف الفيلم حتى الآن. أسارع في الانتقال من جهاز الفيديو لأتابع القناة الثانية لأجد فيلماً وثائقياً عن شافيلا فارغاس من إعداد داريشا كاي وكاثرينا غوند. أكاد أذرف الدموع في كل مشهد ومع كل صوت. باغتني الأمر بالرغم من أنني شاهدتُ هذا الوثائقي في وقت سابق، لكن هذه لحظة تختلف تمامأً عن كل ما عشته من قبل، وليس بوسعي أن أقوم بأي مقارنات الآن. كل ما أعرفه هو أنني محبوس وأوشك على الانفجار في الوقت ذاته. أتابع الأخبار بوتيرة أقل في كل يوم في محاولة لإبعاد القلق والذعر عن نفسي. يمكن وصف الملاذ الذي أشير إليه، من أساليب التسلية والهرب من الواقع، بأي شيء إلا الرّتابة. حتى وإن كنتُ قد شاهدتُ الوثائقي عن شافيلا والذي فاجئني بمشاعر لا أستطيع التحكم بها، ولا أملك حتى الرغبة للقيام بذلك. أبكي حتى المشهد الأخير، وتغمرني ذكريات كل الليالي التي قدمتُها فيها على خشبة مسرح سالا كاراكول أو مسرح ألبينيز الذي كان أول مسرح اعتلتْ هي خشبته كمُغنية. لم يَسمح لها التمييز الجنسي الملعون في المكسيك بالغناء على المسرح مرتدية بنطالاً وعباءة البونشو، وقد تذرّع القائمون حينها بحجة استحالة ارتداء امرأة حقيقية لهذه الملابس.
قدمتُها على مسرح أولمبيا في باريس. كان ذلك أمراً صعباً لكننا تمكنّا من الحصول على جمهور يملأ المسرح. في الصباح وخلال فحص الصوت، سألتْ شافيلا أحد العاملين عن المكان الذي كانت تقف فيه السيدة إديت بياف أثناء عروضها على المسرح، وقامت بالغناء من ذلك الموقع. منذ تلك الليلة، بدأتُ طقساً خاصاً بي كانت فيه شافيلا إديت بياف خاصتي، فبدأتُ بتقبيل السنتميترات القليلة التي كانت تقف عليها شافيلا على المسرح في وقت لاحق.

لم أكن جاهزاً للاستماع مرة أخرى إلى صوت الساحرة العظيمة في حديثها ولا غنائها بعد متابعة فيلم جيمس بوند المسلّي، كذلك لم أكن جاهزاً لأشاهد نفسي وأنا أغني “Vámonos” معها أو أن أسترجع الكثير من لحظات حياتها سواء في مدريد أو في المكسيك.
أذكرُ أنني هاتفتُها من طنجة خلال عيد الميلاد عام 2007. أخافني يومها صوتها وصياغتها للكلمات القليلة التي تفوّهت بها. كان اللفظ القشتالي الرائع واحداً من مميزات شافيلا الخاصة، فكانت الكلمات تصدر من فمها في غاية الكمال دون أن ينقصها حرف واحد. لكنها لم تتمكن أثناء تلك المكالمة من قول أي شيء سوى "أحبكَ كثيراً" و"يمرّ الزمن سريعاً"، وهو ما أصابني بالقلق. بعد أسبوعين، وصلتُ إلى لا كوينتا لا مونينا في مدينة تيبوزتلان حيث كانت تتلقى عناية صديقة من أيام شبابها. كنت جاهزاً لأسوأ الاحتمالات، إذ كنتُ أعلم أنها خضعت للعلاج في المستشفى قبل ذلك بثلاثة أيام. لكنها عندما علمتْ بأنني قادمٌ لزيارتها طلبت أن يُسمح لها بالخروج في الليلة السابقة. ما كان لأحد أن يرفض طلباً لشافيلا. وبالفعل، كانت حاضرةً في استقبالنا في منزلها الصغير
في تيبوزتلان كما لو كانت زهرة من فصيلة بنت القنصل: مشرقةً وبرّاقة وبنفس الصوت الذي اعتدنا عليه، فلم تتوقف عن الكلام طيلة فترة زيارتنا التي استغرقت ثلاث ساعات.
افترقنا في ظهيرة ذلك اليوم وتركناها وحيدة مقيدة بوحدتها. اعتنت بها امرأة من السكان الأصليين حتى الخامسة من عصر ذلك اليوم، ثم بقيت وحدها حتى اليوم التالي، فلم تسمح شافيلا يوماً لأحد من العاملين لديها برعايتها خلال الليل. كان لوالدتي سلوكاً مشابهاً في السنوات الأخيرة التي سبقت وفاتها. لسببٍ غير مفهوم تصبح النساء القويات أكثر حدة وأقل عقلانية، ولا يمكن بأي طريقة أن تحذرهنّ من الليالي الطويلة، والسبب الرئيسي وراء ذلك أنهنّ يعرفن تلك الليالي تمام المعرفة وأنهن يتمتعنّ بقوى خارقة على التحمّل. تحدثنا عن مرضها وعن الموت وأخبرتني كما تفعل أي ساحرة طيبة: "لستُ خائفة من الموت يا بيدرو، نحن الساحرات لا نموت، بل نُرفع للسماء." كنتُ متأكداً من كلامها. كذلك قالت لي: "أنا هادئة، سأتوقف عن الحياة في إحدى الليالي ببطء وسأستمتع بذاك الشعور."
استقبلتنا في اليوم التالي واقفة ومتحمسة لنصحبها لتناول الغداء خارجاً. كان لشافيلا خبرة كبيرة في العودة إلى الحياة كما لو كانت تُبعث من جديد. بعد أن تعافت بشكل تام، عرضت علينا بسعادة بالغة أن تأخذنا في جولة حول تيبوزتلان. بدأت رحلتنا من تلة تشاتشبيتل مقابل المنزل الذي كانت تعيش فيه. في تلك المنطقة، قام جون ستورجس بتصوير مشاهد فيلم “The Magnificent Seven”. بحسب الأسطورة فإن أبواباً خفية في تلك التلة ستظهر من بين الصخور والأعشاب وتُفتح عند حلول نهاية العالم القادمة، وحينها لن ينجوا إلا أولئك القادرين على الدخول إلى رحم الأرض عبر هذه الأبواب. أنظر إليها بدهشة جديدة، فقد كانت تتحضر بالفعل لنهاية العالم الجديدة، ولا يسعني إلا أن أفكر في النهاية التي نعاصرها اليوم.
بالدموع على خدودي ألتقط أنفاسي وأستعد للعودة لمتابعة فيلم جيمس بوند، لكن القناة الإسبانية الثانية تبدو مستمرة بلا توقف، فتقدم بعد الوثائقي عن شافيلا فيلماً آخراً يحتوي اسمه على كلمة "نور"، فيلم “La luz de Antonio”/“Dream of Light”. كان أنطونيو لوبيز رساماً من لامانشا، وكانت زوجته ماريا مورينو نور عينيه. كانت ماريا رسامة من مدرسة الواقعية العظيمة، ولطالما بقيت على الهامش خلف أنطونيو وغيره من مجموعة رسامي الواقعية العظماء الذين عاشوا أثناء الخمسينيات. أنصحُ بمتابعة هذا الوثائقي بشدة، كما أنصح بهذه المناسبة بمتابعة القناة الإسبانية الثانية لما تقدمه من برامج بديعة.
ماتت ماريا مورينو قبل أسابيع قليلة. أذكر أنها كانت ملاكاً على العكس من شافيلا، إذ تترك رسوماتها انطباعاً طيباً وسارّاً وغامضاً، وتختلف كثيراً عن أعمال أنطونيو لوبيز الذي تشاركت معه الرسم في الموضوعات ذاتها ولم تتأخر عنه سوى بضع خطوات. يتحدث الوثائقي كذلك عن عملها في إنتاج فيلم “The Quince Tree Sun“ للمخرج فيكتور إريثيه، وهو فيلم جيد آخر، أظن أنه الأفضل على الإطلاق في التعبير عن معجزة النور الطبيعي التي تنعكس لتشكّل عالمنا. نجد النور، وحده النور في الرحلة الطويلة نحو المساء، وهو ما يجعلنا نمرّ بفصول السنة المختلفة.

في تحفة إريثيه الفنية، يمكننا رؤية أنطونيو لوبيز في مرسمه، يكنس الأرض ويحضر اللوحات التي سينفّذ عليها عمله الجديد. يا له من طقس جميل! يخرج أنطونيو إلى فناء منزله المتواضع حاملاً كأساً من النبيذ، ونراه مأخوذاً بالثمرة الصفراء لشجرة السفرجل كثيفة اللحاء، وهي شجرة بسيطة ورثة قليلاً. لثمار السفرجل لون أصفر زاه وهي محاطة بأوراق من الأخضر الداكن. في الصباح، يتجول أنطونيو حول الشجرة ويركز نظره على الملمس الخشن لحبات السفرجل، وينظر إليها مفتوناً ومنبهراً. ثم يقرر أن يرسمها، حتى وهو يعلم مدى استحالة قدرته على نقل الصورة التي يمعن النظر إليها إلى اللوحة، لأن الثمرة حيّة وستستمرّ في التغير كل يوم حتى أن نورها لن يستمر على نفس الصورة. يتحدث الفيلم عن المعركة التي يخوضها الفنان لالتقاط نور الشمس على السفرجل، وهي معركة خاسرة سلفاً.
في عام 1992، عُرض فيلم إريثيه في مهرجان كان للأفلام حيث كنتُ عضواً في لجنة التحكيم. حاز الفيلم على جائزة لجنة التحكيم الخاصة باستحقاق بعد أن كنتُ أوشكتُ على خوض مشاجرة مع رئيس اللجنة جيرارد ديبارديو الذي لم يحبّ الفيلم أبدأً واعتبره فيلماً وثائقياً. لحسن الحظ، تمكنتُ من الحصول على دعم بقية أعضاء اللجنة.
فيما أنتهي من متابعة القناة الثانية، أدركُ أن الوقت أصبح متأخراً، لكن هذا شيء عادي، فلا حدود للوقت أثناء الاحتجاز ولا رغبة لديّ في تخييب آمال جيمس بوند. لا أريد أن أخلد إلى النوم قبل أن يتمكن شون كونري من إحباط كل خطط المكيافيللي وGoldfinger السمين ونجاحه في إنقاذنا جميعاً.
نُشرت في إنديواير في ٨ أبريل ٢٠٢٠ وهذه ترجمتنا لها.