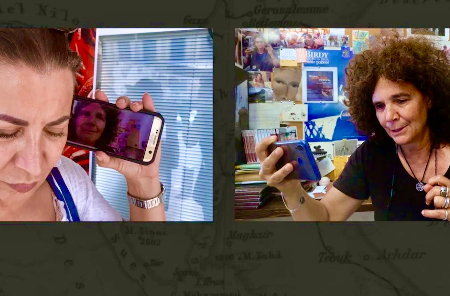تستفيق عين بشرية على واقع جديد محدود، هذه الاستفاقة هي الشخصية التي تبحث ونبحث معها عن شيء ما، ترى في الأفق أضواء وخط حدود المدينة السمائيّ، ألوان متنوعة ما بين شروق وغروب وانعكاسات الضوء في زوايا البيت. تبدو هذه وكأنها شخص يسترق النظر إلى مكان محرّم، أو حالة من التذكار لشيء غاب.
فتحت أزمة كورونا -رغم سوئها الخانق- أفقًا لتحدٍ سينمائيّ جديد هو "سينما الحجر" أو ربما تصح تسميه أيضًا "سينما العزل الاجتماعيّ". مواد بصريّة أنتجت في فضاء محدود، حصار ما بين العدسة وحيّز شخصيّ وآخر عام صغير المساحة، وحريّة كبيرة في الفكرة وغرفة المونتاج لا نهائية الإمكانيات.
نشرت مؤسسة "فيلم لاب" بعضًا من الأفلام المنتَجة ضمن هذا الأفق، يمكن أن يكون بعضها خلاقًا في فكرته وآخر في تنفيذه، لها ما يجمع بينها ولها تميّز واحدها عن الآخر، لكنها دون استثناء لم تنعزل ولم تحجر أفكار أصحابها بعيدًا عن الواقع الفلسطيني المُثقل بالاحتلال والتضييق وغياب العدل.
ضمن مجموعة "أصوات من فلسطين" قدمت المخرجة نجوى نجار فيلم "سقط القناع"، والمخرجة ليلى عباس فيلم "ضبابي"، والمخرج إيهاب جاد الله فيلم "النهاية هنا" وقدم المخرج بلال الخطيب فيلم "تراجع". تماهيت فيها مع ما يثير الحجر فينا من مشاعر مقيّدة، ومع ما يفرزه كل حدث غير متوقع من مشاعر غضب وإحباط، لكني كنت أتمنى أن أرى فيها المزيد من الإبداع في اللغة السينمائية، وإخراجها بالصورة التي تحفّز العقل على المزيد من التحليل والتفكّر.
ضبابي... وتعاطفي الشخصي
في فيلم ليلى عباس، مكان ما وسيدة شابة حبيسة المنزل كما كنا جميعًا، تطالع من شباكها المقيّد بالحديد حيزًا أكثر اتسعًا. تظهر لها سماء خالية من الصخب، هدوء لا يزينه إلا بعض أصوات العصافير، وتلوح في الأفق القريب مدينة ملاهي محرومة من اللاعبين.
في ملعب الأحداث الداخلي، بيت عصري تعلو فيه أصوات برامج تلفزيونية وتوصيات حفظناها عن ظهر قلب "ابقوا في منازلكم"! ممارسة لحياة يومية معتادة بين الترتيب والتنظيف وتبديد الملل بشطب الأيام التي تخلو من أي نشاط يذكر وحالة من الغباش.
مع انطلاقة اليوم ترافقنا سيرورة حياة حبة دواء فوّار، حبة صغيرة توضع في كأس وتُغرق بالماء لتبدأ حالة الثورة والفوران، في صورة أراها تعبيرًا عن حالة نفسية رافقتنا جميعًا، حالة الغليان التي أفرزتها قلّة الحيلة والوحدة والتباعد، رغبة في ثورة على فيروس يقيدنا ولا نستطيع تقييده، يحاربنا دون نراه، وإن لم يقتلنا فقد قتل فينا الكثير من الصبر. كلما تكرر الأحداث وتوالت ازدادت حالة الفوران... الوضع بغلي، على ما يبدو.
وسط حالة التكرار، والأخبار، والتواصل عبر محادثات الفيديو تتم محاولات لتصليح النظار، تبوء إحداها بالفشل فيما، على ما يبدو تنجح أخرى. كان تعاطفي كبيرًا جدًا معتلك الصور التي مرّت دون أن أرى أو ترى المخرجة تفاصيلها، لقد حالت النظارة المكسورة بيننا وبين الوضوح، وهذا هو الحال، إننا نعيش حالة من عدم الوضوح والضبابية، لكني آخذ على محمل الجد هذا اللحظات العينيّة وأرى فيها نفسي طفلة تضع نظارة طبية يعبث بها الأطفال من الأقارب فيكسرونها وأنا أنا حبيسة عدم قدرتي على رؤية الأمور حولي بوضوح حتى يأتوني بنظارة جديدة قلّما سنحت لي الفرصة باختيار لونها أو شكلها!
لم تستطع المخرجة -كما هو الفنان الفلسطيني عمومًا- أن تنأى بإنتاجها الفني عن الواقع السياسيّ، وعن الرغبة في انتقاده والتهكّم عليه. فبينما نسمع في الخلفية صوت الرئيس -أبو مازن- يهدد ويعد بالرد على إسرائيل وقرار الضم، تتعثر الكلمات في فمه، فتسعفة صاحبة البيت بالقليل من سائل وظيفته "تسليك" العثرات، في مشهد ظريف ومعبّر يرافق تعثر الخطاب عندما تقوم برشّ قفل الباب بسائل ما وتختبر قدرته في فتح الطريق أمام القفل ليكون أكثر لينًا وإنسيابًا، فيما تبقى صاحبة البيت حبيسة المنزل تعد المزيد من الأيام.
سقط القناع في بحر حيفا
في فيلم نجوى نجار، التناقض الفظ بين صور السماء والغيوم والموسيقى وكلمات الأغنية المحمّلة بالفرح، تباغتنا أصوات الطائرات الحربية السريعة، فننزل إلى أرض الواقع لنواجه الحقائق السياسية وخطابات السياسيين التي تبدو حربًا كلامية وتراشق التهديدات بين الإسرائيليين والفلسطينيين حول قرار الضم. وبشكل جميل التوظيف ترتبط الخطابات والاقتباسات من أفواه السياسيين بين الفيروس وتوقيت تنفيذ قرار الضم.
نسير مع المشاهد بمحاذاة جدار الفصل العنصريّ وصولًا الى الساحل الفلسطينيّ حيث وقع الحدث المأساوي الأبرز هذا العام إنسانيًا وفنيًا، إذ خسر الفن الفلسطينيّ أيقونة الرقص أيمن صفية الذي قضى غرقًا في البحر وتاهت جثته بين الأمواج ثلاثة أيام متتالية.
هذا الغرق أسقط -من جديد- قناع العنصريّة والتمييز ضد الفلسطينيين عن وجه دولة الاحتلال، وهناك تشوشت الصورة وبدا البحر لنا مكانًا يتسّع للكثير من الماء لكنه أيضًا بحر من الحركة والرقص والتعبير عن النفس، في صورة تعيد للأذهان أيمن صفية الراقص على المسرح يرافقه صوت شاعر العروبة سميح القاسم وهو يلقي على مسامعنا بعضًا من قصيدة "سقط القناع".
يضم هذا الفيلم -مع قصره- نصًا إخباريًا كثيرًا، يغيّب عن عيوننا ما تحمله الصور من تجسيد للفقدان والمقاومة، والتهديد المقترب من خلال تصوير أقدام امرأة تمشي بروية باتجاه الكاميرا.
سقط القناع منذ زمن طويل لكن المخرجة آثرت أن تعيده للأذهان مرّة أخرى من خلال قصة فقدان أيمن صفية وقصة الفلسطينيين الذين ضاعت أرضهم وفلتت من بين أيديهم احتمالات استعادتها.
على الرغم من جمال الرمزية في هذا الفيلم إلا أن الخلط بين قرار الضم وأزمة كورونا وغرق صفية لم تكن لتشكل صورة كاملة متراصّة المعنى، كم كان هذا الفيلم ليكون أكثر عمقًا لو اختار حادثة الغرق محورًا لأحداثه ولم يشتت انتباهنا بالخطابات الكثيفة في الخلفية.
انسحاب التفاصيل الكبيرة
في فيلم بلال الخطيب، بيت في لا مكان تحط العصافير على أطرافه، العصافير وحدها بقيت حرّة طليقة فيما كنا جميعًا حبيسي المنازل. ابقوا في منازلكم، يقول الصوت المنبعث من الراديو أو التلفزيون أو ربما من المسجد القريب. في الحيز الذي تعرفنا عليه من خلال فيلم "ضبابي" لا نسمع هنا أيضًا إلا صوت العصافير.
تتسلل إلى مسامعنا من بين اللامشاهد خطبة دينية ترتبط بالكورونا، ولم أكن لأحب هذا الربط المباشر ما بين حيثيات إنتاج هذا الفيلم والفترة التاريخية.
هذا الفيلم المصنوع في غرفة المونتاج يتسم بالكثير من الرمزية، وحبذا لم تمت الإشارة للكورونا بطريقة أكثر دهاءً وحنكة.
تستفيق عين بشرية على واقع جديد محدود، هذه الاستفاقة هي الشخصية التي تبحث ونبحث معها عن شيء ما، ترى في الأفق أضواء وخط حدود المدينة السمائيّ، ألوان متنوعة ما بين شروق وغروب وانعكاسات الضوء في زوايا البيت. تبدو هذه وكأنها شخص يسترق النظر إلى مكان محرّم، أو حالة من التذكار لشيء غاب.
من يستطيع مشاهدة هذا الفيلم القصير أكثر من مرة سيرى تفاصيل يومية في حالة zoom in، تبدو لنا الكثير مغامرة هذه العين كمن تدقق في تركيبة التفاصيل الصغيرة، كمن يختبر نفسه وهو يعبث بفتحه جفونه ليرى تفاصيل جديدة في الأشياء الاعتيادية.
أشعرني هذا النص البصري فما فرضه علينا الحبس القسري من فرصة لاكتشاف المركبات الدقيقة في كل ما يحيط بنا، الضوء المتأرجح والألوان المتغيرة والألعاب البصرية، ترافقها أصوات ما بين الواقعية والخيال وإعادة اختبار للمساحات المتاحة لنا، وعلى وجه الخصوص ذلك الضوء المتوفر بكثرة. يضعنا هذا الفيلم رهينة للعبة من يشعر بالملل ولا يمتلك الكثير من المُلهيات التكنولوجية!
كلنا رهن الحجر المنزلي والعزل والتباعد، إلا طيارة ورقية تبدو حرّة طليقة لكنها في حقيقة الأمر لا تزال رهينة من يمسك بخيطها الرفيع ويقيّد حركتها من بعيد!
النهاية هنا... والبداية
في فيلم إيهاب جاد الله، عودة للأصل، للبداية، توثيق للعمل الذي نجهل معظمه والذي يتم في غرفة مغلقة حيث المونتاج، حيث تولد الأفلام والتقارير والصور، حيث تصاغ أشكال الحقائق. في حديث بين مخرج ومونتير نكون شهداء على عمل مخبري تتم فيه الاختيارات وتركيب العناصر، كوارث متلاحقة يتم عرضها سريعًا لتختزل حقبًا زمنية وحالات إنسانية، لنكتشف فجأة أننا على مرمى حجر مما يسمى "نهاية العالم"، نهاية نصنعها بأيدينا! هو "footage" إخباري لكننا نعيش فيه ويعيش في يومنا ساعة بساعة.
من الغرفة تأخذنا الممرات الطويلة المعتمة إلى فراغ ينذر بغياب البشر عن المشهد، نشعر فجأة أننا فعلا في قلب كارثة!
في نقلة نوعية يأخذنا المخرج إلى الخارج حيث ضوء الشمس وواقع آخر، نتابع معه لحظات الاستعداد لبدء التصوير الجوي، تحلق الكاميرا فوق أرض تتجسّد عليها كارثتنا الخاصة: الاحتلال والاستيطان.
هنا حيث لا تغيّر أزمة الكورونا الواقع، نحن وهم أمام فيروس لم يوقف التمدد الاستيطاني، تنقسم الارض وتختلف معالمها، هنا لا ترى عين الكاميرا التفاصيل الدقيقة للواقع لكنها كفيلة أن ترى وترينا من مكانها الصورة الكاملة التي تحتوي المركبات الصغيرة.
يعود بنا المخرج بعد ذلك إلى المختبر من جديد، حيث تتم العمليات الأكثر جدية، حيث يتم تقسيم القدس إلى أحياء للحد من انتشار كورونا، لكن في هذا رمزية عالية وتذكير بالتاريخ وحال القدس وتقسيمها وشرذمة وحدتها، هنا حيث لا يزال الحكم العسكري قائمًا، هنا الاحتلال!
لم يجسّد لنا ايهاب جاد الله الحجر الصحي والحبس المنزلي القسري، بل أعاد إلى أذهاننا حبسًا قسريًا لمساحة أكثر اتساعًا من أمتار بيوتنا، وخطر يهددنا أكثر من الفيروس، وواقع سياسي لا يتأثر بكارثة طبية بل يستغلها ليمارس سلطته وسطوته، والنهاية هنا، تقترب، لكن لأي نهاية يشير جاد الله؟