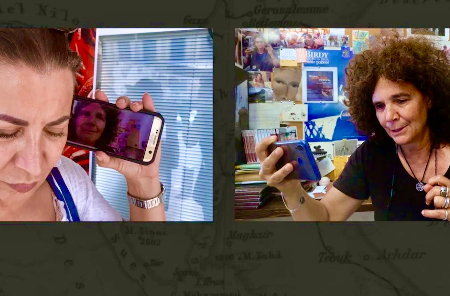يبدأ الفيلم بقصة تيدي كاتس على لسانه، مسلحًا بزوجة قوية وداعمة، فتكون الانطلاقة لمحاولات معرفة الحقيقة حول مجزرة الطنطورة، ما تصرح به وما تخفيه شهادات الجنود، ومنذ الدقائق الأولى للفيلم يحذر كاتس المخرج قائلًا "سيلاحقونك كما لاحقوني".
سبح الإسرائيلي تيدي كاتس ضد التيار في العام 1998 عندما قرر كتابة رسالة الماجستير ضمن دراسته لموضوع تاريخ الشرق الأوسط في جامعة حيفا الإسرائيلية تحت عنوان "خروج العرب من قراهم على سفوح الكرمل الجنوبي في 1948" بإشراف كل من البروفيسور الفلسطيني قيس فرّو وإيلان بابيه المناهض للصهيونية والمعروف بأبحاثه ومواقفه الداعمة للرواية الفلسطينية؛ وتضمن أحد أبواب البحث المركزية ما حصل على أرض قرية الطنطورة في الليلة ما بين 22 و 23 أيار 1948، وذكر كاتس في معرض بحثه أن ضحايا القتال من الفلسطينيين كانوا بين 10 إلى 20 فقط، لكن في نهاية يوم 23 أيار كان عدد الضحايا يتراوح ما بين 200-250 رجلًا أعزل، أي أن مجزرة ارتكبت هناك على يد الوحدة 33 من لواء الكسندروني؛ وفق الشهادات.
لم يتمكن كاتس من السباحة طويلًا، وما لبث أن غرق في بحر العداء الصهيوني الممنهج لكل ما يطالب بالاعتراف بالمجازر والعمليات العسكرية المصحوبة بالترهيب والترويع والتي أدت إلى نزوح الفلسطينيين قسرًا عن قراهم في العام 48. ففي شهر كانون ثانٍ من العام 2000 نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية مقالًا حول المجزرة بالاعتماد على بحث كاتس، فقام جنود الوحدة 33 المذكورة بتقديم دعوى قضائية ضده متهمين إياه بالقذف والتشهير والإساءة للسمعة. على أثر الدعوى التي دعمتها أذرع مختلفة -قضائية وأكاديمية وجماهيرية- تم سحب بحث كاتس رغم حصوله على علامة امتياز، بادعاء تزوير الحقائق واقتطاع جُمُل من مجمل ما أدلى به أصحاب الشهادات المسجلة لديه لتخدم مقولة البحث؛ وجُرّم بالإساءة إلى وحدة 33 من لواء الكسندروني، واضطر مرغمًا لكتابة اعتذار عما جاء في رسالة الماجستير يتضمن تكذيبًا للوارد فيها ونشر الاعتذار في صحيفتين.
أصيب كاتس بجلطة دماغية لأنه لم يحتمل الظلم الواقع عليه، بعد أن حاول التراجع عن الاعتذار بعد يوم من نشره، وتقديم استئناف للمحكمة العليا الإسرائيلية بواسطة المحامي أفيجدور فيلدمان، إلا أن المحكمة رفضت الاستئناف وغرّمت كاتس بتكاليف المحكمة، فعاش حياته إلى يومنا هذا نادمًا على اعتذار عن خطأ لم يرتكبه.
كان تيدي كاتس ولا يزال ناشطًا يساريًا مناهضًا للاحتلال والصهيونية، التقى كاتس بالمخرج ألون شفارتس الذي بدأ بتصوير قصة تيدي كاتس وبحثه، ثم -بعد حصوله على تسجيلات البحث- قرر الانطلاق في مسار شاق لنبش قضية تيدي كاتس ورسالة الماجستير، وقد اعتمد المخرج على الشهادات التي جمعها كاتس في بحثه ويبلغ عددها 135 نصفها شهادات جنود الكسندروني وآخرون ونصفها شهادات فلسطينية من مهجري الطنطورة وجيرانهم في الفريديس، بالإضافة إلى شهادات أخرى ومواد أرشيفية عسكرية، أي أن المخرج أعاد كتابة بحث كاتس بعدسة الكاميرا.
خلال الفيلم نستمع مع شفارتس لبعض التسجيلات، يبحث المخرج ويقارن بين مضمون بحث تيدي كاتس ومحتوى التسجيلات، وخلال تقصي الحقيقة تكشفت المعلومات حول مجزرة الطنطورة، لكن شفارتس، والمؤرخ آدم راز الذي دعم بحث كاتس لم ينجوا أيضًا من ملاحقة بعض جنود الوحدة 33 الذين ادّعوا بأن الفيلم يحاول إظهار تيدي كاتس كضحية وأن الفيلم عبارة عن معالجة سينمائية وتلاعب بالوقائع.
قبر جماعي قرب الشاطئ
في 24.5.1948 كان جنود وحدة 33 من لواء الكسندروني قد احتلوا قرية الطنطورة الواقعة على شاطئ البحر المتوسط جنوب حيفا، ووفق شهادات أهالي الطنطورة النازحين عنها فقد تم قتل مئات الرجال العُزّل ودفنهم في قبر جماعي بمحاذاة الشاطئ، وقد تمت الاستعانة بفلسطينيين من قرية الفريديس المجاورة لحفر القبر ودفن الجثث.
بعنجهية إسرائيلية، كتب الكثيرون مقالات وردود فعل مناهضة ومعارضة لفيلم "طنطورة"، تمسّك معظمهم بالعدد 20 كحصيلة لضحايا المجزرة، منكرين كليًا أن يكون العدد قد وصل إلى 200 لأن اعتباراتهم وتسمياتهم تتعلق بالحصيلة والأعداد، وأن قتل 20 قد يعتبر مجزرة لكن قتل 200 يعتبر إبادة جماعية وبالتالي هو جريمة حرب، وكأن احتلال فلسطين ومحاولات تفريغها من سكانها الأصليين ليس بجريمة حرب!
في فيلم متماسك يسير بخط مثير للاهتمام، ويكشف مخزون معلوماته بتروٍ وتناسق، ويخلق حالة تراكمية وسردية للأحداث بحيث لا يترك مجالًا للسهو أو الملل، ويقدم معلومات تشحن كل إنسان مكترث بالكثير من الغضب، يستضيف شخصيات تخلق حالة من الشعور بالعدائية نحوها، وطريقة عرض شهاداتها في الفيلم تبدو وكأنها نفّذت ما نفّذته من فظائع وشهدت على جريمة وهي تحت تأثير غسيل دماغ عنوانه "بناء الدولة"، وهذا نهج معتمد لدى جنود الوحدات الصهيونية عند ظهرورهم في أفلام سينمائية، فيدّعون أنهم كانوا صغار السن، أو متحمسين للقتال كفورة شباب، أو أنه لم يكن لديهم أي وسيلة أخرى فأرغموا على القتل.
هذا الفيلم في أصله هو عن قضية تيدي كاتس لا عن مجزرة الطنطورة، وهي قصة مكررة في أفلام وثائقية إسرائيلية أخرى يظهر فيها الإسرائيلي المختلف وهو يحارب منظومة متماسكة ترفع شعار "لو لم نقتلهم لقتلونا" و"هكذا هي الحرب" أو "كنا نتلقى الأوامر وننفذها فقط".
يبدأ الفيلم بقصة تيدي كاتس على لسانه، مسلحًا بزوجة قوية وداعمة، فتكون الانطلاقة لمحاولات معرفة الحقيقة حول مجزرة الطنطورة، ما تصرح به وما تخفيه شهادات الجنود، ومنذ الدقائق الأولى للفيلم يحذر كاتس المخرج قائلًا "سيلاحقونك كما لاحقوني".
يلتقي المخرج بمن بقوا على قيد الحياة من الوحدة 33 في الكسندروني معتمدًا بصورة كبيرة على شهاداتهم، من شاركوا في القتل ومن كانوا شاهدين وسائقي شاحنات نقل الجنود، لكنه لا يتوانى عن الزجّ ببعض الجمل والمشاهد التي تقف على خط تماس ما بين الحقيقة والموقف، فيختار من اعترافات الجندي شمعون كوتنر قوله "كنا صغارًا جدًا بعمر الـ 18، وكان هناك أولاد بجيل الـ 17" ويقصد بالأولاد جنودًا حملوا السلاح واقتادوا عائلات خارج بيوتها نحو الشاطئ، عاثوا فسادًا في القرية، وقتلوا الرجال وشهدوا حادثة اغتصاب لطفلة على يد أحدهم، وصفوه فيما بعد بالمجنون الهائج.
الدولة تؤخذ بالسيف
ثم على النقيض من هذه المعلومة حول جيل الجنود اليافع الذي ينفذ أوامر قادته على أرض المعركة، نسمع ضمن شهادة الجندي حاييم لفين قوله "الدولة تؤخذ بالسيف، هكذا قال لي أبي" وتدعمها شهادة الجندي حانوخ عميت "بحرية تامة، قتلت معناه أسديت معروفًا"، ثم يليه آخر قائلًا "قتلناهم بلا ذرة ضمير"، ومن شهادة رابع نسمع قوله "لم أتحدث مع أحد حول هذا الموضوع، حتى زوجتي التي عاشت معي عشرات السنوات لم أخبرها. ماذا أقول لها؟ أنني قاتل!"
ما من شك أن فيلم "طنطورة" المصنوع بحرفية سينمائية توثيقية عالية؛ يحمل من المعلومات المهمة الكثير حول مجزرة غابت طويلًا عن الوعي الفلسطيني، ويعزز هذه المعلومات بآراء مختصين سواء في البحث الأكاديمي أو القانون أو التأريخ أو الجيولوجيا، ويأتي بمن يخلص إلى أن المعلومات الواردة من جهات عدّة تتسّق معًا وتؤكد حقيقة ارتكاب مجزرة على أرض الطنطورة ودفن ضحاياها. لكنه يحاول السير وفق خطوات بحث كاتس، ويسعى لإنصافه من خلال تحويل بحثه إلى مادة فيلمية عن قضية باحث تم اسكاته، وهنا تكمن قوة الفيلم وتفرده. سبق وقرأنا في الإعلام الإسرائيلي اعترافات جنود بفظائع ارتكبوها خلال العام 1948 منهم شهادة ييراح كهانوفيتش الذي شارك في ارتكاب مجزرة دهمش وخلص بالقول "لم يكن بد من ذلك"، ومثله أبطال فيلم "ولد في دير ياسين" للمخرجة نيطاع شوشاني، فنسمع منهم قصة الولد الذي تم تقييده إلى شجرة ثم حرقه، والبنات اللواتي أعدمن بسلاح رشاش وهن يقفن بمحاذاة سور، ومن ثم نسمع شهادة عن أن هناك صور من مجزرة دير ياسين لا تزال إسرائيل تحظر الاطلاع عليها كليًا، الأمر الذي يزيدنا تأكيدًا حول هول ما فيها.
بين معلومة صادمة وأخرى تطل علينا مشاهد أرشيفية لمجندين ومجندات يافعين يحملون سلاحًا ويشهرون في وجه الكاميرا ابتسامات فخر ونصر، وفي الخلفية أصوات اغانٍ قومية للفرقة العسكرية تغذي مشاعر احتفالية، ثم تظهر في مواقع أخرى مسيرة أطفال يحملون أعلام دولة اليهود ملوحين بها، فنفهم ضمنًا أن الأجيال تتعاقب في هذا المكان ويصبح كل ما كان قبل العام 1948 وليمة لأرشيف تتغنى إسرائيل به وتستثمره في أفلام وثائقية تظهرها بمظهر الانفتاح وتقبل النقد والتعددية الايديولوجية.
بين أصوات الجنود هنا وهناك يعود إلينا صوت كاتس وهو الصوت المجازي للمجزرة وبطل الحكاية، الأول الذي كشف المعلومات وقدمها لنا أولًا كفلسطينيين، ومن ثم للتاريخ. نرى من خلال الفيلم كيف تتحد منظومات إسرائيلية متعددة لتدحض محتوى بحثه، فيسأله مقدم الأخبار في إحدى المقابلات كيف توصل إلى نتائج بحثه وكأنه في تحقيق، ويكذبه مذيع تلفزيوني آخر متذرعًا بفحص البحث مقابل باحثين أكاديميين معتمدين، ومن بينهم آسا كاشير كاتب "الكود الأخلاقي للجيش"، ومثل مواقف عديدة نرى تجنّد وحشد الإعلاميين والسياسيين والعسكريين والأكاديميين ضد كل ما لا يخدم روايتهم وأكذوبة الجيش الأكثر أخلاقية.
نهب الأرشيف خسارتنا الفادحة
يظهر لنا من خلال هذا الفيلم مرة أخرى سبقتها عشرات المرات، كم كانت خسارتنا كبيرة حين فقدنا الأرشيف، فالتسجيلات التي جمعها تيدي كاتس وتبلغ من العمر اليوم 24 عامًا تبلغ من الأهمية الكثير لنضال الفلسطينيين من أجل العدالة والاعتراف بحدوث النكبة وارتكاب مجازر التطهير العرقي. فالشهادة حول ذبح عدد من أهالي الطنطورة من جهة، والاعتراف بقتل العشرات بدلًا من أسرهم يأتي ليؤكد أن عمليات ممنهجة تمت في هذا المكان، رغم محاولات عدد من الجنود كتم أصواتهم والتوقف عن الإدلاء بشهادتهم كاملة لقسوة ما أتى فيها.
كانت الطنطورة وفق شهادات الجنود قرية غنية ذات بيوت جميلة مطلة على البحر، وتقول إحدى الشخصيات إنها عاشت جنبًا إلى جنب مع العرب في طنطورة قبل 1948 وإنها لا تعارض وجود نصب تذكاري لضحايا المجزرة، فيما ترفض زميلتها ذلك كليًا وتقول "إذا وضعوا نصبًا تذكاريًا هنا سيكون الأمر مهمًا لهم ومضرًا لي"، فإن وجود اللافتة بصرّح بحدث تاريخيّ يعني اعتراف بملكية الفلسطينيين على الأرض.
تزامن بدء عرض الفيلم مع عودة قضية مجزرة الطنطورة إلى العناوين هذا العام بعد أن تم حفر منطقة قرب البحر لإنشاء موقف للسيارات، ظهرت العظام من تحت الرمال خلال الحفر وأضاءت ضوءًا أحمر، فما عسى هذه العظام تكون سوى قبر جماعي، ذات القبر الذي احتوى أكثر من 200 جثة، هنا أصبحت الفرصة متاحة لانتشار الفيلم، وربما عودة بحث كاتس لشق طريق جديدة نحو إثبات صدقيته. أما الاعتراف بمجزرة الطنطورة وإنصاف من بقي على قيد الحياة من أهل القرية الشاهدين عليها فهو مسار آخر مختلف ليس بوسع فيلم سينمائي، مهما كان مهنيًا ومعززًا بالوثائق والشهادات، انتزاعه.