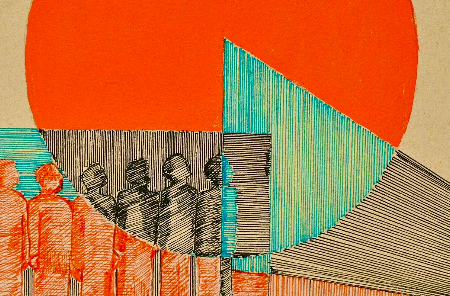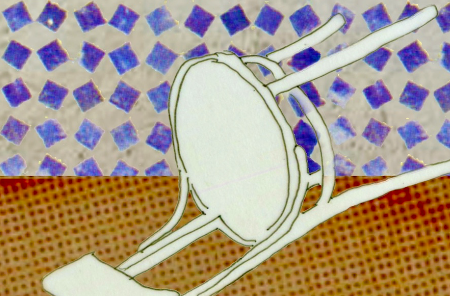كاد فرح أنطون أن يموت جوعًا وتعبًا لكثرة ما أسرف جهده في جلسته تلك على طاولته تيك وكرسيه ذاك مقابل ذلك الحائط الذي عليه تلك المرآة. وهكذا باختصار انتهت قصة كتابٍ كُتِب، أَجْهَدَ كاتِبُهُ نفسه إلى حدّ الإعياء لولا تدخّل أخته المستمر.
الفصل الأول، ربما
كَتَبَ الرّاوي على لسان القصّاص أنّه في إحدى نواحي الاسكندرية، التي لا يرغب استذكار اسمها، كان يقع عنوان مجلّةٍ يقف منشؤها الشاب في مكتبه في نهاية العام متأمّلًا نفسه في مرآة دائرية صغيرة معلّقة على الحائط المقابل لطاولة مكتبه ومتناسيًا شواغله ومصاريف السّنة القادمة ويداعب شاربيه فخـرًا.
وباتجاه تلك الناحية وفي اللّحظة عينها كان يركض فتًى متوسّط الطول أسود الشعر والعينين وأطراف الأصابع. سواد الشعر والعينين يعودان لطبيعته الجسدية أمّا الحبر على أطراف الأصابع فذلك لطبيعة عمله، والركض لطبيعةٍ ثالثةٍ طارئةٍ كان مدفوعًا بها لإيصال دستة ورقٍ مغلفةٍ بغلافٍ ورقيّ بنّي اللّون ومربوطٍ بخيطٍ من القماش. ووجهة الركض كانت إلى المكتب ذاته ليوصل الدستة نفسها إلى الرجل ذاته الواقف أمام الحائط المذكور الحامل للمرآة الدائرية لا غيرها.
صعد أبو وليد، الفتى الراكض، الدرج ولهاثه يكاد ينفث نارًا. كلّ خطوة على الدرج لثقلها كادت تحطّم الخشب الرخيص المصنوع منه، الدرج أفلت من المصير المشؤوم، أمّا الشاب المُكنّى بأبي وليد الذي لم يعهد نفسه ثقيلًا من قبل وَجَدَ روز على باب غرفة المكتب تَهُمّ بالدخول فبادرها سائلًا:
دخلا ووجدا فرح لا يزال على وقفةٍ كانت مستمرةً منذ أن رأته أخته عليها قبل ما يقارب النصف ساعة. ذُهِل أبو وليد لما رآه من أناقة الرّجل الواقف أمامه. لفت نظره ذاك الشارب الممشوقان طرفاه. لم يره ممسّدًا وممشّطـًا ومرفوعـًا بهذا الشكل منذ أن دخل مبنى المجلّة للمرّة الأولى. وفَرَح نَفْسه، الذي كان يتضاءل في الأشهر الثلاثة الأخيرة ولا يبدو عليه إلا الضّمور المتزايد الذي لَحِظَهُ أبو وليد من صباح إلى صباح، بدا قويَّ البنية وممشوقًا مع أطراف شاربيه بكامل صحته.

التفتت روز مبتسمةً لحال أخيها ولحظت ذهول الفتى المتعرّق وقالت له ضاحكةً:
ضحك فرح على تعليق أخته وضحكت أخته على ضحكته في حين التفت أبو وليد إلى المقص أولًا، لم يكن يفهم، حاول استثارة ضحكةٍ يشاطرهما بها ولم يفلح، عاد فنظر إلى شارب فرح وأمعن به ورجع يمعن بالمقص ثانيةً، أمضى نصف النّهار أمام المرآة؟ لقد دفعه المعلم يوسف دفعًا خارج الباب وهو يصيح له أن يسرع ليجد أنّ القيامة لم تقم بعد؟ لا بل مازحه فرح:
توجّه فرح نحوه وأخذ الرزمة من يده وسار بها إلى مكتبه. فتح عقدة الخيط ببطء شديد كما لو أنّ فيها زجاجًا. وضع الخيط برفقٍ على الطاولة إلى جانبيّ هذا الطرد الملفوف به. بدأ يُبعد أوراق الغلاف عن بعضها ببطء. لعق أبو وليد شفتيه. وترك فرح أطراف الغلاف الورقية، فهبطت برفقٍ على الطاولة فوق الخيط.
إنّها مجموعة ورق سميكة وحسب، فكّر أبو وليد، لكنّه كان يعلم ذلك فقد أخبره المعلم يوسف بشأنها مباشرة قبل دفعه خارج الباب. رفع فرح مجموعة الأوراق السّميكة عن مكتبه بكلتا يديه ونظر إلى محدّثه مبتسمًا وقال:
وضع فرح الرزمة التي بيده على الطاولة وتناول الصفحة الأولى التي هي صفحة الغلاف. مدّ يده باتجاه الفتى المتلهّف فاقترب الأخير وتناول الورقة من يد فرح بحذر، أدارها باتجاهه وأخذ يقرأ ما عليها متمتمًا بصوت شبه مسموع...
***
هذه هي إذن نهاية قصة مقالٍ كان هدفه المبدأيّ أن يملأ بابًا في مجلّةٍ في منتصف عام ألفٍ وتسعمئة واثنان. لكنّ المقال مرّ بما لا يمر به أشباهه فكَبُر وأصبح كتابًا في نهاية العام. تداول رجالٌ هذا المقال وتناولوه لكنّهم كلّهم كانوا جزءًا من قصته وهو ينمو وليس هو جزءًا من قصتهم. كاتبه لم يكن فارسًا متوشحًا سيفه ولا زعيمًا سياسيًّا أو عسكريًّا مؤثرًا في المصائر، ولم يعش أيَّ مغامراتٍ أثناء تأليفه، بل على العكس كان رجلًا شابًّا، في الثامنة والعشرين من العمر، ضعيف البنية يجلس خلف طاولته فقط، ولأَشْهرٍ مارس فِعلين بالكاد أضاف فعلًا ثالثًا لهما؛ القراءة والكتابة.
كاد فرح أنطون أن يموت جوعًا وتعبًا لكثرة ما أسرف جهده في جلسته تلك على طاولته تيك وكرسيه ذاك مقابل ذلك الحائط الذي عليه تلك المرآة. وهكذا باختصار انتهت قصة كتابٍ كُتِب، أَجْهَدَ كاتِبُهُ نفسه إلى حدّ الإعياء لولا تدخّل أخته المستمر.