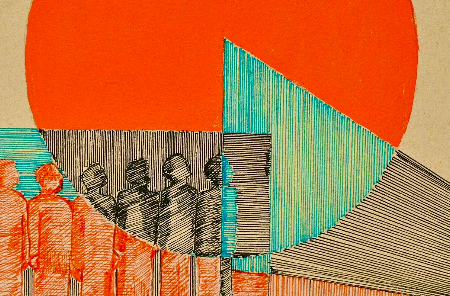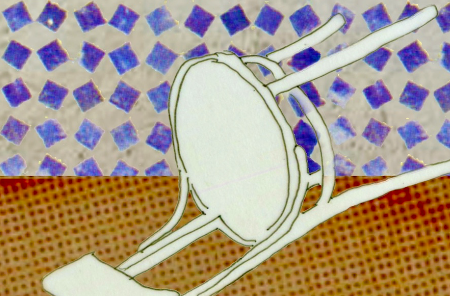تلك المدينة التي نبتت على تاريخ الحرب حتى أصبح جزءاً من مخيّلتها، وجزءاً من روحها، تُشعرك أنك في نزهة على الجبهة في لحظات هدنةٍ قد تنتهي بأي لحظة، تأتيها متحاملاً متثاقلاً كارهاً ومنزعجاً، لكنك تخرج منها ممتلئاً بالشوق لها قبل حتى أن تصعد درجات طائرة المغادرة.
ما تعوّدتُ عليه هو أن تُسَردَ أمامي حكايا المدن كقصصٍ متناثرة تجمعها الذاكرة الجمعية للمكان وسكّانه، قصص المطاعم والمقاهي التي خلقت للمدينة نكهة مختلفة، قصص المواصلات العامّة التي ربطت أعضاء جسد المدينة كشرايين الدم والأربطة، قصص المشاعر التي رافقت السكان من فرح وبهجة من جهة، بمواسم زراعية وافرة أحياناً، أو بإنجازٍ شخصي لأحد أفراد المدينة أحيان أخرى، أو مشاعر الحزن والأسى على أحداثٍ رقّقت مشاعر السكان وفرضت عليهم البكاء والحسرة معاً، لكن بيروت "غير".
أمضيت الكثير من السنين إستمع إلى قصص بيروت دون أن أزوها، وأقرأ الأشعار المنظومة عن بهاء المدينة، والأغنيات التي تصلح للصباح والمساء تباركاً في جمالها، حتى تضخمت في مخيلتي صورة المدينة وحالتها الرومانسية، وأصبحت أظن أن الأحداث المرويّة ربّما جرت في مساحاتٍ شاسعة تتسع لكل أساطير خطى الجنود المذكورين، وأن ذلك التنوّع الواسع في عقائد الميليشيات والفصائل لا بد وأنه انتشر في منطقة أوسع من جبال أفغانستان أو صحارى العراق، وأن جثث الضحايا الذين سقطوا لا بد وأنها تحتاج إلى مقابر تغطّي وجه مدنٍ أكبر، لكن زيارة المدينة خلقت مفاجأة بأن كل ذاك الذي حصل كان في مدينة بحجم قبضة اليد.
لا يمكن الحكم على بيروت عن بُعد حتى من داخل لبنان نفسه، ما إن صعدتُ إلى الجبال المحيطة بها، وهو مشوار لا يزيد عن عشرين دقيقة بالسيارة، حتى صار يصعب عليّ تحديد ملامح المدينة بالعين المجردة حين تنظر لها من أعلى بسبب الضباب الذي يبتلعها أغلب فصل الشتاء، "الجو غطيطة" يقولون باللبناني، في تلك اللحظات التي يمكن فيها ملاحظة المدينة قبل أن تختفي تحت ستار الضباب تبدو كحورية بحرٍ ناعسة ومسالمة، منزوعة السلاح والقسوة والألم، تخدع الناظر بهدوئها.
وعلى الرغم من صِغر حجم المدينة إلا أنها عوالم متعددة معزولة عن بعضها البعض، لكلٍّ منها هويته وثقافته وطبائعه، خطوة واحدة كانت تفصلني بين انتقالي من عالمِ إلى آخر، من رفاه الجناح إلى بؤس صبرا، ومن انفتاح الجعيتاوي إلى خشونة برج حمّود.
تلك العوالم لها أوجه متعددة أيضاً، متّسعة الاختلاف عن بعضها، بل متناقضة، كأنها مسرحياتٌ متنوعة لا تتقاطع بحبكتها وطاقمها إلا قليلاً، بينما تشترك جميعها في خشبة مسرحٍ واحدة، أوضح الاختلافات في تلك الوجوه هو الفارق بين حياة النهار وحياة الليل، ورغم صخب النهار في الأسواق وزحمة المواصلات، إلا أن صخب الليل له إيقاعُ آخر، يحوّل الذكريات المرويّة بالغمز والهمس عن ليالي السهر الصارخ وسط ظلمة الحروب في هذه المدينة إلى واقع، هذا الاختلاف الذي لا تفهمه صديقتي التي عاشت أغلب عمرها في المدينة ولا يمكنها التعبير عنه إلا بأن تضع بين الجملة والأخرى كلمة ambiguity.
بيروت مدينة مختلفة، لأن حكاياها مكتوبة إما بالدم أو عنه، حدودها مرسومة بخطوط التماس، وبدلاً من تجاعيد الزمن على المباني القديمة حفر التاريخ ثقوباً في واجهات البيوت، حتى باتت بقايا إطلاقُ الرصاصٍ أو القصف مدفعي على مبانِ كاملة شواهد على دموية هذا التاريخ.
جولة في السيارة مدّتها ربع ساعة كانت كافية لتعرّفني صديقتي على ملامح المدينة المدوّنة بالدم: "هنا أنهى خالد علوان حياة 4 ضبّاط إسرائيليين، يحتفل به القوميون كل عام"، ذلك الموقع في قلب الحمرا تحت جدارية الشحرورة صباح التي تغطي ابتسامتها 7 طوابق، "وهنا اغتيل رفيق الحريري"، ذلك أمام فندق سان جورج الذي أمضى رفيق سنواته العشرة الأخيرة بتطويقه في مشروع السوليدير، "هذه هي الروشة، يقابلها منطقة فردان التي اغتالت فيها إسرائيل ثلاثة من قيادات حركة فتح"، "وعلى هذا المفرق أنهى مجهولون حياة بيير الجميّل قبل أن يختفوا"، هكذا رسم القتل المنظّم محكم التخطيط والخالي من المساءلة والعدالة نقاط الاستدلال التي أحتاجها لتذكّر جغرافيا المدينة.
ومن نقطة اغتيال إلى أخرى قادتنا السيارة إلى ما هو أوسع، مقابر تلو الأخرى، بدأناها بالفرنسية التي تحتضن رفات قتلى الحرب العالمية الأولى، وأنهيناها أمام مقبرة الشهداء إلى جانب مخيم شاتيلا، حيثُ ترقد الثورة الفلسطينية في مثواها الأخير.
كيف يمكن أن يُحشر مارد في قمقم؟ أو في قبر؟ مواجهة حقيقة أن ما تبقّى من جسد غسّان كنفاني يوجد داخل حفرة صغيرة في مقبرة الشهداء قد تكون أصعب مواجهة قُمتُ بها في بيروت، أو ربّما في حياتي، فلا يمكن تخيّل أن تلك الفكرة الضخمة، القدرة الثورية الشعرية المتّقدة هي في داخل الحفرة التي أقف فوقها الآن! مستحيل!
في الليل، عندما يقدّر الجميع قيمة اختراع الكهرباء، ينسكب كل شخصٍ في موقعه متأهّباً، العسكر على الحواجز الأمنية قابضين على السلاح، جنود الفصائل الذين كانوا قابضين على مداخل المخيمات يلتفّون حول إبريق الشاي، سائقو سيارة الأجرة الذين تخلو لهم شوارع المدينة من الازدحام يتمترسون خلف عجلات القيادة، والكثير من الشباب في المطاعم والحانات التي تتحول فيها كل مساحة صغيرة بين طاولتين إلى ساحة رحبة للرقص والسهر، تنبسط قدر ما احتاجت السيدة الأنيقة من مساحة لتحرّك شعرها في الهواء على أنغام موسيقى اليسار، فتحرّك في المكان رائحة الكحول الممتزجة بدخان السجائر.
تلك المدينة التي نبتت على تاريخ الحرب حتى أصبح جزءاً من مخيّلتها، وجزءاً من روحها، تُشعرك أنك في نزهة على الجبهة في لحظات هدنةٍ قد تنتهي بأي لحظة، تأتيها متحاملاً متثاقلاً كارهاً ومنزعجاً، لكنك تخرج منها ممتلئاً بالشوق لها قبل حتى أن تصعد درجات طائرة المغادرة.