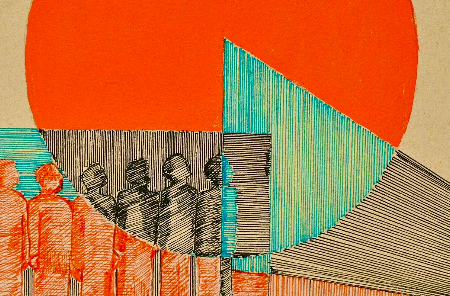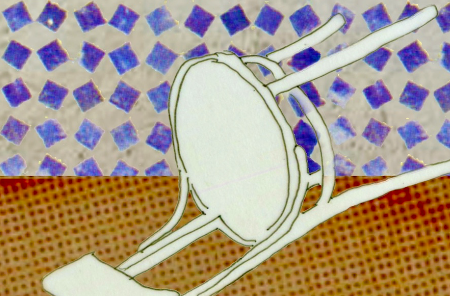ربما كان عليّ أن أجيبهم "بلى، مُسلم والحمد الله" بشكلٍ واثق أكثر، وبنظرة فيها عنفوان المؤمنين في فيلم "الرسالة"، أو ربما كان عليّ أصلاً أن أعود أدراجي راكضًا منذ سدّوا نهاية الطريق المظلّل بشجر الكينا بسبابة صوّبت نحوي: "هيّاته المسيحي!".
كنت ذاهبًا يومها، من بيتنا في حارة الصفافرة، إلى بيت جدتي في حارة الروم القريبة. الحيّان متلاصقان ومتوازيان، لكنهما يلتقيان أحيانًا، في دكانة "الحاج" أو في الخانوق. الأول حيّ لاجئين على طرف المدينة، لم يكن يسمّى مخيمًا، ليس فقط لأنّ أهله أقرب من اللازم إلى القرية التي هُجّروا منها، "فركة كعب" فعلاً، عشر دقائق مشي بطيء، بل لأسباب أخرى أيضًا. والثاني، حيّ أصليّ جبليّ ينبع من قلب المدينة، ويصرّ أهله، رغم كل احتفالات العالم ومفرقعاته النارية في الواحد والثلاثين من ديسمبر، على أنّ عيد الميلاد في السابع من يناير ورأس السنة في الرابع عشر منه، ويشوون من أجل ذلك اللحمة على السطوح الباردة والشرفات الضيقة فتغطي سحابة دخّان متخمة الحيّ في تلك الليالي، ويضطر بابا نويلات المدينة إلى العمل مرّة أخرى ليوزّعوا الهدايا على أطفالهم المعتزين بروميتهم، ويحتفلون بسنتهم الجديدة بثقة كاملة وقنينة عرق.
المهم أنني كنت ذاهبًا إلى بيت جدتي، ممشط الشعر نحو اليمين، ربما تكون أمي قد ألبستني يومها قميصًا أبيض، أو هكذا يتخيّل لي، لكني بالتأكيد كنت مرتب الهندام، لم أكن لأخرج من البيت أصلاً غير ذلك. خلف بيت عائلتنا الصغيرة، هناك طريق مختصرة، تمرّ بالقرب من حاكورة جارنا الواسعة، التي كانت يومًا ما أرضًا للبلدية، لكنه زرعها بخيرات الدنيا وأطلق فيها دجاجاته العزيزات كثيرات الحركة، وأحاط شرقها بأشجار كينا عملاقة، يبدو أنّه أحضرها معه من عمله في شركة "سولل بونيه" أول حياته أو أنّ هربرت صموئيل المندوب السامي أهداها لأبيه، لا أعلم بتاتًا كيف وصلت تلك الشجرات إلى حارتنا، لكنها صنعت طريقًا أنيقًا مرتبًا، مثل شعري، إلى الجهة الأخرى من الحي، لأصير، بعد اجتيازه أقرب إلى دكانة "الحاج"، وإلى جدتي التي لا بدّ تنتظرني قرب شباكها الصغير.
كعادتي، كنت أركل حجرًا أمامي يرافقني طيلة الطريق، وأتركه عندما أصل بيت جدتي أو المدرسة، ولم أكن أشعر بالذنب بتاتًا، لأن تلك الركلات قد أوصلت الحجر إلى مكان مختلف، مثلما أوصلتني، بل لأنّي كنت أخرّب الأحذية، ويتهمني أهلي بعدها بعدم المسؤولية. ركلت الحجر، وعندما رفعت رأسي رأيتهم، كانوا مجموعة من خمسة أو ستة فتيان، لست متأكدًا الآن من عددهم، أكبر مني بقليل، أحدهم أطول مني بكثير، التفتوا إليّ، أشّروا نحوي، وقفوا مكانهم سادّين مخرج الطريق المظلّل بالكينا وأنفاسي."هيّاته المسيحي!"، صرخ مرة أخرى. تسمّرت مكاني. وأتوا هم نحوي.
"هو هذا، هو هذا أكيد، المسيحي اللي فوّت علينا جول، وخسّرنا!" قال ذلك الولد للمرة الثالثة فرحًا باكتشافه العظيم، كأني المسيح الدجّال بحدّ ذاته، وكأنه سيحصل مقابل اصطيادي على خمسة آلاف حَسَنة. اقتربوا مني، ولم أنكر أنني أنّا الذي خسّرهم. ما كنت لأنكر أنني صاحب الهدف، حتى لو صلبوني يومها على شجرة الكينا، وعذّبوني كما عذّب أمية بن خلف الجمحي القرشي بلال بن رباح، في فيلم "الرسالة".
كان إعجابي بالكابتن ماجد وضرباته الملتّفة قد وصل إلى درجات من التماهي والإعجاب غير مسبوقة عندي، إذ كنت من المهووسين عمومًا بمسلسلات الكرتون، أو الميكي ماوس، كما كنا نسميها لسبب ما، انتظر الساعة الرابعة بفارغ الصبر، أتضرّع إلى الله أن ينهي فقرة القرآن بسرعة كي أعرف ماذا حدث مع سباستيان وعدنان وعبسي وتوم سوير ومع سالي وساندي بيل وسيدريك وساسوكي وباقي الأصدقاء، منذ الحلقة الماضية التي غالبًا ما كانت تنتهي في لحظة حاسمة شائقة.
أردت، يومها، أن أصير مثل الكابتن ماجد، ألححت على أبي أن يضمني لفريق، فأخذني أنا وأخي إلى ساحة ضخمة قرب بناية الفرير، المطلة على البلدة القديمة، وسلّمنا إلى "أبو بيلي"، مدرّب فريق "السوق"، الذي كان يربط شعره الطويل القليل الشيب، ويصفّر كثيرًا، ولم يحفظ إسمي من أول مرة، ولم يذهل بتاتًا من طريقة استلامي للكرة ولا من ضربتي الملتفة (على نفسها). تحسّنت مع التمارين القليلة، كنت جيدًا، لكن مارادونا لم أكن، أكيد.
دوري أندية الناصرة 1989. المباراة الأولى لنا كانت مع نادي "القلعة"، نادي حارة الصفافرة، كانت اللعبة في ملعب نادي الطلبة العرب، قرب المركز الثقافي البلدي، وكان الجمهور غفيرًا، وكنا، فريقنا، نصطف حول أبي بيلي، نلبس زيًا موحدًا بسيطًا في رواق الممر المدرسي. بين الجمهور، كان عمي المغترب في ألمانيا وكان ابنه، الذي يكبرني بسنة، يصوّر المباراة بكاميرا فيديو لم يكن لها مثيل في الناصرة، من الطرف الثاني للملعب، ويلوّح لي، بلغة الإشارات، التي كنا نتحدث بها عند جدتي، أن أدخل إلى الملعب، هيّا.
ألححت على أبي بيلي أن يدخلني إلى اللعبة، "أدخلني أيها المدرب! أدخلني أيها المدرب!"، فأدخلني، كانت النتيجة واحد-واحد، وكانت الدقائق الأخيرة للمباراة. ضربة حرة مباشرة، طلبت أن يعطوني فرصة تسديدها، أعطوني، سدّدتها، لم يكن هناك شباك لتهزّه، لكنها اخترقت الفراغ داخل الإطار الحديدي المطلي بمربعات بيضاء وسوداء، رغم قفزة حارس المرمى وقفّازاته الجديدة. رفعوني على الأكتاف، وابن عمي هرب من أبيه ودخل الملعب ليصوّرني، فرفع الكاميرا نحوي، ونظرت إلى عينها، من فوق، بفرحة أبطال الملاعب. يومها كنت أغني وأرقص في الحمّام الساخن بالبيت.
أحاطوني. وأنا لا علاقة لي بفنون القتال. لم أكن بحاجتها. في تلك اللحظة تمنيت لو أني أُجيد مثل ساسوكي فنّ الاختفاء أو اللكمات الشديدة مثل فارس الفتى الملاكم الشجاع، وليس مثل الكابتن ماجد. لم أنكر أنني صاحب الهدف، وكيف لي أن أنكر؟ لكني قلت إنني لست مسيحيًا، فلم يصدقوني. "يعني بدك تقولي إنك مسلم؟!" سألني غير مصدق، فأجبته "بلى، مسلم" لكن بتردّد ما، قد يكون مردّه الخوف الذي اعتراني، أو صِدقي الذي كان أصفى حينها، إذ أنّ جدتي، وهي شيعية الأصل من مواليد بنت جبيل بجنوب لبنان، قرّرت أن تعمّد أولادها الأربعة بكنيسة الروم الأرثوذكس لندرٍ أخذته على نفسها، عندما كانت تسكن في حيّ اللاتين بالسوق، بعدما كادت أن تفقد ابنها البكر فزارتها ستنا مريم ووعدتها بشفائه وبأولاد ثلاثة غيره إن عمّدتهم، فأصبح أبي مسلمًا ومسيحيًا في آن، ما مكّنني من المناورة الطائفية أحيانًا، كما أنّ أبي نفسه كان شيوعيًا وقوميًا، في الوقت نفسه، وكان يجيبني عن أسئلتي الكثيرة، حتى فقدت القدرة على الإجابة يومها عن هذا السؤال البسيط. وانشغلت طيلة حياتي بسؤال الهوية.
"إذا مسلم، إقرأ الفاتحة". عندما طلب مني أطْوُلهم أن أقرأ الفاتحة وقلت: فُرجت. فأنا أحفظها طبعًا، وأقرأها كلما مررت مع أبي أو جدتي قرب المقبرة حيث يُزهر النعناع فوق قبر جدي، في طريقنا إلى السوق المزدحم.
"بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين..." لم أكمل الآية الكريمة حتى جاءتني الصفعة اللئيمة على وجهي. لم أدر لهم الأيسر، بل رميتهم بحجر، لأنني، كنت فعلاً بلا خطيئة.
سمعت صراخ أبي، لست أذكر كيف علِم بالمحاصرة، ولا هو يذكر أصلاً أنّ هذه الحادثة قد حدثت فعلاً أصلاً، لكني أذكر أنّه مشى نحوهم بسرعة كما يليق بأبٍ غاضب، وأنهم هربوا، وأن طفولتي لا زالت عالقة حتى الآن في الطريق بين الحارتين.