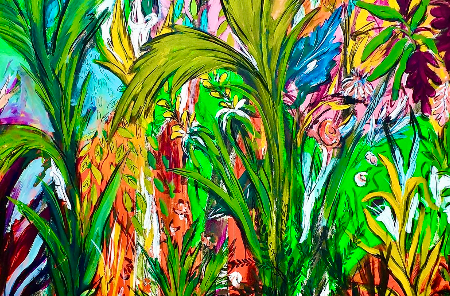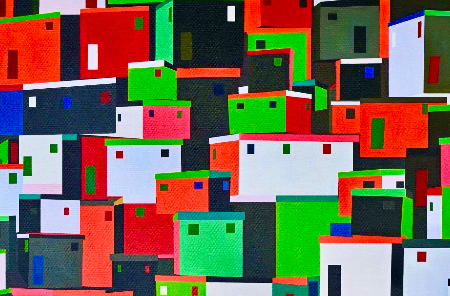تقول كتب الحيوان القروسطية إن محبّة البجعة الأمّ تجاه فراخها غامرةٌ تبلغ حدّ القتل، فيختنقون بينما الكيس المنتفخ أسفل منقارها عامرٌ بالسمك. حين يعود البجع الأب، بعد غياب ثلاثة أيام، يرى الفاجعة فيشقّ صدره بمنقاره، حزناً على أطفاله الموتى في العشّ المشؤوم. دمه المسفوك بمنقاره، دافقاً من جراحه، يفكُّ أسر الطير من قبضة الموت.
رحماك، أيّها المعنى
هل يعيدنا صفاءُ الضوء في لوحات فيرمير إلى رخاء هولندا، أم إلى تجارة العبيد التي أثرى من ورائها نخّاسون في أمستردام ولاهاي؟ هل سنرى في لوحات الانطباعيين أنوار البرجوازية الفرنسية وضباب صالوناتها؟
ماذا ستقول اللوحة عن بلاد رسّامها وعصره ونكباتهما؟ أسيسمّى الفنان خائناً إذا استهواه، في الفنّ تحديداً، الكَذَبةُ وشهودُ الزور، ومقتَ شهودَ الحقيقة؟
حالياً، لا مفرّ للفنان السوري من تعميمات المتفرّجين وتداعياتهم المسبقة عند تلقّيهم عمله، وقسم كبير منها مردّه الطغيان الإعلامي ولغته واستعاراته التي تُجهِز على أي عمل فني وتُودي به إلى مثواه، ليشيّع المتفرجون والنقاد اللوحةَ التي تشيّع بدورها بلدَها الذبيح. ربما يسعى عدد غير قليل من الفنانين السوريين إلى ابتكار سوريا عبر الفنّ من دون تسميتها بالاسم، اسمها الذي بات كناية عن غيتو العالم، غيتو الكوابيس-الاغتصابات-الآلام-الأنقاض-القيامة، وأبناؤها النازحون المُهانون رسل الهلاك والهاوية. ألا يقتضي الوقوف على اللوحة ابتعاداً عن هيمنة هذه البلاغة بكل آرائها القطعية وباستعجالها الفهمَ وربما افتقارها إلى التواضع؟ ألا تسدّ غزارة الصور الإعلامية المهيمنة منافذَ العقل لتحوّل الذاكرة إلى نوعٍ من الإعاقة الفنية لدى أي مبدع وتزرع فيه الخوف من الابتذال؟ ألا يستلزم الفهم رفضاً لسطوة مثل هذه التآويل المسمّاة "حقائق"، بل نسيانها جميعاً؟ هل مثل هذا الكلام المقحَم الذي يخلع على الفن عباءة القيم الإنسانية العظمى، يزيد حقاً من وضوح رؤيتنا ودقّتها؟ أليس ذلك حجاباً آخر يُعمي النظرة بغبار الألفاظ ويعطّل التفكير؟ أليس جلياً عنف "المعنى العميق" الذي تكرِهنا مثل تلك التوصيفات على قبوله وترديده؟ ماذا لو عمل الفنّانون على إخفاء المعنى وحجبه ورفضوا التصريح به، إذا كان فحوى التجربة الحية هو الفظاعات والإذلال منقطع النظير؟ وإن شئنا استخدام دارج الشعارات، أليس هذا الرفض صوناً للكرامة أيضاً ودفاعاً عنها، كسكوت الصامدين في جلسات التعذيب؟ أين سنذهب بما نعجز عن تسميته؟
"قد سمعتُ كثيراً مثل هذا. معزّون متعِبون كلّكم"، نقرأ في سِفر أيوب. سأستخدم تعبيراً لا ينقصه التهذيب، ليس متداولوه قلةً في بلبلة الأصداء التي تكتنف اسم سوريا: "متعِبٌ كلّ هذا ومضجر". قصدي الضجر من هذا الخطاب الفني الذي يكاد يقتصر، بفظاظة أطروحاته المباشرة وفجاجة "واقعيتها"، على بلاغة الموضوعات المراوحة بين الحرب واللجوء والمنفى في فنون المحنة وآدابها، ولا سيما في أوروبا التي تخصّ مبدعي الشرق الأوسط بمنصات وأبواب وأضواء معينة تراها الأنسب لهم، وكأن السلطات الثقافية لهذه القارة هي الأدرى بجديد الابتكارات، وهي الأقدر على تصدير المفاهيم وتحديد المراتب واختيار الصفات وتوزيع الألقاب. على المقلب المضادّ، ثمة ضجر من خطابٍ آخر لا يخلو اللوم فيه من الوضاعة، يحتجّ على زجّ السوريين أنفسهم بفنونهم وحكاياتهم في أقفاص الإعلام، ويحمّلهم وزر الانحطاط والابتذال وتدجين الجحيم، مدّعياً مناهضةَ التنميط وكسر القوالب ويكاد يضاهي نظيره الخطابَ الأول في الرواج والضحالة والتأفف من كل شيء. ليس الفنّ حكاية تُروى وحسب، وليس الألم وحده هويةَ السوريين الجامعة التي قد لا يختلفون حولها ولا يختصمون فيها. لا مناص من إساءة الفهم، ولا بد من طرق أخرى لا ننساق معها وراء التفاسير والتفاصيل والمعلومات التي يزوّد بها الفنانون جمهورهم. أحسب إن أعمال رسّام مثل علاء حمامة قد تقول أشياء أخرى وتثير تداعيات أخرى. أحسبه راغباً عن فنٍ موسوم بالواقعية جاهزةِ التفاسير، وإن بدا عنوان معرضه الأخير "ذاكرة حقيبة" في باريس استمراراً لبلاغة تجمع بين التجريد والتشخيص، بين الترميز والواقعية، ولا تزال مألوفة في الفن والكتابة السوريين، وقد تعيدنا إلى اشتقاقات وتنويعات دارجة على "ذاكرة للنسيان"، أو "وطني ليس حقيبة وأنا لستُ مسافرْ". لن أعود إلى "بقايا صور" حنا مينة أو أغنيات فيروز، بل إلى لسان العرب. للحقبة والحقيبة جذر واحد: الزمان كيسٌ مثقوب لا يدومُ ما فيه.
المفارقة ممضّة: مرور الزمن يغيّر الماضي أيضاً. ذاكرتنا تغيّرت بالقدر الذي اتّسعت فيه، طوال السنين السبع الخوالي الكافية لخلق صور نمطية في اللاوعي العام: السوري لاجئاً أو مجنوناً أو متسوّلاً… إلخ. كثيرون منا، نحن السوريين العاجزين عن الرجوع من أوروبا إلى سوريا، اختبرنا مُصاب بلادنا عن بُعد. ربما لم يطلنا أذى جسديّ ملموس ولكن، على الأرجح، لم تفارقنا الحاجة إلى التعبير عما لم نتعرّض له ولم نختبره بحواسنا كلها، مشاهدين ما سمّي أهوال سوريا، مثلنا مثل غيرنا من كارهينا والمتضامنين معنا، من دون أن تكون لنا على الأغلب أي سلطة فعلية لتغيير أي شيء، مسكونين بهواجس الشهادات أو مستنفَرين لتوثيقها، نسعى إليها ونصون ذاكرتها ونُعلي من شأنها، طابعين بصماتِنا على جدران كهف الإنسانية الكبير، حتى صرنا شهوداً على ما لم نشهده إلا كمتفرّجين ومستمعين أو كزوّار لإخوتنا المنكوبين في شتات المخيمات، غرباء عن بلادنا التي كانت، وقد لا نعرفها ولا تعرفنا إذا ما استطعنا الوصول إليها.

المسيح الصامت
سأناقض نفسي وأجازف بالحديث عن أمثولة. سآخذ استعارة "القيامة" السورية لأضعها ضمن إطار آخر، مسترجعاً، وإن موارَبةً، "صمت المسيح" أثناء محاكمته قبل الصّلب، واحتار في فهم هذا الصمت المفسّرون والشرّاح على مرّ القرون. إزاء سوريا الأسد أو سوريا الرسول (سواء أكان بولس الرسول أو النبي محمد)، أو سوريا الفينيق المنبعث من رماد الموت إلى القمم في أدبيات القوميين الاجتماعيين، أسترجع نقشاً لم يغب عن كؤوس القرابين في أرض الكنائس الأولى-سوريا التي غيّر جمال عبد الناصر اسم "وادي النصارى" فيها إلى "وادي النضارة" أيام الوحدة مع مصر. هذا النقش هو البجعة.
نعلم أعجوبة البجعة السوداء وتأويلات التمييز العنصري في الفنّ، ونعلم حكاية انزواء البجعة حين يدنو أجلها لتطلق تغريدتها الأخيرة قبل الموت. لقد غيّر المعرّبون اسم الطائر المقصود في هاتين الحالتين، على شاكلة "بحيرة البجع" لتشايكوفسكي، ربما لأنهم حسبوا التمّ أو الإوزّ العراقي أقلّ جمالاً أو أقلّ جلالاً.
دانتي غابرييل روسيتّي تخيّل بجعة مرسومة لا تظهر في اللوحة. دانتي الأكبر، في "الكوميديا الإلهية"، سمّى المسيح "بجع الإنسانية" الذي شقّ قلبه وافتدى العالم بدمه وقام من بين الأموات، مضيفاً هذا الطائر إلى رموز المسيح الأربعة المعروفة كنسياً، وهي الإنسان والنسر والأسد والعجل (أو الثور).
تقول كتب الحيوان القروسطية إن محبّة البجعة الأمّ تجاه فراخها غامرةٌ تبلغ حدّ القتل، فيختنقون بينما الكيس المنتفخ أسفل منقارها عامرٌ بالسمك. حين يعود البجع الأب، بعد غياب ثلاثة أيام، يرى الفاجعة فيشقّ صدره بمنقاره، حزناً على أطفاله الموتى في العشّ المشؤوم. دمه المسفوك بمنقاره، دافقاً من جراحه، يفكُّ أسر الطير من قبضة الموت.
فسّر القديس جيروم ما جاء في المزمور 102 "أنا بجعة البراري، أنا بومة الخراب" على نحوٍ آخر، فعزا موتَ الفراخ إلى الأفعى. تبنّى ليوناردو دافنشي تفسيرَ جيروم شفيع المترجمين، وكتب إن القتلة هم الأفاعي. تطعم البجعة صغارَها الذين ماتوا جوعى لحمَ صدرها وتسقيهم دمَها ليعيدهم موتها إلى الحياة. هنا، يسوع الفادي مؤنّثٌ كسوريا بجعة الإنسانية.