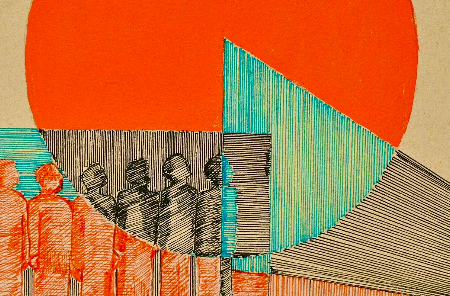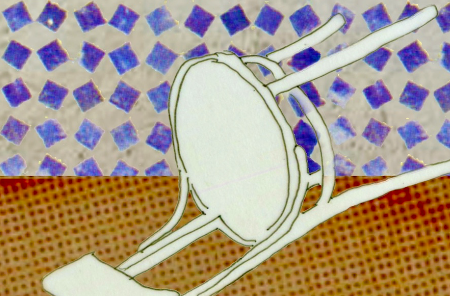كان أبي يدلّك كتفي أمي حين يتفاقم ألمها. ويسأل عنها اذا غابت قليلاً في الغرفة المجاورة. "وين امّك؟ شو بتعمل؟ مطولة؟". كان يحبّها حبّاً صافياً سلساً خفيفاً.. وهي مكرّسةٌ نفسها لتصنع ما يحبّ. السعادة بالنسبة إليهما أن يجلسا معاً في غرفة الجلوس في مساءٍ عاديّ يشاهدان الأخبار ثم مسلسلاً ويعلّقان على أحداثه.
كان أبي يحبّ الكتب منذ صغره. في بيتنا، منذ ولدت، مكتبةٌ فيها موسوعة علمية وموسوعة قصصٍ عالمية وأخرى طبية وكتب أدبية كثيرة.
أثناء حديثنا عن الموسوعات في بداية تشرين الأول الفائت، قال لي: "جبت مجموعة جبران الكاملة قبل كم سنة.." وصمت قليلاً ثمّ قال: "بس الواحد ما عنده وقت للقراءة بين الشغل وهموم الحياة." فقلت له أنّه، بعد التقاعد، سيمتلك وقتاً كافياً لذلك. فأخذ نفساً عميقاً وقال: "شو بعرّفني.. انشالله الواحد يضلّ..".
بعد هذا الحديث بثلاثة أشهر وأربعة وعشرين يوماً، مات أبي بالسرطان. لم يتسنّ له الوقت ليتقاعد. ظلّ، حتى اليوم الأخير، يهتم بشؤون العمل عبر الهاتف وهو على سرير المستشفى. ولم يقرأ شيئاً من الكتب التي ما زالت في المكتبة تنتظر.
الصورة أعلاه أخذت له على بحر صور، حيث أمضى طفولته وشبابه قبل أن يسافر إلى الخليج ويستقر بعدها بسنوات في قرية في جبل لبنان.
كان، أيام المدرسة والجامعة، يأخذ كتبه وقت الفجر إلى البحر، ويدرس ذهاباً وإياباً حتى طلوع الصّباح. أتذكّر صوته وهو يخبرني ذلك كلّما مررنا إلى جانب البحر في صور، شارحاً كيف كان الشاطئ أوسع حينها، قبل أن يردموا بعضاً منه ليصنعوا طريقاً للسيارات.
في زيارتنا الأخيرة لصور قبل عام أو أكثر، أراني بيت العائلة القديم، والطريق المؤدي سيراً من هناك إلى البحر، وفي صوته نشوةٌ وحنينٌ يتكرّران كلّما تذكّر تلك الأيّام.
مات أبي في مثل هذا اليوم منذ ثلاثة أشهر، ولم يتسنّ له الوقت ليودّع بحر صور أو ليخبرني تلك القصة مرّةً أخيرة.
كان أبي محبّاً للحياة، قليل الكلام، خفيف الظلّ، سهل التعامل، مليئاً بالحبّ. كان يروي القصص والنكات والحزازير في الجلسات العائليّة، فيضحك ويضحكنا جميعاً.
كان يساعد في أعمال البيت. يحضّر الفطور أيام العطلة. يصنع السندويشات لنا جميعاً وقت العشاء. يقطع الفواكه لجميع الجالسين. يغلّف بحرصٍ طعاماً طبخته أمي لتضعه في حقيبتي قبل السفر.
في زياراتي إلى بيروت، كان يصرّ أن يأتي إلى المطار ليستقبلني بنفسه. ويتوقف على الطريق ليأتي لي بشيءٍ أشربه. ويحرص أن يظلّ في الثلاجة نوع البوظة التي أحبّها. ويذكّرني، حين أسافر، بمواعيد مباريات كرة القدم كي لا تفوتني.
كان أبي يدلّك كتفي أمي حين يتفاقم ألمها. ويسأل عنها اذا غابت قليلاً في الغرفة المجاورة. "وين امّك؟ شو بتعمل؟ مطولة؟". كان يحبّها حبّاً صافياً سلساً خفيفاً.. وهي مكرّسةٌ نفسها لتصنع ما يحبّ. السعادة بالنسبة إليهما أن يجلسا معاً في غرفة الجلوس في مساءٍ عاديّ يشاهدان الأخبار ثم مسلسلاً ويعلّقان على أحداثه.
لم يتشاجر أبي وأمي مطلقاً. ولو حدث وقال أحدهما ما يزعج الآخر، يتحدثان عن الأمر بهدوء، أو يعبّران عن غضبهما مباشرةً، لتعود الحياة الى طبيعتها بعد وقتٍ قصير.
حين مرض أبي، كانت أمي تلبسه وتطعمه وتهتم بكل تفاصيله في كلّ لحظةٍ من اليوم. وتنام على كرسيّ في المستشفى لكي لا تتركه لحظةً واحدة.
في اليوم الأخير قبل أن يفقد وعيه، ولم يكن قادراً على الكلام، قبّلها عشرات المرات وشدّ على يديها كأنّه يقول لها شكراً على كل شيء.
مات أبي وهو ما يزال راغباً في الحياة. لم يعطه الموت وقتاً ليرتاح من سنوات العمل المتواصلة. مات وفي عينيه أملٌ بأن يشفى بمعجزةٍ ما.
وها أنا الآن هنا، عاجزة عن السفر لأحضن أمّي، أحاول أن أجد ضوءاً أنهي فيه نصّي هذا، لكنّي حزينةٌ بحقّ، وليس عندي رغبةٌ في تجميل ذلك.
أثناء حديثنا عن الموسوعات في بداية تشرين الأول الفائت، قال لي: "جبت مجموعة جبران الكاملة قبل كم سنة.." وصمت قليلاً ثمّ قال: "بس الواحد ما عنده وقت للقراءة بين الشغل وهموم الحياة." فقلت له أنّه، بعد التقاعد، سيمتلك وقتاً كافياً لذلك. فأخذ نفساً عميقاً وقال: "شو بعرّفني.. انشالله الواحد يضلّ..".
بعد هذا الحديث بثلاثة أشهر وأربعة وعشرين يوماً، مات أبي بالسرطان. لم يتسنّ له الوقت ليتقاعد. ظلّ، حتى اليوم الأخير، يهتم بشؤون العمل عبر الهاتف وهو على سرير المستشفى. ولم يقرأ شيئاً من الكتب التي ما زالت في المكتبة تنتظر.
الصورة أعلاه أخذت له على بحر صور، حيث أمضى طفولته وشبابه قبل أن يسافر إلى الخليج ويستقر بعدها بسنوات في قرية في جبل لبنان.
كان، أيام المدرسة والجامعة، يأخذ كتبه وقت الفجر إلى البحر، ويدرس ذهاباً وإياباً حتى طلوع الصّباح. أتذكّر صوته وهو يخبرني ذلك كلّما مررنا إلى جانب البحر في صور، شارحاً كيف كان الشاطئ أوسع حينها، قبل أن يردموا بعضاً منه ليصنعوا طريقاً للسيارات.
في زيارتنا الأخيرة لصور قبل عام أو أكثر، أراني بيت العائلة القديم، والطريق المؤدي سيراً من هناك إلى البحر، وفي صوته نشوةٌ وحنينٌ يتكرّران كلّما تذكّر تلك الأيّام.
مات أبي في مثل هذا اليوم منذ ثلاثة أشهر، ولم يتسنّ له الوقت ليودّع بحر صور أو ليخبرني تلك القصة مرّةً أخيرة.
كان أبي محبّاً للحياة، قليل الكلام، خفيف الظلّ، سهل التعامل، مليئاً بالحبّ. كان يروي القصص والنكات والحزازير في الجلسات العائليّة، فيضحك ويضحكنا جميعاً.
كان يساعد في أعمال البيت. يحضّر الفطور أيام العطلة. يصنع السندويشات لنا جميعاً وقت العشاء. يقطع الفواكه لجميع الجالسين. يغلّف بحرصٍ طعاماً طبخته أمي لتضعه في حقيبتي قبل السفر.
في زياراتي إلى بيروت، كان يصرّ أن يأتي إلى المطار ليستقبلني بنفسه. ويتوقف على الطريق ليأتي لي بشيءٍ أشربه. ويحرص أن يظلّ في الثلاجة نوع البوظة التي أحبّها. ويذكّرني، حين أسافر، بمواعيد مباريات كرة القدم كي لا تفوتني.
كان أبي يدلّك كتفي أمي حين يتفاقم ألمها. ويسأل عنها اذا غابت قليلاً في الغرفة المجاورة. "وين امّك؟ شو بتعمل؟ مطولة؟". كان يحبّها حبّاً صافياً سلساً خفيفاً.. وهي مكرّسةٌ نفسها لتصنع ما يحبّ. السعادة بالنسبة إليهما أن يجلسا معاً في غرفة الجلوس في مساءٍ عاديّ يشاهدان الأخبار ثم مسلسلاً ويعلّقان على أحداثه.
لم يتشاجر أبي وأمي مطلقاً. ولو حدث وقال أحدهما ما يزعج الآخر، يتحدثان عن الأمر بهدوء، أو يعبّران عن غضبهما مباشرةً، لتعود الحياة الى طبيعتها بعد وقتٍ قصير.
حين مرض أبي، كانت أمي تلبسه وتطعمه وتهتم بكل تفاصيله في كلّ لحظةٍ من اليوم. وتنام على كرسيّ في المستشفى لكي لا تتركه لحظةً واحدة.
في اليوم الأخير قبل أن يفقد وعيه، ولم يكن قادراً على الكلام، قبّلها عشرات المرات وشدّ على يديها كأنّه يقول لها شكراً على كل شيء.
مات أبي وهو ما يزال راغباً في الحياة. لم يعطه الموت وقتاً ليرتاح من سنوات العمل المتواصلة. مات وفي عينيه أملٌ بأن يشفى بمعجزةٍ ما.
وها أنا الآن هنا، عاجزة عن السفر لأحضن أمّي، أحاول أن أجد ضوءاً أنهي فيه نصّي هذا، لكنّي حزينةٌ بحقّ، وليس عندي رغبةٌ في تجميل ذلك.