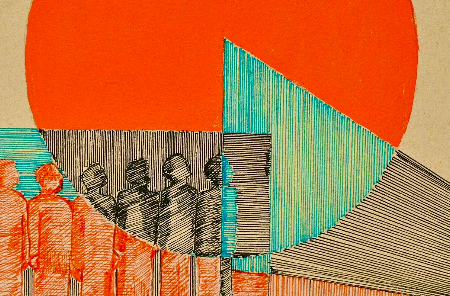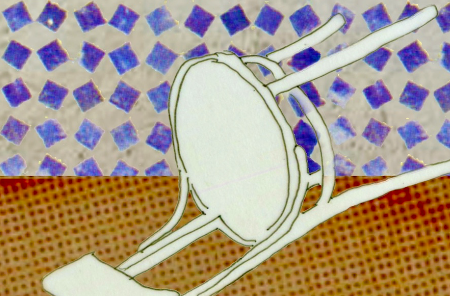على شاطئ المتوسط في مدينتي غزة، كنت أحلم ببيت جدي على بعد ساعتين أو ثلاثة ولكنها كانت مسافة أبدية لي، والآن بعد أن صرتُ بعيدة حتى عن بيت أمي وأبي وصرتُ بلا بيت أصبحت قادرة على فهم تماماً كيف قد تتجسد نفس الفكرة في نسخ مختلفة ولكن لها كلها نفس التوق الذي لا ينتهي، لأنها تسكن قلب الحالم نفسه.
على شاطئ المتوسط كنا ننثر الرمل في وجه الشمس ونضحك لموجة من الأمل امتدت على طول ساحل لا نعرف منه إلا بضعة كيلومترات، مع ذلك قد يحمل الماء هوية أقوى أحياناً من تراب الشاطئ، لأجل ذلك كنا نهمس لبعضنا بالأمل ونحن نتخيل أطفالاً آخرين على امتداد البحر يحلمون مثلنا بمركب يعبر بهم الأفق الشاسع حيث قد يلتقون في عرض البحر بنا. نرسم بخيالاتنا ذلك اللقاء وسط الماء حيث سنكون قادرين على التحديق في الآخر وتمييز ملامح الوجه ولون الذكريات، هوية الأحلام المتكسرة في الأعين المترقبة، حيث سيكون العناق المنتظر واليد المواسية التي يجري في عروقها نفس الدم ونفس التساؤلات.
من هذا المشهد تستيقظ أفكاري التي لا تنتهي أبداً إلا حينما أفتح نافذة الغرفة الصغيرة المتنقلة التي أعيش فيها حالياً، غرفة بحجم زنزانة ولكنها لي بيتٌ مؤقت، أما البيت الآخر الحقيقي، البيت الذي تصوره باشلار وهو يصير قصرًا نسند إليه أحلام اليقظة، هو بيت كنت أحلم به منذ طفولتي، بيت سكنه جدي وجدتي فوق أرضهم قبل أكثر من سبعين سنة، وهنا يأتي السؤال، هل يستطيع الإنسان أن يعيش في خياله داخل بيت لم يصنع فيه ذكريات، تماما كما يستطيع أن يعيش في وطن من خيالات، وطن لم تطأه قدماه إلا في أحلام بلا ضباط ولا جنود، ولا محطات تفتيش، ولا سطوة للمستحيل.
في رحلتي الأولى في حياتي إلى الولايات المتحدة، سألنا المدرس عن مكان نحلم بالذهاب إليه في العالم، كنت في السادسة عشر من عمري، وفي الحال لم أفكر سوى بفلسطين، قلت له حينها، أحلم بزيارة فلسطين، أحلم بلقاء فلسطينيين آخرين من فلسطينيي الداخل أو الضفة الغربية، أحلم بذلك الحلم الذي قد يجمعني بتلك الوجوه وإن كان في عرض بحرٍ منسي أوفى من التراب فـ "البحر صورتنا... فلا تذهب تمامًا". أحلم بذلك المركب الذي قد يجعلني أشعر أنني لست منسية ولست وحدي حتى في غربتي العبثية. عادت أمنيتي إلى السطح مجدداً ولم أكن واعية بعد عشر سنوات أنني أكرر ذات الجواب ولكن في عاصمة أوروبية الآن وفي درس تعلم لغة أخرى/لغة رابعة. قال مرة جيفارا أنه يشعر بالحنين لزمن لم يعشه، لكن الأمر يتجاوز الحنين، هناك شيء يتوارثه الحالمون ويبقى مثل هوية لهم حتى ولو لم تتحقق تلك الأحلام.
يخيّل إليّ وأنا أرى العديد من الأشخاص الذين لا يمتلكون بيوتاً هنا في عواصم أوروبا أن ما يجعلهم قادرين على مواصلة الحياة الهامشية التي يعيشونها هو صورة البيت المرتقب الذي كان يوما ما ملكا لهم أو ذلك الذي يحلمون به، وأتذكر مصطلح "العودة إلى المنزل"، كمصطلح يستخدم في وصف الموت المسالم بدون ألم أو لوصف مشاعر الناس الذين عاشوا تجربة الموت الوشيكة. صارت رؤية المشردين جزءا من يومي وصارت أحلامي عن البيت يومية الانبعاث أيضاً.
أشعر بالألم لجوعهم وبؤسهم ولكن أكثر ما يوجعني في تلك الأعين هو الحنين إلى البيت مهما كانت العودة صعبة أو مستحيلة في زمن حياتهم المؤقتة تلك، البيت كفكرة وليس كوجود مادي هو ما ينقذ الضائعين في الكون، وأحياناً يكون هناك بعض المحظوظين الذي يجدون وطنهم في أشخاص على حد تعبير روبين هوب.
كلما شعرتُ بخوف مفاجئ أو حزن، أردد دون وعي: أريد العودة إلى البيت، كما يحلم المساجين بسريرهم ونافذة غرفتهم وطبق حساء ساخن في المساء، أحلم بكتف بيتٍ أسند وجعي وغربتي عليه وأنام، تمر الليالي في البُعد وتكبرُ الفكرة ويتسعُ البيت في مخيلتي، على مر السنين وضعتُ له نوافذ أكبر وزرعت على شرفته الأوركيد والزعتر وفي الزاوية ثبتُ شجرة زيتون عنيدة ولم أنسَ أن أضع كرسياً هناك لأجلس عليه يوماً ما أتأمل وجع تأملاتي الآن على بعد آلاف الكيلومترات من ذلك الشاطئ الحنون كيد إله.
الحديث عن العودة هو جزء من رواية الحنين الأكبر التي توارثها أجيال من الحالمين الصابرين في بلدي وفي العديد من البلاد التي صارت تجمعها هوية الغربة والهجرة ووحشة الأبناء في بحثهم عن طريق البيت الحقيقيّ، حيث أضواء القناديل تنادي على من يطفئها فتستريح الشعلة ويهدأ الحنين.
على شاطئ المتوسط في مدينتي غزة، كنت أحلم ببيت جدي على بعد ساعتين أو ثلاثة ولكنها كانت مسافة أبدية لي، والآن بعد أن صرتُ بعيدة حتى عن بيت أمي وأبي وصرتُ بلا بيت أصبحت قادرة على فهم تماماً كيف قد تتجسد نفس الفكرة في نسخ مختلفة ولكن لها كلها نفس التوق الذي لا ينتهي، لأنها تسكن قلب الحالم نفسه.
أعود وأسير في الشوارع الباردة، أسمع عن بعض المشردين الذين يرفضون الاستقرار في منازل مدّعين أنهم يفضّلون حياة التشرد. لكني أفهم أيضاً أن ما يشعر به هؤلاء ليس الرفض للبيت وإنما الرفض للبيت المادي الذي لم يلبِ فكرتهم الضاربة في العلو والعمق عن الدفء والعائلة والوجوه التي نبتسم فور أن نراها وهي تنادينا من على عتبة المنازل.
كلما نظرت حولي وأنا الآن بلا بيت أشعر أنني لا أقف على شيء سوى حلمي مثل جدي، مثل أطفال اللجوء في كل بقاع الأرض الآن، أفكر بجدي وهو يحلم كل يوم ببيته هناك خارج حدود المخيم والأسلاك الشائكة، بعيدا خلف خيوط المؤامرات حيث لا تزال رائحة الدم تُعيد ذكرى الضياع الأول. جدي استند إلى حلم بيته المعتّق بالياسمين وأعال أجيالاً وهو يقف على قدم واحدة بينما قدمه الأخرى ضاربة كجذور أشجار الزيتون هناك بقرب البيت ونشوة الحياة الأولى.
أحلم ببيت كبير بحجم العودة أو بحجم موت مسالم، وأنا أحلم بذلك تراودني فكرة أن ما يوحد الناس أحياناً ليس فقط أنهم قد يتشاركون حياتهم في بيت واحد، ولكن أيضا يتوحد البشر عندما يشاركون حلمهم بالبيت في كون شاسع يهيم فيه ملايين الحالمون الآن، حتى في منتصف ليالي شهر شباط البارد في العقد الثالث من الألفية الثالثة.
أنظر إلى ظلالٍ مكسورة في عيناي في المرآة وأرى هناك جدران بيتي وقد صارت عالية، أعلى صور كثيرة باتت معلقة هناك من مخيلتي، امتلأت أرضية الشرفة بحبات الزيتون التي لم يقطفها أحد، بيتي الذي يكبر لابد أن يصير حقيقة على بعد كيلومترات من شاطئ المتوسط، هناك حيث سأنثر كثيرًا من الرمال وأحتضن المدى وأغني.