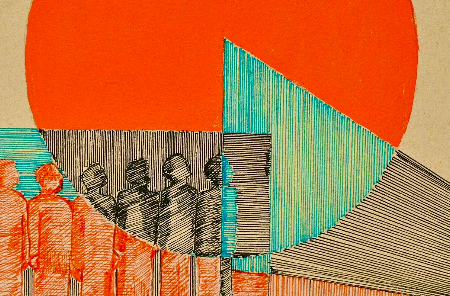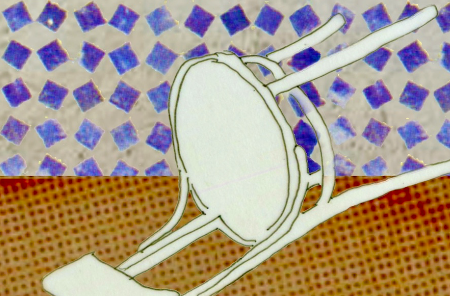سبقتني الحرب يا أمي! وها أنا أعلَقُ من جديد بين أنيابها، بعد ثلاثة وعشرون عاماً من الألفية، أنام بجانب حقيبتي وأطفالي وأحاول لملمة دعاء في صلاة لم تفقد أبجدية للأمل.
لم أكن يوماً من الأشخاص الذين تربطهم علاقة جيدة مع الأرقام، بل إن نفوراً ما صحبني منذ طفولتي، حتى بنيت أساساً معرفياً متجنبة فيه الحضور الرياضي قدر ما استطعت. لكن حين أصبحت أماً تحاول ألا تُسقط مواطن هشاشتها على أطفالها، بتٌّ أستحضر بوعي تحليلي، ارتباط ذاكرتي بأرقام معينة، وإغفالها عن أخرى، في محاولة لتفكيك ذلك النفور أو الإخفاق. وحيث أرتبطُ بمدينة عاشت حروباً متعاقبة، خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، بالحديث عن الحروب التي تبدأ وتحتاج عقود لتنتهي. شهدت في غزة الحروب على شكل إعصار مباغت، تأتي وتختفي، كأن شيئا لم يكن في موازين العالم الخارجي. أما نحن الناجون، نعلم تماما أن نجاتنا تحمل معها ندوب لن تختفي. هذه الحروب التي يأخذ رقم عامها العلامة المميِّزة لها في تتالٍ رقمي يربك ذاكرة تختار عوضاً مشاهد ومشاعر وفواصل ذاتية جدا لتحديدها. فلا بد أن يرتبط الرقم بحكاية، عاطفة، شخص…
أذكر أول حرب من خلال أول مشهد لها، مشهد تكشفت فيه أشكال جديدة من الغدر والتوحش العسكري، كنت وقتها أعمل معلمة لمرحلة ابتدائية، وكان يوم عادي جداً حتى بدأ الصوت يباغت كل شيء، فكان الخوف بين طلابي، أركض بهم حولي هربا من شيء مجهول رغم بداهة ماهيته .. هي آلة الموت ذاتها التي ندرس عنها كل يوم.
لم أكن أعلم أن ذلك سوف يكون شكل من أشكال الحرب التي سوف تتعاقب بعد ذلك. ولم أكن أعلم لماذا نسميها حرباً ونحن نعيش في ظل احتلال عسكري، كان ومازال يمارس كل أدواته العسكرية منذ بداية النكبة. لكنني أذكر تماما أن ضربة غدر مست القطاع من شماله لجنوبه على وتيرة واحدة صحونا بعدها كمن يتحسس أجزاء جسد بترت جميع أطرافه. كانت كرات الفسفور المضيئة أحدث ما توصلت إليه حداثة الدولة الصهيونية. أركل بقاياه المحترقة على الأرض وأنا أمشي وصولا لبيت آخر، قد يكون أكثر أمنا.
قَدِمت الى مدينة غزة في احتفاء لوالدي بصدور أوراق لم الشمل، التي بموجبها نستطيع دخول البلاد!! كان وقتها العام الأكثر صخبا ورنينا في البلد الأردني، المستقر سياسيا، والذي ارتحل عنه إلى مكان لا أعلم منه غير بديهيات الاسم والعلم. كان الاحتفاء ببلوغ نهاية الألفية الثانية أكثر حضورا بالنسبة لي، حيث تزامن مع التحرر من ثانويتي العامة، وحيث كان ذلك يجد سبيله في أشكال الترويج المختلفة وخاصة الاستهلاكي، وبقي الرقم ثيمة مطبوعة على كل شيء من القمصان القطنية إلى الأدوات القرطاسية، إلى المناسبات الموسيقية .لكن ارتباط هذا الرقم بذاكرتي أن "عودتنا" كعائلة لفلسطين، كانت في الوقت السابق للانتفاضة الثانية بشهرين. سبب انبعاث الانتفاضة من جديد كان دخول شارون باحات المسجد الأقصى مدنسا ومشرعا لنوايا جديدة. كنت وقتها لا أرتبط بالأخبار بصورتها المتلفزة، وأبدأ مشوار دراستي الجامعية على صوت الإذاعة الصباحية الناقلة لأخبار الحواجز الفاصلة للمناطق في القطاع. لحن زهرة المدائن، المصاحب لانتظاري الطويل في مقعد السيارة أمام الحاجز، وقبل انسحاب المستوطنات كان المشهد الأكثر تكرارا على مدى سنوات دراستي الجامعية. ومما كثف صخب المعرفة الهوياتية في تلك الفترة، توازي ما يحدث على الأرض مع دراستي للأدب، فكانت أم أسعد وجدران الخزان الذي لم يدقه رجال كنفاني، يضخ دماء جديدة في ذاتي. جغرافيا فلسطين، وتاريخها القديم والمعاصر، كل ذلك بدا ملموسا أكثر عندما أمسكت بين يدي كتاب اسماعيل شموط "الفن التشكيلي في فلسطين" . استعرته من زميل يدرس في كلية التربية الفنية، وددت لو أهرب به إلى أي مكان. ترافقني أعمالهم حتى اليوم على الجدارن، أحملها معي وأعيد ترتيبها كأنني أحمل فلسطين.
في حرب لاحقة، أدركت أكثر أن الأمومة في سياقنا الفلسطيني شيء مستهدف إفناؤه، فالحرب قبل الأمومة شيء وبعدها شيء آخر. كنت كل ليلة أضع طفلي الرضيع في سريره المتنقل بجانب باب البيت، المكان الأكثر أمنا، وأضل جالسة بجواره. كانت الحرب الأكثر استهدافا للأطفال والأمهات، وكنت أمارس أمومتي الحديثة بمرارة من يترقب دوره تحت المقصلة، في وجه عدوان يستخدم كل أدوات الحداثة لتعزيز وجوده. ومقابل كل محاولات الإفناء، تتكثف مشاهد الذاكرة في علاقة طردية مع الموت. لا أعلم أين ستنقلنا هذه الحرب في الذاكرة، ما نعيشه اليوم بعد الألفية الثانية بثلاث وعشرون
عام، هو استرجاع لما حدثنا أهلنا عن النكبة، حيث الطرد الإجبارى والفوري من المكان، المأوى، البيت. يحمل كل واحد من أبنائي في حقيبته، بالاضافة بعض الملابس، أحد أبطاله الخارقين، وأوراق الأونو. أما أنا فأحضرت معي أقلام الخشب التي أحب، وبعض الصور، ورسائل والدي إلي.
في سياق سابق، وأنا أعد حقائب رحيلي عن هذه المدينة وأعلم أنني أهرب بطفلين بحثا عن نجاتهما من توحش الآلة العسكرية، كنت أدرك أنني أزاحم عالم لجوء يكتظ بمعذبي حروب أخرى. أرتب مسار رحيل في عجلة كأنني أسابق آلة الزمن العسكري التي أدرك تماماً تربصها بحياتنا. أنا الآن كمن يجلس في منتصف الطريق، لا بيت أعود إليه، ولا أدنى احتمال لانتهاء هذه الحرب، التي بينما تزهق أرواحنا بين الثانية والأخرى، تخبرنا نشرة الأخبار عن احتمال إدخال مساعدات!
كان الجدل حول جدوى البقاء أو الرحيل يرافق كل حوار وكل بيت، أمي لا تجد في الحرب سبباً للرحيل.
سبقتني الحرب يا أمي! وها أنا أعلَقُ من جديد بين أنيابها، بعد ثلاثة وعشرون عاماً من الألفية، أنام بجانب حقيبتي وأطفالي وأحاول لملمة دعاء في صلاة لم تفقد أبجدية للأمل.