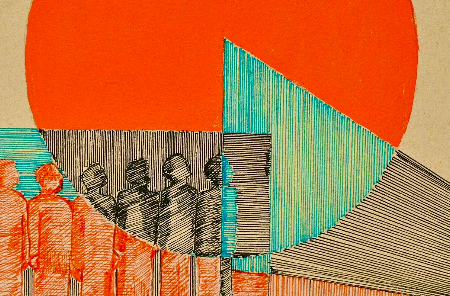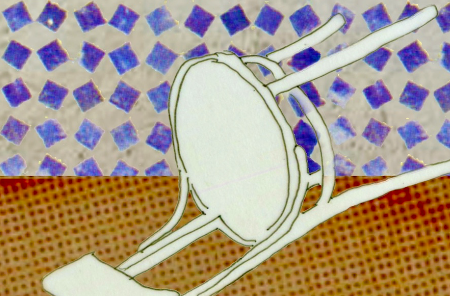أمّا عن قراري بعدم التسبب لأبنائي المُحتملين بأن يرثوا الكرت الأزرق عنّي، فقد غيّرت رأيي؛ سأمنحهم هويّتي الغزّية قبل اسمي، وأنا على يقين من أنهم سيدركون مآلات اللون لاحقًا، وسيكونوا مسرورين، مثلي الآن.
بدأ الأمر على جسر الملك حسين، أو ما نسمّيه "معبر الكرامة"، في أوّل مرة سافرت فيها، والتقيت بـ "الكرت الأزرق". وقف الجميع على شبابيك ختم الخروج، فوقفت خلفهم في الصفّ؛ أتينا كلّنا من مدن الضفة الغربية، والتقينا في هذا الصف؛ لأنّ لا شبّاك آخر لنا نحن فلسطيني ال67 لرؤية العالم من خلاله، إلا شبّاك الجسر هذا، الذي يربط الضفّتين غير الشقيقتين -بطبيعة الحال-، الضفة الغربية الفلسطينية، والأردن.
يحمل المسافرون الفلسطينيون معهم كرتًا، بمثابة وثيقة سفر لقطع الجسر والوصول إلى العاصمة الأردنية، يسمّى "كرت الجسور"، ويُعطى حسب مكان الولادة في جواز السفر؛ الكرت الأخضر لمواليد الضفة الغربية، والأصفر لمواليد القدس، والأزرق لغزّة. كنت لا أزال لا أملك واحدًا مثله، وبعد عدّة دقائق، وعدّة نظرات فاحصة إلى جواز سفري من ضابط شبّاك العالم الخارجي، يُقال لي: "آه غزّة، رح تاخدي كرت أزرق من هذاك الشباك بعينك الله"، وأشار بيده نحو طريق الآلام الذي سأكتشفه فيما بعد.
كنت قد سمعت عن "الكرت الأزرق"، من أفراد عائلتي الذين سبقوني في السفر، ولكنها المرّة الأولى التي نلتقي فيها، والمرّة الأولى التي سأحمله فيها قدرًا، ويحملني هو فردًا آخر من أبنائه قليلي الحظ عند السفر.
منذ ذلك الحين، تشكّلت هويتي في صورة أخرى؛ أكثر نضوجًا وأكثر ألمًا في داخلي، وبدأ سؤال أزليّ يراودني في كل مرة سأسافر فيها، فيما بعد؛ لماذا يكون لون البحر، مسقط رأسي، سببًا لمعاناتي في السفر؟
وماذا لو أردت أن أكون ابنة البحر والجبل في نفس الوقت؟ لو أردت أن أقسم هويتي بين طفولتي في غزة، وصباي في رام الله؟ من المحتمل أنهم لا يملكون اللون "السيان" الناتج عن البحر والجبل.
حسنًا، فهمت لاحقًا أنه عليّ أن أتأقلم مع "الكرت الأزرق"، ففي النهاية أنا ابنة مدينة لم تمنح أبناءها الكثير من الحظ في الحياة، بل منحتهم حمضًا نوويًا؛ يشكّل الحزن والتراجيديا أكثر من 90% منه! وماذا توقعت ممّن يسيئون فهم الألوان، أو يمتلكون ذوقًا رديئًا في اختيارها؟ بالطبع لم أتوقع سجّادة حمراء توصلني إلى المطار. في الحقيقة، لم يكن لديّ يومًا مشكلة مع الأزرق؛ لم أنكر هويتي، ولا من أين أنا، ولطالما تباهيت بها -بمناسبة وبغير مناسبة- عند سؤالي عن "مكاني الأصلي"، كوني أقيم في رام الله منذ ما يقرب ال15 عامًا. أنا من غزّة، وبحرها يشكّل شخصيّتي، وأزرقها هذا، قبل أن يقوموا بتشويهه، هو تجربتي الخالصة في الحياة، إذ إنني أنظر إلى الإنسان من خلال ما يحمل من تجربة، وإلا كان عبارة عن أفكار تنظيرية تفتقد إلى الخشونة. لم أحتاج إلى إنكار هويّتي الغزيّة في حياتي، حتى لو ستُعيقني عن السفر، لكنّي لم أتأقلم مع فكرة الكرت الذي يحكم عليّ بإجراءات كثيرة ومقيتة، في المطارات والجسور، ستجعلني أفكر كثيرًا وأتردّد، قبل أن أرغب بالسفر.
مع تكرار السفر، تشكّلت لديّ عقدة "زرقاء"، سأظل أقاومها كأي روح حرّة ترفض أن يتم تقييمها بناء على معايير، لن تفهم، ولن يكون لها مبررًا إلا في السياق الاستعماري، والذي كفلسطينيين، لديه وجه واحد في حياتنا؛ هو الاحتلال الإسرائيلي! سأقرر دون وعي منّي أنّي لن أنجب أبناءً يضطرون للوقوف على شباك موسوم بكلمة "أبناء غزة"، للإجابة على أسئلة غير مفهومة، ولن أتسبب بتشويه الألوان في عيونهم، قبل أن يقرروا دلالاتها بأنفسهم، وماذا يعني كلّ لون بالنسبة لهم، وسأحمل هذا القرار معي حتى السابع من أكتوبر للعام 2023، التاريخ الذي سيعيد ترميز اللون لديّ، مثلما أعاد تعريفي لكل شيء آخر في الحياة.
وضعتني الحرب على غزة، على مفترق طرق من كلّ المفاهيم والبديهيات، التي لطالما ظننت أني أعرفها، أو لديّ منها موقف واحد ومحدّد. تجرّدت فجأة، أو ليس فجأة، من كل القوالب التي وضعت نفسي فيها من جهة، وتلك التي وضعتها للعالم من جهة أخرى، وأسقطت عنّي كل المبادئ التي لم تبقى كذلك، وفقدت بوصلتي في الحياة؛ فصارت بوصلتي غزة.
منذ ذلك التاريخ، وضعتُ غزة في مركز الكون، وحاكمت نفسي والعالم من خلاها. أو في الحقيقة، استطاعت غزة أن تكون المركز، وحدها، وكلّ شيء عداها في الهامش؛ بسبب ما يزيد عن عشرة آلاف شهيد -حتى كتابتي لهذا السطر-، وبسبب صراخ أطفالها، الذين قرر العالم أن يصمّ آذانه عنهم؛ فوجدتني أفقد إيماني بهذا العالم، وأؤمن بغزة وحدها، وبرغبة الحياة لديها، وأصالتها في التعامل مع الجوع والحصار.
عندما تنتهي الحرب، سأحمل كرتي الأزرق وألوّح به من باب البيت حتى وصولي إلى آخر موقع في الكرة الأرضية، مرورًا بشباك "رقم 10"، الذي سيسألني عليه الضابط المناوب عن سبب سفري، وإن كنتُ أحمل معي "عدم ممانعة بالسفر". عندها، سأجيبُ على السؤال الأول بأن السبب هو كي أعرّضكم إلى اللون الأزرق ما استطعت؛ فترون فيه بحر مدينة شوّهتم طاقته فترة طويلة، والآن هو بشفافية تسمح لكم برؤية وجوهكم الضعيفة والصامتة على صفحته بكل وضوح، فتأمّلوا الكرت جيدًا، لا مانع لديّ من تعطّل سفري ساعتين إضافيتين.
أمّا عن قراري بعدم التسبب لأبنائي المُحتملين بأن يرثوا الكرت الأزرق عنّي، فقد غيّرت رأيي؛ سأمنحهم هويّتي الغزّية قبل اسمي، وأنا على يقين من أنهم سيدركون مآلات اللون لاحقًا، وسيكونوا مسرورين، مثلي الآن.