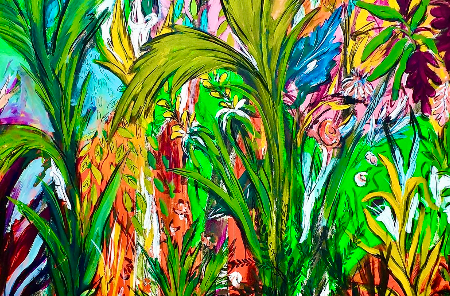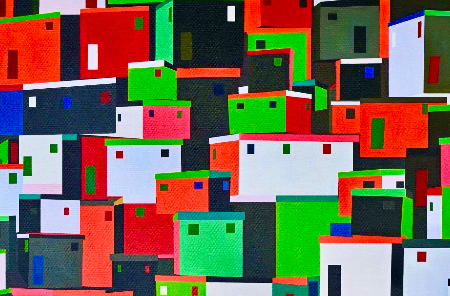يبقى انتقاد رينان مؤرقاً: الإسلام، في واحدة من تعريفاته الجوهرية، يقتضي التسليم لله: وهذا التسليم شامل، وكامل، للإله القادر القدير. انتقاد رينان يتردد صداه في كتابات استشراقية كثيرة؛ وبشكل غريب، يتحوّر ليوجّهه الغربيون للهندوس والبوذيين، وأحياناً، للشرق بأكمله.
{قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ}
قرآن كريم
في منتصف القرن التاسع عشر، وجّه الفيلسوف الفرنسي إرنست رينان اتهامات متعددة للإسلام، أهمها هو أن المسلمين يتواكلون على الله، ويسلّمون بكل شيء، بدون رغبة في العمل، أو التغيير، أو التفكير. كان ذلك في ذروة بناء الإمبراطوريات الفرنسية والإنكليزية، عندما كان الفكر الاستشراقي يبرر التوسع على الأرض، وبوعي أو بدونه، لما يقترفه الجنود وقادتهم.
ردّ الأستاذ الإمام محمد عبده على رينان، وبقيت ردوده، ورؤاه، بشكل عام، محورية لفهم أنفسنا: واحدة من الصدامات العديدة بين الشرق والغرب، قادها الإمام الذي تتلمذ على يديه الليبراليون مثل طه حسين والسلفيون مثل رشيد رضا. اتسم فكر عبده بنفس سلْمي علمي هادئ، يجمع الناس من كل الأطراف، ويحاور الغرب والعلم والتراث، في إنجازٍ لم يكتمل ولم يكن عميقا بما فيه الكفاية في أكثر الأحيان، ولكن روحه وقّادة صادقة تنير الدرب، وسنفتقده طويلاً بعد غيابه.
يبقى انتقاد رينان مؤرقاً: الإسلام، في واحدة من تعريفاته الجوهرية، يقتضي التسليم لله: وهذا التسليم شامل، وكامل، للإله القادر القدير. انتقاد رينان يتردد صداه في كتابات استشراقية كثيرة؛ وبشكل غريب، يتحوّر ليوجّهه الغربيون للهندوس والبوذيين، وأحياناً، للشرق بأكمله.
في الحقيقة، قدّمت الرواقية قراءة تكاد تتطابق مع المفهوم الإسلامي للقبول بالقدر، وقد رفضها بشكل قاطع أنطون تشيخوف في عنبر رقم 6. خشي تشيخوف أن تؤدي إلى التسليم بالشر، خصوصاً حين تقول لنا إن كل شيء زائل، وأن الأفكار أعمق من الأحاسيس. ربما، بطل تشخيوف يشوّه الرواقية، وربما لا. تاريخياً، كرّست الرواقية قراءة دينية واسعةً في العالم الروماني، ستؤثر في المسيحية، وستوازي قراءات مماثلة في الشرق. أيضاً، شنّ عليها الأبيقوريون والشكاك حملات متعددة، لم تثمر. في النهاية، ابتلعت المسيحية الصاعدة كل الفلسفات الهلنستية، الرواقية والأبيقورية والشكاكة، بالعنف وبالإقناع، ولم يبق منها إلا ما انتخبته هذه المسيحية نفسها.
قبل عقدين من الزمن، كنتُ مقتنعاً بالانتقادات تلك. كنتُ شاباً، أؤمن بقدرة الإنسان على التحدي، والتغيير، والثورة. وجدت هذه العواطف مكانها في الربيع العربي. اعتقدتُ أن أسوأ ما قد يفعله الإنسان، هو أن يكون رواقياً، أن يسلّم للأديان -السماوية أو الأرضية (هل هذا هو اللفظ المناسب؟)- بقدره ومصيره ومستقبله. كنتُ أقرب إلى الماركسية، وإلى علمانية متشددة، وتنوير قاسي -ولكن صادق- يجب أن يتغلغل في أعماق الناس، بدل القبول والخنوع.
تدريجياً، اكتشفتُ، مع توسيع قراءاتي، ورغبتي بفهم أعمق للمشكلة في حد ذاتها تجريدياً، وللإسلام أيضاً، بأن مذهب الحتمية والقدرية لا حلّ له، وحرية الإنسان مشروع فلسفي مفتوح أكثر مما هو شيءٌ ثابت ومفهوم. في أعمق ما قدّمته الفلسفة الغربية، اضطرّ إمانويل كنط إلى تشكيل مملكة موازية لعالمنا، هي مملكة الحرية، التي تخرج عن قوانين الفيزياء الحتمية، كي يحمينا من القدرية.
كما ابتدأت أفهم أن التسليم، والرغبة بالمصالحة مع الكون، قد تكون من أفضل ما قدّمه البوذيون والمسلمون. ربما، هزيمة الثورة السورية، وفشلي الكامل على المستوى الشخصي المادي والمعنوي والمهني، وتقدّمي بالعمر، وحقيقة أني الآن أبٌ لطفل أخاف عليه حتى من نسيم الربيع- لا سلطة لي على الأمراض الخفيفة التي تصيبه ولا الأحزان الصغيرة التي تنتابه، واغترابي الطويل جداً عن أهلي، جعلني أفهم أكثر ذلك الهدوء الذي طبع حياة الإمام الحسن البصري، أو ابن حنبل، على سبيل المثال.
حتى في شبابي، أثّر بي كثيراً وداع جبران تويني. كان والده غسان تويني الأكثر تماسكاً، وثقةً، وعقلانيةً، وتسليماً. بدا كأنه يمثل كل قيم الإسلام السنّي، بهدوئه، وصفائه. لا نعرف ما الذي دار بخلده بعد الدفن، ولكنه كان يتكلم عن الناس، عن التسامح، عن المستقبل، عن دفن الخلاف، عن الحياة. قتلت المخابرات السورية رفيق الحريري، وبعده سمير قصير، وجورج حاوي، وجبران تويني، وآخرين. كان غسان يعرف القتلة، ولكنه لم يجعل من مأتم ابنه مناسبة للحقد. كان يريد الحقيقة، ولكن لم يرد الدم. كنا ننتظر، في سورية، برعب، مصير لبنان ومصيرنا. لم أكن إلا أحد الشباب السوريين، الصامتين، المتابعين بأسى أخباراً لا تحمل إلا الرعب. فجأة، في قلب الاغتيالات، وجدتُ صوت غسان الدافئ الهرم، الذي حفر فيّ عميقاً، ولكنني نسيتُه بسرعة، بعدها، ولم أتذكره إلا الآن، في نكبة غزة 2023.
تذكرت الصحفي النبيل غسان، وكل تلك النقاشات داخل نفسي، والخلافات، والعجز عن الفهم، عندما رأيت الجد الغزاوي أبو ضياء يودّع حفيدته ريم، بابتسامة واثقة، مليئة بالمحبة، والحنان، واللوعة، والاندماج مع الموت، والحياة، حتى لتتخلخل الحدود بينهما، حين يفتح عينيها، يقبلهما، بدون أن يرتجف، بدون أن يبكي؛ حين يهمس لنفسه، نفسه الوحيدة في قلب غزة، في قلب الكون، في قلب الله: "وين طارت؟". فهمتُ ما الذي يعنيه التسليم.
ثم يقول، كأنه يخاطبها، ويخاطب القاتل، ويخاطب كل الناس: "هي روح الروح".
ويبتسم.
ربما، يستطيع المرء أن يواجه بدون التسليم، ويستطيع أن يرسم دروب الخروج من الحصار والجوع وخيانة الحلفاء والأقارب والليبراليين واليساريين، بدون التسليم. ولكنه سيكون مليئاً بالمرارة، بالحرقة، بالكراهية. سيموت مسموماً، أو، بالأحرى، سيعيش مسموماً. يقتضي التخلي البوذي عن مباهج الحياة، في أحد وجوهه، هذا الصفاء العميق. ويقتضي هذا الصفاء بدوره، أن نعيش مع الموتى، مع المصائب، مع الأطفال الذين غادرونا، بمحبة.
قد يكون فهمي قاصراً. أجل، بالتأكيد. لم أفهم، ولن أفهم، كيف يغادر الأطفال هذا العالم بهذه الطريقة. ولكنني أتمنى لو استطعتُ أن أودّع الناس، أو أن أستقبلهم، كما فعل ذلك الجدّ الغزاوي. أن أحيا مع تلك الابتسامة، أن أعرف الحصار، والقهر، والهزيمة، وأبقى مسلّماً "للقضاء والقدر، بخيره وشرّه"، بحسب الصيغة الرهيبة، القاسية، غير المُجاملة، التي اعتمدها فقهاء الإسلام.
قد يكون تفسيري وتأويلي فاسداً، أو ناقصاً، أو منحرفاً، أو باطنياً، أو تجسيمياً. لا يهمّ. ولكنني أعتقد أن هذا التسليم، يقتضي، بالضرورة، شيئاً من التوحد مع الكون، والاندماج فيه؛ يقتضي القبول وليس الرفض. وليعذرني القارئ على الشطحات، ولكنني لا أجد نفسي قادراً على متابعة تأملاتي بدونها: القبول، والاندماج، ووحدة الوجود، تقتضي أيضاً مقداراً أصغر من الكراهية، رغبةً أوسع بالتفاهم، شيئاً من التعالي على الانتقام: أن تفهم خصمك، عدوك: الإسرائيلي على الطرف الآخر، الأوروبي الأبيض الذي يبرر التجويع والتعطيش، الأمريكي الأخرق الذي يقود الحرب إعلامياً واقتصادياً. أعرف كم تثير هذه الأفكار من السخرية، وربما، برأي البعض، الاستسلام. ولكنها أيضاً تثير الرغبة بالمقاومة، الرغبة العميقة والكاملة والأصيلة بالمقاومة، بالضبط، كي لا يتكرر ذلك، لا في غزة، ولا في غلافها، ولا في أي مكان يعيش فيه الأطفال.
للمرة الأولى، أشعر بأنني أعرف ما يعنيه غاندي، أو طاغور، أو ابن عربي، بأن تكون جزءاً من كل ما يجري، هنا وهناك، في الماضي وفي المستقبل، بشكل واقعي تماماً. الحاج بكوفيته ودشداشته يعرف كل ذلك، بالقلب، عرفانياً، على ما يقول المتصوفة والغنوصيون. أشعر بأن تلك الكلمات الخفيفة البسيطة القليلة، وتلك الابتسامة، ودغدغة اللحية الخشنة البرية للوجه الميت البارد، تحمل أكثر بكثير من مجرد وداع: إنها تجسّد مواجهة كاملة مع الشر، مع الموت، مع "المائة عام من الحرب على فلسطين"، بحسب العنوان الصارم والصادق والدقيق للمؤرخ الفلسطيني رشيدا لخالدي؛ تجسّد حكمة الإسلام بقرونه الطويلة على هذه الأرض، وقدرته على الصمود، والقبول، والمحبة.
لا تعني هذه الأفكار الاستسلام، ولكنها تقود إلى التسليم بالشر، وبمحاولة مواجهته، في آنٍ معاً: بابتسامة، بقبلة في العين، بوداع غير صاخب ولا ناقم.
التسليم، كي تبقى قلوبنا صافية، كقلبه، كعينيها، اللتين تفتحتا، للمرة الأخيرة، بدون أن ترياه.