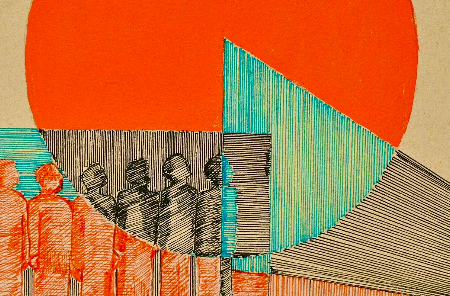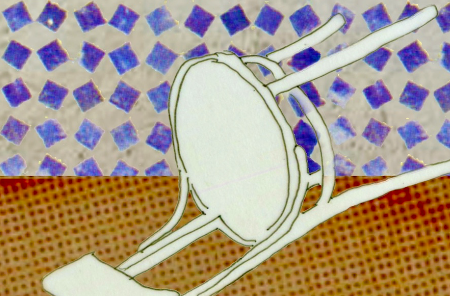ما يثير غضبي هو أطفال غزة باتوا مادة إعلامية فقط، سواء كانوا شهداء أو جرحى أو ناجين من الموت، كل ما يريد العالم أن يراه هو صورة طفلٍ بائس من غزة يقتنص القليل من الوقت ليبتسم، حبكة مثالية لفيلم درامي مؤثر ينفضون بسهولة مشاعرهم بعد انتهائهم من مشاهدته، دون أن يشعر أحدهم برغبة حقيقية في إنهاء تلك المعاناة.
أكثر من ثمانين يومًا على حرب الإبادة الجماعية في غزة، ولا زالت تنتشر بشكل عفوي فيديوهات الأطفال السعداء المثيرة للبهجة بين الوقت والآخر، يكسر الأطفال حاجز الخوف في ساعة اللعب وأمام الكاميرات بتلقائية لم أجد لها تفسيرًا نفسيًا مقنعًا ومقبولًا، خاصة وأنهم في حال قاطعهم صوت صاروخ ما ارتجفوا خوفًا وتسمروا في مكانهم، لا تعابير مفهومة على وجوههم.
ذاكرة الأطفال قوية وخيالهم خصب. فلا حدود لكل الصور والأصوات التي يمكن أن يشكلها. لست خبيرة في ذلك لأفتي ولكنني أم لثلاث طفلات استغربت أصغرهن عندما صرنا في بلدٍ لا تحلق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية في سمائِه، وسألت عن صوتها الذي كانت تسمعه منذ ولدت في عام 2016 وحتى غادرت غزة عام 2020 بشكل مستمر ومتواصل ولا انقطاع فيه " وين الإز از يا ماما".
قالت طفلتي إنها كانت تظن أن هناك عطلاً في التلفزيون الذي في السماء فيصدر هذا الصوت. ويظن أطفال غزة حاليًا أن السماء لا أبواب لها فهي تسمح لأطنان من المتفجرات بالسقوط عليهم، ربما يظن بعضهم أن ذلك جزءًا أصيل من حياتهم، فلا أستغرب إن قالت أم من غزة إن ابنها سأل "هل يكبر الأطفال في غزة؟". ولا أتعجب من فيديو لطفلة بالكاد تبلغ العامين تقلد صوت أزيز الصواريخ التي تخترق الهواء قبل وبعد انفجارها.
لا يعرف الطفل لماذا يموت، ولماذا تسقط فوق رأسه أطنان من المتفجرات، ولماذا يجبر على تحمل ذلك، ما يعرفه هو أن هناك صاروخاً إسرائيليًا قادمًا يمكنه إلقاء اللوم عليه لأنه قتل عائلته أو سرقَ أطرافه أو أصابه بحروقٍ بالغة.
هذه هي الصورة الواضحة للحرب على غزة، دموية جدًا وعنيفة جدًا ومجبرون عليها. رغم ذلك يستسهل الكثيرون التغني ببطولة الأطفال، وعدا عن أن "بطولة" كلمة غير مناسبة البتة لوصف تحملهم مضطرين لكل ما يحدث، يتناقل الكثيرون عبارات فخورة بأولئك الأطفال الذين يخرجون من تحت ركام منزلهم يرتجفون ويبكون "فقط"، ثم في اليوم التالي يرقصون في حلقات على أغنيات يتطوع بعض النازحين لغنائها لهم في ساعات الهدوء القليلة أثناء النهار، وتنتشر هذه الصورة العصية على التفسير للفرح مقابل تلك الواضحة عن الموت.
قبل أيام نشر مؤثر عربي مقطعًا مسجلًا له وهو يمتدح "بطولة أطفال غزة" وقال إنه يتعجب كيف أن الأطفال يخرجون من تحت الركام يرفعون اصبع السبابة ولا يبكون، في حين أن أطفالهم إن سقط أحدهم عن الكرسي يبكي حتى الفجر متألمًا.
لا أخفيكم أنني شتمت المؤثر في سري كثيرًا، وبقيت أشتمه وأنا أرى كل صور الأطفال المحروقين والمبتورة أطرافهم بلا تخدير، والباكين على أرض المستشفيات، والباكين أمام شاشات هواتف النشطاء آملين من العالم أن ينقلهم للعلاج في مستشفياتٍ يمكنها أن تقدم لهم أكثر من كلمة "تحمل شوي" التي لا يجد غيرها أطباء غزة لتخفيف آلامهم.
وعلى غرار صورة البطولة تلك التي يُلبسها الجميع للأطفال، هناك دائمًا فيديوهات لأطفالٍ فرحين بقليلٍ من طعام متبقٍ في قعر إناء في مركز الإيواء، أو يجمعون الدقيق والماء الملوث عن الأرض، فيديوهات مبهمة معنونة "انظروا لحال أطفال غزة" ومرفقة بأغنياتٍ مؤثرة لا هدف لها إلا اجترار عاطفة ودموع المشاهد، دون الإشارة حتى إلى أن مئات الشاحنات التي تحمل أطنانًا من المساعدات تصطف خلف جدار المعبر من الجهة المصرية ولا يدخل منها إلا ما يوافق الاحتلال الإسرائيلي على إدخاله.
ما يثير غضبي هو أطفال غزة باتوا مادة إعلامية فقط، سواء كانوا شهداء أو جرحى أو ناجين من الموت، كل ما يريد العالم أن يراه هو صورة طفلٍ بائس من غزة يقتنص القليل من الوقت ليبتسم، حبكة مثالية لفيلم درامي مؤثر ينفضون بسهولة مشاعرهم بعد انتهائهم من مشاهدته، دون أن يشعر أحدهم برغبة حقيقية في إنهاء تلك المعاناة.
ربما تشرح فيديوهات الطفلة زهوة السموني حال الأطفال في غزة وهي تزور خيمة الصحافيين في مستشفى شهداء الأقصى لتسأل عن أخبارٍ جديدة عن والدها الذي اختطفه الاحتلال أثناء نزوحهم. زهوة تبكي في كل مرة وتقول "أبوي كان سندي"، هذه الطفلة التي شهدت النزوح القسري وكانت شاهدًا على اختطاف والدها تضحك أحيانًا وتبكي أحيانًا، ولا تدعي أنها بطلة، هي تقول ببساطة إن ظهرها مكسور. حزنها يشبه حزن كل غزة لكنها تجيد بكلماتها البسيطة التعبير عنه.. إن زهوة تبدو كأقرانها أكبر بعشرين عامًا من عمرها. كلهم صاروا أكبر من عمرهم، ولا أعرف متى حدث ذلك.