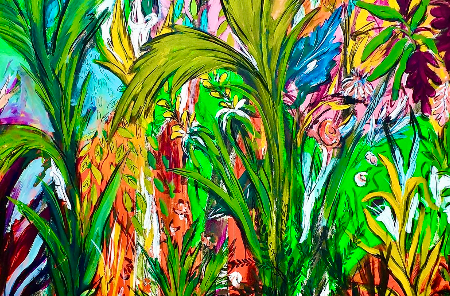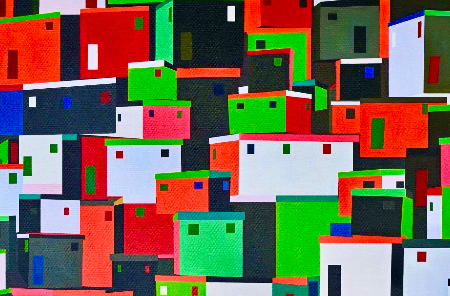يشعر المرء بالانكسار وهو يرى أنّ البلاد التي حلم بحريتها، ولا يزال، لا تحتمل وجود نصّ أدبي في فضائها، ويغدو الانكسار أشدّ وأقسى حين يرى أنّ المشكلة لم تعد تقتصر على الطغاة والغزاة، بل باتت تمتد إلى المهمّشين والعاديين الذين يصفقون للقتل، ويهلّلون له، كما لو كان طقس الخلاص.
المشهد الواقعيّ الذي عشناه في الأيام الماضية، يبدو مأخوذًا بشكل حرفيّ من حلبات المصارعة الرومانية، حيث دماءُ واحدٍ منا نجاةٌ للآخر وتطهيرٌ للجميع، وفي الوقت نفسه هي متعةٌ تسلّي ضجر الشعب والإمبراطور.
المشهد الواقعيّ إياه يذكّرنا بإحدى قصص السوري جميل حتمل، التي تتحدّث عن معتقلٍ يتلقى التعذيب في أحد أقبية الاستبداد، من جلادين هم بالأساس أبناءٌ لعمّال أو فلاحين، رغم اعتقاله على خلفية الانتماء إلى حزب يدافع عن هؤلاء بالذات.
في ردود الفعل على رواية "جريمة في رام الله"، يهالنا أن نرى أن هناك سيّافين أكثر من الرقاب، ويهالنا أنّ القتلة يتكاثرون بشكلٍ يوحي أن لا نجاة للضحية إذا لم تتحول إلى قاتل، والنتيجة الأخيرة: قتلةٌ أكثر من الضحايا، وضحايا أقلّ مما تحتاجه شهوة القتل كي تنجز المجزرة!
ما يحدث مخيف. إما أن الشعب تحوّل إلى طاغية، وإما أن الطاغية استطاع الحلول في عدد لا نهائي من الأفراد. تلك هي قسمة الاستبداد، وذلك هو عدله، وهو يمضي إلى تشكيل جسده في مسخٍ مكوّن من قوة السلطة ويقين الدين وصلابة العرف والتقليد وهذيان العفاف.
دائمًا يأتي هذا الموت، دائمًا يُفلت سعارَهُ في وجه الكتب والكلمات والخيال. حدث هذا من قبل مع "وليمة لأعشاب البحر" و"قصر المطر" وسواهما، وسيظلّ يحدث على الدوام كي يذكّرنا بما لم نحقّق من عدالة، وبما لم ننجز من احترام الكتب والأفكار، ولأجل هذا نحتاج إلى آلاف الجرائم مثل جريمة عبّاد يحيى، نحتاج إلى "جريمة في دمشق"، وإلى "جريمة في الرباط"، وإلى "جريمة في القاهرة"... إلخ. نحتاج إلى أدبٍ يرتكب الجريمة، ولا يكتفي بكتابتها وحسب، بل يصّعدها وينظّمها ويجعلها حرفةً واختصاصًا.
تاريخ الأدب، بهذا المعنى، صنعه مجرمون وخارجون على قواعد الفن والأعراف معًا. شجعان ويابسو الرؤوس مثل أبي نواس وأمل دنقل ومحمد شكري... انتموا إلى الاحتجاج وأعطوا الكلمة قوة الذكاء وحرارة الرفض، لكي لا يكون لأية سلطة أن تصل يومًا إلى راحة البال.
كيف لهم أن يتحدّثوا عن الأخلاق ولا نرى في حياتنا اليومية إلا الاحتيال والكذب والنفاق؟ يكذب الأب أمام أولاده حين يأمرهم أن يقولوا للمتصل إنه غير موجود، وبعد قليل تراه يصير جلادًا يضرب أحد الأبناء إذا ما تمثّل به وكذب كذبةً. يكذب الشيخ على المنبر كي لا يزعج المخبر الذي يصلّي ويكتب تقريره في آن. كذلك يلبس الجميع جلد الحرباء أمام النافذين والأغنياء والوجهاء. يكذب كلٌّ من النجّار والحدّاد والدهّان في المواعيد، ويغشون في المواد. تعيش المرأة في حقل ألغام من المتحرشين، وعليها أن تصمت خشية الفضيحة. العلاقة مع الأبوين مبنية على الطاعة العمياء، رغم أن خياراتهما قد تكون إجرامية بحق الأبناء. قائمة تكاد لا تنتهي، ترصد معادلات حياتية ضدّ الحياة، لا يجب علينا إلا التسليم بها، بل والتصدي لمن يأتي لزعزعة هذا البنيان الزائف.
عاصفة هوجاء ضد رواية لم تُقرأ، وهذا جيد جدًا، يجب ألا يقرؤوها، يكفي أنها تخيفهم وتحبطهم، يكفي أنها تثير هذا الرعب كله، فمن أين لهؤلاء شجاعة مواجهة المرآة؟
يقدّم المشهد عطبًا نفسيًا هائًلا، يتجلّى في رفض الذات للذات، الذات نفسها لنفسها، لكنها تلعب لعبة حمقاء تحاول من خلالها أن تداري عارها، عبر صناعة آخر من أبناء جلدتنا، ثم ترفضه وتلعنه، ليكون ثمة منطق ما لرفض الذات لذاتها، باختيار طريق مواربة.
لن أتحدّث عن الرواية لأنهم لا يتحدثون عنها. مثلهم أتحدث عما حولها، وكلي ثقة أنها سوف تتحدث عن نفسها عما قليل، حين تخلق لنفسها مناخًا حواريًا يليق بها. حسبي من هذا كلّه الإشارة إلى المفصومين والفصام الآن.