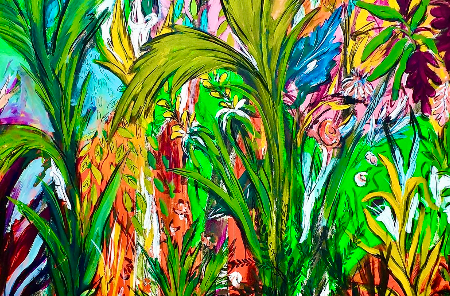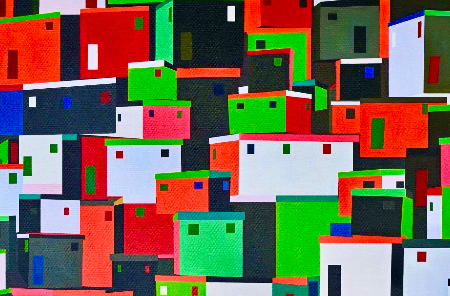لا تستهدف القوى الاستعمارية الثقافة الفلسطينية ورموزها فوق أراضيها وبين شعوبها وحسب، بل تستهدف ذاكرتنا نحن -الشعوب المستعمرَة- أيضا. حتى ولو كانت الممارسات التعسفية تحدث على أراضيها بالمباشر،
منذ صغري، تعلمتُ أن حدودي الأشد وضوحًا ترسمها لي القضية الفلسطينية. وقبل أن أقرأ لباسل الأعرج، كانت فلسطين المعيار الأخلاقي الأساسي في اتخاذي لقرارات مختلفة، حتى في أقل الأمور أهمية، كمتابعة ممثل/ة على صفحة الانستغرام مثلًا. وبعد حرب غزة، ضاقت الحدود كثيرًا، ولكنها المرة الأولى التي ألعب فيها دوري السياسي كما يجب، باتساق كبير مع مبادئي، بعيدًا عن الأفكار المعلبة والجاهزة للاستهلاك السريع والمريح. اليوم أكتب للمرة الأولى بعد ٧ أكتوبر، وأنا أخشى أن أفرط في الخوف حدّ اليأس أو أفرط في التفاؤل بانتظار مستقبل بلاد قد لا يعيش نصف أهلها ليشهدوا عليه. ولذا أكتب مقالي بحذر كافٍ، كي ألعب دوري الصحافي في التوثيق ونقل السردية دون أن تصبح الكتابة هدفًا قائمًا بحد ذاته، وأرتب جملي بحيث أبوحُ بما أراه حقيقيًا لا بحيث تكون الجمل طربية، تُرضي آذانٍ دون أخرى.
عندما أقولُ أن غزة أخرجتنا من "منطقة الراحة" لا أعني فقط وقت النوم الطبيعي مثلا، أو أكل وجبة لذيذة دون الشعور بالذنب أو الاستمتاع بوقت الراحة دون أي اعتبارات. بل هو الخروج عن الراحة الوهمية التي عشنا في داخلها لوقت كافٍ كي نستغني عن أدوارنا التاريخية كشعوب مستعمَرة وفئات مهمشة أصبح النضال بالنسبة إليها غير معقول ما دام يُلزمها ببعض التضحيات. واليوم إذ نضطر على الخروج من هذه الدائرة، لم يعد مرحبًا بكسلنا وخياراتنا الأنانية في التخلي عن مسؤولياتنا تجاه بعضنا ومحاولة النجاة كأفراد من معاناة شكلها جماعي أصلا. لم يكن احتراق نضالنا الورقي أمامنا سهلًا، ولم يكن إدراك حقيقة هذا العالم وقدرته على استخدام أدواتنا ضدنا سهلًا أيضا، وهو وقت قاسٍ لتعلّم الدروس ووقت ضيّق لمراكمة وعي على هذه الدروس، ولكن فلنبدأ.
قرأت مرة في مقال يتحدث عن ثقافة الإلغاء، أنها تحولت منذ فترة لثقافة تقدمية نظرًا لاستخدامها من قبل الفئات المهمشة لمحاسبة بعض الشخصيات (والتي تكون في موقع قوة غالبا)، اقتصاديا وعزلها اجتماعيًّا بسبب موقف سيء اتخذته بحق فئة مهمشة أو أكثر. فرأينا مقاطعة لفنّانين بسبب عنصريتهم/ن ورأينا طرد ممثلين من إنتاج سينمائي بسبب تهم التحرش وغيرها الكثير. و"الإلغاء" آداة جدلية كان يُتهم من ينتقدها بقربه من اليمين والتيار المحافظ، وكانت في الولايات المتحدة الأميركية مثلا إحدى أهم أدوات اليسار في النضال. وبغض النظر عن مدى فاعلية هذه الاداة ومدى تقدميتها، الّا أنها عندما تستخدم بشكل مُعاكس، أي من أولئك في موقع القوة ضد الأضعف، فإنها تتحول لأداة قمع ممنهج. وهنا لا نستخف في قوة الجموع وقدرتها على التأثير، ولكننا نلفت النظر لخطورة في أن يصبح الإلغاء سلاحًا قانونيا في يد السلطات.
بعد طوفان الأقصى ومسرحية do you condemn Khamas، واتخاذ شعوب العالم موقفًا طبيعيًا (وبلا شك مفاجئ) الى جانب الشعب الفلسطيني، اجتاحت الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأوروبية موجة من القمع ومحاولة إلغاء تمثلت في طرد تعسفي لبعض الموظفين الداعمين لفلسطين وإلغاء حفلات توقيع كتب مع أدباء فلسطينيين وقطع التمويل عن أي مشروع يعبر عن موقف واضح ضد الإبادة في غزة وغيرها الكثير من الإجراءات التي من شأنها عزل الوجود الفلسطيني والسيطرة على صدى صوته والتلاعب في سرديته لصالح السردية الإسرائيلية. ورغم القهر الذي يولده هذا القمع، إلّا أنه جميل من حيث عبثيته. في السنوات القليلة التي عشتها، رأيت مرارًا كيف ينسعر الديكتاتور من الحريات، كيف يضرب وهو خائف، يرتجف، يبحث عن أي طريقة لاسترجاع سيطرة هو يعلم أنها لن تعود.
الاستحواذ الثقافي والإبادة المعرفية
في العادة، تُعطى الأولية في المقاومة للمعارك العسكرية، وهو أمر مفهوم ومفروض، شرط أن لا نشيح وجهنا عن المعارك خارج السلاح، إذ أن الحرب مع العدو ليست حلبة مصارعة يتواجه عليها واحد ضد الآخر والأقوى بَدنيًا يفوز وتنتهي اللعبة، ولو أنها كذلك، لاندثرنا من التاريخ بعد النكبة. بالتوازي مع الحرب العسكرية في السنوات الأولى للاحتلال، كانت إسرائيل تعمل على "الإبادة المكانية" و"الابادة المعرفية" عبر تغيير شكل المكان وهدم ذكريات الفلسطينيين وبيوتهم وبناهم التحتية وتدمير الأشجار والأنماط الزراعية الفلسطينية وتغيير التضاريس بواسطة المقالع والكسارات. هذه الممارسات الاستعمارية كانت حجرًا أساس في تصديق العالم للسردية الاسرائيلية عن السكان الأصليين للأراضي الفلسطينية، والتي أصبحت تتبلور اليوم بممارسات جديدة. لم تكتفِ إسرائيل بتغيير شكل المكان بل ذهبت لتغيير أسماء المدن والقرى إلى أسماء عبرية والتي أصبحت هي اللغة الرسمية في الأراضي المحتلة. وخارج جغرافيا فلسطين، ثمّة من يخوض الحرب نيابة عن إسرائيل ضد الوجود العربي عامّة والوجود الفلسطيني خاصّة، فقد نجحت القوى الاستعمارية بربط اللغة العربية بالإرهاب والخوف مثلا، وقللت من شأنها حتى أصبح الناطقين بها يتمتعون بمصداقية أقل من أولئك الناطقين بالانكليزية. ولم تكتفِ هذه القوى بملاحقة لغتنا، بل ذهبت وراء رموزنا وثيابنا ورقصاتنا وحتى أكلنا. وبدل من الغائها وتجريمها كما هو الحال مع العَلَم مثلا، حاولت هذه القوى تسليع بعض الرموز وإخراجها من سياقها التاريخي وما تعنيه في ذاكرة الشعوب الجماعية، مثل استخدام الكوفية كموضة خارج أي سياق سياسي او فلسطيني. أو إدراج الحمص على أنه أكلة شعبية إسرائيلية، أو ارتداء زوجة وزير الدفاع الاسرائيلي الثوب الفلسطيني في زيارة رسمية إلى البيت الأبيض في الستينيات على أنه من "التراث الإسرائيلي". هذه الممارسات الاستعمارية، والتي تأتي غالبا بقوالب رومانسية على شكل "عالم واحد وثقافة واحدة" و"اندماج ثقافات"، هي في صلبها استيلاء واستحواذ ثقافي يهدف لتفكيك ذاكرة الشعوب وإبادتها ومحو أثرها حتى عن المائدة. لقد نجحت الرأسمالية مثلا في الجعل من غيفارا رمزًا عالميا تستفيد هي منه ولا يكون له أي دور تاريخي بعيدًا عن السيغار الكوبي والقبعة الثورية، وأصبحنا نرى ملايين العالم تلبس صورته دون أن تعرف عنه شيئًا.
الفضاء الالكتروني شريك في إبادة الذاكرة
كان من المفترض أن تكون مواقع التواصل الاجتماعي، فضاءً حرّاً يهدد الديكتاتوريات وأصحاب النفوذ والقوة، كان من المفترض أن يخرج عن قوانين المال والسياسة وما أنتجته من ظلم وقمع. كان من المفترض أن يحل الفضاء الالكتروني كمنبر بديل عن كتب التاريخ التي كتبها المنتصرون والأقوياء، لتوثيق سردية المظلومين. ولكن الحقيقة أن هذه الوسائل يسيطر عليها بضعة رجال مجانين، يتاجرون في بياناتنا ويأتمرون ممن هم خطر على بقاء البشرية أصلا. لم تكن شركة "ميتا" أو "اكس" أفضل من الإعلام التقليدي الخاضع لأجندات سياسية معينة، ولم تكن "غوغل" أفضل من الاثنتين. قامت هذه الشركات بطرد العاملين الذين يدعمون القضية الفلسطينية، كما أقفلت حسابات صحافيين من قلب غزة وخارجها بسبب تأثيرهم العالمي، وحاولت حظر أي محتوى يتحدث عن غزة أو ضد اسرائيل، وربطت كلمة فلسطيني بالإرهاب، وحاولت أن تحدّ من قدرة العالم على الوصول للمعلومات. وأنا لا أستغرب أن نستيقظ يومًا لنجد أن المجانين قد أقفلوا هذه المواقع، إذا كان ذلك يصب في مصلحة إسرائيل.
الدروس التي لم تتعلمها الديكتاتوريات
لا تستهدف القوى الاستعمارية الثقافة الفلسطينية ورموزها فوق أراضيها وبين شعوبها وحسب، بل تستهدف ذاكرتنا نحن -الشعوب المستعمرَة- أيضا. حتى ولو كانت الممارسات التعسفية تحدث على أراضيها بالمباشر، إلّا أن ما تحدثنا عنه مسبقًا حول مواقع التواصل الاجتماعي خير دليل على نية هذه القوى في إبادة ذاكرتنا وقتل عزيمتنا وتحوير اهتماماتنا بما يخدم مصالحها ويؤبد بقاءها. وقبل هذا القمع المسعور الذي نشهده اليوم، نجحت هذه القوى في تنفيذ البعض من أجندتها السياسية بحق شعوبنا. الّا أن الديكتاتوريات لم تتعلم أن النتيجة الحتمية للقمع هو حريّات أكثر عمقًا ووضوحًا. فخلال ثلاثة أشهر من الحرب وقمع العلم الفلسطيني وتجريمه في بعض الدول الأوروبية، نجح المثلث الأحمر في أن يصبح رمزًا عالميا للمقاومة يرفعه المتظاهرون في وقفاتهم التضامنية. والمثلث الأحمر ليس رمزًا "دبلوماسيًا" كالعلم، بل رمز عسكري يُخرج التضامن العالمي مع فلسطين من التضامن الساذج مع الفلسطيني المظلوم الذي لا حول له ولا قوة، للتضامن السياسي الحقيقي مع حق هذا الشعب في مقاومة محتله. وهذا المثلث وإن دلّ على شيء فهو يدل على أن هذا الشعب ما زال قادرًا، بعد ٨٠ عامًا، على إنتاج رموز لمقاومته تحميه من الإبادة الماديّة وتلك المتعلقة بالذاكرة.
عندما رسم ناجي العلي حنظلة قال أن يديه متشابكتان خلف ظهره رفضا للحلول التي تقدّم على الطريقة الأميركية، ولو عاد ناجي اليوم، لرسم حنظلة ملثمًا وفك يديه ليحمل مثلثًا وقذيفة الياسين، لقال لنا: هذه لحظة تاريخية ولا بد من ملاحظتها على أنها كذلك.