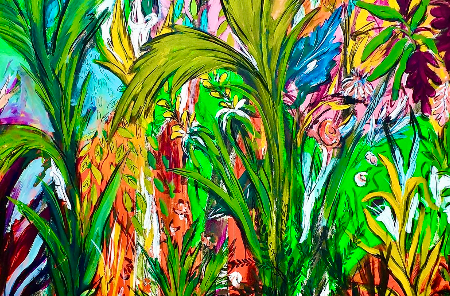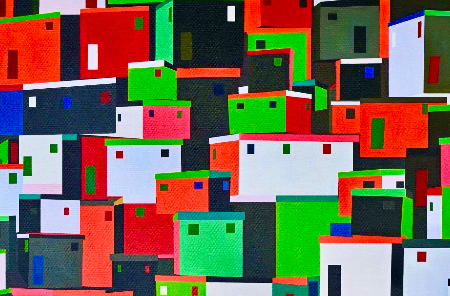الخطير في الأمر، أن السواد الأعظم من مجتمعاتنا بهذا المعنى، دُفعت دفعاً لملء شواغر مسرح ما عرفه الفرنسي "جي ديبور" بمجتمع الفرجة أو الاستعراض" ذاك الذي تتحكم في أبوابه وتمتلك مفاتيح اقفاله قوى الاستعمار التي باتت تقدّم لنا المقدّس والمدنّس بصيغ معلّبة تلبّي تعريفاتها ومعاييرها ومصالحها.
حين نتحدّث عن هذا العنوان الكبير، لا يسعنا في هذه المساحة أن نشمل كلّ ما يمكن أن يقال أو يطرح، تحت سقف ارتفع إلى أعلى درجات الحضور الفاعل، في الحياة اليوميّة للشّعوب والجماعات والأفراد والهيئات والمؤسّسات؛ خاصّة وأنّ وسائل التّواصل الاجتماعي شكّلت ثورة هائلة وغير مسبوقة على صعيد طرح الأفكار والتّصوّرات وتشكيل الآراء، بما يعرف أو يطلق عليه صناعة الرّأي العام أو هندسة العقل الجمعيّ، إن صحّ التّعبير.
ولكنّنا كي ندخل إلى الموضوع مدخلاً صحيحاً وربّما مغايراً، تبادر أمامي أن نحاول معاً ولو سريعاً، أن نجيب عن سؤال بديهي وبسيط ومباشر: ما هو الرّأي بالأساس؟ فعلى الرّغم من شيوع مصطلح "الرّأي العام" لم يتوقّف الكثيرون أمام التّعريف، لا على جهة اللّغة، ولا من الجانب الاصطلاحيّ، ونحن أيضا لن نفعل كي لا نأخذ الكثير من المساحة، ولكنّ الاجتهاد يأخذنا لطرح ملخّص أعتقده يفي بالحاجة، إذ أراه، وأقصد الرّأي، باعتباره أمراً كثيراً ما يقع في المنطقة الفاصلة بين التّحول من الجهل بالشّيء أو المعلومة، إلى المعرفة النّسبّية أو الكّليّة بهذا الشّيء أو المعلومة، ما يعني أنه متحرّك ونسبيّ إلى حدّ بعيد.
هذا المدخل ينقلنا بالضّرورة إلى منطقة مسكونة بالكثير من الأفكار والتّصوّرات، ويطرح سؤالا آخر بسيطاً ومركّباً: ممّ يتكوّن الرأي العام وكيف يتشكّل؟ نظريّاً يقال إنّ هناك الكثير من العوامل والأدوات التي تلعب دوراً أساسيّاً في تكوين الرّأي وآليّات تشكيله، منها على سبيل المثال لا الحصر، العادات والتّقاليد والدّين، والإعلام، والنّخب السّياسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة والاجتماعيّة، وما يسمّى بجماعات الضّغط... إلخ، يتّفقون أو يختلفون حول رأي ما في هذه القضيّة أو تلك؛ عادة ما يُطرح من قبل فرد لينتقل إلى مجموعة محدّدة أو قطاع معلوم، وصولاً للنّقاش العام سواء كان نقاشاً افتراضيّاً أو واقعيّاً، ولكنّ العامل الأساس المحرّك لكلّ هذه العمليّة، يدور حول موضوعة الإرسال والتّلقي، وهي عمليّة عادة ما تُطرح بصيغ مكتوبة أو مسموعة أو مرئيّة أو حسيّة وتخضع لاشتراطات ما يسمى بـ "قوى الدّفع".
أما في عصر الرّقمنة، ومواقع التّواصل الاجتماعي، فالأمر اختلف قليلاً؛ نعم هناك مرسل لا شكّ، ولكنّه قد لا يكون معلوماً أو مرئيّاً، يقدم المعلومة كما يريدها هو، أو من يمثّله من جهة أو جماعة أو حزب، وبالتّالي يُصبح الدّفع بهذا الرّأي أو ذاك موجّهاً بشكل أو بآخر، في مواجهة عناصر مقاومة عادة ما تفقد الكثير من قوّتها ويضعفها موقعها المدافع عن الاتّجاه الآخر للطّرح.
للوهلة الأولى، يبدو الرّأي محقاً، ولكنْ مع شيء من الفحص والتّدقيق ينزاح الأمر نحو النّسبيّة، حيث الحقيقة التي لا يُمكننا النّظر إليها من كافّة الزّوايا في ذات اللّحظة، وهو ما يُدخلنا في نفق ما أسمّيه بشيفرة التّلقي، وتعرف في الأوساط الفكريّة والأدبيّة بنظريّة التّلقي، تلك التي لن نتوقّف أمامها بالتّفصيل لضيق المساحة أيضا، ولكن يكفي أن نشير إليها باعتبارها أحد أهمّ السّياقات الأساسيّة لتوجيه الرّأي في عصر الرّقمنة، ومواقع التّواصل الاجتماعي، وهو ما يُذكّرنا بكتاب مهمّ في هذا السّياق للباحث الأمريكي " ماثيواف جايكويز" إذ يطرح نظريّة "المعرفة في خدمة الهيمنة" ليدرس ويناقش مع جمهوره، أبعاد توظيف المعرفة بكلّ مكوّناتها التّقليديّة والحديثة لاستمرار فعل الهيمنة؛ وبلغتنا البسيطة أو الوسطية لـ"صناعة القطيع" ما بين مزدوجين، وبكلّ الأحوال، لا ينزاح الهدف عن أهميّة تقديم النّسخة بديلاً عن الأصل، وملامح الوهم عوضاً عن وجه الحقيقة، وبالتّالي خلق شريحة واسعة من الأعداء والأنصار بصيغ مجانيّة، ولكنّها مفيدة وضروريّة في خلط الأوراق وصولاً للهدف الكليّ المتمثّل في السّيطرة والهيمنة؛ ويكفي أن تدفع هذه الحيلة بالطّرفين أو بالأطراف مجتمعة إلى أتون صراع داخليّ دائم ومتحرّك ومستمرّ لا ينتهي. ولنا في العديد من حالات الشّرق نماذج يمكننا الانتباه إليها، كما هي حالة الصّراع المعلن والمستتر بين السنّة والشّيعة، وكذا صراع الهويّات الفرعيّة، الكرديّة، الأمازيغيّة، وغيرهما في بعض مناطق هذا الشّرق، وأخيراً حالة الانقسام الفلسطينيّ الداخليّ بوصفه النّموذج الأكثر وضوحاً للعيان، والأكثر عبئاً على كاهل القضيّة الوطنيّة الفلسطينيّة.
من هنا يُمكننا البحث في عنوان "صناعة الرّأي بين الحقيقة والوهم" ببساطة لأنّنا شئنا أم أبينا محكومون لقوانين لعبة علاقات القوّة، التي لا تطيق بعض بنودها المعارضة، ولا تحتمل المناظرة، ومنها: "أنّ من يملك التّأثير في المخيال الجمعيّ، يعلم كيف يقود الجماعة" كما يشير للأمر بلغة أخرى الفرنسي غوستاف لوبون.
ولعلّنا حين نتحدّث عن عصر الرّقمنة، نشير بشكل واضح وجليّ إلى ما استحدث من ثورة قلبت موازين الصّحافة والإعلام رأساً على عقب، ألا وهي مواقع التّواصل الاجتماعي، بوصفها الأكثر نفعاً وخطورة في آن واحد، حيث بات هذا الفضاء المزدحم بكمّ هائل من المعلومات سلاحاً ذي حدّين، فهو من جهة يقدّم معلومة زائفة ومشوهة ومجتزئة، ومن الأخرى يتيح المجال واسعاً لبعض معلومات دقيقة وحقيقيّة، ما خلق بدوره حالة التباس كبرى استغلّها ويستغلّها كلّ صاحب أجندة خاصّة من أفراد وجماعات وهيئات، الأمر الذي لا شكّ يؤثّر في صدقيّة ما يُطرح بشكل آنيّ ولحظيّ، ما يدفعنا للقول: إنّ كلّ ما ينشر ونتلقّاه على هذا الفضاء الشّاسع، ناقص بالضرورة والاحتمال، ما يفرض علينا ضرورة البحث والتدقيق والتحقيق بوصفنا أفراداً، وعلى الصّحافيّ والإعلاميّ بشكل أساسيّ، والمثّقف على وجه التّخصيص، المشاركة الفعّالة في صناعة المحتوى من خبر ومعلومة وفكرة وربّما معرفة.
نحن إذن، بصدد ما يعرف بـ"حرب الأفكار"، حيث لم يعد الأمر عصيّاً على الإدراك، أنّنا اليوم أمام دور مؤثّر وحيويّ وموجّه تلعبه مواقع التّواصل الاجتماعي على جبهتين أساسيّتين، الأولى لا شكّ إيجابيّة باتجاه كونها باتت منصّات استطاعت أن تشكّل أرضيّة خصبة للتّفاعل مع القضايا العامّة، وحرّية التّعبير، وتبادل الأفكار والتصوّرات، بوصفها أداة تعزيز للوعي والمعرفة، فضلاً عن المساحة المناسبة التي وفّرتها هذه المواقع لعمل المؤسّسات والشركات على صعيد الحيّز الإعلانيّ الترويجيّ، ولكنّها في المقابل أتاحت فرصاً واسعة للتّوظيف السياسيّ والاقتصاديّ والثقافيّ المقيت، إذ باتت منبراً فاعلاً لطرح الأفكار الهدّامة، والتجسّس، وانتهاك الخصوصيّة، والدّفع بالمزيد من المغالطات والأوهام والأكاذيب والتّزييف والتّحريف والتّشويش، خدمة لأجندات لا علاقة لها بالجمعيّ قدر تعزيزها للفرديّ والحزبيّ في زمن الاستهلاك والتّشيّؤ، وارتداء الأقنعة الخادعة لتقديم السمّ مُحلّى بالكثير من ادّعاء الورع والتّقوى، استجابة لما يمكن أن نسمّيه بالحروب القذرة، تلك التي تستهدف تزييف وعي الأمم والشعوب بقضاياها المحقّة.
الخطير في الأمر، أن السواد الأعظم من مجتمعاتنا بهذا المعنى، دُفعت دفعاً لملء شواغر مسرح ما عرفه الفرنسي "جي ديبور" بمجتمع الفرجة أو الاستعراض" ذاك الذي تتحكم في أبوابه وتمتلك مفاتيح اقفاله قوى الاستعمار التي باتت تقدّم لنا المقدّس والمدنّس بصيغ معلّبة تلبّي تعريفاتها ومعاييرها ومصالحها.
الأخطر والحال هكذا، أننا بتنا نستهلك هذه المعرفة المبرمجة لخدمة الآخر النّقيض، للمسّ بأوطاننا ومقدّراتها ومشاريعها، في عالم افتراضيّ لا مرئيّ، وبواسطة أدوات تفوق قدرة الحواس، وتتمثّل الواقع بقوّة دفع هائلة لا تخضع إلا لسطوة وشروط ومادّيات ما ينتجه القويّ، من اشكال جديدة للصّحافة يدعى بعضها بـ"صحافة المواطن" بهدف هيكلة النّقاش العام وتأجيجه بغية تأطيره تحت ظلال كلّ ظّرفي وعابر ومؤقت، الذي فرضته وتفرضه مخطّطات استراتيجيّة هيّأت وتهيّئ البيئة المفترضة لتّدافْع الجزئيّ على حساب الكلّيّ بقضاياه الكبرى، فتنزاح الأخيرة أو تكاد، بفعل تطويع الإمكانيّات، وترويض القدرات، لدفع الجموع نحو التّغريد خارج السّرب، ما يفرز لنا تلاشي ما يجمع المجتمعات من عادات وتقاليد وقيم عليا، لنصطدم بما أنتجته حركة المعرفة المبرمجة هذه، من هُويّات فرديّة، أصبحت من حيث تقصد أو لا تقصد نقيضاً معادياً في بعض الحالات للهويّة الجمعيّة.
ختاماً، أعتقد أنّ الحلّ الممكن والمحتمل يوجد بيد شرائح عديدة من المجتمعات، أولها، وعلى رأسها نخب المثقفين، والصحافيّين، وهم من يمتلكون أدوات المواجهة من حيث يبرعون في فنّ التّواصل، والإرسال والاستقبال، وجمع المعلومات ومشاركتها، والقدرة المفترضة للتحليل والاستخلاص، وتوظيف المعلومة في طرح خطاب متوازن يُمكنه أن يفتح مغاليق العقول المزدحمة بالأفكار والتصوّرات المتّكئة بالأساس على العامل الأيديولوجيّ.
وهنا أيضا يمكننا أن نطرح سؤالاً لا أعتقده بات غائباً عن عقول ساسة المنطقة ومفكّريها، إلى أيّ حدّ يُضير الأنظمة الحاكمة، أن يملأ إعلامها الخاص والعام فراغات النّقاش الهائم على وجهه، عبر التّناول الجدّيّ والعميق وربّما النقديّ، لكافّة القضايا الكبرى والشّائكة والمختلف عليها، بأجندات وطنيّة، عوضاً عن تركها تسبح في بحر من نقاشات الآخرين بأجندات سياسيّة وحزبية موجّهة؟ في الإجابة عن هذا السّؤال يكمن حلّ معضلة صناعة الرّأي في عصر الرّقمنة؟