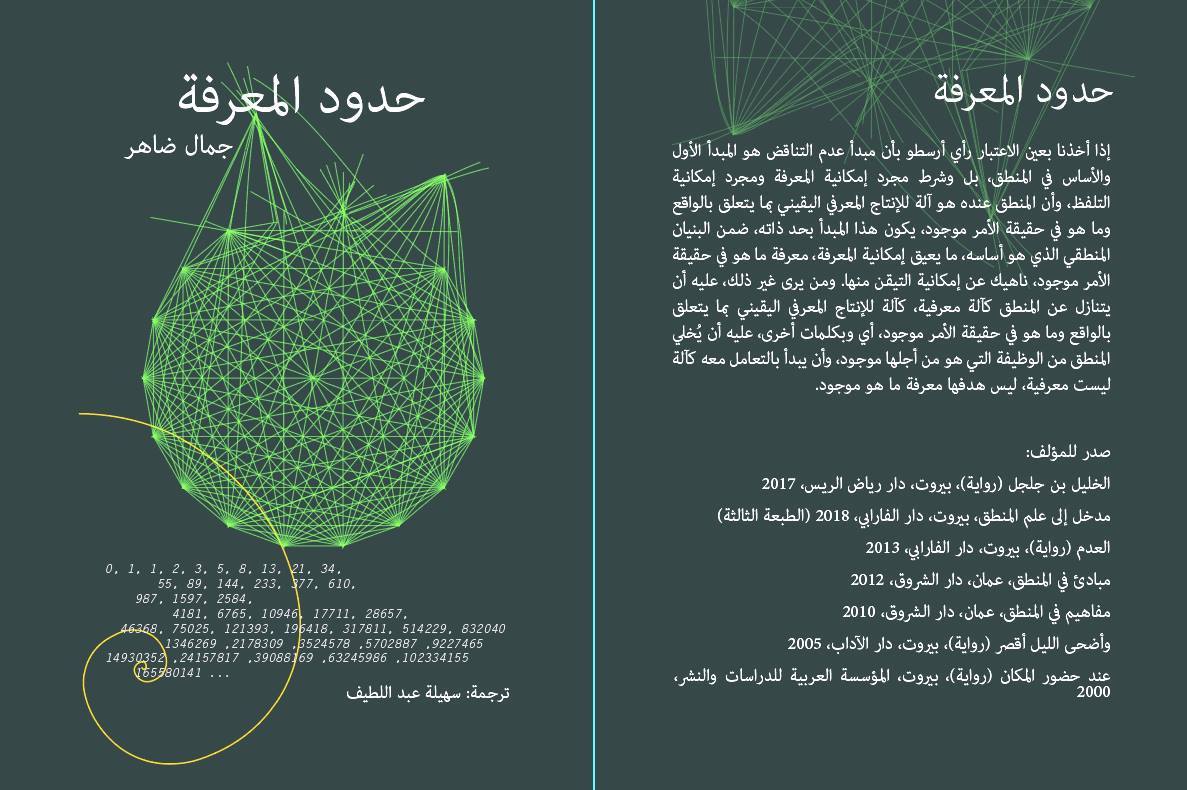إنّ النقد، اليوم، يغلب عليه الاهتمام بالمعنى، وليس بالعمل من حيث كونه أدباً، فنرى الناقد يبحث في المعاني وما قد تكون مقاصد الروائي، فلا يأخذ المركب الأدبي، الشيء الذي يجعل من العمل أدباً، مقدار ذرة من الاهتمام. لا أقول إنهم النقّاد أجمعهم لا يلتفتون إلى الجانب الأدبي، ولكنهم بغالبيتهم كذلك.
صدر للروائي الفلسطيني جمال ضاهر من الروايات: «عند حضور المكان» (2000)، «وأضحى الليل أقصر» (2005)، «العدم» (2013)، و«الخليل بن جلجل» (2017). ومن الدراسات: «مفاهيم في المنطق، أسس وقواعد» (2010)، «قواعد في المنطق: أسس ومفاهيم» (2012)، «مدخل إلى علم المنطق» (ط:3 - 2018). هو باحث في مجال المنطق وعرب ما قبل الدعوة الإسلاميّة،، رئيس دائرة الفلسفة والدراسات الثقافيّة في جامعة بير زيت، ومدير برنامج ماجستير الدراسات العربيّة فيها. آخر مؤلفاته كتاب «حدود المعرفة» الذي كان محور حديثنا معه، كما تطرقنا في سياق الحديث إلى جديده وآخر أعماله الروائية ومجمل مشروعه الكتابي الإبداعي.
ماذا يخبرنا جمال ضاهر عن نفسه؟ سيرته؟ وما الذي جاء به إلى عالم الكتب؟
لست على يقين من صواب ما سأقول؛ من الأسباب التي تجعل منا ما نحن عليه، وكيف نأخذ خطواتنا، أو، لماذا نمتنع عن طرق وإمكانات أمامنا. فالكثير منها محجوب عنا، دفين في النفس، في ظلمتها.
لم تكن حياتي مرسومة، أبداً لم أعرف الخطوات ولا أنها يوماً كانت محددة أمامي. كنت أسير وفق ما تُمليه عليّ الأسئلة وما ظننته الطريق للحصول على أجوبة لها. فقد استحوذت عليّ، عندما كنت في الثامنة عشر من عمري، أسئلة تتعلق بالقيم والمنظومة الأخلاقية، ولم تكن لدي أجوبة عنها. فالتحقت بالجامعة لدراسة الفلسفة، مُتوقعاً الحصول عليها.
ليس أني حصلت على أجوبة، ولكنها كانت بداية طريق.
آخر مؤلفاتك كتاب «حدود المعرفة»، الصادر في نسخته العربية بترجمة لسهيلة عبد اللطيف، عن "دار الفارابي" في بيروت. حدثنا عنه.
هو كتاب يبحث في حدود المنطق، القياس منه، كآلة للإنتاج المعرفي؛ يُظهر أين بإمكاننا الاعتماد عليه للتيقن مما نُنتج من معارف باستخدامه، وأين يُشكل حاجزاً أمامنا، بل وأين نكون، باستخدامه، لا نعرف إن كان ما نُنتج صحيحاً أم أنه كاذب. فالمنطق، كما كل آلة معرفية، كما الحواس كما العقل، له إشكالاته البنيوية، أي النابعة من طبيعة بنيانه وقواعده، والتي تؤثر في كيفية عمله وما ينتج عنه من معلومات. وعلينا أن نكون على معرفة وإدراك لحدود بنيانه، وإلا، فسيفضي الارتكاز عليه، في أحسن الأحوال، إلى إنتاج معلومات لا نعرف صدقها من كذبها، وفي أسوئها، سيُفضي استخدامه إلى إنتاج معلومات كاذبة، لا نعرف أنها كذلك، فنأخذها على أنها صادقة وحقيقة.
أعتقد أنه سيكون من المفيد للعاملين في المجال، أو الذين يستخدمون القياس في عملهم، أن يطلعوا عليه، فيتجنبوا الإشكالات المرتبطة بنيوياً به.

أنتقل معك للحديث عن آخر أعمالك الروائية «الخليل بن جلجل»، لأسألك كيف ولدت فكرة العمل لديك، أو لنقل ما الذي أملى عليك هذه الحكاية تحديداً؟ وهل هناك حدث معين حفزك لكتابة هذا النصّ؟
تبحث رواية «الخليل بن جلجل» في حركة الحياة ومنظومة القيم، وعندما تحضر السلطة وتسيطر الغرائز. وقد أخذتُ بالشروط التاريخية الخاصة بالقرنين الثالث والرابع للهجرة كخلفية لأحداث الرواية التي دارت بين بغداد والبصرة، لأنّ الحضارة العربية الإسلامية موضوع اهتمام عندي.
وقد كنت، في رواية «العدم»، قد تتبعت طريق متصوف، وما ساوره من أفكار وأسئلة وشكوك، لنقل: هفوات نفسه وقلبه. فقد تتبعت، في رواية «الخليل بن جلجل»، طريق رجل بسيط، همومه يومية، أرضية، وأسئلته لا تتجاوز حدود المُعاش والمحسوس، رغم أنها حياته أبداً غير مُتوقعة، أبدا ًغير مُتخيلة. هي حقيقة مُعاشة، وتجارب كانت، ولكنها ليست ضمن ما نُصادف في الظاهر، ما نرى، وما يكشف عنه الناس.
وبتسليط الضوء على شخصيات أقل مركزية، مثل شخصية "رزينة"، الزانية، أردت التأكيد على فهمي أنها الحياة مليئة، وأنها كلها أعجب من أن تكون حقيقة، أو حتى مُتخيلة.
هناك من يرى أنّ الروايات عادة ما تحمل سمات من شخصية الروائي وتعكس بعضاً من تجربته الخاصة، ما هي حدود الواقعي والمُتخيل في كتاباتك؟
في البداية، مع العمل الأول، يقوم الروائي، أو القاص، بتوظيف كل تفاصيل حياته، المُعاش منها والمُتخيل. لا أحد لا يفعل ذلك. ثم، من بعدُ، يبدأ بالنظر إلى حيوات غيره من حوله، ثم إلى حيوات بعيدة عنه. ولكنني، بقولي هذا، لا أقصد أننا نأخذ، كأنما صورة، تجاربنا أو تجارب غيرنا، بل نقوم بمعالجتها؛ كلٌ ومُخيلته، كلٌ وحدود ملكاته الأدبية.
بهذا المعنى، فإنّ جميع الشخوص الفاعلة في رواياتي، المركزية وغير المركزية، هي نسخة غير دقيقة مني، وقد تكون نسخة غريبة بعيدة عني. وبهذا المعنى، فإنّ الصالح، في رواية «العدم»، والخليل ورزينة، في رواية «الخليل بن جلجل»، هي شخوص نَسْخ عني.
كيف تتعامل مع رقيبك الداخلي أثناء الكتابة؟ ومن ثم هل تكتب بعيداً عن شروط النشر الخاضعة بشكل رئيسي لمزاج الناشر ومتطلبات سوق الجوائز الأدبية؟
في الحقيقة، لا أرى أين الرقيب الداخلي الخاص بي، لا بد وأنه موجود، ولكني لا أراه. فمن حيث مواضع الاهتمام في أعمالي الأدبية، فيها أجمعها، ومن حيث طرائق طرحها، والأسئلة التي أقوم بمعالجتها، لا أرى كيف الرقيب الداخلي يؤثر فيما أكتب. فالموضوعات المطروحة في رواية «الخليل بن جلجل» ليست حساسة فحسب، بل مُشكلة، وترتبط بأكثر الأمور تغييباً في المجتمعات بعامة، وفي مجتمعنا بخاصة، من مثل مسألة الأبوة والأمومة؛ هل حقاً، أم أنها أسطورة، كما الطفولة؟
مع هذا، لا أستطيع أن أجزم بعدم وجود رقيب داخلي، لا أراه، لا أشعر بوجوده، ولكني أعتقد أنه قابع في زاوية ينظر، يراقب، ويمنع. أما مزاج الناشر و/أو متطلبات الجوائز، فليست ضمن حساباتي؛ يوماً لم أفكر بالأمر، ولا فحصت شروط الجوائز أو النشر.

أنت تعيش في مدينة الناصرة تحت الاحتلال الإسرائيلي. سؤالي: هل استطعت من خلال كتاباتك التعبير عن كل ما تشعر به بكل حرية؟
لا أكتب في السياسة، وإن كان الاحتلال لا يُفارقنا، لا يُفارق تفكيرنا ولا شعورنا، ولا حتى تتشكل أذواقنا الجمالية بعيداً عنه؛ هو الخلفية التي نعيشها، ولكنه ليس حاضراً بوضوح في ما أكتب.
بين «عند حضور المكان» روايتك الأولى، و«الخليل بن جلجل» آخر أعمالك الروائية ما الذي تغيّر في كتاباتك تقنياً، أو على الصعيد الفني الروائي إذا صح السؤال؟
نحن نميز، عند تعاملنا مع الأعمال الأدبية من حيث كونها أدباً، بين مركبين إثنين، بنية العمل الروائي واللغة. المقصود ببنية العمل الروائي، بين الأشياء، هي علاقة الأحداث، ترتيبها في فصول، حركة الشخوص الفاعلة وبنيانها، إلخ. المقصود باللغة، هو صيغة الجملة، تركيبها، الإيقاع الداخلي الخاص بها.
إنّ بنية الرواية عندي، هي بنية حداثية، معروفة ومعمول بها. أما اللغة، فهي ما يميز أعمالي الروائية جميعها، هي ما يميز الأدب الذي أكتبه. لقد حاولت، منذ الرواية الأولى، «عند حضور المكان»، أن أستخدم لغة تتلاءم والحدث، تتلاءم والحالات الشعورية المحكي عنها. وقد عبرت الناقدة اللبنانية يمنى العيد عن تجربتها في قراءة «وأضحى الليل أقصر» بقولها: "يحتاج القارئ أن يلف رأسه ليتتبع الجملة".
جاءت محاولتي هذه لاعتقادي أنه ليس من الصواب، ولا أننا نفعل ذلك في حياتنا اليومية، أن نستخدم صيغة جملة لوصف جثة إنسان يأكلها الدود يُفتتها، وأن نستخدمها ذاتها لوصف مائدة طعام.
والمتتبع لمشروعي الأدبي، سيُلاحظ أنّ المشروع هو هو، إنما صار أقل ضجيجاً، أقل تطرفاً، وربما الفضاءات أكثر اتساعاً.
كيف تنظر إلى موضوع التجريب والحداثة في العمل الروائي؟
إذا كان التجريب لا يسبقه معرفة، ولا اطلاع ولا تمكن من أدوات، فأنا لا أعرف حقيقة علاقته مع الحداثة. هنالك فكرة سائدة بين الشباب اليوم أنّ الإنسان بإمكانه أن يقول وأن يفعل في الكتابة الأدبية ما يشاء، ومن حيث الأمر كذلك، فلا حاجة، باعتقادهم، لأن يقرأ ولا أن يكون على معرفة بتجارب غيره من التجريبيين، بل ويظن أنه لا حاجة لمعرفة قواعد الكتابة ولا أن يعرف قواعد اللغة، ما دام سيكسرها ويخرج عنها في التجريب.
إنّ التجريبية، ليس أنها لا تتناقض والقواعد، بل لا تكون التجربة تجريبية من دونها؛ وإن لم يكن الكاتب على معرفة بالقواعد، فلا يكون قد كسرها ولا يكون قد خرج عنها. وكذلك الحداثة، هي خروج عن بنية، عن قواعد وعن قوانين بناء؛ وإن كان الكاتب لا يعرفها، لا يكون حداثياً بكونه خارجها.
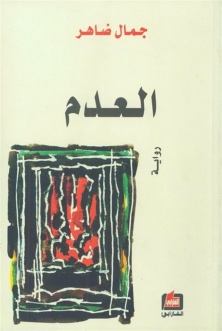
كيف ترى العلاقة بين الفلسفة والأدب؟ وبالتالي هل من رابط بين الحقلين؟
سيكون من المتعذر علينا أن نرى أدباً من دون فلسفة، أو، لنقل: أن نرى حركة أدب من دون فلسفة. فحركة الأدب في علاقة تبادلية مع حركة النقد. والنقد ليس سوى فلسفة. ولكن العلاقة بينهما ليست كما تبدو، بسيطة مباشرة، ولا أظنك تسأل عن هذا.
إنّ الفلسفة، دون سواها من العلوم، الإنسانية وغيرها، تجعل من الرؤية أكثر اتساعاً، أكثر اتساقاً، وأكثر تجريداً. لا أقول هذا لكوني في الحقل. وعندما المُنْشغل في الفلسفة يكتب أدباً، فإنّ مُعالجته لا تكون موْضعية، لا من حيث المكان ولا من حيث الزمان. فتراه يتجاوز حدود الأحداث في خلقه لها، ليضع فكرة، أو ما يُؤسس لها.
هذا هو الأدب الذي أكتبه، ولهذا، ربما، يجد الناس صعوبة في تناوله. في قولي هذا، أراني أجيبك عن سؤال لم تسأله؛ هل تكتب بعيداً عن مزاج القارئ؟
في كتابه «الأدب والشّر»، يرى الفرنسي جورج باتاي، أنّ "الكتابة شر لا بد منه". فكيف تراها أنت؟
نعم، هو كذلك. أو، لنقل: هو معاناة لا أستطيع ألا أعيشها. الموضوع لا يتعلق بالرغبات، بل بالمقدرات؛ هو أمر ليس بإمكاني ألا أفعله.
ما تقييمك لمعايير النقد اليوم في المشهد الأدبي الفلسطيني والعربي؟ وهل أعطى النقّاد تجربتك الإبداعيّة حقها؟
إنّ النقد، اليوم، يغلب عليه الاهتمام بالمعنى، وليس بالعمل من حيث كونه أدباً، فنرى الناقد يبحث في المعاني وما قد تكون مقاصد الروائي، فلا يأخذ المركب الأدبي، الشيء الذي يجعل من العمل أدباً، مقدار ذرة من الاهتمام. لا أقول إنهم النقّاد أجمعهم لا يلتفتون إلى الجانب الأدبي، ولكنهم بغالبيتهم كذلك.
لست على يقين كيف أجيب عن السؤال المتعلق باهتمام النقّاد والتفاتهم إلى مشروعي الأدبي. فالإجابة، الإجابة المحض، كلمة؛ نعم أو لا أو إلى حد ما، من ناحية، والمكان لا يتسع لإجابة أوسع، من ناحية أخرى.
لا، لم يعط النقّاد تجربتي الأدبية حقها، ربما لأنّ أدبية الأعمال الأدبية ليس من اهتمامهم. ربما.
أخيراً، ما الذي يشغلك هذه الأيام على صعيد الكتابة؟ وما هو عملك القادم؟
شارفت على إنهاء كتاب جديد، في المرحلة الأخيرة منه، يبحث في العلاقة بين الحضارة العربية والحضارة العربية الإسلامية. المقصود بالحضارة العربية هو حضارة العرب قبل الدعوة الإسلامية. أحاول أن أبين أنّ أصول الفكر والفلسفة في الحضارة العربية الإسلامية تمتد إلى ما قبل الدعوة، وأنّ حركة الفكر والفلسفة فيها بدأت قبل الدعوة، ولم تكن، كما الجميع يعتقد، بتأثير اليونان. للتأكيد، أمران: الأول، أنا لا أقول إنه لم يكن تأثير لليونان، بل أقول: إنّ المنابع ليست هناك، بل محض عربية، وأقول: لقد كان تأثير اليونان على المشروع المعرفي العربي سلبياً.
الثاني، أنا لا أتحدث عن الشعر عند العرب، واستمراره وتأثيره على ما جاء بعد الدعوة، بل أتحدث عن الإنتاج العلمي وعن آلياته، وأتحدث عن الفكر والفلسفة عندهم. وأبيّن، بالدليل، أنّ العرب، عرب ما قبل الدعوة، أنتجوا من العلم والفكر والفلسفة، ما أنتج وما لم ينتج اليونان، أو غيره، بل أنتجوا ما لم يكن باستطاعة اليونان أن يُنتج.
لا يتسع المكان لأقول في هذا أكثر، ولكن عليّ التنويه أنّ المعلومات التي اعتمد عليها في كتابي هذا متوفرة بين أيدي الجميع، إنما علينا أن ننظر فيها من زاوية لا تحكمها الآراء المسبقة.