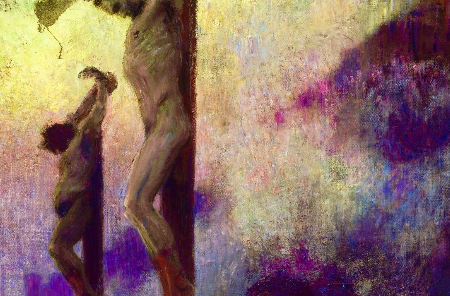ما تزالُ أوروبا إلى اليوم قادرةً على تجنّبَ دفعِ ثمن الهولوكوست من جيوبها الشخصية، وإحالةِ الثمن إلى شعوبٍ ودول أخرى، لكن هل تستطيعُ فعلَ ذلك إلى الأبد؟
لعلّ السمةَ الأوضح للقضيّة الفلسطينية في أذهان نسبةٍ كبيرة من شعوب العالم العربي أنها قضيّة سهلة. يسهلُ إعلانُ الموقفِ من القضيةِ الفلسطينية، على الرغمِ من ظهورِ تياراتٍ تُحاولُ طرحَ وجهاتِ نظرٍ مخالفة للسياق من زوايا عدّة ولأسبابٍ كثيرة، من بينِها ضرورة نزع القدسيّة وإنزال القضيّة إلى مصاف القضايا "الأرضيّة" بحيث يُمكنُ التفاوضُ لها وعليها، والمرونة تلك تحتاجُ إلى ما هو أدنى من المُقدّس ليتمّ التعامل معها بواقعيّة ووضع أهداف مرحليّة لها، قابلة للقياس والتحقّق. ولوجهاتِ نظر تلك التيّارات أسباب أخرى مثل محاربةِ النظمِ الحاكمة في المنطقة العربيّة بالتضادّ التام معها. فإذا كان اعتبارُ أنظمةِ الاستبداد العربيّ القضيّة الفلسطينية مركزيّة بغرض خلقِ مبرّرٍ لتسويف وتأجيلِ التنميةِ في بلادها، بل ونفي وتجريم أحقيّة المطالبة بالحريّة أيضًا وأولًا، ما دامَ المُحرّرُ منه ليس قوّةً خارجيّة، فإنّ المنطق يقولُ، بالنسبةِ لتلك التيّارات، أن نقفَ جميعًا ضدّ تلك الذريعةِ المرفوعةِ في وجوهنا بعصى أنظمتنا الغليظة.
وعلى الرغم من واقعيّة تلك التيّارات، أو نزوعها إلى فرض الواقعيّة حتّى على مسائل الحقّ والحقيقة، إلا أنها تتخلّى، على نحوٍ يُثيرُ الاستغرابَ والرّيبةَ، عن واقعيّتها، إذ ترفضُ أفكاراً مثل تلاقي مصالح الخصوم في مسألةٍ ما وافتراقها في أخرى. كما وترفضُ الاعترافَ بواقعيّةِ أنّ كلّ ما يجري في فلسطين هو نتيجة طبيعية لواقعِ حالِ الشّعب الفلسطيني ومسارات قضيّته المتعرّجة والدامية. تنسى تيّارات الواقعيّة السياسيّة أحيانًا أنّ واقعَ فسادِ السلطات الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة إنما يعاني منهُ الشعبُ الفلسطينيّ نفسُهُ قبل أي أحد. ولا يستقيمُ منطقٌ بجعلِ ذلك الفساد سببًا للتنصّل من الوقوف مع الشعب الفلسطينيّ لكي لا يواجه، فوق سلطته وسلطة الاحتلال وسلطات الدول المجاورة، الشعوب أيضًا! والمنطقُ لا يقول إن سوء إدارة المؤسسات الفلسطينية ينفي بالضرورة جوهريّة القضيّة (إذا كانوا يكرهون كلمة مركزية) وتأثيرها في حالِ دول وشعوبِ المنطقة، ذلك على الرغم من أنّ أنصار تلك التيّارات لا يبذلون جهدًا كبيرًا للوصول إلى الحقيقة التي لا يُمكنُ لأحدِهم إنكارها: أنّ لإسرائيل يد عليا في تحديد شكل أنظمة الحكم وآليّة الإدارة في دول جوار فلسطين والموافقة عليه.
وعلى أية حال، فإنّ هذه التيّارات رغم تناميها خلال العقد الأخير من القرن العشرين والربع الأول من القرن الواحد والعشرين ما تزال أقلّ عددًا وأضعف تأثيرًا ولم تستطع خلال ما يقاربُ الثلاثين عامًا إلى الآن أن تنزعَ عن القضيّة الفلسطينية سِمةَ السهولة.
وبالمقابل فإنّ هذا النّزوع (الذي قد يشبهُ الغيرةَ الطفولية) إلى فصلِ القضايا ثمّ خلقِ تمايزاتٍ جوهريّة بينها وبذلِ مجهودٍ في إثباتِ أحقيّةِ واحدةٍ على الأخرى، لم يكن حكرًا على شرائح من شعوب العالم العربي إزاء القضيّة الفلسطينية، بل إن العكسَ أيضًا صحيح، إذ إنّه كان موجودًا بدورِهِ عند قطّاعات ملحوظة من الشارع الفلسطينيّ تجاهَ قضايا الشعوب الأخرى، وفي الحالةِ السوريّة تحديدًا تلقّى السوريون صدماتٍ من شرائح متنوعة من فلسطينيين، لم يشكّلوا أغلبيةً طبعًا ولكنّهم لوحظوا، تجاه قضيّة الشعبِ السوريّ وانتفاضته في وجهِ نظام آل الأسد، وقد كان من بينهم كتّاب وصحفيون وشعراء وفنانون. ها هو العدوان الإسرائيليّ على قطّاعِ غزّة يُثبتُ للكلّ ما لم يكن بحاجةٍ للإثبات: الأسد لم يتحرّك لإنقاذ فلسطين، ولم يفتح الجبهات، في وقتٍ كان يُمكنُ لذلك أن يزيد المعضلة الإسرائيلية وفق رأي محللين كثر في العالم من بينهم ضباط استخباراتٍ سابقون ومسؤولون أمميون، مثل سكوت ريتر، أحد مفتّشي الأمم المتحدة عن الأسلحة النووية في العراق بين عامي ١٩٩١ و ١٩٩٨، والذي أكّدَ على ضعف القوات البريّة الإسرائيليّة، وحذّر في مقابلة تلفزيونية من أنّ الاجتياح البري لقطاع غزة سيجعلُ من أي حركة على الجبهتين السورية واللبنانية تضعُ حكومة إسرائيل، بل و"التجربة الإسرائيلية" برمّتها، كما أسماها ريتر، أمام تحدّي بقاء جدّي.
كما ولم يتحرّك الأسد لدعمِ حماس، وهو ما يُشكّلُ جزءً من ذرائع تيارات الواقعية السياسية لاتخاذِ موقفٍ "إنسانويّ" مما يجري في غزة، فيما يُشبهُ موقفَ شخصٍ ألمانيّ من القضية الفلسطينية!
يتجنّبُ دُعاةُ تحميل حماس مسؤولية ما جرى ويجري في غزّة بحجّة تجريم المسار المسلّح في الحالة الفلسطينية، أنّ فلسطين ليست محتلّةً منذُ عامين ولا بدّ من التروّي وإعطاء فرصة للمسار السلمي ليأخذ مجراه في محاولة لتقليل الخسائر وتفادي الهزيمة. يتجنّبون تاريخَ الاحتلال، ويتمّ التعامل مع كلّ القضية على أنّ حلّها الوحيد سياسيٌّ لا عسكريّ وهدفه تطبيق القرارات الدولية والعودة إلى حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧، بدون أن يرفّ لهم جفنٌ واحدٌ بإغفالهم لتسعة عشرة سنةً كاملة من الاعتداء قبل الرابع من حزيران ١٩٦٧، ولا يعتبرُ أولئكَ أنّ الموافقة على هذه الصيغة بحدّ ذاتِها إنما هي بادرة حسن نوايا "سلميّ" تمامًا يقدّمهُ الفلسطينيون في سبيل إنهاء مأساتِهم. يتناسى أصدقاؤنا أولئكَ أنّ الفلسطينيين جرّبوا كلّ المساراتِ الممكنة في سبيل نيل حقوقهم الطبيعية، بما فيها ذلك المسار الذي كان ذروة مكتسبات انتفاضة ١٩٨٧ السلمية: أي اتفاق أوسلو!
نعم، أثبتَ العدوانُ الإسرائيليّ المُستمرّ ما لم يكن بحاجة إلى إثبات، لكنّهُ بالتوازي أعادَنا إلى سؤالٍ كان أقلّ وحشيّةً فيما مضى، وأعاد قطاع غزّة طرحهُ نيابةً عن كلّ فلسطين: هل القضية الفلسطينية سهلة على كلّ العالم؟
ردود أفعال العالم على ما يجري توحي بعكسِ ذلك. نعاصرُ بأنفسِنا انقلابَ المفاهيم والتسميات، فالقضيّةُ بالنسبةِ للولايات المتحدة وأوروبا يتحوّلُ اسمُها إلى "القضية الإسرائيلية" لا الفلسطينية وتبقى فلسطين والشعب الفلسطيني "الفيل" الوحيد الذي يبرد بمفرده في غرف اجتماعاتهم، وما السُّعارُ المجنونُ الذي يصيبُ حكومات ونسبة معتبرة من شعوب هذه الدول إزاء ما يجري إلا تعبير صارخٌ عمّا تعنيه إعادةُ فتحِ الصراع على نحوٍ يجعلُ من الإسرائيليين مجتمعًا قلقاً غيرَ مستقرٍّ أو آمن، ما يجعلُ من المحتمل أن يُعيدُ التفكيرَ في قيمة المكتسبات التي يحقّقها انتقاله للحياة في الأرض المُحتلّة، مقابلَ الحياة دائمة القلق والتهديد. هل يريدُ العالمُ ذلك؟!
جُنّ جنونُ أوروبا، إعلاميّون وسياسيون، قادةُ رأيٍ ومؤثرون، أندية رياضيّة ووسائل إعلام، أسماء كبيرة تحوّلت إلى أبواق تضليل وكذب، أندية بحجم بايرن ميونخ الألماني تُحاسبُ لاعبًا مغربيًا أعلنَ تضامنَهُ مع أهل غزّة، فرنسا تضعُ "قيمَ الجمهوريّة" جانبًا وتمنعُ المظاهرات المتضامنة مع غزة بالقوة، فيخرج وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ويتّهم اللاعب الفرنسي الجزائري الأصل كريم بنزيمة بأنه ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين على خلفيّة إعلان الأخير تضامنهُ مع ضحايا غزّة.
يُدينُ الغربُ (وبعضُ سكّان الشرق عربًا وغير عرب) أيّ تضامن مبنيّ على الرابطة الدينية الإسلاميّة، بعضُ العرب يرون أنّ التضامنَ مع الفلسطينيين يجب ألا يرتبطَ بوشيجة الدين، فالحيفُ واقعٌ على الكلّ في الأرض المحتلة، وهذا صحيح. غير أنّ أيًا منهم لحظة إدانتهِ تلك، يتجاهلُ أنّ دولةَ الاحتلال برمّتها، بل ومشروعُها ونظريّتُها وسلوكُها إنما هو قائمٌ على أساس الدين!
حملات الكذب والتحريضٍ الغربية هذه يشاهدها العالمُ بأسرهِ على الهواء مباشرةً، ففشلُ "التجربةُ الإسرائيلية"، بتعبير سكوت ريتر، ناهيك عمّا يعنيهِ من احتماليّة استغناء اليهود الصهاينة عن الحياة غير الآمنة والعودة إلى دولهم (لا ننسى أنّ ملايين منهم يحملون جنسيةً أخرى) وزيادةِ الضغط على حكوماتٍ لديها مشاكل كبرى في الاقتصاد والتنمية وقضايا محليّة شديدة التعقيد مثل التنمية وصعود اليمين وأزماتِ المهاجرين وقضايا الاندماج، يُضافُ إليها التهديد الحقيقيّ الذي يحيطُ بتجربة "الاتحاد الأوروبي" برمّتها، والتي كان ثمّة دلائل كبرى على أنّها تقفُ على خيطٍ رفيعٍ يُخشى أن ينقطع، لا سيّما إذا كان الخصم السياسيّ، روسيا الاتحادية يملك رئيسًا من قبيل فلاديمير بوتين، رجلُ الاستخبارات العنيد والطموح، والمستعدّ للإجرام لأجلِ طموحِهِ في أيّ وقت!
ما تزالُ أوروبا إلى اليوم قادرةً على تجنّبَ دفعِ ثمن الهولوكوست من جيوبها الشخصية، وإحالةِ الثمن إلى شعوبٍ ودول أخرى، لكن هل تستطيعُ فعلَ ذلك إلى الأبد؟