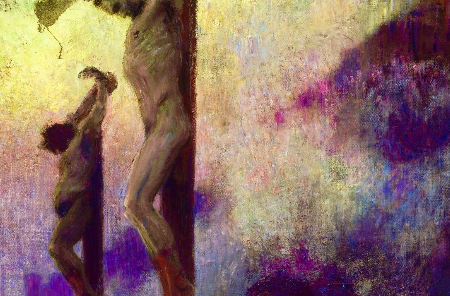في ٢٧ يناير ١٩٤٥، حرّر الجيش الأحمر السوڤييتي معسكر أوشڤيتز النازي، في بولندا اليوم، لتُكتب الحياة مجدّداً لمعتقليه، وكان غالبيتهم من اليهود. وكان ذلك، قبل ٧٧ عاماً تماماً، واحداً من علامات اقتراب النهاية بتحرير الجيش الأحمر نفسه لمدينة برلين في معركة استمرت من ١٦ إبريل إلى ٢ مايو من العام نفسه.
حتى اليوم، بعد ٧٧ عاماً من إنهاء مأساة أوشڤيتز، وغيره من معسكرات الاعتقال المنتشرة في أوروبا كآثار تركتها النازية خلفها، نجد استعادات لهذه المناسبة للتذكير بمأساة عرف أصحابها، اليهود، كيف يبقونها راهنة ومتجدّدة، ومفيدة إذ ربطها العديد منهم بالصهيونية، ما جعل الأخيرة شرطاً للخروج من الأولى، أي من اضطهاد اليهود (اللاسامية)، وجعل اللاسامية هذه، وهي مشكلة أوروبية حصراً، مصطلحاً غير تاريخي، فأدمجه بذلك، اليوم، مع مناهضة إسرائيل كدولة احتلال، وهي الحالة الاستعمارية الأوروبية الوحيدة المستمرة حتى يومنا.
لن يهمّنا هنا هؤلاء، فما يفعلونه يتماشى مع الإيديولوجية الصهيونية، بالتالي لن نتوقع منهم غير هذا الدمج. لكن، نحن من يتوجّب عليه، في المقابل، عدم الدمج بين مأساة اليهود من جهة والمشروع الصهيوني من جهة ثانية، لأسباب عدّة قد تكون أكثرها مباشرة وبساطة "ووطنية" (وأقلها إنسانية!) أنّنا المتضرر الثاني، بعد اليهود، من المحارق النازية التي كانت المبرر التاريخي الأساسي لقيام إسرائيل على أرضنا. علينا، أساساً، وفوق ذلك، أن نتعلّم منهم، من "شطارتهم" في ما كنّا خائبين فيه.
من هنا أنطلق، وفي مناسبة تحرير معسكر أوشڤيتز، إلى مسائل ثلاث مرّت عليّ في الفترة الأخيرة، نتعلّم منها، من اليهود، كيف نبقي حكايتنا، روايتنا، مأساتنا، أو بمفردتنا الخاصة: نكبتنا، حيّة بالشكل الذي أبقى فيه اليهود مأساتهم في المحارق النازيّة، حيّة إلى اليوم.
في برلين هذا الصيف، عصراً، كنت أتمشى دون خارطة، أضيع، متقصّداً، بين الأبنية والشوارع، خرجتُ من بين أبنية رمادية وضخمة، قيل لي بأنّها من الحقبة النازية، خرجتُ إلى عمل فنّي مبهر، مفروش على مساحة واسعة (١٩٠٠٠م)، قوالب كونكريت كأنّها توابيت بارتفاعات متباينة، اقتربت لأعرف أنّها ساحة "النصب التذكاري لضحايا يهود أوروبا" (هكذا مكتوب بنشرتهم العربية، "ضحايا يهود أوروبا" وليس "الضحايا من يهود أوروبا"، ما قلب المعنى)، وأن أسفله ما يشبه المَتحف. جلتُ بنظري فوجدت العلم الإسرائيلي مرفوعاً على مبنى مجاور. قبل ذلك بيومين حاولت البحث في "غوغل مابز" على متحف للهولوكوست في المدينة ولم أجده. يومها، وجدته صدفة. لم أبال بالعلم، اقتربت من المدخل أقول لنفسي بأني لن أدفع لهم كي أدخل. عرفت أن الدخول مجاني، براڤو لليهود. دخلت.
ليس في المكان سوى حكايات، كتابات وصور وڤيديوهات وخرائط، حكايات وحكايات أكثر، قد لا يحوي المتحف حكايات لأكثر من خمسين شخص، لكنّها فردية، شخصية، ولا تُقدَّم هنا كحكايات جماعية معمّمة تائهة بلا ملامح ولا أسماء. هنالك أسماء وأعمار وتفاصيل حياتية وصور شخصية وعائلية، قد يقضي أحدنا ربع ساعة أمام تفصيل بسيط من حياة أحدهم، يقرأ في مذكّراته ورسائله، أو ينصت إليها مقروءة، يدخل في عالمها وقد يخرج من المتحف بحكاية صغيرة، واحدة فقط، إنّما تبقى عالقة أكثر من الحكايات الجمعيّة الصالحة لأن تُطبَّق على آلاف الأفراد، والمأسطَرة بالتالي، فتكون أقرب للخيال منها للواقع، والتي تُخرج متلقّيها، أخيراً، بلوحة ضبابية في ذهنه، تتلاشى إذ لا تفاصيل تثبّتها، كالمسامير، هناك.
قبل أشهر قليل من اليوم، شاهدت فيلم «المحرقة» (Shoah . 1985) للمخرج الفرنسي الصهيوني كلود لانزمان. يُعتبر الفيلم من أبرز المراجع عن الهولوكوست، كما يُصنَّف من أفضل الأفلام الوثائقية تاريخياً، لقيمته التوثيقية فقط كما أعتقد، فلا قيمة فنية أو جمالية له إذ أنه مبني على شهادات، وفقط شهادات.
تزيد مدة الفيلم عن عشر ساعات، كلّها شهادات، حكايات شخصية يرويها أصحابها أو جماعية يرويها شهود، بأسماء أمكنتها وأشخاصها، وتواريخها. يتنقّل المخرج بكاميراته من ألمانيا إلى بولونيا إلى دولة الاحتلال، ليوثّق ما يقوله النّاس، وقلّما يقاطعهم. يخرج أخيراً بفيلم هو اليوم، وسيبقى دائماً، من المراجع الأهم لمأساتهم، وقد صوّره مع معاصرين للحدث، أي بعد أقل من ٤٠ عاماً فقط من زمن المحارق.
قبل أسابيع قرأت رواية «دورا بروديه» (Dora Bruder . 1997) للفرنسي باتريك موديانو. لم تُترجم إلى العربية، لا يهم. هي رواية واقعية تماماً، إذ تسرد أحداثاً حقيقية تماماً، بتفاصيلها كما هي في الكتاب. لا خيال أبداً في الرواية، وقد أكّد موديانو ذلك.
تحكي الرواية عن بحث الكاتب (نوبل للأدب . ٢٠١٤) عن فتاة اسمها دورا بروديه بعدما قرأ إعلاناً في صحيفة قديمة يشير إلى أنها مفقودة وأن والديها يبحثان عنها، وذلك عام ١٩٤١، أثناء الحملات النازية لاعتقال اليهود وترحيلهم إلى معسكرات الاعتقال.
دورا مخلّدة اليوم، وهذه حكاية واحدة، واحدة فقط لضحية واحدة للمحارق النازية. في الرواية عدّة أزمنة، يسرد فيها موديانو بحثه، أو تحقيقه، عن هوية دورا، ليدخلنا في عالم من العبث الذي كان آنذاك. لا وحشية تُذكر في الرواية ولا وصف لمعسكرات أو لمحارق أو لغيره، بل فقط لمحاولات موديانو، التي بدت كافكاويّة، في التعرّف على اسمٍ واحد، راح أخيراً مع ملايين الأسماء الأخرى ليهود آخرين، ذكر موديانو في روايته رسائل بعضهم الموجّه إلى مسؤول الشرطة في باريس، بأسماء وتواريخ محدّدة، تسأل عن أبنائها وآبائها.
روايات موديانو وجائزة نوبل خلّدوه، وهو خلّد دورا، الفتاة التي سيقرأ عنها الكثيرون وسيعرفون من خلالها واحدة من الحكايات الكثيرة عن ضحايا النازية من اليهود. واليوم، اسم دورا بروديه، الفتاة التي رُحّلت إلى أوشڤيتز، صار اسمَ ممشى في باريس، يقول موديانو في افتتاحه بأن "دورا بروديه صارت رمزاً".
نحن، ألا نحتاج لمتحف نسرد فيه حكايات شخصية جداً، فردية جداً، بعيداً عن السردية الجماعية لشعب تمّ تهجيره؟ ألا نحتاج لشهادات مصوّرة في فيلم طويل جداً، لمن تبقّى ممن عايشوا النكبة؟ وقد تأخرنا جداً في ذلك، بعد ما يقارب سبعين عاماً. ألا نحتاج روايات تسرد بشكل حكائي/توثيقي حكايات حقيقية جداً، شخصية جداً، فردية جداً، بعيداً، مجدداً، عن السردية الجماعية لشعب تمّ تهجيره، وإضافةً لها؟
سيُقال: كُتب وصُوّر الكثير. سأقول بأنّه قليل، وأنّه ليس شخصياً وفردياً كما يجب، وأنّه غير منتشر (بالمرّة) عالمياً، وأنّ بعضه "رفع عتب"، وأنه، وأنه، وأنّنا، لستُ أكيداً، إن كنّا جديرين بنكبتنا.