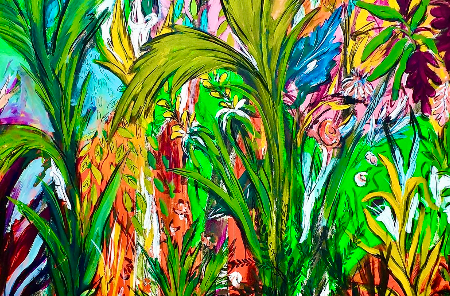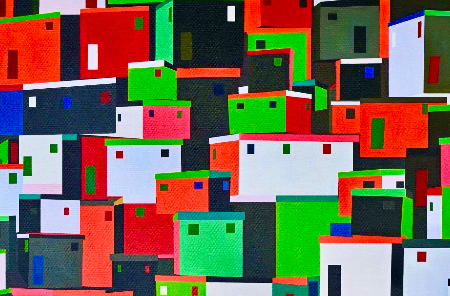وبقي الناس يحتفلون بالربيع، حتى مع تغير معتقداتهم. عندما اطلع الغربيون على حضارات الشرق القديم، في بدايات القرن التاسع عشر، من خلال آثارنا المتناثرة في الصحارى، هالهم ما قدمته بقايا الأحجار البريئة. فقد اكتشفوا قيامات الآلهة تلك،
في الشوارع، والبيوت، ومحلات الزهور، والحدائق، والبقاليات، وسلاسل السوبرماركت، ينتشر في السويد نوعٌ شائعٌ من أزهار الربيع، يُسمّى بالسويدية زنبق الفصح. يشتريه الناس احتفالاً بالربيع، ويرعونه، ويتفاءلون به. ولكنه ليس زنبقاً، بل نرجس أصفر، واسمه الشائع بالإنكليزية، النرجس البري، على الرغم من أنه ليس برياً فقط؛ أما اسمه العلمي، فالنرجس الكاذب، على الرغم من أنه نرجس حقيقي. ينحني زهره، ليحدّق في الأرض؛ لا يسمو عالياً، كالتوليب والأقحوان والورد. ويبدو تاجه الشهير، داخل بتلاته، مكتفياً بذاته، راضياً، وادعاً. البتلات، والتاج الذي يميز النرجس، والأَسْدية، كلها صفراء، بتدرجات خفيفة. لا أعرف كيف اقتنص لنفسه اسماً لا يشبهه ولا يعنيه. هل لأن اسماً، مثل نرجس الفصح، لن يكون شاعرياً، كزنبق الفصح؟ لا يبدو أن السويديين يسألون أنفسهم ذلك السؤال، بل يكتفون بنشر أريجه في كل مكان، حتى يصبح الأصفر لونَ الفصح، لون المسيح، لون الربيع.
وعيد الفصح، في جوهره، يمثّل عودة الإله القتيل، كما في عودة تموز وأدونيس وبعل، كي تحيا الأرض، وتخضوضر الروح. ولكن المسيح، على العكس من تلك الآلهة، بعد أن قام للمرة الأولى (الغنوصيون لم يؤمنوا بذلك) سيعود في آخر الزمن كي ينهي كل الأزمان، وينهي دورة الفصول. وعلى أية حال، يطابق الاحتفال السنوي بالفصح الاحتفالات القديمة في شرقنا، ويقتبس منها. في بعضها، يجلد الناس أنفسهم بقسوة، مستذكرين مقتل إلههم؛ قسوة سيستعيدها بعض الكاثوليك والشيعة بأشكال مختلفة في احتفالاتهم ومهرجاناتهم. وليس من الضروري أن يكون العيد مترافقاً مع القتل. عيد النوروز، أو رأس السنة الفارسية، أحد أشكال الاحتفال بعودة الربيع، بدون آلهة مذبوحين أو مختفين، وقد انتشر بين الفرس والكورد وقبائل الترك وغيرهم من شعوب المنطقة. كمعظم سكان مشروع دمر، ودمر البلد، وقدسيا، أتذكر جيداً رائحة إطارات السيارات المحترقة، وطلقات نارية متفرقة، تأتي من "جبل الرز"، حيث يتجمع فقراء الأكراد القادمين إلى العاصمة دمشق من الجزيرة السورية، في محاولاتهم السنوية للاحتفال بالعيد، والشرطة تحاصر مداخل الجبل ومخارجه، عاجزةً أمام روائح الحريق وأصوات الأغاني.
وبقي الناس يحتفلون بالربيع، حتى مع تغير معتقداتهم. عندما اطلع الغربيون على حضارات الشرق القديم، في بدايات القرن التاسع عشر، من خلال آثارنا المتناثرة في الصحارى، هالهم ما قدمته بقايا الأحجار البريئة. فقد اكتشفوا قيامات الآلهة تلك، بل أن العهد القديم بأكمله قائم على الأساطير السومرية والبابلية والأوغاريتية والفرعونية والزارداشتية: الطوفان، وولادة موسى، والتوحيد، ونشيد الأنشاد، وغيرها. بهذا تفكك العالم الذي آمنوا به كلياً: بعد كوبرنيكوس وغاليليو، ثم داروين، وأخيراً أساطير الوثنيين القدامى. ومن خلال كل ذلك، اتضح أن اليهود شكلوا أحد فروع الكنعانيين المتجدّدة بعد انهيار العصر البرونزي، المتلاحمة مادياً وفكرياً مع محيطها الواسع. وقد دعانا الشاعر الفلسطيني زكريا محمد لربطهم مع ذلك المحيط، ولتمييزهم بوضوح عن الصهيونية. سيتلقف العرب الأساطير القديمة، ليفخروا بها ليل نهار، وليجادلوا بأنهم مهد الحضارة. يتشكك المرء كثيراً في صلتنا اليوم بأجدادنا، وفي فكرة القومية التي تستند على التاريخ العريق الموغل في القدم. وقد استوطن النرجس أراضي أواسط آسيا وحوض المتوسط منذ أقدم العصور، ومنها انتشر شمالاً وشرقاً وغرباً، كما انتشرت منها الأحرف الأبجدية، واستخدام الحديد، وفكرة الدولة.
النرجس الأصفر لا يشبه النرجس الأبيض، الأكثر انتشاراً في سوريا؛ الثاني محتشمٌ رزين. وقد أحب الشاعر الألماني غوته اللون الأصفر، وتعلّق به، لون الشمس والنور والضياء، وتبعه في ذلك الرسام الإنكليزي جوزيف تيرنر. تكاد لوحاته تصبح ما ورائية، رمزية، تجريدية، خصوصاً في مرحلته الأخيرة. ولكنها ليست كذلك. في الحقيقة، رسم ما رآه: أصفر يغطي كل شيء. وهذا سرها، هذا ما يميزها عن حداثة القرن العشرين المجرّدة. في حين وصف فاتح المدرس اللون الأصفر، في الوثائقي المدهش الذي أعدّه ثلاثة مخرجين معاً - عمر أميرلاي، ومحمد ملص، وأسامة محمد-، باللون "الشرشوح"؛ ومال إلى الأزرق، والأحمر. العفوية والصدق فيه تكاد تعيد تعريف فكرة الوثائقي: دردشة طويلة، بلا ادعاء، عن سوريا، والألوان، والعائلة، في بيته في مشروع دمر. كذلك هوكوساي الياباني أولع بالأزرق، تحديداً تلك الدرجة الجديدة منه القادمة من هولندا البعيدة وتقنياتها الأوروبية. زميله الأصغر سناً، ومنافسه، هيروشيغه، فضّل الأحمر. ويظهر يسوع في بعض اللوحات الهندية باللون الأزرق، كإلههم الأصلي فيشنو؛ وفي إفريقيا، أسود؛ وفي الغرب، أشقر؛ وفي بدايات الفن المسيحي، متأثراً بفنون الفراعنة أو الآراميين أو اليونان، يظهر بكل الأشكال التي احتفى بها هؤلاء. إذ يتلوّن المسيح بحسب مشاعر المؤمنين به. ولإليا ريبين، الرسام الروسي الأشهر، الذي ولد في أوكرانيا وتوفي في فنلندا، لوحة ساحرة عن قيامة يسوع بعنوان "الجلجثة": لا يظهر فيها إلا الصليب الفارغ، وكلبان يلعقان الدم على الأرض. على العكس من كل لوحات يسوع، التي تصوّره في عذابه، أو في شبابه الغض، يبدو غيابه أكثر قدرةً على الوصول إليه: كأن الغياب قيامةٌ، أو موتٌ، أو أي شيء آخر، يهجس به المتلقّي. بالمقابل، لم يظهر النبي محمد في الرسوم، إلا في بعض المنمنمات الفارسية والعثمانية. لا يبدو فيها وجهه واضحاً، ولا تتميز ملامحه عن الآخرين؛ فقد جرت الأعراف ألا يهتم فنانو المنمنمات بالوجوه، بل بالأحداث وحركات الجسد وتركيب اللوحة وألوانها.
أدندن لنفسي، مع حسين نعمة، في برد الربيع: "عمي يا بياع الورد". للأسف، لا يوجد الكثير من شعر الطبيعة في تراثنا، إذ لم يكن شعراؤنا مولعين بها، بل بالفخر والهجاء وسخافات أخرى. حتى المعري وأبو نواس لم يلتفتوا إليها. لدينا حفنة أبيات شهيرة، عن الربيع وزهره، خطها البحتري وابن زيدون وابن الرومي، فقط لا غير. ولكن بيرم التونسي قدّم رؤيته الباهرة للبنفسج، التي ترجمها رياض السنباطي لصوت صالح عبد الحي، في أغنية لا تشبه شيئاً مما اعتدنا عليه في علاقة العرب بالطبيعة، أو بالأغاني؛ كأنهم قرروا أن يجسدوا ذلك البعد التراندستالي للفن، البعد الذي يخرق أسوار العالم المادي، بحسب كنط وشوبنهاور: "والعين تتابعك، وطبعك، محتشم ورزين". أما النرجس البري، فليس محتشمٌ تماماً، ولكنه أقل ادعاءً من الورد الجوري، المنتشر في سوريا، الذي غنّى له صباح فخري: "الورد الليليّ اللون في الحي الوادع، والزنبق...". وقد سمّى بيتهوفن سوناتا الكمان والبيانو رقم خمسة بسوناتا الربيع. وفي سمفونيته الرعوية، تكاد تنطق النسمات. لا يشبه هذا ما اشتُهر به، من عالمه الشخصي الفردي، وارتباطه بالتنوير والثورة الفرنسية، ومشاعره الجياشة العاصفة؛ ولكنه يقترب من الرومانسية، التي شكل الموسيقار العبقري حدها الفاصل عن الكلاسيكية. عادت الرومانسية إلى الطبيعة، واختلطت هذه العودة مع كراهية العلم والعقل والتنوير. وفي اليابان، طبعوا دواوين أشعار الهايكو مقسمة إلى فصول السنة. بالطبع، الربيع يحتل المكانة الأولى، والأهم. ولكن، على الدوام، يكون سريعاً، مارقاً. يستشعر المرء أن موهبتهم تتجلى في قصائدهم الخريفية، لا الربيعية. في قصيدة هايكو، يلخّص الشاعر بوسون كل احتفالات البشرية بعودة الحياة الدورية:
في غسق الربيع،
بعيداً عن درب البيت
ناسٌ يسرحون.
الجو ماطر، والربيع هنا باردٌ متكّلف ممل. مع ذلك، تمتلئ مسرحيات أوغست ستريندبرغ وأفلام إنغمار برغمان بإشارات لقدوم الربيع، كأنهما آمنا فعلاً بأن الحياة دوراتٌ لا تنتهي من فصول تتعاقب. هل يتعلق الأمر فقط بحساسيتنا للطقس؟ أليست هذه الإشارات خادعة مخاتلة؟ احتفت المجتمعات الزراعية ما قبل الصناعية بعودة الربيع، لأن الحياة، مهما كان شكلها، قائمة على الحصاد. تأتي جيوش، وتختفي أخرى. تُرتكب مجازر باسم الدين والحضارة، ويتبارى أباطرة وملوك وسلاطين على مجد زائف. كل هذا يجري في الخفاء؛ لا تراه الطبيعة، والأرياف تعود إلى حياتها مباشرةً بعد أن ينقشع غبار المعارك. ولكن، بعد الثورة الصناعية، أصبحنا بيادق في أيدي الرأسمالية: لا الفصح، ولا عيد الأضحى، ولا رأس السنة الصينية، سيخرجنا مما نحن فيه.
في الشوارع، والبيوت، والمقاهي، ومداخل البنايات، والمحلات، ينتشر النرجس الأصفر. على مدخل بنايتي، عشرات منها. أدنو إليها. أتفحصها. أتذكر جدتي. كانت تفرح بالفصح، كأنها طفلةٌ في بيت جدها. قالت لي إن بيض الفصح لم يكن من عاداتهم في طفولتها. جلبه الانتداب الفرنسي، مع أشياء أخرى، إلى سوريا. أتردد. هل أقطف زهرةً؟ قالت إن الأعياد كانت أبسط، أجمل، أكثر حميمية. تهتز الزهرة. الريح قوية هذا الصباح. خلفي طفلان يراقبانني. لم تأخذني إلى الكنيسة إلا مرتين أو ثلاث. كانت تدرك جيداً أنني مسلمٌ. أنحني مرة أخرى. ألمسها. الأصفر ليس من ألواني المفضلة. يقترب الطفلان. يتهامسان باللغة السويدية. ولكن جدتي فعلت كل ما بوسعها كي أفرح بالفصح. أقف، وأنظر إلى الشجرة أمامي. صفصاف. أغصانها خضراء مصفرّة، كأن مصيرها لم يتقرر بعد. أحبت جدتي الفصح لأنها أحبتنا؛ أحبت العائلة، والأطفال، والمرح. هذه قيامة يسوع، بالنسبة لها. يقطف الطفل الأصغر زهرة. تنهره أمه من بعيد. دائماً أزرو الكنائس، للسياحة، في أسفاري؛ ومرات نادرة، في المدينة التي أعيش فيها. وبمناسبة الفصح، اشتريتُ أرنب شوكولا كبير، رخيص الثمن، منصاعاً لعادات السوق، كما يفعل الجميع في هذه البلاد. حبّات بَرَد تبدأ بالتساقط، تجلد الأرض بقسوة. يركض الطفلان إلى أمهما، وأنا أسرع الخطى إلى بيتي. هذه السنة، أيضاً، سأمضي الفصح بعيداً عن أهلي. صوت رعد يهزّ السماوات المصمتة البعيدة؛ ولكن لا برق، لا برق في الأفق!
يرمي الطفلُ النرجسَ الكاذب على الأرض، يدوس عليه؛ يضحك. ثم يختفي، تحت وابل المطر والبَرَد والريح...