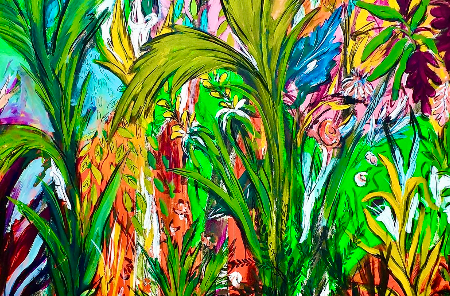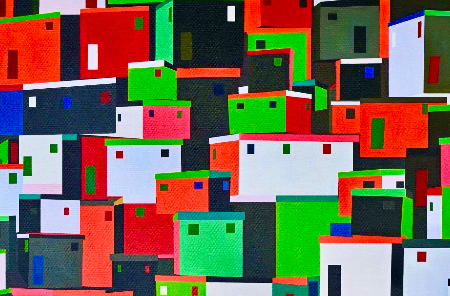"نحن لا نحب أن نسمى لاجئين. نسمي أنفسنا الوافدين الجدد أو المهاجرين".
هكذا تبدأ المفكرة الألمانية اليهودية حنّا أرندت مقالة مطولة بعنوان "نحن اللاجئين"(*)، ترجمها فتحي المسكيني، والتي تشتبك فيها مع واقع لحظة ترك اليهود ألمانيا وانتقالهم إلى أمريكا وبلدان أوروبا الأخرى في خضم الحرب العالمية الثانية.
تخبرنا أن اللاجئ هو شخص دُفع من أجل البحث عن ملجأ بسبب جرم ما ارتكبه أو بسبب رأي سياسي. لكن هذا لم يكن حال الكثير من اليهود في تلك اللحظة. والأمر نفسه ينطبق على السورييين اليوم. فأغلب من دُفعوا لترك بيوتهم والنزوح إلى البلدان المجاورة أو الغربية كانوا أناسًا عاديين، لم يكن لهم أي دور سياسي في التطاحن الواقع بسوريا في اللحظة الحالية.
يبدو اليمين الأوروبي في اللحظة الحالية (ليس فقط كأحزاب أو أيديولوجيات، لكن كممارسات فردية لا تبعد كثيرًا عنها) أنه يسير بميكانيزمات تفاعلاته مع أكبر حركة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، بشكل يتقاطع ويتقارب مع السياق الذي أنتج النازية وتفاقماتها التي اضطرت إلى هرب الكثيرين من ألمانيا هتلر.
لا جدوى من حديث عمّا كان يجب أن تفعله الأنظمة في الشرق الأوسط للحدّ من تفاقم الوضع السوري عامة، واللاجئين على وجه أكثر تحديدًا. فلن يقطع المرء البحر بطريقة يبدو الموت فيها ملاصقًا لكل خطوة يخطوها في نزوحه، لو كان في إمكانه الحصول على الحد الأدنى من كرامة العيش في أي بلد مجاور، دون التعرّض مجبرًا لصعوبات اللغة والثقافة والعنصرية التي تستفحل بلا توقف في أوروبا.
على الناحية الأخرى، ضفّة اللاجئين على تنوعاتهم، ومع إدراك لحقيقة أن حديث جمعي عمومي عنهم هو وقوع في فخّ يقترب من طريقة التعامل "الأوروبية" في أغلب أوجهها معهم أيضًا. ثمة ملاحظة تحتاج لتأمل على نواحي عدة حول كون البعض ممن قُبِل طلب لجوئه أسرع من الآخر، أو حظى بتسهيلات لم يحظ بها غيره، يتحول بصورة ما إلى صياغة عملية للمقولة الإنجليزية "ملكيون أكثر من الملك". ويصبح الحديث عن المصاعب التي واجهوها حتى قبول لجوئهم، أو ما يقابله غيرهم من تعنّتات على طرق مختلفة ملفوفاً بالتذمّر على نحو ما. وكأن هناك شيء ما في عمق الوجداني للاجيء الآخذة حياته في الاستقرار في البلد الجديد، يخبره بأن عليه أن ينسى.
لا يخص الأمر السورييين وحدهم، حنّا أرندت من جديد تخبرنا عن هذا: "قيل لن ننسى. نسينا بشكل أسرع مما يمكن لأي كان أن يتخيل. وبطريقة ودية تم تذكيرنا بأن البلد الجديد سوف يصبح موطنًا جديدًا. وبعد أربعة أسابيع في فرنسا وستة أسابيع في أمريكا ادّعينا أننا فرنسيون أو أمريكيون. بل إن أكثرنا تفاؤلًا أرادوا حتى إضافة أن حياتهم السابقة بكاملها قد مرّت في نوع من المنفى غير الواعي.. وأن بلدهم الجديد هو وحده الذي علمهم الآن ماذا يكون الموطن حقًا"
ثمّة حديث دائم في الغرب حول ضرورة الاندماج. لكن هل يعني هذا، الاندماج مع أي شيء وكل شيء؟
"لم يكن الاندماج يعني التكيف الضروري مع البلد الذي أصبحنا فيه. بل نحن مدفوعون للتكيف من حيث المبدأ مع أي شيء وأي شخص."
لكن إلى أي حد يمكن أن يحدث هذا الاندماج؟ فكرة اللاجئيين نفسها وما تأخذه من معنى آخر حول جرأة العبور من مكان لآخر دون أوراق ثبوتية أو تأشيرات أو أي من القيود التي وضعتها الحكومات ، تحمل في طياتها اشتباكاً مع فكرة الاندماج بالمفهوم المتداول.
اللاجيء بالأساس يعبر ومعه ما أتى به من المكان الآخر، هو يغيِّر شكل الديموغرافيا على الجانبين: الآتي منه والذاهب إليه. وإن في لحظة ما يحتاج لانصهار ولو جزئي مع إيقاع المجتمع الجديد إلا أن هذا لا يعني بالضرورة طمس شخصيته بالمعنى الأكثر اتساعًا للكلمة.
والشخصية هنا ليست حول شابة سبّاحة تذهب للأولمبياد، وليست حول طفل ملقى على وجهه ميتًا على الساحل التركي، أمر الهوية ليس حول أن تجد الصحافة حكاية تروِّجها وتبرزها، بل حول الحق في أن تحصل على اعتبارك كإنسان بالأساس، بغض النظر عمّا يميزك فردانيًا.
فالأمر أحيانًا يكون كما تقول أرندت من جديد: "في هذا العالم المجنون، يكون المرء مقبولًا لكونه رجل عظيم، أكثر من أن يكون مقبولًا لأنه كائنًا إنسانيًا".
(*) Hannah Arendt, “We Refugees”, in: Altogether Elsewhere: Writers on Exile, Edited by Marc Robinso (Boston /London: Faber & Faber. First Edition, 1994), pp. 110-119