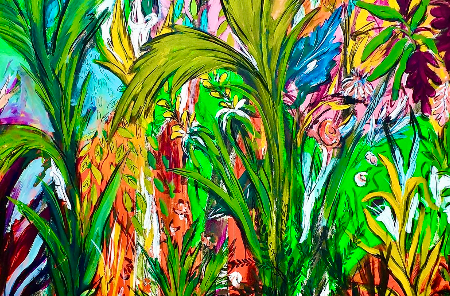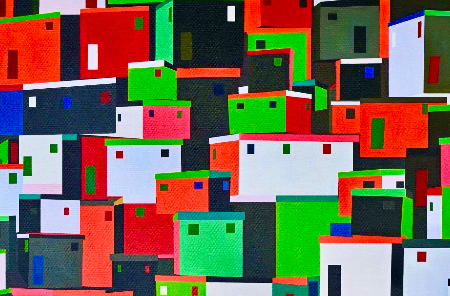عندما دخلت أوروبا عصر الطباعة الورقية في القرن الخامس عشر، شعرت الكنيسة الكاثوليكية بالتهديد، وبأن الحاجة لفرض رقابة على الأفكار المطبوعة، باتت أكثر إلحاحاً. فأحكمتْ قبضتها على الجامعات الأوروبية بما في ذلك السوربون، وأعلنت أن ما من منشور سوف يطبع إلا بعد موافقة السلطة الدينية عليه. بعدها افتتحت فرنسا تقليداً جديداً من الرقابة. فأصدر الملك شارل التاسع عام 1563، قراراً يقضي بمنع طباعة أي كتاب إلا بعد موافقته شخصياً. الملك الفرنسي كان أول رقيب، يجاهر بتوليه هذه المهمة، مسلحاً بالسلطتين الدينية والعسكرية. وسرعان ما حذت دول أوروبية أخرى حذوه. فمنعت كتب وصودرت وأحرق مؤلّفوها في بعض الأحيان وهم على قيد الحياة. قرار ملك فرنسا كان حجر الزاوية لنشوء المؤسسات التي تتولى اليوم رقابة الكتب والمطبوعات كافة ثم المنشورات المصورة، بما في ذلك الصور الفوتوغرافية والرسوم الكرتونية، قبل أن تنضم الرقابة السينمائية، وأخيراً الإلكترونية إلى هذا النادي. ويبقى أن ما فعله الإسبان بإحراقهم مخطوطات شعب المايا، ضمن ما مارسته محاكم التفتيش، هو أسوأ الجرائم في هذا السياق.
لم تخلُ المجتمعات اليونانية القديمة من الرقابة التي زعمت أن هدفها آنذاك، كان نحت شخصية المجتمع. أي جعله أشبه بقطعة خشبية ملساء، لا نتوءات حادة فيها. ولعل سقراط، أشهر من حوكم - وليس أولهم - ليقرر بدلاً من الفرار، أن يحاضر أمام تلامذته لمرة أخيرة، وهو يجرع السمّ مجبراً ويموت. كانت أسئلة سقراط، خروجاً على السلطة السياسية وتهديداً للمقدس الديني والرمز. وقد يكون في كل كاتب يقف موقف المعارض من سلطة أو شخص ما، جينةٌ، بالمعنى المجازي، من الفيلسوف اليوناني. الرومان أيضاً، سبقوا باقي الأوروبيين بفرضهم الرقابة على الرأي خوفاً من انهيار روما، الصغيرة قياساً بامتداد حكمها كامبراطورية أنهكتها غزوات القبائل الجرمانية، لكن أيضاً الصراعات الداخلية، ما فاقم خوف السلطات من أي عصيان فكري. فلوحق المعارضون وقتلوا. ثم كانت الصين، وهي أشهر من لحق باليونانيين والرومان مباشرة في المنع. تاريخها يسجل أقدم إحراق مكتبة حتى الآن، عام 221 ق.م. مستبقة الأوامر الملكية الإنكليزية بإضرام النار في مكتبة أوكسفورد بنحو تسعة عشر قرناً. الأمر الذي لم يغب تماماً عن ذاكرتنا المعاصرة، أي عندما تم إحراق جميع المؤلفات الألبانية في كوسوفو بأوامر من حكومة صربيا بين عامي 1990-1999. أما الإتحاد السوفياتي، وريث الإمبراطورية الروسية التي كانت بطيئة في اللحاق بالانفتاح الأوروبي، فيسجل أطول فترات قمع للفكر وحرية الرأي، على امتداد القرن العشرين.
جُرّدت الكنيسة الكاثوليكية من سلطاتها الرقابية بعد الثورة الفرنسية، إلا أن اهتمامها بنشر فهرس للعناوين التي تحظر الكنيسة مطالعتها، ظل قائماً. يروي ألبرتو مانغويل، كيف أن البابا بولس الرابع (جيوفاني بييترو غارافا)، أصدر كتاباً بعنوان فرعي هو "فهرس الكتب المحظورة"، والذي أعادت الكنيسة طباعته عشرين مرة وبيع منه ملايين النسخ، حتى ألغي هذا "التقليد" البابوي عام 1966. توفي بولس الرابع عام 1559، وهو من رعى محاكم التفتيش. وعقب وفاته، قُطع رأس تمثال له وكُتبت فيه هجائية تقول "غارافا، الذي يبغضه الشيطان والسماء/ مدفون ههنا، بجثته المتعفنة".
مع ذلك، فإن الرقابة لم تكن دوماً في حاجة إلى إذن من السلطتين الدينية والسياسية لتبادر إلى منع كتاب أو تبرير جريمة إنسانية ما. كتّاب كثر تطوعوا معبّدين الطريق الخلفي لفرار مسؤول سياسي أو عسكري من المحاكمة. كما لو أن خطاب الشاعر الإنكليزي جون ميلتون، أواسط القرن السابع عشر، الذي دافع فيه وبشراسة عن حرية الرأي، حمل في طياته ورقة نعوة مبكرة جداً لهؤلاء. ماريو بارغاس يوسا، الكاتب البيروفي (نوبل، 2010) كان أشهر من دافع عن الجرائم التي ارتكبها الجيش الأرجنتيني بحق معارضيه السياسيين والأكاديميين والطلاب والمدنيين في ثمانينيات القرن العشرين. ليخلط مسؤولية الجلاد، بمسؤولية مفترضة للضحية على قاعدة "أيها، الضحية، أنت من بدأ الاحتجاج، فتحمّل تبعاته".
اندثرت الملكيات بمعظمها. ألغت السويد الرقابة على المطبوعات الصحافية، أواخر القرن الثامن عشر وقبل الثورة الفرنسية بنحو ثلاثة عقود. تبعتها النرويج والدنمارك. واضطرت الولايات المتحدة الأميركية للحاق بركب دول مهد الفايكنغ (رغم أنها لا تزال تشهد حتى الآن منع مؤلفات من حين إلى آخر)، ثم فرنسا (مع اندلاع الثورة الفرنسية). إلا أن حوادث منع الكتب لم تتلاش كلياً من هذه المجتمعات. خصوصاً على يد المعلمين والمكتبيين، أفراداً، ممن كانوا يراقبون مكتبة المدرسة والجامعة والأكاديمية، ثم يتخذون قراراً ذاتياً بحظر كتاب أو مصادرته أو منعه، ما كان يدفع بالمؤلفين والناشرين إلى خوض معارك للدفاع عن حرية الرأي والتأليف. غير أن النظام القضائي ظل دوماً المقياس الحقيقي لحرية الرأي، الذي كفلته دساتير هذه الدول وغيرها. فكل قرار بمنع كتاب، ظل بمثابة اختبار حاسم لنزاهة القضاء وتماسكه واستقلاليته في الدفاع عن حق الرأي والتعبير والكتابة والنشر والتأليف وعرض الأفكار. غير أن ما حدث مؤخراً في رام الله، مفارقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القمع، إذ لم يسبق أن منعتْ مقاطعة جغرافية صغيرة ومحاصَرة بقوات احتلال، كتاباً، في الوقت الذي تتوسل فيه العالم لنجدتها من الأبرتهايد.
لم يبق من كل ذلك التاريخ إلا فكرة محاكم التفتيش والرقيب. فأعيد انتاجهما بكاموفلاج مؤسساتي وغطاء قانوني. وبقي الرقيب راسخاً، عابراً للأزمنة والتغيرات السياسية والتطورات التكنولوجية والاكتشافات العلمية والانفتاح على الثقافات، متروكاً، وحيداً ومغروراً وفظاً. إنه خليفة المَلَكيات ورجال الدين، وربيب محاكم التفتيش الأولى والقرون السوداء في تاريخ الإنسانية. لا يريد أن يترك مكانه في العصور الوسطى حين صار للطباعة الورقية مهمة خبيثة، وهي إرشاد السلطة إلى السيطرة على كل ما ينشر. وما زال الرقيب يعتبر أنه منوط بمهمة تحصين المجتمع سياسياً وتحسينه أخلاقياً. وأنه يقوم بعمل رسولي، يكلّفه بها صوت داخلي، سامٍ، آت من سلطة أعلى أو شعور بالالتزام بشخص أو حزب أو حرصاً على صورة ما، في انفصال تام عن الواقع. وبالتالي، فإنه لا يرى ضيراً في منع كتاب أو مصادرته أو الحجر عليه، كما لو أن الكتاب متهم ينبغي التحقيق معه، أو مريض يعاني خللاً عقلياً ويجدر عزله عن الناس كي لا يصابوا بالعدوى منه.