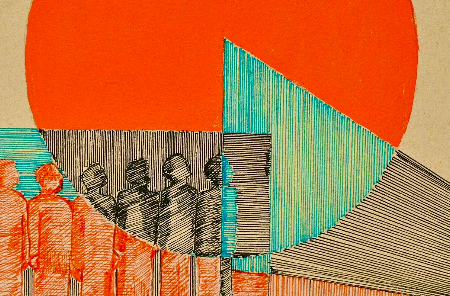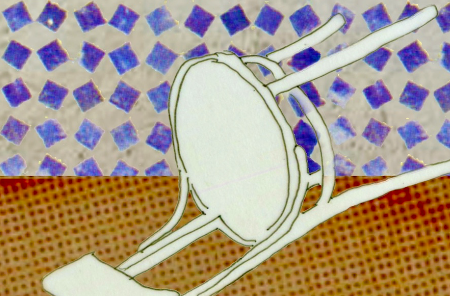قشعريرة برد نتج عنها اصطكاك مُضحك لأسناني. لم أكن أضحك بعضلات وجهي. العقل ما كان يضحك. واستعذبتُ الصوتَ الناتجَ عن هستيريا الاصطكاك. ملأ رأسي.
لكنه، وعلى نحو مُفاجىء، ذكّرني بصوت غسالة الملابس؛ وهي تدورُ دورانها العنيف قبل التوقف، ويرتجّ كلّ شيء.
لماذا ربطتُ صوتًا استعذبته بصوت مُقلق ومُزعج؛ ينطوي على تكليف؟ لأن المسك على هناءة، من صوت فيه ملهاة، أمر لا يدوم. ولأنني كنت أجّلت، ليومين، وضعَ وجبة الملابس في الغسالة.
الصوتُ المُضحك والمُستعذب، إياه، جعلني أستحضرُ، أيضًا، نفضَ طائرٍ ريشَه الجافّ لكن الدافىء، بُعيد استيقاظه من النوم. واستحضرت انتفاضته وهو مُبلّل.
كنت أحاولُ، على سطح الجدل، تجنّبَ التباين بين إيقاع نفض الطائرٍ ريشَه الجافّ، والطائر نفسه لريشه وهو مُبلّل. كان همّي أن أستقي الإيقاعَ من الصورة في رأسي، لا من الصوت.
أتذكّر في الأيام الأولى من لجوئي إلى الشمال، في قرية بعيدة عن مركز المدينة؛ كان برد وريح وثلج. لم تكن الطبيعة الخلابة، في بداية الأمر، مِعيارًا مُحرضًا أمام حداثة الغريب على بلاد لا تعمل فيها الشمسُ بكامل قوّتها.
ذات يوم استعرتُ درّاجةً هوائيةً من جارٍ سودانيّ لاجئ، أشرتُ إليه في قصيدة، وذهبتُ لشراء بعض الأشياء. في الطريق المُخصّصة للمشاة وللدراجات كانت طبقةُ ثلجٍ عقلُه خفيف. انزلقت الدرّاجةُ بي إلى حافّةٍ تحتها مجرىً قليلُه ماءٌ وكثيرُه صخور. وقعتُ على الحافّة، وكنت في لحظة الألم والرضوض مقيمًا، بلغة هايدغر عن المُعرّضين للموت، على اللحظة الرهيبة التي تفتح الغامض.
يومها رأيتُ الموتَ نهرًا كرهته. لكن، سرعان ما استعدتُ عافيتي مع التعوّد على الحياة.
الآن، النهرُ بعيدٌ عنّي ومُتجمدٌ أيضًا. أتخيّل صخورَه البارزة، في هذه الأوقات، قطعَ لحم مطهوة ومغروزة في سبيكة الشحم المعرّض للبرد. وفي نيتي القول له لو زرته، في صيف أو ربيع، والماءُ أعلى من صخوره: كنتَ ستقتلني، لكنني لم أنكر عليك اسمَك.
***
على ذكر السبيكة، كانت جدّتي لأبي، وبعد انتهائها من حفلة تسبيك لحمة العيد، تُؤمّن الإناء تحت سريرها. ذات يوم تسلّلتُ إلى اللذة على أربع قوائم؛ مُستغلاً غفوتها.
أزحتُ غطاء الإناء فأحدثتِ الحركةُ ضجّةً غير محسوبة العواقب. استفاقت الجدّة، مُتخذةً وضعيّة مصطلحٍ غير مشوّه. أخذت يدُها تدكّ ظهري، قبل أن يفسد الوعي لديها ظنّها بأني قطة؛ بأمارة أنها صرخَت: "بسس.. الله يلعنِكْ". وعندما تعرّفَتْ على ذلك الكائن المُهاجم، وظهره مكشوف، ضحك علينا أهل البيت الذين رصدوا الكمين.
غدت تلك الحادثة مَرويّةً ومثلاً يُستحضرُ عند تذكّر يومّيات الجدّة وشقاوة ومقالب الأحفاد. لم يقف هذا النمط من الحوادث عند هذه الملهاة.
كان لجيراننا قطّ عزيز، دخل بيتنا.
كنتُ نائمًا على السرير الذي سيُسجّى عليه أبي، بعد أعوام.
كنتُ يومها طالبًا أدرس الإقتصاد والعلوم السياسية، وطموحي أن تكون لنا دولة ووزارة اقتصاد عليها العين، أو خارجية لها عيون قوية.
سلك القطّ الجميل طريقه إلى الغرفة، حسب رواية الأمّ، وانزوى تحت السرير؛ فاعتبرَت، بدورها، جولته أمرًا عاديًّا. فالجيران لبعضهم، وبيوتهم مفتوحة للحيوانات الأليفة. أنا هنا لا أهمز في قناة معبر رفح. غير أنها سمعته يئنّ ويُصدر صوتًا مرعبًا وينتفض. تلك اللحظة، أيقظتني بنبرة استنجاد وحزن، وقالت عن خبرة، لا عن ظنّ، بسرعة موت كلّ أليف: "قوم يمّة شوف هالمصيبة إللي تحتك، في قتيل"!
قمتُ من فوري، لا أفهم عليها. أدخلتُ رأسي تحت السرير، وأنا على أربع قوائم، وأنارت لنا الحقيقةُ عينيه. قلنا لابدّ أنه أكل من بقايا الطعام الزفر المُطعّم بالسمّ الذي يضعُه الجيران، من أجل القضاء على الجرذان.
مات القطّ الجميل ذو الفرو الذي تحسده عليه الكلاب.
مات ذو الهيبة الكاملة تحت السرير الذي سجّى عليه أبي العائد، قبل سنوات، إلى البيت جثةً من المشفى الذي أخرجوني منه، ذات عصر فلسطيني، بعد ساعة من إصابتي برصاصة في فخذي، أيام الانتفاضة الأولى، ليكون هناك سريرٌ شاغر لمن سيأتي، بعدي، مصاباً إصابة خطيرة؛ قد تحمله الدقائق القليلة على لقب الشهيد.
***
بعض المنامات ثانويّ وعابر، لا يحتاج كرم التأويل.
لكننا سنبالغ، كما دومًا، عند تذكّرنا المنام؛ سنشبعه بتآويل مختلفة ونحن جماعة. بالنسبة لي، الآن وتحديدًا - وربما هذه عدوى من بعض كتّابٍ المناماتُ هي شرارة أعمالهم- الحسُّ الأدبي لدي هو ما وراء ذريعة المبالغة والحرص على الإثارة والتنويع؛ أمام سخاء الإشارات التي أعلت كعب وشهوة التحليل النفسي.
أمس، مثلًا، رأيتُ في منامي عربةً عسكرية مختبئة بين أشجار.
عند الصباح، وفي طريقي إلى متجر كبير؛ لفت نظري جيب عسكري اللون بين عربات ملونة، تحت أشجار، في البلدة النرويجية.
الجيب كان مدنيّ المهمة، مثله مثل سترةٍ على جسد حسناء؛ لونُها مستعار من المظهر العسكري؛ تمشيًا مع الموضة الجديدة.
لكنني لم أكتفِ، بل لم أرضَ بمصادفة تحقق المنام وتمثلّه على نحو موضوعي؛ بل أسرفت، وبي وسواس نقدي، في بناء الثنائيات وأنا أجتاز خطوط المشاة:
عربة المنام كانت عسكرية الوظيفة في منامي.
الجيب ذو اللون المُدان، في صباح هذه البلدة، مدني المهمة.
عربة المنام اختزالٌ لمأساة في بلادنا.
وهذا الجيب بلونه البهيج، هو علامة من علامات الترف، على نحو مشاكس بشكل سلمي، بين عربات مختلف ألوانها.
في المتجر جلست أتصفّح جريدة إعلانات، وفيها عروض وتخفيضات بمناسبة اقتراب عيد الميلاد المجيد.
في إحدى الصفحات صورة لبائع مبتسم أعرفه، في الواقع.
في اللحظة التي كنتُ أقرأ فيها الإعلان وأنظر إلى صورته، مرّ هو ذاته، بشحمه ولحمه وابتسامته، بمحاذاتي؛ نازلًا على الدرج الإلكتروني بحذاء له سطوة أحذية العسكر. لكنه حذاء جميل منح منتعله أناقة، وخطواتِه -لئلا أقول سطوة- وجاهة.
***
خوفًا من العدوّ دفنَ إخوتي، في الثمانينيات، آلة لطباعة المنشورات الوطنية؛ تحت شجرة في حاكورة البيت. بعد "اتفاقية أوسلو" بحثوا عنها وقد نسوا مكانها بالضبط؛ فالشجرة كبرت وصار حولها أشجار وأشجار.
سادت في تلك الفترة حركة حفر في الأرض، وتحت العتبات.
قادت حركةَ الحفر أحاديثُ كبار السنّ من الأقربين، الذين خبّأوا في الأرض بواريدهم المشحّمة ملفوفة في خيش أكياس السكر وأغطية شتوية.
دلّت رواية لمختار عائلتنا يومها الشبابَ على مكان بارودة دفنها تحت عتبة باب. كنا صغارًا. حفروا وحفروا، فعثروا عليها بشحمها الداخليّ، وقد أتى الصدأ على جسدها وصارت خباياها رطبة. بعد التحقّق من لا جدواها، صارت تلك البارودة لعبة في أيدينا نحن صغار الحارة. وقد شبّهنا الشحمة، ونحن نجترّها بأصابعنا من قلبها، بذلك الصمغ الذي كنا نضعه على العصيّ لاصطياد العصافير.
***
كان توفي مختار عائلتنا، فزار أبو عمار العزاء في حارتنا، لتقديم الواجب. فعلاقة أبو عمار بالعائلات كانت قوية، ولم يخرجها يوماً من حساباته.
كانت الناس تجلس عادة على كراسٍ بلاستيكية. لكنّ أحد الرجال طلب قبل وصول عرفات أن نحضر طقم الكراسي الخيزران من بيتنا الذي أطلّ على الخيمة، والذي اعتلى سطحه حرس الرئيس يومها.
جلس أبو عمار على كرسيّ من كراسي الطقم، وصار للكرسيّ صيت بعد أن أعدناه إلى البيت. فكلما جاء زائر مهم علينا قال أحدنا له: تفضّل أقعدْ على الكرسيّ الذي قعد عليه أبو عمار!