وعلى نحوٍ يُغذّي بلطفٍ التخيّلات الجامحة لدى المجتمع السينمائي، فقد تضمّن البرنامج فيلم «الحرب الخامسة»، 1980، الذي حمّلتهُ الممثلة العالميّة فانيسا رديغريف بجاذبيتها والتزامها الراسخ -الذي أثبتهُ مرور الوقت- وذلك في تأريخ دقيق ومفصّل، أقرب إلى العمل الصحفي، للمراحل الأخيرة من الثورة، وتحديداً عمليّة الليطاني؛ حينما اجتاحت إسرائيل الجنوب اللبنانيّ في محاولة للقضاء على منظمة التحرير الفلسطينيّة.
نشرها موقع BFI، وهذه ترجمتنا لها.
"في النضال ضدّ الوضع القائم، فإنّ النقدَ ليس هوى في الرأس، بل هو رأس الهوى. وليس مبضعاً، بل هو سلاح. ومع ذلك، فإنّه لا يُمكن لسلاح النقد، بطبيعة الحال، أن يحلّ محلّ نقد السلاح".
كارل ماركس*
فضلاً عن مصير كفاحهم، فإنّ تاريخ الفلسطينيين سيظّل، على الأرجح، وهو كذلك في واقع الحال، عرضة لذلك النمط من التلاعب العنيف الذي يتعرّض له المضطهدون، ومُعذّبو الأرض، والمهزومون. ومن أجل نزع الشرعيّة عمّا قد صادقَ عليه القانون الدولي، تحتاج القوى القمعيّة إلى إعادة اختراع القصص والتاريخ، وهندسة سرديّات سامّة تغذّي بها عقول كلّ من القرّاء السذّج والمتفرّجين السلبيين الذي يتوقون إلى رؤية "الخير" مُنتصراً على "الشر". إنّه بمقدور الدعاية الموجّهة التي تعتمد على وسائل الإعلام الجماهيريّة أن تصنعَ المعجزات: وهكذا يصير من الممكن أن يظهَر التطهير العرقيّ وكأنّه دفاع عن النفس، وسيغدو الفصل العنصريّ حاجةً صائبة، وستُدان المقاومة باعتبارها إرهاباً. وفي كلّ مرّة، يواجِهُ المضطهدون ظلماً مزدوجاً يستهدفُ كلّاً من حاضرهم وماضيهم في الآن نفسه؛ يُشوّهُ تاريخهم، ويُسلَبون على نحوٍ عمليّ حقّهم في التعبير عن الذات.
ولهذا السبب، فإنّ الكفاح من أجل الحق في تقرير المصير لا بدّ أن ينطوي على الكفاح من أجل الحق في تمثيل الذات أيضاً. لقد حذّر إدوارد سعيد من ذلك الانفصال الذي يحدثُ من خلاله أنّ "تُنزّه الثقافة وتُبرّأ من أيّ تعالق مع القوّة، وتُعتبر التمثيلات مجرّد صور لَيْ-سياسيّة (ليسَت موجودة لشيء إلّا) لكني تُعرّب وتُتَأوّل كعدد من قواعد (نَحْو) التبادل، ويُفترض بداهةً أنّ الطلاق بين الحاضر والماضي قد اكتمَل"**. في برنامج نظّمَتهُ مؤخّراً، نبشَت مؤسسة الفيلم الفلسطيني PFF في لندن أفلاماً (وملصقات) نادرة من الثورة الفلسطينيّة في سبعينيات القرن المنصرم، والأبعاد التاريخيّة والسياسيّة والثقافيّة التي أطّرَتها، والتي لم يكن من الممكن بدونها تكوين أيّ فهم نقدي للمقاومة الفلسطينيّة المسلّحة.

في البداية، تكشف القراءة السريعة للجنسيّات المختلفة التي تعود إليها تلك الأفلام الذي جرى عرضها الطبيعة الدوليّة لنزاعٍ لطالما وُصِف (وعُومِل) باعتباره يستند إلى اعتبارات عرقيّة ودينيّة وقوميّة. من صربيا إلى الولايات المتّحدة الأميركيّة، ومن إيطاليا إلى روسيا، ومن لبنان إلى اليابان، توافد المخرجون وصنّاع الأفلام الإخباريّة القصيرة وطواقم المحطّات التلفزيونيّة، حيثُ تجمّعوا في ساحة معركة المقاومة الفلسطينيّة، التي لا تنتمي إلى نطاق مناطقيّ مُحدّد، من أجل إنتاج معلومات مضادّة، وبيانات عامّة عن العمل المسلّح، وتواطؤات من التعاطف.
وعلى الرغم من الميزّات المتناقضة والخصائص المناطقيّة، فقد ظهر الكفاح الفلسطينيّ المُسلّح الذي تُصوّره هذه الأفلام، وثائقية كانت أم روائية، كجزء من سلسلة عالميّة مُستمرّة من مُناهضة الإمبرياليّة، بجبهة تمتدّ من إفريقيا إلى آسيا، ومن أميركا اللاتينيّة إلى الشرق الأوسط. وبصورةٍ ناجحة في بعض الأحيان (مقارنة بفيتنام، وكوبا، وأنغولا...)، فضلاً عن كونه مُبرّراً على الصعيد التاريخيّ، فقد أكّدَ الفلسطينيون على حقهم في تقرير المصير بالكفاح المسلّح وتحقيق العيش المشترك على قدم المساواة في أعقاب حرب الأيّام الستّة في سنة 1967، وذلك بعد أن سُحِقَت محاولةَ جمال عبد الناصر لتشكيل تضامن عربيّ شامل تحت الدبّابات الإسرائيليّة.

يُقدمّ الخبير في السينما الوثائقيّة الهولنديّة، يوهان فان دير كيوكن، سرداً جديّاً للنزاع في فيلمه الفلسطينيون (De Palestijnen, 1975). وبدءاً من الشرعيّة النظريّة للمشروع الصهيوني، وتطبيقاته الاستعماريّة، و، الأهم من ذلك، الدعم الاقتصادي المبني على أساس انتهازيّ، فإنّ المخرج يُقدمّ وصفاً دقيقاً للتعقيدات التي تحيط بـ "القضيّة الفلسطينيّة"، مُقارباً على نحوٍ جوهري المصالح العالميّة وإمدادات النفط، والتي جرى تحت اسمها تهجيرُ شعبٍ واضطهاده، في مقابل "دفاعٍ" زائف عن شعب آخر.
ولأنّ الصحفيين غالباً ما يتحاشون هذه المهمة، فقد تَقصّى فان دير كيوكن القوى السياسيّة والاقتصاديّة التي بمقدورها في لحظة واحدة أن تخلق نزاعاً، وتبرّر المظالم، وتُشوّه التصوّرات العامّة في نهاية المطاف. وفي حين يُدافع الفيلم بصورة سَويّة عن فكرة دولة يهوديّة، في انسحابٍ ضروري من أذى معاداة الساميّة الأوروبيّة، إلّا أنّه يُسلّط الضوء بعنايةٍ على آثار عصاباتها المأجورة والتشويه الوضيع للقضيّة الفلسطينيّة التي لا تهدف إلى إبادة اليهود (باعتبار أنّ هذه الأخيرة حق حصري للمسيحيّة الغربيّة في المقام الأوّل)، بل إلى تحقيق التعايش السلميّ على أساس المساواة.

يُقدّم فيلم «الفتح: فلسطين»، 1970، للمخرج لويجي بيريللي، تأريخاً مُفصلّاً ودقيقاً لولادة المقاومة من خلال متابعته عن كثب لواحد من تشكيلاتها الرئيسيّة، فتح، والتي تولّى قيادتها شاب قوي الإرادة، ياسر عرفات. بعدَ تمهيدٍ تاريخي مقتضب، يزور الفيلم الوثائقي مسقط رأس الثورة الفلسطينيّة: مخيمات اللاجئين. في أعقاب طردهم من أرضهم، فقد عاش الفلسطينيون كمواطنين من الدرجة الثانية في إسرائيل، أو كأقليّات منفيّة، خارج الوطن لِمَن استطاع تحمّل التكلفة، أو تحت وطأة البؤس اليومي لمخيّمات اللاجئين لِمن لم يستطع.
في تلك الأماكن اليائسة تحديداً، حيث لا مياه جارية، ولا تعليم أو حريّة، وحيثُ شكّل الاغتراب واليأس المكبوت العزاء الوحيد، زرعَت الثورة بذور الكرامة وتقدير الذات والتحرّر. وعلى الرغم من أنّ التعليق المفرط في التبسيط قد أثقله في بعض الأحيان، إلا أنّ فيلم بيريللي ينقلُ بصورة مُقنِعة ذلك التوق الذي انبعث مرّة أخرى نحو المقاومة المُسلّحة، والذي مثّل إعادة تنظيمٍ جادّة وتفاؤليّة للحياة اليوميّة. لقد ساهمَت كلّ من المجموعات النسائيّة، ووحدات محو الأميّة، والتدريبات العسكريّة، وجلسات القراءة، والرقصات التقليديّة، والتدريبات القتاليّة للأطفال، في تحويل اللاحتميّة المُدمّرة في مخيّمات اللاجئين إلى مُختبرٍ واعٍ للممارسات التحرّريّة؛ وهي الخطوة الاجتماعيّة الأوّليّة لفلسطين حرّة لم تتحقّق بعدُ مع مرور الوقت.

في فيلم «نحنُ الشعب الفلسطيني» (ثورة حتّى النصر، 1975)، عَمِل فريق أميركي مُنشَق عن مجموعة صنّاع الأفلام الإخبارية القصيرة Pacific Newsreel على مونتاج لقطات أرشيفيّة حصريّة، للخروج بعملٍ يعيد تشكيل النزاع بصورة تاريخيّة ومفصّلة. ثمّة اهتمام كبير للتكوين السياسيّ للصهيونيّة، ودور المستعمر البريطاني في إسناد فلسطين إلى الصهاينة، والدور الإستراتيجي الذي لا تزال إسرائيل تمارسه منذ ذلك الحين في السيطرة على السلعة الأكثر طلباً في العالم، واحتكارها؛ النفط. وفي حين أكّدَت عناوين أخرى في تلك الفترة على البعد الدولي للثورة الفلسطينيّة، وذلك من خلال ربطها بكفاحات أخرى ضد الاستعمار، فإنّنا نجد هُنا المفهوم نفسه أيضاً ولكن من زاوية مُختلفة، فإذا ما كانت مُناهضة الإمبرياليّة ظاهرةً عالميّة، فإنّ القمع كذلك أيضاً. أدرجَت في الفيلم لقطات للجنرال موشيه ديان أثناء زيارته إلى فيتنام لغاية تعلّم تقنيّات مكافحة الشغب (والتي أجادَ، على نحوٍ مُفجِع، استخدامها أكثر من زُملائه الأميركيين).
من السهولة بمكان أنّ تُلمّع صور الثورات، على غرار الحروب العدوانيّة، لتبلغ حدّ المثاليّة، وأن تُعرَض على نحوٍ مُجرّد باعتبارها حركات بطوليّة موحّدة؛ بيد أنّ الواقع في الغالب أقلّ رومانسيّة، لكنّه ليس كذلك عندما يتعلّق الأمر بالقهر. وفي الحقيقة، فإنّه من الممكن في بعض الأحيان أن تُقدّم القصص الشخصيّة التي تُحفّزُ الحركات التاريخيّة مداخل أقلّ غرابة لفهم تطوّراتها المعقّدة والمؤلمة، والانتصاريّة في مناسبات قليلة.

كذلك هو الأمر في حالة فيلم «سببٌ للرحيل» (المعروف أيضاً باسم أرض الآباء، 1976)، حيثُ يجتمع المخرج الهولندي جورج سلويزر مرّة أخرى (صاحب فيلم «الاختفاء») بعائلة فلسطينيّة تعيش في بيروت في أعقاب حربٍ دامت لمدّة سنتين ما بين قُوّاتيين لبنانيين مسيحيين يمينيين من جهة، وقوّات مؤيّدة للفلسطينيين من جهة أخرى، وقد أفضَت إلى دمار كبير في أجزاء من العاصمة اللبنانية. لم يكن سلويزر واثقاً بأنّه سيجد أفراد العائلة جميعاً على قيد الحياة. يلتقي بهم، وينصت إلى قصصهم التي ينصهر فيها الشخصيّ بالسياسي. في هذا الفيلم، يُسرَد كفاح الفلسطينيين من أجل حقّهم في العودة بكلماتهم وظروفهم، وتبعثُ وجهات نظر أجيالٍ متباعدة، وآراء سياسيّة متباينة، متوحّدة في قناعتها بأنّ الثورة ستستمرّ حتّى النصر، ولو كان ذلك بدراسة الهندسة في جامعة إيطاليّة.
وعلى نحوٍ يُغذّي بلطفٍ التخيّلات الجامحة لدى المجتمع السينمائي، فقد تضمّن البرنامج فيلم «الحرب الخامسة»، 1980، الذي حمّلتهُ الممثلة العالميّة فانيسا رديغريف بجاذبيتها والتزامها الراسخ -الذي أثبتهُ مرور الوقت- وذلك في تأريخ دقيق ومفصّل، أقرب إلى العمل الصحفي، للمراحل الأخيرة من الثورة، وتحديداً عمليّة الليطاني؛ حينما اجتاحت إسرائيل الجنوب اللبنانيّ في محاولة للقضاء على منظمة التحرير الفلسطينيّة.
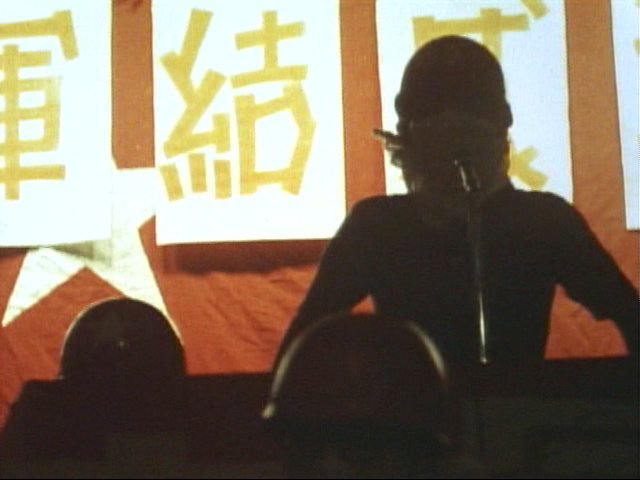
جاء فيلم «الجيش الأحمر/ الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين: إعلان الحرب العالميّة» (Sekigun-PFLP: Sekai sensô sengen)، 1971، أبعد من سابقه عن جنس الأفلام الصحفيّة، ولكنه ربّما أكثر إثارة للاهتمام على الصعيد السينمائي. أخرج العمل كلّ من كوجي واكاماتسو وماساو أداتشي، وذلك عندما عبر صانعا الأفلام اليابانيّان من فلسطين خلال رحلتهما للمشاركة في مهرجان كان السينمائي. ومع الأخذ بعين الاعتبار أنّه جرى تصوير الفيلم ضمن الإطار الواسع لـ "نظريّة المشهد الطبيعي" لأداتشي، والتي تفترِض أنّه ثمّة حضور جليّ لعلاقات القوّة في كلّ ما يُنتِجه الإنسان من مشاهد، فإنّ الفيلم يُعدّ دعاية سياسيّة تحثّ على التضامن مع القضيّة الفلسطينية. وبينما سيواصل واكاماتسو انخراطه العسكريّ في الفنّ السابع من خلال أعمال روائيّة حصراً، فإنّه سرعان ما سيتفرّغ أداتشي تماماً إلى النضال ضدّ الإمبرياليّة، وسينتقل إلى لبنان بصحبة أفراد آخرين من "الجيش الأحمر الياباني".
وعلى الرغم من أنّ معظم الأفلام التي تضمّنتها السلسلة قد اعتمدت بشدّة على أحداث واقعيّة، وكان يُنظَر إلى ذلك آنذاك باعتباره الأسلوب "الأنسب" للانخراط في العمل السياسي، إلا أنّه برز فيلمان لمُخرجين عربيين لِما فيهما من جرأة رسميّة في الطرح: فيلم «مئة وجهٍ ليوم واحد» للمخرج كريستيان غازي، 1972، و«الزيارة» للمخرج قيس الزبيدي، 1970)

في تجريدٍ ليليٍ وأحلاميٍ، يدحض فيلم «الزيارة» الإجحاف الذي يُؤطّر سينما الشرق الأوسط عدسات واقعيّة مُقيّدة. إنّ الجماهير الغربيّة تميل إلى اعتبار أنّ التجريب الرسميّ سِمةٌ حصريّة لتقاليدهم الاستِطيقيّة (نسبة إلى الاستِطيقيا/ علم الجمال). ويؤكّد هذا الافتراض على وجود تحيّزُ مسبَق عميق يعتبر أنّ الثقافات غير الغربيّة ليست قادرة على التفكير الجاد بمسائلها أو تفكيك مواثيقها الرسميّة، فضلاً عن أنّه يراها سجينةً لتلك الثقافات، في حين أنّ المصطلح ذاته تماماً، "ثقافة"، يرمز ضمن السياق الغربي إلى كلّ من الإبداع والإنتاج النقدي.
وعلى نحوٍ مثير للفضول، يحدثُ أنّ هذه السمات النموذجيّة للسينما التجريبيّة هي أيضاً خصائص لثقافة بصريّة إسلاميّة، والتي، بحسب أوليغ غرابار في كتابه تكوين الفنّ الإسلامي: "سعَت بوعيٍ تامّ إلى تأكيد الظاهر على حساب الشكل، ومنحَت نفسها ما يلزم من أدوات للتحرّر قدر المستطاع من الخواص الماديّة للموضوع أو الأثر المُجسّد". ومن هُنا، فإنّ الانحياز إلى السيرورة على حساب النمط الكلاسيكي، وللتجريد والرمزيّة مفتوحة النهاية، وبصورة أكثر إثارة للاهتمام، إلى الإدراك الضمني، إنّما هي عناصر نجدها كلّها في الفن الإسلامي. وبحكم أنّ الإسلام لا يولي تفكيراً مليّاً إلى التصوير البصريّ لله، فإنّ الجسد هُنا، على عكس حالة المسيح، ليس مادّة للتمثيل، بل للاستحضار. وكنتيجة لذلك، تمارسُ الصورُ، المُحرّرة من أعباء شكليّة التمثيل، دوراً إيحائيّاً للبُنى الممكنة بدلاً من إملائها، وليعتمدَ شكلها النهائي على تفسيرات المُشاهِد. وتُظهِرُ الزخرفة العربيّة، والسجّاد برسوماته التنويميّة، وترقين اللغة العربيّة نفسها، علامات استرساليّة يترابط فيها انكشاف كلّ من الصورة والمعرفة والروحانيّة.

من المثير للاهتمام كيف أنّ التزام الزبيدي وغازي بالقضيّة الفلسطينيّة، وانخراطهما بها، قد استلزم منهما تجريباً على مستوى رسميّ؛ وبالتالي المطابقة ما بين الجهود العسكريّة وتخيّل مستقبل آخر لفلسطين. وبصورة ترفض كلّ الأعراف الدعائيّة أو السرديّة، يجمعُ فيلم «مئة وجه ليوم واحد» ما بين تقنيّات الوثائقيّ والسرد التجريبيّ، لإدانة نخب الثورة الثقافيّة والسياسيّة بما اعتبرَهُ غازي نفاقاً وانحلالاً. وبمؤثّرات صوتيّة مُبهرة، وأداء قوي وجريء للممثّلة الرئيسيّة مادونا غازي، في وسعنا النظر إلى أن هذا الفيلم قد بلغ أوجَ الصناعة السينمائيّة النضاليّة بما فيها من تمرّد وإثارة. وأمّا النخب الثقافيّة نفسها التي انتقدَها الفيلم، فقد حاولَت الحطّ من قدره في وقت صدورِه، وذلك باعتبارِه "ثوريّاً وجودياً" لدرجة مبالغ بها (والاقتباس هُنا من من مقالة "القضيّة الفلسطينيّة في السينما" لغاي هِنيبيل)، فإنّ الفيلم يُمثّل الصورة النهائيّة للسينما السياسيّة التي لا تُقدّم التنازلات إطلاقاً، ولا ترضى بالقليل مهما كانت الأسباب قاهرة.
* اقتباس من مُقدّمة «نقد فلسفة الحق عند هيغل» لكارل ماركس- المُترجِم.
** اقتباس من «الثقافة والإمبرياليّة» لإدوارد سعيد- ترجمة كمال أبو ديب، دار الآداب. المُترجِم.





















