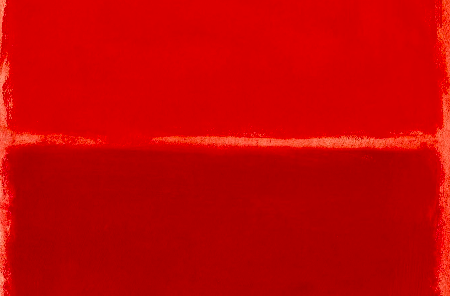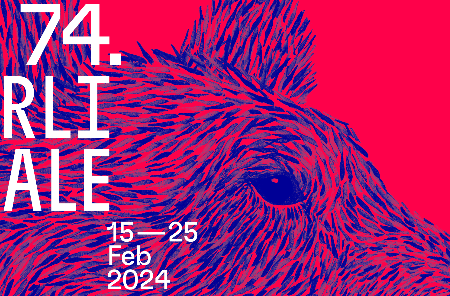يتسبَّب إصرار إسرائيل وألمانيا على التفرُّد والاستئثار بالمحرقة في إحداث فجوةٍ بين السرديَّات التاريخيَّة لمعاداة الساميَّة والعنصريَّة، إلى درجةٍ تجعل من هذين النموذجين من القوَّة السياسيَّة، اللذين تغذِّيهما الكراهية، يتنازعان مع بعضهما البعض.
كتبها إيال وايزمان في LRB، ونشرت في ٢٥\٤\٢٠٢٤.
في الحادي عشر من كانون الثاني، ادَّعت دولة جنوب أفريقيا دفوعاتها أمام محكمة العدل الدوليَّة في لاهاي أنَّ أفعال إسرائيل في غزَّة "ذات طابع إباديّ"، باعتبار "أنَّ القصد من ورائها تدمير جزء كبير من الشعب الفلسطينيّ على الصعيد القوميّ، والعرقيّ، والإثني". أشار محامو الادِّعاء إلى مقتل 23,000 فلسطينيّ (بلغ هذا العدد قرابة 33,000 حتَّى لحظة كتابة هذه المقالة)، غالبيَّتهم من النساء والأطفال، فضلاً عن تدمير البنى التحتيَّة اللازمة لإدامة الحياة، بما في ذلك المدارس والمستشفيات، إضافةً إلى تشريد سكَّان غزَّة كلّهم تقريباً. في اليوم التالي، قدَّمت إسرائيل دفوعاتها، زاعمةً "أنَّه لو كانت هناك أفعال إباديَّة، فهي تلك المرتكبة ضدَّ إسرائيل". كما طالبَ محاموها المحكمة برفض كلٍّ من القضيَّة وطلبِ دولة جنوب أفريقيا بوقف العمليَّات العسكريَّة الإسرائيليَّة ضدَّ غزَّة.
عقب أقلّ من ساعتين من اختتام إسرائيل مُرافعتها، أعلنَت ألمانيا أنَّها ستتدخَّل كـ "طرفٍ ثالث" إلى جانب إسرائيل. واستناداً إلى اتِّفاقيَّة مَنع جريمة الإبادة الجماعيَّة والمعاقبة عليها، الصادرة عام 1948، يحقُّ لأيٍّ من الأطراف الموقِّعة تقديم "حجج موضوعيَّة" بشأن أيِّ نزاعٍ يتعلَّق بتفسير الاتِّفاقيَّة. في عام 2023، تدخَّلت ألمانيا في قضيِّة الإبادة الجماعيَّة التي رفعتها غامبيا ضدَّ ميانمار، بسبب نهج الأخيرة في معاملة الروهينغا. دعمَت ألمانيا الموقف القائل إنَّ أفعال ميانمار ترقى إلى إبادةٍ جماعيَّة. لكن، في القضيَّة الجنوب أفريقيَّة، صرَّح المتحدِّث الرسميّ باسم الحكومة الألمانيَّة أنَّه "من منطلق تاريخ ألمانيا والجريمة ضدَّ الإنسانيّة- المحرقة- فإنَّ الحكومة الفيدراليَّة تجد نفسها ملتزمةً بصفةٍ خاصَّةٍ باتفاقيَّة منع الإبادة الجماعيَّة". وبعبارةٍ أخرى، لدى ألمانيا الخبرة بصدد هذا النوع من المسائل، وترى أنَّ الاتِّهامات الراهنة ضدَّ إسرائيل "عارية تماماً عن الصحَّة": بل محض محاولةٍ لتسييس الاتِّفاقيَّة. تُعتبر ذكرى المحرقة الأساسَ الأخلاقيَّ لألمانيا ما بعد الحرب، ويُنظَر إلى الدفاع عن أمن إسرائيل، كما أكَّدت أنجيلا ميركل في عام 2008، باعتباره "مصلحةً وطنيَّة" بالنسبة إلى ألمانيا. وبالتالي، تبدو فكرة إمكانيَّة اتِّهام إسرائيل بارتكاب إبادةٍ جماعيَّة -أو مقارنة أيّ إبادة جماعيَّة بالمحرقة- نوعاً من الهرطقة.
في 13 كانون الثاني، اليوم التالي للإعلان الألمانيّ، انتقد الرئيس الناميبيّ حاجي جينجوب (الذي توفِّي في 4 شباط) ألمانيا، بحجَّة أنَّها "غير قادرة أخلاقيَّاً على التعبير عن الالتزام باتِّفاقيَّة الأمم المتَّحدة لمنع الإبادة الجماعيَّة... في الوقت الذي تدعم فيه ما يعادل محرقة وإبادةً جماعيَّة في غزَّة"، ومضيفاً أنَّ "الحكومة الألمانيَّة لمَّا تُكفِّر تماماً بعدُ عن الإبادة الجماعيَّة التي ارتكبتها على الأراضي الناميبيَّة". تلالنغ موفوانغ، المقرِّرة الخاصَّة للأمم المتَّحدة المعنيَّة بالحقِّ في الصحَّة، لخَّصت الوضع بالقول: "إنَّ الدولة التي ارتكبت أكثر من إبادةٍ جماعيَّة على امتداد تاريخها {ألمانيا} تحاول تقويض جهود دولةٍ ضحيَّة للاستعمار والفصل العنصري {جنوب أفريقيا}، حمايةً لإبادةٍ جماعيَّة أخرى {تلك التي ترتكبها إسرائيل}". بعد أسبوعين، أقرَّ قضاة محكمة العدل الدوليَّة، بأغلبيَّة 15 قاضياً مقابل اثنين، بمعقوليَّة الادِّعاء بأنَّ إسرائيل انتهكَت اتفاقيَّة عام 1948، وأمروا الأخيرة باتِّخاذ التدابير اللازمة لمنع الأفعال الإباديَّة.
تقاطع تلميحُ موفوانغ إلى مسؤوليَّة ألمانيا عن "أكثر من إبادةٍ جماعيَّة" مع صدفةٍ تاريخيَّةٍ عجيبة؛ إذ تصادف تاريخ اليوم الثاني للاستماع إلى تدخُّل ألمانيا -أي 12 كانون الثاني- مع الذكرى 120 لبدء الأحداث التي أفضَت إلى أوَّل إبادةٍ جماعيَّة في القرن العشرين، تلك التي ارتكبها الجيش الاستعماريّ الألمانيّ، المعروف باسم "شوتزتروبه" (وتعني حرفيَّاً قوَّة الحماية). كان ضحايا هذه الإبادة كلّاً من شعبَي أوفاهيريرو (غالباً ما تشير المراجع الأوروبيَّة إلى هذه الجماعة باسم هيريرو) وناما، وذلك في منطقةٍ استعمرتها ألمانيا تحت مسمَّى جنوب-غرب أفريقيا- وتُعرف اليوم باسم ناميبيا. كانت القوى الأوروبيَّة الأخرى قد تنازلت عن هذه المنطقة لألمانيا إبَّان مؤتمر برلين لعامي 1884-1885، الذي أضفى طابعاً رسميَّاً على أفريقيا. وفي عهد بسمارك، سعى الرايخ الثاني إلى تحقيق الإمبراطوريَّة الاستعماريَّة التي كان يرى أنَّها تستحقّ قوَّتها على المسرح العالميّ، وجرى تحويل المناطق التي تغطِّي اليوم كلَّاً من توغو، وكاميرون، وتنزانيا، ورواندا، وبوروندي، وناميبيا، "حامياتٍ" ألمانيَّة.
في 12 كانون الثاني لعام 1904، اندلع قتال في مدينة أوكاهانديا ما بين القوَّات الألمانيَّة ومقاتلي أوفاهيريرو بقيادة صاموئيل ماهاريرو. وقد شهدت الأيَّام القليلة التالية مقتل أكثر من مئة من الجنود والمستوطنين، معظمهم مزارعون ومبشِّرون، وأُجبِرَ الشوتزتروبه على الانسحاب. على إثر ذلك، شرعَت ألمانيا المهُانة بالتخطيط للانتقام. كان الأوفاهيريرو رعاة ماشيةٍ تقع أراضيهم في الهضبة الوسطى من المنطقة. لم يصل الاستعمار إلى تلك التلال الخصيبة إلَّا في فترةٍ متأخِّرة، كما نجت من تجارة الرقيق الشنيعة عبر المحيط الأطلسيّ بفضل الكثبان الرمليَّة التي تمتدُّ لمئات الأميال على طول الساحل، والتي كانت كفيلةٍ بحجبها عن أعين البحَّارة الأوروبيِّين المتَّجهين إلى كيب. في لغة ناما/ دامارا، تحمل مفردة ناميب معنى الدرع. لكن ما إن أُقيمت الحامية الألمانيَّة حتَّى أصبحَت المنطقة مرشَّحةً مثاليَّةً لِما اصطلح عليه الجغرافيّ الألمانيّ فريدريش راتزل في عام 1897 تسمية "ليبنسراوم" (أو المجال الحيويّ) - وتعني الفضاء اللازم لاستمراريَّة الأنواع، أو الشعوب، ضمن الصراع الداروينيّ من أجل البقاء. كان لا بدَّ من إزاحة الشعوب الأصليَّة من أجل تمكين الاستيطان الألمانيّ. في بادئ الأمر، حدث الاستيلاء على الأراضي تدريجيَّاً من خلال عقود حماية واتِّفاقيَّات بيع قسريَّة، وكذلك تهديدات ورشاوى ومجازر. لكن شيئاً فشيئاً دخلت ألمانيا الأفريقيَّة حيِّز الوجود على هيئة منظومةٍ تنطوي على مزارع، ومراكز تبشيريَّة، ومناجم معدنيَّة وماسيَّة، وثكناتٍ عسكريَّة مثل تلك الموجودة في أوكاهانديا. اعتقدَ راتزل أنَّ جنوب غرب أفريقيا هي إحدى الأماكن الملائمة لتقوية شخصيَّة "العرق الألمانيّ"، مُستلهِماً أفكار فريدريك جاكسون ترنر الذي اعتبرَ أنَّ الهويَّة السياسيَّة والثقافيَّة الأميركيَّة قد تشكَّلت إلى حدٍّ كبير، قبل نصف قرن، بفضل تجارب التخوم الغربيَّة الوعرة. على نحوٍ مماثل، كان يُنظَر إلى سكَّان التخوم الأفريقيَّة باعتبارهم ما دون البشر، وجزءاً من البيئة الطبيعيَّة، بحيث من الممكن استغلالهم، أو طردهم، أو إبادتهم بحسب الرغبة.
في شهر حزيران لعام 1904، وصل الجنرال لوثر فان تروثا، وهو ضابط استعماريّ ساكسونيّ بنى سمعته من خلال مساعدته على سحق انتفاضة الملاكمين في الصين، إلى جنوب-غرب أفريقيا ليتولَّى الإشراف على حرب الشوتزتروبه الانتقاميَّة ضدَّ الأوفاهيريرو. تبنَّى تروثا نهج "الإرهاب المطلق"، وأقسم على "تدمير العشائر المتمرِّدة بإراقة أنهار من الدماء". في شهر آب لعام 1904، لجأ قرابة ثلاثين ألفاً من الأوفاهيريرو إلى موقعٍ قريبٍ من مساكن عشيرة كامبازيمبي، عند سفح هضبة جبليَّة في ووتربِرغ. ضرب الشوتزتروبه طوقاً لمنع فرار الأوفاهيريرو غرباً، وأجبروا الرجال والنساء والأطفال على دخول صحراء كَلَهاري، حيث سيتعرَّض العديد منهم للمطاردة والقتل. في اليوم الثاني من شهر تشرين الأوَّل، أصدَر تروثا أمام قوَّاته أمرَ الإبادة سيِّئ الصيت:
"لم يَعد شعب هيريرو رعايا ألمان. لقد قَتلوا وسَرقوا، وقطَّعوا آذان الجنود الجرحى وأنوفهم وأجزاء أخرى من أجسادهم... يجب على شعب هيريرو... مغادرة هذه الأرض. وإن لم يُذعنوا لهذا فلسوف أجبرهم بواسطة {مدفعيَّة} غروت روهر. وضمن الحدود الألمانيَّة، سيردى كلّ فردٍ من هيريرو بالرصاص، سواءٌ أكان مُسلَّحاً أو أعزل، وبماشيةٍ أو بدونها. ولن أتسامح مع النساء والأطفال بعد الآن، سأجبرُهم على اللحاق بشعبهم، أو سأسمح بإطلاق النار عليهم".
على مقربةٍ من الموقع الذي أصدر منه تروثا أمره الإباديّ، والذي صار يعرف لاحقاً بتسمية "أوزومبو زو فينديمبا" (وتعني "آبار الأمراض الجلديَّة" بلغة الأوفاهيريرو)، لقي العديد من الأوفاهيريرو حتفهم ببطءٍ وعذاباتٍ مبرحة من جرَّاء شرب المياه من الآبار التي سمَّمتها القوَّات الألمانيَّة. كما استسلم كثيرون غيرهم للعطش والجوع في الصحراء. لم ينجُ سوى أولئك الذين كانوا على معرفة وثيقةٍ بتضاريس المنطقة، لا سيما أماكن العثور على المياه الجوفيَّة وكيفيَّة ذلك. بينما وجدَ البعض ملاذاً نسبيَّاً خارج الحدود في بيتشوانا لاند البريطانيَّة، المعروفة اليوم ببوتسوانا.
لا يُحيل الزعماءُ التقليديّون لشعبَي ناما وأوفاهيريرو تاريخ بداية الإبادة الجماعيَّة إلى الهجوم في ووتربِرغ، بل إلى غارةٍ لا يُعرَف عنها الكثير كانت قد حدثت قبل ذلك بأحد عشر عاماً. في يوم 12 من شهر نيسان لعام 1893، هاجمَت فرقة من الشوتزتروبه مستوطنةً للناما في المنطقة المعروفة باللغة الألمانيَّة باسم هورنكرانز، حيثُ كان مقرّ هندريك ويتبوي، زعيم عشيرة ناما ويتبوي. كانت المنطقة شمالاً ما بين ناما وأوفاهيريرو متنازعاً عليها، وكانت المناوشات شائعةً هناك، بيد أنَّ ويتبوي رفضَ كلَّ عروض الحماية الألمانيَّة، مُصرَّاً على أنَّه لا بدَّ من إفساح المجال للشعوب المحلِّيَّة كي تتعامل مع مشاكلها الخاصَّة بنفسها. في عام 1886، وأثناء تواصل وفدٍ ألمانيٍّ أرسله المسؤول الاستعماريّ هاينريش غورينغ، رفض ويتبوي التفاوض مع أيِّ شخصٍ آخر سوى الإمبراطور نفسه. وكان ردُّه: "أفهمُ أنَّكَ تريد التفاوض على السلام، أنت، يا من تُسمِّي نفسك "نائباً". لكن كيف أردّ؟ أنتَ مُمثِّلُ شخصٍ آخر، في حين أنَّني حرٌّ ومستقلّ ولا أخضع لأحد سوى الربّ". احتفظَ ويتبوي بمذكِّراته تُقدِّم منظوراً أفريقيَّاً مهمَّاً بصدد تجربة الاستعمار الألمانيّ.
كان رجال ناما مقاتلين متمرِّسين، وضمن مجموعاتٍ صغيرةٍ نصبوا من على ظهور خيولهم العديد من الكمائن الخاطفة ضدَّ القوافل الألمانيَّة كلَّما تعدَّت على أراضيهم. لم يتمكَّن رسَّامو الخرائط من دخول المنطقة، وظلَّت موقعها على الخريطة خاوياً. خلص الألمان إلى أنَّ السبيل الوحيد لإيقاف "السكَّان الأصليِّين المتمرِّدين" هو إبادتهم. وفي خلسة من الليل، اقتربَ الشوتزتروبه وشنّوا الهجوم مع بزوغ الفجر، ممَّا أجبر مقاتلي ويتبوي على الانسحاب. دمَّر الجنود الألمان المستوطنة، وقتلوا النساء والأطفال والعجائز. ثمَّ ما لبثوا أن أقاموا مركز شرطةٍ ومزرعةً فوق ركامها.
في الأعوام التي أعقبَت تلك الحادثة، واصلَت عشائر ناما الانضمام إلى المعركة ضدَّ الألمان. وفي اليوم 22 من شهر نيسان لعام 1905، أصدَر تروثا أمرَ إبادةٍ آخر، مُستهدفاً شعب ناما هذه المرَّة: "ستواجِهُ تلك القلَّة التي لم تخضع المصير نفسه الذي لاقاه شعب هيريرو، الذي أوهمه غروره أيضاً أنَّه قادرٌ على هزيمة الإمبراطور الألمانيِّ القويّ والشعب الألمانيّ العظيم. وإنَّني أسألُكم، أين هم الهيريرو اليوم؟". بحلول ذلك الوقت، كانت الحكومة الألمانيَّة قد أبطلَت أمر تروثا بإبادة شعب أوفاهيرير، بعد أنَّ أضرَّ بسمعة ألمانيا في أوروبا. لكنَّ أمرَه الآخر بإبادة شعب ناما لم يلغَ رسميَّاً قطّ.
زُجَّ بالناجين من شعبَي ناما وأوفاهيريرو في معسكرات اعتقال، حيثُ استُغِلّوا في أعمال السخرة لبناء طرقات المستعمرة وسككها الحديديَّة ومزارعها ونقاطها الإداريَّة. شهد العام الأوَّل من الأسر موت أكثر من نصف السجناء. وكان أحد معسكرات الاعتقال في جزيرة القرش، وهي شبه جزيرةٍ عاصفةٍ ومكشوفة بالقرب من ميناء لودريتز جنوبيّ المحيط الأطلسيّ، حيثُ تتكسَّر أميال لا تحصى من الكثبان الرمليَّة لتُشكِّل خليجاً صغيراً. كان هذا الموقع أوَّل مرسى يستخدمه البحَّارة البرتغاليون في القرن الخامس عشر. في جزيرة القرش، تعرَّض الأسرى للتجويع والضرب والاغتصاب والإعدام. وأُجبِرت النساء على سلق رؤوسٍ منزوعةٍ عن أجسادها، والتي كانت تعود في بعض الأحيان لأقاربهنّ- وكذلك كشط اللحم عنها باستخدام الزجاج كي يتسنَّى إرسال تلك الجماجم إلى المتاحف والجامعات والمجموعات الأنثروبولوجيَّة في ألمانيا. غالباً ما يُشير أحفاد الناجين إلى جزيرة القرش كأوَّل معسكر إبادة، باعتبار أنَّها شهِدت موت قرابة 80% من السجناء.
بحلول نهاية الحملة الألمانيَّة، في عام 1908، كان أكثر من 65,000 من شعب هيريرو (أي أكثر من ثُلثي تعدادهم الإجماليّ) قد قُتِلوا، وكذلك 10,000 من شعب ناما (أي قرابة نصف تعداهم الإجماليّ). وعلاوةً على ذلك، لم يسترد الناجون أراضي أجدادهم. بدلاً من ذلك، كُوفِئ عددٌ من الضبَّاط السابقين في الشوتزتروبه، ومن بينهم أولئك الذين شاركوا في الإبادة الجماعيَّة، بمزارع على أراضي ضحاياهم. في عام 1902، كان الأوروبيّون يمتلكون ما نسبته أقلّ من واحد بالمئة من جنوب-غرب أفريقيا؛ بعد الإبادة الجماعيَّة، تفاقمت تلك النسبة لتبلغ أكثر من عشرين بالمئة. كما لم تمسَّ حيازات المستوطنين الألمان للأراضي بسوء حينما احتلَّت جنوب أفريقيا، كدومينيون للإمبراطوريَّة البريطانيَّة، جنوب-غرب أفريقيا إبَّان الحرب العالميَّة الأولى: إذ تجاوزت الوشائج بين الأمم الاستعماريَّة الأوروبيَّة حالة العداء في زمن الحرب. زرع الأوروبيّون المناطق الخصبة، في حين اقتصرَ وجود السكَّان الأصليِّين على بانتوستانات في مناطق تعاني من الجفاف. ظلَّت هذه البنية لملكيَّة الأراضي قائمةً بعد الاستقلال عن جنوب أفريقيا وتأسيس ناميبيا في عام 1990.
اليوم، يملك 4500 مزارِع أوروبيّ، الذين يُشكِّلون نسبة 0.3% من تعداد السكَّان، ما نسبته 44% من أراضي ناميبيا، و70% من أراضيها الزراعيَّة. أسَّس أحفاد ضحايا الإبادة الجماعيَّة لأوفاهيريرو وناما بلداتٍ في "أوطانهم الإثنيَّة" حملت أسماء مساكن أجدادهم، ولم يتخّلوا قطّ عن مطالبهم بالحصول على التعويضات من ألمانيا وحقِّهم في العودة إلى أراضيهم.
بكلِّ إخلاصٍ وإصرار، دعمَت كلٌّ من سلطة أوفاهيريرو التقليديَّة ورابطة الزعماء التقليديِّين لناما القضيَّة الجنوب-أفريقيَّة ضدَّ إسرائيل، وعبَّرتا عن تضامنهما مع الفلسطينيِّين. وجاء في بيانهما المشترك أن: "نحنُ، شعبا أوفاهيريرو وناما، على درايةٍ تامَّةٍ بالعلاقة ما بين الاستعمار الاستيطانيِّ والإبادة الجماعيَّة، وكيف تبثق الإبادة الجماعيَّة كنتيجةٍ مباشرة، وذروة، لعنف الاستعمار الاستيطانيّ". على الرغم من ذلك، اتَّهمتا الرئيس الناميبيّ بـ "النفاق إلى أبعد الحدود"، بسبب مواصلته "لعب دورٍ سلبيٍّ وضارٍّ في وجه مساعي شعبَي ناما وأوفاهيريرو لتحقيق العدالة". هناك نزاع طويل الأمد بين المجتمعات المتضِّررة من الإبادة الجماعيَّة والحكومة التي يتزَّعمها حزب سوابو (المنظَّمة الشعبيَّة لجنوب غرب أفريقيا)، الذي تتشكَّل قاعدته الشعبيَّة من شعب أوفامبو ومجموعاتٍ إثنيَّةٍ أخرى في شمال ناميبيا، والتي لا يرتبط تاريخها بالاستعمار الألمانيّ، بل بالكفاح التحرُّريّ المسلَّح ضدَّ الفصل العنصريّ، الذي قادته سوابو (كنقابة عمَّاليَّة وحركة) بجانب المؤتمر الوطنيِّ الأفريقيّ (الحزب الحاكم في دولة جنوب أفريقيا). ما فعلتُه الحكومة من تأميمٍ للذكرى عَنى، في مُفارقةٍ تاريخيَّةٍ خارج السياق، تَحوُّل "الإبادة الجماعيَّة لشعبَي أوفاهيريرو وناما" إلى "الإبادة الجماعيَّة الناميبيَّة". تمحور النزاع حول أهمِّيَّة الإبادة الجماعيَّة بالنسبة إلى التاريخ الناميبيّ- حيث زعم جينجوب أنَّ "الفصل العنصريَّ كان أسوأ من الإبادة الجماعيَّة"- ومن يملك الحقّ في التفاوض مع الحكومة الألمانيَّة بشأن إقرارها بالمسؤوليَّة.
في عام 2015، وبعد أعوامٍ من نضال مُنظَّمات المجتمع المدنيّ الناميبيَّة والألمانيَّة، وافقت الحكومة الألمانيَّة على الاعتراف بحدوث إبادةٍ جماعيَّةٍ ما بين عامي 1904 و1908، ممَّا مهَّد الطريق نحو مفاوضاتٍ ثنائيَّة. كان موقف ألمانيا أنَّها لا تستطيع التفاوض إلَّا مع حكومةٍ أخرى، وأنَّ على الحكومة الناميبيَّة اختيار ممثِّليها. وعلى الرغم من أنَّ الوفد الذي شكَّلته ناميبيا ضمَّ أفراداً من شعبَي ناما وأوفاهيريرو، إلَّا أنَّه لم يشهد مشاركة مُمثِّلين عن سلطاتهم المنتخبة والتقليديَّة. في شهر أيَّار لعام 2021، توصَّل البلدان إلى اتِّفاق. وفي بيانهما المشترك، قالت ألمانيا إنَّها مستعدَّة للاعتراف بـ "مسؤوليَّتها الأخلاقيَّة عن استعمار ناميبيا"، والاعتذار عن "التطوُّرات التاريخيَّة التي أفضَت إلى الأوضاع الإباديَّة ما بين عامَي 1904 و1908". بدورها أعلنَت الحكومة الناميبيَّة عن "قبولها، وقبول شعوبها، اعتذار ألمانيا"، بيد أنَّها لم تتداول هذا الموقف مع المجتمعات المتضرِّرة.
في العام المنصرم، بعث عددٌ من المقرِّرين الخاصِّين في الأمم المتَّحدة رسالةً إلى الحكومتين لتوضيح أنَّه، وبالاستناد إلى إعلان الأمم المتَّحدة بشأن الشعوب الأصليَّة، الذي وقَّعته ألمانيا وناميبيا في عام 2007، فإنَّ "للشعوب الأصليَّة الحقّ في المشاركة في صنع القرارات التي تتعلَّق بمسائل من شأنها التأثير على حقوقهم، وذلك من خلال ممثِّلين يختاروهم بأنفسهم". تجسَّد موقف سلطة أوفاهيريرو التقليديَّة ورابطة الزعماء التقليديِّين لناما بشعار: "كلّ ما يتعلَّق بنا، دون مشاركتنا، هو ضدَّنا". جاء اعترافُ ألمانيا بالإبادة الجماعيَّة على نحوٍ أقلّ ممَّا كانت تأمله المجتمعات المتضرِّرة. اعتبرَت ألمانيا أنَّ اعترافها أخلاقيٌّ أكثر من كونه مُلزِماً قانونيَّاً؛ أي يمكن وصف الأحداث ما بين عامي 1904 و1908 كإبادةٍ جماعيَّة، لكن فقط إذا ما نُظِر فيها بالمنظور الراهن. وقد اعتمدَت في ذلك على شكلانيَّةٍ قانونيَّة لطالما واجهَت الطعن في قضايا الإبادة الجماعيَّة والعبوديَّة: يقتضي "مبدأ عبر الزمانيَّة" أنَّه لا بدَّ من تقييم المسألة القانونيَّة على أساس القوانين السارية في زمن ارتكاب الفعل. وجادَلت ألمانيا أنَّه باعتبار أنَّ اتفاقيَّة الأمم المتَّحدة لمنع الإبادة الجماعيَّة لم تدخل حيِّز التنفيذ حتَّى عام 1948، فإنَّه لا يمكن تطبيقها على الإبادة الجماعيَّة في جنوب-غرب أفريقيا. يستحضر هذا في الذهن ذريعةً مشابهةً قدَّمها آيخمان خلال محاكمته في القدس: بما أنَّ لأوامر هتلر "قوَّة القانون" في الرايخ الثالث، فإنَّ أفعال آيخمان متماشية مع القانون في ذلك الوقت. كان القتل الجماعيّ للمدنيِّين في سياق الحرب غير قانونيٍّ بالفعل بموجب شروط اتِّفاقيَّة لاهاي في عام 1899، أي منذ ما قبل ارتكاب كلتا الإبادتين الجماعيَّتين: لكن بما أنَّ القانون الدوليَّ يشير إلى الحروب بين "الشعوب المتحضِّرة"، فقد عنى هذا استثناء العنف الاستعماريّ ضدَّ الشعوب الأصليَّة. تذرَّعت ألمانيا بأنَّه لا ينبغي تقييم الجرائم المرتكبة في جنوب-غرب أفريقيا وفقاً للمعايير القانونيَّة المعاصرة، بل استناداً إلى القوانين العنصريَّة للحقبة الاستعماريَّة. دفع هذا سيما لويبرت، الناشطة في رابطة الزعماء التقليديِّين لناما، إلى الردّ بأنَّ ما تقوله ألمانيا في الواقع هو أنَّ شعبَي ناما وأوفاهيريرو قد أُبيدا باعتبارهما "همجاً غير متحضِّرين".
بالإضافة إلى ذلك، عَنى إقرار ألمانيا بالإبادة الجماعيَّة بمعناها التاريخيّ وليس القانونيّ أنَّها تتنكَّر لأيِّ التزامٍ بدفع التعويضات أو تسهيل إعادة الحقوق. كان من شأن الإقرار بالمسؤوليَّة القانونيَّة أنَّ يخلق سابقةً يمكن استخدامها من قبل الشعوب المستعمَرة الأخرى التي عانت من إباداتٍ جماعيَّةٍ على أيدي الدول الأوروبيَّة، بما في ذلك فرنسا وبريطانيا. أعلنَت ألمانيا أنَّها ستدفع 1.1 مليار يورو على مدى ثلاثين عاماً على صورة مساعداتٍ إنمائيَّة. قبل الاستعمار، كان شعبا أوفاهيريرو وناما أغنياء على صعيد الأراضي، والماشية، والثقافة. تُبيِّن لويبرت المسألة بالقول: "إنَّما التنميةُ أعظم أكذوبةٍ شماليَّة، وهي السخاء المفترض لحضارةٍ قامت على اضطهادنا". تصرُّ المجتمعات المتضرِّرة على أنَّه ينبغي على ألمانيا شراء بعض أراضي الأجداد من نسل المستوطنين الألمان وإعادتها إلى أصحابها. بعد مرور ثلاثة أعوامٍ من نشره، وكنتيجةٍ لاعتراض جماعات المجتمع المدنيِّ وأحزاب المعارضة الناميبيَّة، فإنَّه لم يصادق على ذلك الإعلان المشترك أيُّ من البرلمانين الألمانيّ والناميبيّ.
في أحيانٍ عديدة، تشيرُ سلطة أوفاهيريرو التقليديَّة ورابطة الزعماء التقليديِّين لناما إلى صلاتٍ تاريخيَّة بين الإبادة الجماعيَّة التي تعرَّضوا إليها والمحرقة. "لطالما شعرنا بالتعاطف والتقارب مع الشعب اليهوديّ، كناجين من الإبادة الجماعيَّة الألمانيَّة، وبالإلهام من سعيه للحصول على التعويض"، جاء في بيانهما المشترك، "وليس مردُّ هذا فقط أنَّنا عانينا من إبادةٍ جماعيَّةٍ أيضاً، بل لأنَّ المحرقة اليهوديَّة على ارتباطٍ مباشرٍ كذلك بما حدث في جزيرة القرش وغيرها من مُعسكرات الإبادة التي أنشأها الألمان على أراضينا".
هناك استمراريَّةٌ جليَّة بين الإبادتين الجماعيَّتين الألمانيَّتين: إذا جرى استخدام العديد من العناصر الرئيسيَّة للنظام النازيّ- على غرار الإبادة المنهجيَّة للشعوب التي يُنظَر إليها باعتبارها أدنى عرقيَّاً، والقوانين العرقيَّة، ومفهوم ليبنسراوم (المجال الحيويّ)، ونقل البشر في شاحنات البهائم لإجبارهم على أعمال السخرة في معسكرات الاعتقال- في جنوب-غرب أفريقيا قبل نصف قرنٍ من الزمن. بل حتَّى أنَّ هاينريش غورينغ، الحاكم الاستعماريّ لجنوب-غرب أفريقيا الذي حاول التفاوض مع هندريك ويتبوي، ليس في الحقيقة سوى والد هيرمان غورينغ (مؤسِّس الشرطة السرِّيّة الألمانيَّة غستابو، وقائد كتيبة العاصفة).
ربَّما لا يزال إشكاليَّاً الادِّعاء بأنَّ هناك علاقةً بين الاستعمار والاشتراكيَّة القوميَّة في الأوساط الأكاديميَّة والسياسيَّة الألمانيَّة، وفي الإعلام أيضاً، لكنّ من المؤكَّد أنَّه ليس بجديد. في كتابها "أصول الشموليَّة" الصادر عام 1951، تناقش حنَّا أرنت أنَّ "الإمبرياليَّة الأوروبيَّة لعبت دوراً جوهريَّاً في تطوُّر الشموليَّة النازيَّة وما رافقها من إباداتٍ جماعيَّة". إنَّ "تأثير بومِرانغ"، كما عَرَّفه إيمي سيزير، يُحدِّد الفاشيَّة الأوروبيَّة باعتبارها عودة العنف الاستعماريّ. في عام 1947، كتبَ دبليو. إي. بي. دو بويز أنَّه "ما مِن فظائع نازيَّة -من قبيل مُعسكرات الاعتقال، والقتل والتشويه بالجملة، وهتك حرمة النساء، والإساءات المروِّعة للطفولة- إلَّا وقد سبق أن مارستها الحضارة المسيحيَّة في أوروبا لفتراتٍ طويلة ضدَّ الشعوب الملوَّنة في مختلف أرجاء العالم". ومؤخَّراً، نوقشَت هذه الصلات في أعمال كلٍّ من ديفيد أولسوغا وكاسبر دبليو. إريكسِن في كتابهما "محرقة القيصر" (2010)؛ ويورغِن زيمِّرِر في كتابه "من ويندهوك إلى أوشتفيتز؟" (2019). تستند الروابط بين الإبادة الجماعيَّة في جنوب-غرب أفريقيا والمحرقة إلى شيءٍ آخر يتحدَّث عنه زيمِّرِر بإسهاب: ألا وهو البعد الاستعماريّ لحرب الإبادة النازيَّة في أوروبا الشرقيَّة. يُبيِّن تيموثي سنايدر أيضاً أنَّ الأطماع الاستعماريَّة قد حوَّلت "الأرض السوداء" للسهوب الأوكرانيَّة إلى "أراضٍ من الدم" للغزو، والاستعباد، والإبادة الجماعيَّة على أساسٍ إثنيّ. بعد خسارة ألمانيا الإمبرياليَّة إمبراطوريَّتها الاستعماريَّة في الحرب العالميَّة الأولى، خطَّط النازيّون لتحقيق الليبنسراوم عبر استعمار المناطق الخصيبة المنتجة للغذاء في أوكرانيا، حيثُ يعيش أغلب يهود أوروبا الشرقيَّة. وربَّما شكَّلت سياسات ألمانيا الاستعماريَّة عوامل التدمير شبه الكامل لليهود، واستعباد الشعوب السلافيَّة في أوروبا الشرقيَّة، لكنَّ البعدَ الاستعماريّ- الإمبرياليّ وحدَه غير كافٍ لتفسير كافَّة جوانب المحرقة، باعتبار أنَّ لها جذوراً أيديولوجيَّةً في معاداةٍ ساميَّة أوروبيَّة تسبقُ الاستعمار بوقتٍ طويل.
لم يقتصر الربط ما بين الإبادة الجماعيَّة الناميبيَّة والمحرقة على الأوساط الأكاديميَّة وحسب. ففي عام 2017، رفع مُدَّعون بالنيابة عن منظَّماتٍ من ناما وأوفاهيريرو دعوى قضائيَّةً جماعيَّة ضدَّ ألمانيا في نيويورك، زاعمين أنَّ جزءاً من الثروات الناجمة عن أعمال السخرة ومصادرة الممتلكات في جنوب-غرب أفريقيا سابقاً قد استُثمِر في المدينة الأميركيَّة؛ ومطالبين بالجبر والتعويضات القانونيَّة نفسها التي حصل عليها الناجون اليهود من المحرقة. بعد عامين، أعلن القاضي أنَّه ليس للقضيَّة أساسٌ قانونيّ، ورُفِضت على إثر ذلك.
على مدى الأعوام القليلة الفائتة، زرتُ ناميبيا عديد المرَّات بصحبة فرقٍ من منظَّمة الهندسة الجنائيَّة "فورنسك أركيتكتشر" ومجموعتها الشقيقة في برلين "فورنسيس". وكانت كلٌّ مِن سلطة أوفاهيريرو التقليديَّة، ورابطة الزعماء التقليديِّين لناما، ومؤسَّسة أوفاهيرير/ أوفامباندرو للإبادة الجماعيَّة، قد طلبَت منَّا التعاون مع المؤرِّخين الشفويِّين التقليديِّين من أجل تحديد، ورسم خرائط، قرى الأجداد التي تعرَّضت للتدمير إبَّان الإبادة الجماعيَّة، ومعسكرات الاعتقال والمقابر الجماعيَّة، والمساعدة في بناء ملفَّات الأدلَّة التي ستُقدَّم دعماً للقضايا التي تطالب بالمحافظة عليها، وكذلك بالتعويضات واسترداد الأراضي. وفي شهر كانون الأوَّل، وبالتعاون مع سلطة أوفاهيريرو التقليديَّة ورابطة الزعماء التقليديِّين لناما، قدَّمنا مُخرَجاتنا في مركزٍ ثقافيٍّ في برلين، وكذلك أمام لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألمانيّ (البوندستاغ).
بعض المواقع التي حدَّدناها توجد اليوم في مزارع تعود ملكيَّتها لنسل الشوتزتروبه. المزارع المحيطة بووتربِرغ قد تحوَّلت خلال العقود الأخيرة إلى محميَّات صيد للسيَّاح. أحياناً، وخاصَّة في الأيَّام التذكاريَّة، تُمنَع المجتمعات المتضِّررة من الوصول إلى المنطقة بذريعة أنَّها قد تعكِّر صفو الحياة البرِّيَّة. ينطوي هذا على مفارقةٍ تاريخيَّة: إذ جُرِّد السكَّان الأصليّون من مُمتلكاتهم لأنَّهم، استناداً إلى المبدأ القانونيِّ للأراضي المباحة الذي كان مُستخدماً لتسهيل نقل الأراضي من السكَّان الأصليِّين إلى المستوطنين إبَّان الحقبة الاستعماريَّة، كانوا يُعتبرون "جزءاً من البيئة الطبيعيَّة"!
تَنتشر في جميع أنحاء ناميبيا نصبٌ تذكاريَّة لا حصر لها لمرتكبي الإبادة الجماعيَّة من الألمان. بيد أنَّ غياب التمويل الحكوميّ والإهمال البنيويّ، قد تسبَّبا في تداعي عددٍ من المواقع ذات الأهمِّيَّة للمجتمعات المتضرِّرة. في سواكوبموند، أخذ السكَّان المحليّون على عاتقهم مسؤوليَّة صيانة إحدى المقابر التي دُفِن فيها ضحايا الإبادة الجماعيَّة على الرغم من اعتراض سكَّانٍ بيض في الغالب كانوا يستخدمون الموقع كحقلٍ اختبارٍ للدرَّاجات المخصَّصة للتضاريس الوعرة. هناك مواقع تاريخيَّة أخرى غير معروفة أو غير محدَّدة. يعتمد اقتصاد ناميبيا على السياحة الأوروبيَّة، لذا من شأن إحياء ذكرى إبادة جماعيَّة أوروبيَّة أن يُشعِر الزوَّار بعدم الارتياح. في المخيَّم السياحيِّ لمنتزه ووتربرغ الوطنيّ، يجد المرء مطعماً يُقدِّم أطباقاً ألمانيَّة- كان طبق "الشنتزل" ضمن القائمة عندما كنتُ هناك- يَشغل موقع مركز شرطةٍ يرجع للحقبة الاستعماريَّة. في المطعم أيضاً، صورةٌ للقيصر تطلُّ فوق روَّاده، في حين يُجلَب النبيذ من قبوٍ كان ذات يومٍ سجناً إبَّان الإبادة الجماعيَّة. وأمَّا بالنسبة إلى المقبرة الوحيدة في المنطقة- والتي تحظى بعنايةٍ جيِّدةٍ وزياراتٍ كثيرة- فتضمُّ رفات الجنود الألمان الذين قُتِلوا أثناء هجوم الأوفاهيريرو في ووتربرغ. لا تدرك سوى قلَّة من زوَّار هذه المساحة الطبيعيَّة الخلَّابة أنَّ تلك المقبرة تقع على أنقاض مساكن عشيرة كامبازيمبي، التي دُمِّرت في شهر آب لعام 1904. تأكَّدنا من هذه الحقيقة، التي يَعرفها المؤرِّخون الشفويّون، من خلال صورةٍ وحيدةٍ للقرية عثرنا عليها ضمن الأرشيف الفوتوغرافيّ الاستعماريّ في فرانكفورت. وكان ذلك بفضل تكوينٍ صخريٍّ مُميَّزٍ في السلسلة الجبليَّة، يقع في خلفيَّة الصورة، تَكفَّل بحسم هذه المسألة.
في زيارةٍ حديثةٍ إلى المزرعة التي لا تزال تحمل اسم هورنكرانز- وتجدر الإشارة هنا إلى أنَّه يتعيَّن على المرء اتِّخاذ تدابير خاصَّة من أجل الدخول إليها- رأينا لافتتين من حقبة الفصل العنصريّ تسيئان تمثيل الإبادة الجماعيَّة إذ تصفاها بـ "معركة"، وتستخدمان ألفاظاً تحقيريَّة لوصف شعب ناما. وأثناء تجوُّلنا عبر الصخور المحيطة بالمزرعة، عثرنا على خراطيش بندقيَّة تعود للقرن التاسع عشر، تَشهَد على موقع المناوشات التي سبقت المجزرة. كذلك حافظَت البيئة الجافَّة على آثار أخرى؛ على غرار آثار منازل مصنوعةٍ من الخشب والقشّ، ممَّا سمح لنا برسم خريطةٍ تُبيِّن نطاق المستوطنة.
في موقع معسكر الإبادة في جزيرة القرش، عمدت الحكومة الناميبيَّة إلى سكب الحصى بغية تسهيل مرور السيَّارات عبر الصخور، وأنشأت طاولاتٍ ومقاعدَ للسيَّاح الراغبين بالتخييم والشواء هناك. وذلك بدلاً من أن تصير "مكاناً للتأمُّل والذكرى، مكاناً يُحذِّر من أهوال أفعال الإبادة الجماعيَّة التي يجب ألَّا تحدث أبداً"، يقول يوهانِّس إيزاك، وهو زعيم ناميّ وعضو في مجلس رابطة الزعماء التقليديِّين لناما، "وبعد 33 عاماً من استقلالها، ما زالت جزيرة القرش وجهةً سياحيَّةً حيثُ يتسنَّى للزوَّار... تناول الطعام والنبيذ فوق عِظام الأبطال والبطلات الذين أطلقوا شعلة المقاومة ضدَّ الاحتلال الاستعماريّ".
أنا اليوم في ناميبيا لحضور الذكرى السنويَّة لبداية الإبادة الجماعيَّة، في يوم 12 نيسان، في هورنكرانز، ودعم المساعي القانونيَّة للمجتمعات من أجل وقف التوسُّع الوشيك لميناء لودريتز في ذلك الموقع. المفارقة هي أنَّ هذا التوسُّع المزمع هو جزءٌ من مشروع ضخم "للطاقة الخضراء" مدعومٍ من قبل الحكومتين الناميبيَّة والألمانيَّة. الرياح العاتية التي جلبَت الاستعمار إلى هذه الشواطئ وتسبَّبت في موت بعض السجناء تجمُّداً في جزيرة القرش، هي نفسها التي ستشغِّل مئات التوربينات من أجل إنتاج الهيدروجين السائل- الوقود الذي سيُحمَل إلى أوروبا من رصيفٍ في جزيرة القرش.
بعد أسابيع قليلة من السابع من تشرين الأوَّل، كتبَ ديدييه فاسين أنَّ هناك "تشابهاتٍ مُقلِقة بين ما حدث في جنوب-غرب أفريقيا وما يحدث اليوم في غزَّة". ففي كلتا الحالتين، يأتي القتل الجماعيّ، والتدمير، والتشريد، في أعقاب هزيمةٍ عسكريَّةٍ مُذلَّة على أيدي شعبٍ كانوا يعتقدون أنَّه أدنى منزلة. وتصرُّ السلطات التقليديَّة لكلٍّ من ناما وأوفاهيريرو على الاعتراف بهذه السرديَّات التاريخيَّة المستمرَّة، بالقول: "إنَّ تجربتنا المشتركة مع الاستعمار الاستيطانيّ والفصل العنصريّ قد أضحَت منصَّةً، لكن ليس من أجل المطالبة بالتميُّز والتفرُّد، بل لتحقيق العدالة العالميَّة، والسعي للتضامن والحرِّيَّة العالميَّة". من المهم بمكانٍ الإصغاء إلى هذه الأصوات؛ إذ بمقدور مثل هذه السرديَّات المستمرَّة أن تجمع تاريخ المحرقة مع تاريخ الاستعمار والاستعباد، وبالتالي تفسح المجال للإقرار بالتضامن التاريخيّ بين السود واليهود، وبين اليهود المناهضين للصهيونيَّة والفلسطينيّين.
يتسبَّب إصرار إسرائيل وألمانيا على التفرُّد والاستئثار بالمحرقة في إحداث فجوةٍ بين السرديَّات التاريخيَّة لمعاداة الساميَّة والعنصريَّة، إلى درجةٍ تجعل من هذين النموذجين من القوَّة السياسيَّة، اللذين تغذِّيهما الكراهية، يتنازعان مع بعضهما البعض. ضمن هذا السياق، فمن الملهم أن قرَّرت مجموعات ناما وأوفاهيريرو الردَّ على المناخ السياسيِّ القائم على الرقابة والترهيب ضدَّ أيَّ تعبيرٍ عن دعم الفلسطينيّين- الأمر نفسه الذي عانت منه تلك المجموعات إبَّان زيارتها لبرلين في شهر كانون الأوَّل. "نُلاحظُ بعين القلق أيضاً الهجمات ضدَّ أصوات الناشطين من فلسطين، والجنوب العالميّ، والعالم الإسلاميّ، وكذلك الفنَّانين والباحثين اليهود المعارضين الذين ينتقدون السياسات الإسرائيليَّة على العلن. ونحنُ نقف في صفِّهم لأنَّنا ندركُ معنى قول الحقيقة في وجه القوى القمعيَّة، وما هي عواقب مثل هذه الأفعال".