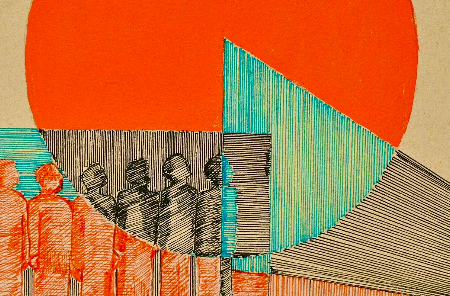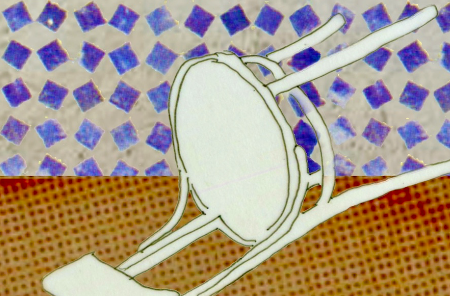منذ أكثر من مائة يوم وأنا أعاود الكرّة ذاتها، وصارت القُبلة كرزيّة، لكن كالكرز الذي تصنعه الصين، وترسلها إلينا عبر حاويات يحملها البحر. إنّها الصين تُرسل إلينا فاكهة بلاستيكية وترسم للعالم حياة جديدة خالية من القُبل ومن أشياء حميمة أخرى، أولم يقل بونابرت يوما "الصين تنين نائم لا توقظوه".
ربما ليس الأثر الذي تركته وتتركه جائحة كورونا على العالم أقلّ وطأة هاهنا! في مدينة قامشلي، يبدو أنّ الجائحة استثنتها عن العالم إلى حين ظهرت الحالات لدينا متأخرة بعد أن صار نصف الشعب عارفا بأمور الفايروس أكثر من الأطباء ربما، لما لهذه الجائحة من إفرازات معرفية اندلقت وتندلق علينا المعارف حولها كما لم يتم مع جائحة أو وباء آخر عبر التاريخ على ما أعرف.
إذن لنعد إلى الجائحة وحكايتنا معها. إنّ الجائحة هاهنا تأخذ أبعادا أخرى، ففي بلاد شهدت كورونا بالفعل وبأعداد هائلة بالآلاف كان هناك تعامل مع كيان ما، مرض ما، له وجوده، لكن وعلى اعتبار أنّنا لا نشهدها شهود جائحة تطال الآلاف، فإنّ الجائحة تأخذ شكلا آخر، فنحن نخشى تداعياتها أكثر منها، فنفكّر بالعمّال المياومين، وأفكّر أنا بقريبي الذي خسر عمله لمدة شهرين متكبّدا خسائر فادحة في هذه الأيام العصيبة مع هبوط انتحاري لليرة السورية.
هنا خشية من جائحة فاقة الفقر، فالحياة التي تزداد وتيرة الاستهلاك فيها، والبلاد التي تشهد أتون الحرب وألوانها، والسجون والشهداء والعزلة والأمل واليأس، إذن هناك خشية من أمور أخرى تفرزها الجائحة أو لنقل تعرّي عن جانبها.
سحابة شهرين مكثت في المنزل، كان أطفالي فرحين بملازمتي شبه الطوعية، لكنّهم كانوا يحتاجون للخروج من قمقم العزلة، لذا كنت أُخرج بهم في مشاوير قصيرة ضمن الحارة التي حفظوا كلّ شوارعها القصيرة في مربعنا عن ظهر قلب، بإمكانهم أن يعرفوا أو يتعرّفوا على كلّ ما في الطريق، فبعد مئتي متر سيجدون ذات الأطفال يلعبون كرة قدم صغيرة يستعجلون عبورنا، فرحين لخلوّ الشارع إلا من سيارتي سلحفاتية السرعة، وذلك طمعا منا في تزجية أكبر وقت ممكن في مربع الحارة.
بعد فترة الحظر الكلّي تطوّر الأمر فكبُر المربّع، لكنّه لا يزال غير كافٍ لرغبة الأطفال من الخروج من قمقم العزلة، فالحدائق لا تزال مٌغلقة والشوارع مغلقة في غالبيتها، وهكذا تناوب الحظر الكلّي وأعقبه الجزئي حتى تم إلغاء كافة أنواع الحظر.
لكن ماذا عن لحظة القبلة؟!
في فترة العُزلة والحظر، صار الجميع مثقّفا في حيثيات الجائحة، بل صاروا يُجارون الكُسالى من أطباء المدينة من اختصاص الأنف والحنجرة، وخاصة أنّهم يتلقّون تحديثات مستمرة حول الجائحة، وصار الجميع عليما بها وبطرق تداولها وحتى إجراءات الدول ومنظمة الصحة العالمية، والتطوّرات المستمرة، وكذلك نظريات المؤامرة التي حُيكت أو حيكت عنها.
أعرف أنّ الكثيرين كانوا ولا يزالون غير مبالين، ويؤمنون بنظرية أنّ من شرب من صنابير مياه المدرسة فلن يُصاب بالفايروس أبدا (وهذا سمعته من أكثر من شخص، حيث تعدّ صنابير المدارس الملوّثة في العهد الذهبي للبعث علامة فارقة على اكتساب المناعة)، لكن في المقابل ثمة من بالغ في العناية بالنظافة وصار يُمعن في استخدام ديتول وأخواتها (كنت أقول قبل الجائحة كلما شاهدت إعلانات ديتول، أنّ هذه الشركات أنفقت أطنانا من المال لإقناع السوق الخليجية بضرورة الوصول بالنظافة إلى حدّ أن تصير وسواسا).
بالنسبة إليّ لا أبالغ في النظافة ولا في تدابير الوقاية ولا أتسيّب فيها، لكنّني التزمت فيما التزمت أن أغسل يدي بالصابون ووجهي بفرك الماء جيدا، لكن، هل هذا الإجراء جيّد؟!
بالتأكيد سيربت البعض على كتفيّ ويضحك آخرون، لكن دعوني أقول لكم أنّني خسرت قُبلتي!
لا شيء يزيد من الحب كالقُبلة، ولا شيء يعوّض ملوحة شفاهنا المتعبة وهي تطبع قُبلة.
أدرتُ المفتاح ودخلت، فكان طفلاي بابتساماتهم المختبئة وراء امتعاض مُصطنع، وتذكّرت أنّ عليّ أن أغسل يدي ووجهي بداية، ثم أعود فأحضنهما وأقبّلهما كما اعتادا، لكن المسافة بين صنبور الماء والمِنشفة والعودة واصطناع لحظة الولوج إلى المنزل أفقَدتْ القُبلة طعمها ونكهتها الكرزية.
للقُبلة لحظتها، التي لا يمكن أن تعوِّض حرارتها إن غيّرتَ ميقاتها (اطبعِ القُبلة لميقاتها!) فإنّ قوما (يؤخّرون القُبلة عن ميقاتها) يفقدون الحبّ، وتتيبّس شفاههم.
لا أعلم كيف أقوّم هذا الأمر دون أن يغرز ضميري، لكنّ الحبّ والخوف، يدفعك لتأخير ميقات القبلة، ويدفعك إلى ألقِ الخسارة.
منذ أكثر من مائة يوم وأنا أعاود الكرّة ذاتها، وصارت القُبلة كرزيّة، لكن كالكرز الذي تصنعه الصين، وترسلها إلينا عبر حاويات يحملها البحر. إنّها الصين تُرسل إلينا فاكهة بلاستيكية وترسم للعالم حياة جديدة خالية من القُبل ومن أشياء حميمة أخرى، أولم يقل بونابرت يوما "الصين تنين نائم لا توقظوه".