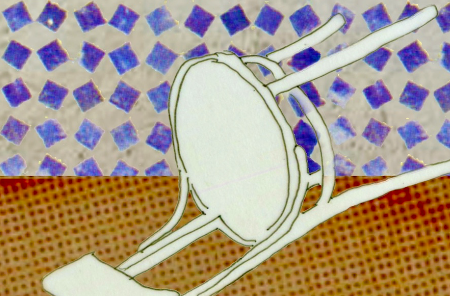حزينة لأنه غير مسموح لي أن أحزن بينما شقيقتي شيماء آخر العنقود تبحث منذ أسبوعين عن رقعة من الأرض لتنصب فيها خيمة تأويها وزوجها وطفليها، وحزينة جدًا لأنني لا أجرؤ على استخراج ومشاهدة الفيديو الذي التقطته لغزة يوم سفرنا.
في الصباح الباكر لليوم السادس من سبتمبر الماضي استقلتني السيارة برفقة زوجي وأطفالي من أمام باب بيتنا في حي الرمال بغزة، وانطلقنا باتجاه معبر رفح البري، كانت السيارة تجر عربة محملة بشنط سفر كثيرة تشي بأن أصحابها سيطول غيابهم.
التقطتُ الهاتف المحمول بيدِ مرتجفة وبدأت أسجل مقطع فيديو للطريق، لقد سلك السائق شارع البحر "الرشيد" اختصارًا للمسافة، كانت المدينة الجميلة مبللة بالندى ولم يخرج الناس بعد إلى أشغالهم، كنت في انفراد معها، شعرت بالرهبة وبكيت كثيرًا لأسباب أعلمها ولا أعلمها، دققت النظر في الشوارع، المحلات، البيوت وحيطانها التي اتُخذ منها صحيفة للكتابة والتعبير، طلبت من السائق التوقف عند شارع بيت أهلي في حي الزيتون، ركضنا نحو البوابة الصفراء حيث كانت أمي بانتظارنا، ومن فوقها تتدلى ياسمينة زرعتها منذ سنوات طويلة، أما أبي فقد سبقني السفر إلى مشافي الضفة الغربية للاطمئنان على قلبه.
احتضنتني أمي كثيرًا وقالت مبتسمة "ستكونين بخير مع زوجك وأطفالك"، ودعتها وأكملنا طريقنا نحو المعبر، أشعر الآن أن كرة من اللهب أكلت الأخضر واليابس كانت تعدو خلفنا طيلة الطريق؛ فقد بدأت المحرقة بحي الرمال لرمزيته لدى الغزيين، وتم محو المعالم الراقية لشارع الرشيد، وانهال بيت أهلي الكبير على الأرض، لا أثر للبوابة الصفراء ولا الياسمينة!
شهر واحد فقط مضى على خروجي من قطاع غزة قبل بدء العدوان الإسرائيلي عليه، لم أكن قد انتهيت بعد من افراغ شنط السفر، ولم أتمكن من التحدث مع أهلي لأخبرهم عن شقاء مسافة 9,584 كيلو متر قطعناها وصولاً إلى كندا برفقة ثلاثة أطفال تحت سن الرابعة، ولا عن قراري بالعودة إلى غزة والذي اتخذته فور وصولنا إلى المدينة الباردة، فما أن دلفنا إلى البيت حتى شعرت بأنني محتجزة بين جدرانه الأربعة، شعور لم أختبره من قبل؛ وأنا التي قضيت 32 عامًا من عمري في أكبر سجن في العالم؛ غزة المدينة المحاصرة منذ 18 عامًا والتي لا تتجاوز مساحتها 365 كيلومتر، إلا أنني حوصرت فعلاً في قلب قارة أمريكا الشمالية.
منذ وصولنا إلى كندا لم أكف عن المقارنات بينها وبين غزة، فقد كانت الأخيرة هي الرابحة دومًا؛ وعدتُ محبطة في أول مشوار تسوق أجريناه وعناء البحث عن الطعام الحلال وملحمة الأسعار التي بدت غير منطقية بالنسبة لحديثة عهد مثلي.
زارتنا احدى زميلات زوجي في الجامعة وكنت أعرفُ مسبقًا أنها من غزة، رحبت بها وقبل أن نصعد السلم قلت بحماس "أنت من غزة إذًا !"، لكنها صفعتني حين نفت ذلك بمزاج متعكر "اه لا .. في الحقيقة غادرت غزة منذ سنين، وعشت في الكويت"، شعرت وقتها بأنا غزة التي أحملها بين ضلوعي عليها أن تبقى كذلك ولا داعٍ لاستدعائها في الأحاديث والوجوه.
حتى أعادت غزة نفسها بنفسها إلى صدارة أخبار العالم، وبعد أن كنتُ مركز اهتمام عائلتي؛ إلا أننا سرعان ما تبادلنا الأدوار وأصبحت ألاحق أخبارهم بفزع، كابوس طويل دخل في شهره الخامس، إنه العدوان الأول الذي يحدث بعد أن لفظتني غزة من بطنها بعيدًا؛ لكنه بالتأكيد الأكبر خسارة بالنسبة لي ولعائلتي!
ففي السابع من نوفمبر دمرت طائرات الجيش الإسرائيلي مربعًا سكنيًا كاملاً في حي الشجاعية، وكان شقيقي تامر قد لجأ إلى بيت أنسبائه في نفس الحي برفقة زوجته هند وأطفالهم "تالا، زينب، خليل"، ظلّ أبي يبحث لثلاثة أيام في أنقاض البيت المدمر، حفر الباطون بأظفاره لكن دون جدوى، الأرض ابتلعت البيت وبقي شقيقي تحت الأنقاض حاله كحال آلاف آخرين استحال استخراجهم بسبب القصف المتواصل وعدم وجود وقود لفرق الإنقاذ، كما أن الجيش أمر الناس بإخلاء غزة باتجاه الجنوب وقد فعل ذلك أهلي مجبرين.
"ما قدرت أطلع أخوك يابا" يبكي أبي معتذرًا لروح ابنه، بينما تريد أمي رؤية جثمانه لتصدق بأنها فقدته وفقدت أحفادها للأبد، تريد رؤيتهم حتى تأذن لعينيها بالبكاء "نفسي أعيط يما مش قادرة، عيني بتوجعني الدمع فيها متل الحجر"!
كنتُ قد أعدّت نفسي مسبقًا لمواجهة عناء اكتئاب الغربة والحنين لأسرتي الكبيرة، كم كنت محظوظة بأن أصبحت عمَة وخالة في سن صغيرة، لكنه بدا لي ترفًا أن أعاني من مشاعر إنسانية طبيعية، فجاء الفقد مفجعًا وتهاويت من الضعف والوحدة، لا أب لا أم ولا أخوة يشاركونني البكاء على فقد شقيقي الشاب الرشيق ذو اليدين القويتين، الذي يستطيع فعل كل شيء، لقد كان مقربًا من الجميع، لأنه المنقذ الأول لنا عند كل مأزق، ابتداءً بإصلاح لعبة أطفالنا وحتى تدبر مشاكل الكهرباء والمياه والأجهزة، يكفي أن تعرض عليه مشكلتك حتى يبدأ بتخيل طريقة العمل، رفيق المبيت مع والدي في المستشفى بسبب عدة عمليات أجراها في القلب، لقد كان له من اسمه نصيب "تامر كثير الثمر".
"هذه أول مرة أعمل عملية والشهيد ما يقوليش الحمدلله على السلامة يابا" أرسل أبي هذه العبارة على جروب العائلة عبر الواتساب، بعد اجراءه عملية تركيب بلاتين داخلي لقدمه، إثر إصابته بينما كان هائمًا في رفح يبحث عن كيس طحين، ولا أعرف كيف جاءه الجلد ليكتب هذه الجملة، قضيت ليلتي أتقلب في السرير وأهذي بشقيقي، أتخيله خارجًا من تحت الأنقاض منقذًا نفسه بنفسه كما كان يفعل دائمًا، شقيقي تامر الذكي العنيد.
بعد فقداني لخمسة أفراد من عائلتي أصبحت في رعب دائم، لقد سقطت هالة النجاة عن البقية، انني دائمة القلق وألاحقهم على الواتساب، أبي، أمي، شقيقتي شيماء وشقيقي أحمد، شقيتي زينب العالقة في غزة، صديقاتي، لقد أصبحنا نحن المغتربون مصدر الأخبار بالنسبة لهم، "في جديد؟ في أخبار عن تهدئة؟" يطلبون منا أخبار مطمئنه، لكنني وبعد دخول العدوان في شهره الخامس سأتوقف عن الكذب عليهم!، لا أخبار عن وقف قريب لهذه الإبادة الجماعية.
كنت أحلم باللحظة التي يتوقف فيها الموت ويعود أبي وأمي إلى بيتهما لترتاح عظام جسديهما قليلاً من ذُل النزوح، سيستردان جزءً من كرامتهما فقط حين يعودا بين جدرانه الأربعة، إلا أن هذا الحلم أيضًا تم القضاء عليه، فحين عادت الاتصالات، علمت من ابن شقيقتي "قاسم" أن بيتنا صار كومة دمار، فور سماعي للخبر شعرت بفراغ في بطني وافترشتُ الأرض، أخذت أشكك في معلومته ليتراجع عنها، لكنه أكد ما رأته عيناه، أنهيت المكالمة وصرخت باسم زوجي "محمد دار أهلي راحت!".
بكيت يومها بحرقة وكان أول من خطر ببالي شقيقي تامر، ماذا كان سيفعل إزاء هذا الحدث؟ بالتأكيد لديه الحل!، لن يسمح بأن تبقى شقته وألعاب أطفاله تحت الأنقاض، في هذا العدوان خسرنا كل شيء، شقيقي وعائلته، صحة أبي وأربعة جدران كانت تسترنا.
انتقلت أحلامي مؤقتًا من شقيقي إلى بيتنا؛ أجدني داخله برفقة أطفالي وزوجي بينما الطائرات الاسرائيلية تقصفه فوق رؤوسنا، استيقظ وجسدي يرتجف من شدة الألم والخوف، أمعن التفكير في كل شيء خسرناه، مقتنياتنا، ألبومات صورنا، غرف الأحفاد والكتب التي كنت أهديها لهم و أوصيهم بتبادلها، أفكر في أمي التي تركت ملابسها الجديدة في المنزل وخرجت مرتدية القديمة، كانت تعتقد أنها ستعود بعد أسبوع أو اثنان على الأكثر.
خسرنا أيضًا بيت صديقتي بشرى، كان جميلاً وأنيقًا، تناولت فيه أشهى الطعام، اعتدتُ على زيارتها دون ميعاد مسبق، آخر مرة وطأته قدمي قبل سفري بيوم، كأنه بيتي أدخله مسرعة وأخرج محدثه الضجة ونبقى نحدث بعضنا حتى بعد هبوطي السلم.
ها أنا أفقد كل البيوت التي كان لي مطرحًا فيها، وأفقد بيتي أيضًا، لقد تعرض بيت عائلة زوجي للتدمير الجزئي ثم سكنه أغراب كثر، لم أستوعب الأمر!، يعيش الآن في بيتي وينام على سريري أناس لا أعلم أسمائهم ولا من أين جاءوا، يتم اقتحام خصوصيتي من قبل مجهولين، حاولت التماسك بأن أقضم قهري ليصغر أمام فقدي لشقيقي وبيت طفولتنا، إلا أن القهر يعود أشرس إذا شعر بمحاولاتك لتجاهله، لقد تم سرقة محتويات بيتي!.
أحيانًا على اختلاف حجم مصائبك إلا أنك تشعر بضرورة إعطائها حقها من الحزن، نعم أنا حزينة.. على الوقت والجهد الذي بذلناه لنأثث بيتنا ويصبح نسخه تشبهنا، حزينة على صورنا ورسائلنا وقصاصات الورق التي أودعتها في صندوق زهري اللون لحين عودتي من السفر، لأزيح عنها الغبار وأقلب بها على مهل كمشهد سينمائي مبتذل، حزينة على رسومات وألعاب أطفالي ودراجة ابني الخضراء التي مازال حتى الآن يُلقي عليه باللوم لعد احضارها معنا.
حزينة لأنه غير مسموح لي أن أحزن بينما شقيقتي شيماء آخر العنقود تبحث منذ أسبوعين عن رقعة من الأرض لتنصب فيها خيمة تأويها وزوجها وطفليها، وحزينة جدًا لأنني لا أجرؤ على استخراج ومشاهدة الفيديو الذي التقطته لغزة يوم سفرنا.