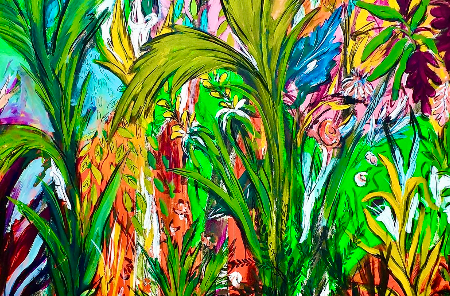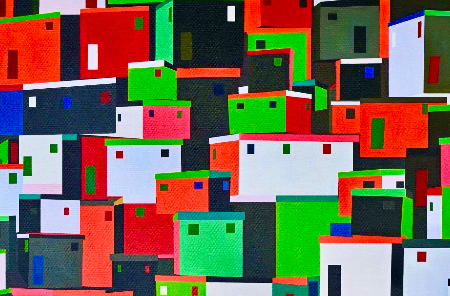يضج رأسي بالقلق، توجهتُ إلى صديقي الطبيب المغترب، والذي يحب الفلسفة أكثر من التشريح فترك عمله الأول، قال لي لا تبحثي عن إجابات، بل عن الأسئلة الصحيحة، إنه وقت الأسئلة الصعبة ويجب مواجهتها لاستيعاب ما يحدث في غزة، صديق آخر يكتب الشعر في بلجيكا يُؤكد لي أني مدمنةٌ على حزني وأحبه، وأنه جاء وقت المغامرة والتغيير.
أَنظرُ إلى ملفاتي "الوورد" على جهاز اللابتوب، جميعها غير مكتملة، لقد كتبتُ نصف الكلام ونصف المشاعر ونصف الألم، كما أنها نصف الحقيقة، لو قلتُ الحقيقة كاملةً سيرجمونني مثل كلبٍ متشرد، نحن لا نقول الحقيقة، يجب أنْ نكذب، نخفي الكلام، نهمس ببعضه، فالموقف الوطني يستلزم منا النفاق أو البوح همسًا في أحسن الأحوال.
نُجمّل الموت والفقد، نُزيّن الخيمة، ونصنع أعراسنا في الإبادة، ونُعلّق الزينة في الرمل والظلام، ندّعي أنّنا نحتمل، والحقيقة أنّ ما يحدث غير قابل للاحتمال، بل هو الهوة نفسها، وما بعد الحافة، والجراوند زيرو.
أعرف ونعرف أنّنا لا نستطيع هزيمة أميركا وإسرائيل لكنّنا قادرون على المقاومة والصمود بعد كل هذا الوقت، وهذا لم تستطع عليه العراق أو أفغانستان، بل حتى الدول العربية مجتمعة في حرب 67، لكن هذا صمود أهل الأرض وسواعد رجال المقاومة البدائية الذين تحولت كفوفهم إلى قطع خشبٍ من خشونتها وبقت كفوف القادة والسياسيين ناعمة غارقة بالعطور والعناية.
صمود غزة ليس به ما هو أسطوريّ كما تُصوّر الجزيرة، وضيفها الدائم دويري، ومحاولتهما مساواة غزة بقوة الردّ مع الاحتلال، هذا وهمٌ كبير، وكون هناك صمود اختياري لا يُغير كون كثير منه صمود إجباري، كما حدث مع أهل الشمال حين فقدوا نصف أوزانهم بل أكثر في ظل المجاعة، وقد أطلقوا عليه "رجيم السنوار" إما للتندّر أو لشرح مآلات الإرادة الشعبية ومن يُقرّر حياتها في هذا الوقت بالذات.
نعم الإرادة الشعبية التي لم نعد نعرف ماهي وما خياراتها، كما لم يعد أحد يسأل ماذا تريد، بل لم يعد أحد منا جزءًا منها، فلا أذكر أن أيّ أحد منا كان يُريد حربًا، بل كادت غزة أنْ تكون سنغافورة على الشاطئ، كما تنبأ عرفات قبل ثلاثين عامًا، والآن لم يتبقَ حتى جدار واقف على الشاطئ، مستقبل المدينة غادر بلا رجعة.
أخاف ألّا أُكمل هذا المقال أيضًا، لا شيء يكتمل معي، منذ شهور، لم أستطع أنْ أُكمل نصًا أو تقريرًا، أشعر بأنني فقدت القدرة على الكتابة، هي هناك في مكانٍ ما، بعد شهور من الأرق والحزن والانكسار على مدينتي التي راحت، دخلتُ في اكتئاب، فقدت الأمل في قدرة المقالات والكتابة والأدب والفن على التغيير، لا صوت أعلى من صوت الرصاص والقصف، العدالة مجرد أسطورة أخرى مثلها مثل الحب نُحيك حولها القصص الكاذبة.
جمعتُ أغراضي وما معي من مال، وغادرتُ إلى باريس، أبحثُ عن إجابة، أجريت مقابلاتٍ عديدة ربما لا يحتاج المحرر جميعها.
لكنني كنت في حاجة إلى إجابة، لماذا حدث كل هذا؟، قابلتُ ناشطًا عاد بي في آلة الزمن وكأنني في ميدان التحرير وفي ظلال الربيع العربي لكني لا أحتاج للعودة إلى ذاك الوقت حين حملّنا قدراتنا ما لا تحتمل، ثم قابلت أديبًا يهوديًا فرنسيًا جعلني أعود إلى سؤال الجدوى من الكتابة مرة أخرى، لكن مع بعض الأمل هذه المرة.
يضج رأسي بالقلق، توجهتُ إلى صديقي الطبيب المغترب، والذي يحب الفلسفة أكثر من التشريح فترك عمله الأول، قال لي لا تبحثي عن إجابات، بل عن الأسئلة الصحيحة، إنه وقت الأسئلة الصعبة ويجب مواجهتها لاستيعاب ما يحدث في غزة، صديق آخر يكتب الشعر في بلجيكا يُؤكد لي أني مدمنةٌ على حزني وأحبه، وأنه جاء وقت المغامرة والتغيير.
ألا يكفي أنْ آتي إلى باريس لأسبوع، وأترك كل شيء خلفي، وأنام في فندق بالكاد بقيت به على قيد الحياة من شدة البرد، أشكر الله أنه لم يخرج لي فأر من تحت السرير، حين قلت لموظف الاستقبال عن البرد ابتسم، وحين سألته عن الإفطار ضحك كثيرًا، أعتقد لو قلت له هناك فأر بالغرفة فسأكتشف أنه يربيه.
كنت أريد دعوة صديقي الشاعر كي يجري الحوارات معي، فليس هناك أجمل من المغامرات الصحافية المشتركة، لكن يبدو فعلًا أنني لست مغامرة كفاية أو أنني لم أعد أرى أيّ جمال وتغيير في شيء.
أخذتنا الحرب إلى الذروات المتعددة في الشهور الستة السابقة، أقصى المغامرة صباح 7 أكتوبر وأقصى الجنون في الساعات اللاحقة، وأقصى الانتقام ما فعله جيش الاحتلال بعدها، وأقصى تراجيديا هو جميع القصص التي نراها كل يوم لغرباء يودعون عائلاتهم ويصرخون "راحوا الحبايب".
فكيف سأغامر وأبحث عن الجديد وهذه الحرب وضعتنا في مفرمة تجربة المرة الأولى في كل شيء. لقد غيرتني الحرب، لم أجد في باريس ما يعطيني إجابة، لا الحوارات الصحافية، ولا الحديث مع أصدقاء بعيدين ولو كانوا من نفس مدينتي ترهقهم الأسئلة ذاتها وقد أصابهم مثلي شيء من فقر وخوف… لكن هذه الحرب تحتاج منا أنْ نكون وحدنا، بل نحن نحتاج أنْ نكون فيها وحدنا.
مطر شديد، أجرُّ حقيبتي الثقيلة على المياه، حتى اليوم لست ناجحة بتوضيب حقائبي، لا أعرف أن آخذ قطعتين وأسافر، أجلس في مقهى باريسيّ بامتياز، نوافذه زجاجية طويلة، إنارة خافتة، أحتاج أحيانا للضياع، أن أسافر دون هدف ليس لمؤتمراتٍ وندوات، بل بلا هدف، يقودني الخذلان والبحث عن نفسي، يعود صديقي يكتب لي "اصطادي تلك السعادة من الضياع، ولا تتركيها بعد أن تعودي".
من منا استطاع القبض على السعادة، أنا أشعر أن مياه قوية تتدفق في قلبي، هو طوفان الضياع والألم، لا يسعدني سوى حين ألحظ العالم يرى ذاك الألم، وقد أعاد لي تحرُك الجامعات بعض التفاؤل، رغم أنني أحيانا لا أرى سوى كونه سذاجة وعفوية، بل وفيه خطابًا راديكاليًا، فهو يمثل موقفًا أخلاقيًا ثابتًا، بينما أزمتنا تحتاج سياسة والسياسة عكس الموقف والأخلاق والثبات، لذلك لن ينالنا من العالم سوى الصراخ والهتاف والشعارات..
في بداية الحرب اعتقدت مثلكم جميعًا أن كل الاعتصامات والمظاهرات ستفعل شيئًا، لكن كل شيء لم ينل من قرار إسرائيل للاتجاه نحو قتل كل فلسطيني.
لكن من أنا لأحاكم هؤلاء الفتية؟ أنا التي وصلت من العمر حدًا أصبحت أُسلّم به بوحشية العالم، بل أنه قادرٌ على أكثر من ذلك من إبادة، وجيلي كله معي، يرى أننا نعيش في وقت يبرر فيه الإنسان هذا الإجرام، بينما هؤلاء الطلبة هم ضمير العالم الحي، الذي لا يصدق أن مثل هذا الظلم موجود، ولا يتقبله ولا يسكت عنه.. ربما حتى يصلوا إلى عمرنا ويصبحون الجيل الذي شهد إبادتنا فيستسلم لكل حرب وإبادة لاحقة، فجميعنا نمرُّ في آلة تحطيم الضمير والعدالة والأمل هذه..
قالوا لي إن حبيبًا قديمًا، غادر ونجا من الحرب، هي المرة الأولى التي يسافر بها على الإطلاق، سعدت أنّ أحدهم أعرفه نجا، قالوا لي إنه بكى في الطريق إلى القاهرة، وبكى في القاهرة، ويبكي كل يوم. وحتى الآن لا يشعر بأنه ذاك المسافر الجديد في بلد جديد..
ليس حبيبي القديم وحده الذي يبكي مطرحه في غزة، بل أصدقاء كثر غادروا المطار إلى كندا وأستراليا وأمريكا، بكوا بكاءً مريرًا، لقد وزع الساسة والاحتلال دمنا وأرواحنا على القبائل، لقد تفرقت أمنياتنا، وأحلامنا..
ربما لا يجب أن أتحدث بصيغة نحن، لقد تركت غزة أنا وأغلب عائلتي منذ حوالي ثماني سنوات وكانت آخر حرب شاهدناها هي في صيف 2014 والتي اعتقدت وقتها أنه لا يوجد أقسى منها، ولم أصدق أن الإبادة تنتظرنا في مكان ما.
أنا أكتب… أنا أسترسل، أفعل ذلك بعد أسابيع من الجفاف، وكنت كأنني أتعلم المشي من جديد، وأجبر نفسي على تحريك ساقي/قلمي. ربما استنزفت ذاتي بمشاركة الناس على وسائل التواصل أفكاري ومعلومات كشف الفساد والكسب الشخصي خلال الحرب، وظهوري الحي لمناقشة الأفكار السياسية.
أعتقد أنني كنت أبحث عما هو أقوى من كتابة المقالات والحكايات، طوال أسابيع من الجدالات والنقاش المرير والغرق في المبادرات ومحاولات مساعدة الناس على الأرض وإخراجهم من الجوع والفقر والعوز.
لكني أعرف نفسي، لست ذاك الشخص الذي يريد الغرق بالواقع وتفسيره وكشف أسراره، أريد أن أعود لي أنا، وترك الناس، لقد استلبني التعاطف والمشاركة، وتركني صحراء. أحيانًا العجز عن الحل وتغيير الواقع هو دافع كبير للكتابة، بينما الفعل الملموس يطفئ كل شيء.
أظهر أنانية هنا، لكن متأكدة أن كثيرين سيفهمونني، يشعرون بأن روحهم ذوَت ولم يبق شيء لديهم… أريد العودة لهويتي، ليس فقط السفر لباريس يساعدني على ذلك، بل التحدث مع الآخرين، والتأمل، والعودة للحياة، وتراجيديا المعقول بعد أن أكلتني تراجيديا تفوق الحدود.
وصلنا على الموتوسيكل، نناور في شوارع باريس المزدحمة، صديقتي الناشرة تبدو سعيدة أنّ كتابنا القديم تُعاد ترجمته وقد باع ويبيع آلاف النسخ، وقفت وأعطتنا قبلات جميعًا، فكأنه يطرح الآن في الأسواق، لا أدري هل أكون سعيدة أم تعيسة أننا كنا نحتاج إلى الحرب كي ينتبه العالم لكتابٍ عن غزة بعد أن كان مهملًا في المكتبات لسنوات، تصلني رسائل جميلة من القرّاء يوميًا، لكني لا أستطيع أن أشعر بالسعادة، (ليس لأنه لا تصلنا الأرباح، فأنا أسلم بفقر صناعة الكتاب عالميًا بالأساس)، بل لأنني فقدت الأمل بكون الكلمة قادرةً على التغيير، المجازر مستمرة، كل يوم هناك مائة ومائتان يموتون، وهذا في أفضل الأيام، واحتمال أن تطال عائلتك يتحقق في كل لحظة.
أقول ذلك لصديقتي الناشرة، ويبتلعني الحزن، وهي تقول أنظري إليك، لست مكتئبة أنتِ حزينة فقط، وسيمرُّ كل ذلك، لقد كنت مثلك أبكي في كل مكان ومن ثم عرفت أنني أمرُّ بفترة "سن الأمل" انقطاع الدورة، رددت عليها نعم أنا أبكي كل يوم في كل مكان مثل جدي قبل وفاته لكن لا أعتقد كونها مشكلة هرمونات إنها مشكلة هوية ووجود.
ستة شهور وأنا كطائرٍ مقصوص الجناحين يُحلق قليلًا ويقع مرةَ أخرى...يُحلق ويقع..لا وصل السماء ولا بقي على الأرض، مُعلق يريد أن يفعل شيئًا ولا يستطيع، 34 ألف روحٍ رفرفت عاليًا، وأنا لا أزال عصفور لن تنمو أجنحته أبدًا مرة أخرى، يعلو ويهبط إلى أن تدعسه وحشية العالم.