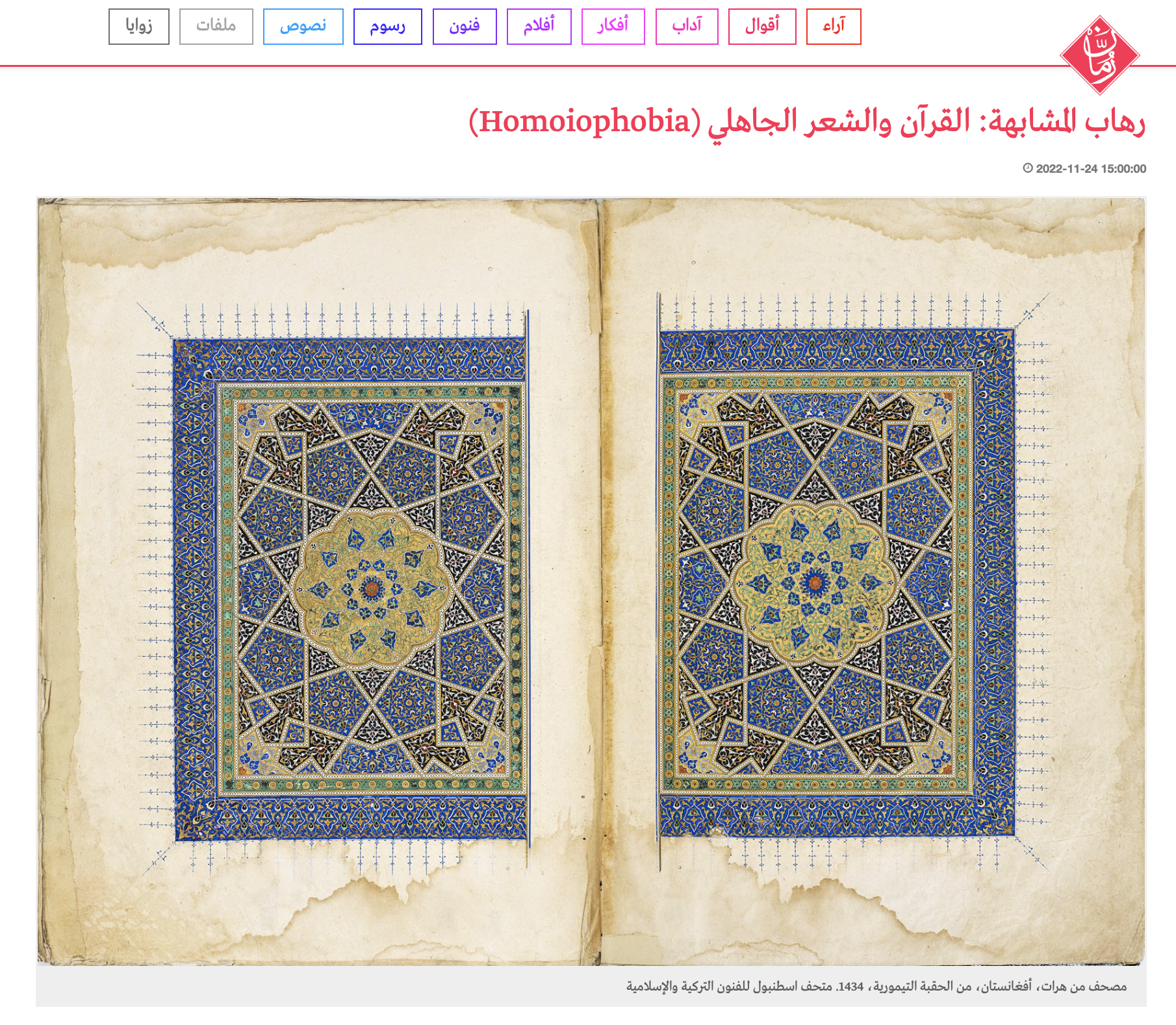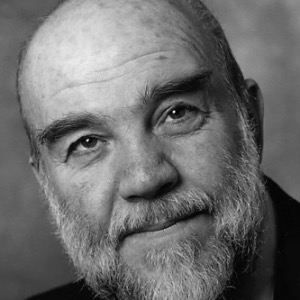نهايات البحث:
وللحرب في الشعر بالطبع تشبيهات أخرى بالغول والأنياب المتوحشة وما شابه، غير أن التشبيه الذي يهمنا هو تشبيه الحرب بكوارث الطبيعة كالزلازل والنار التي تلتهم كل شيء والريح التي فيها حريق وغيرها من أهوال الطبيعة، تلك الطبيعة التي يقف أمامها الشاعر مفتوناً مبهوراً وكأنه في حضرةِ إلهٍ غاضب لا يلوي على شيء ولا يكترث لما يسببه من دمارٍ وخطوب.
والنجوم والأنواء وتقلّب الفصول والحر والبرد جميعها كثيفة الحضور في الشعر. وقد نُعمّم هنا فنقول ان شعراء الجاهلية كانوا يجعلون طلوع النجوم وافولها هي المُقدِّرة لكافة هذه الظواهر، كما ويتفاءلون أو يتطيّرون من بعض هذه النجوم. ولسنا هنا بحاجة إلى الإتيان بالشواهد من الشعر فهي أكثر من أن تُحصى، ونجد العديد منها في كتاب الانواء لابن قتيبة على سبيل المثال.
والذي يثير نفور القرآن من كل ذلك هو ما قد نسمّيه استقلال الطبيعة والنجوم عن الله وكأنها لا تخضع لأيّ نظام أو قانون سوى لقانونها الخاص بها. ويبدو النفور القرآني واضحاً من كل هذا وذاك في آيات كمثل: {والشمس والقمر والنجوم مسخّرات بأمره} و {وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها} و {ألم ترَ أن الله يسجد له مَن في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثيرٌ من الناس} و {فلا أُقسم بمواقع النجوم} و{وما أنزل الله من السماء من ماءٍ فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابّةٍ وتصريف الرياح والسحاب المسخّر بين السماء والأرض} و {ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين} و {وإنه هو رب الشِعرى} وغيرها العديد من الآيات التي تؤكد أن الله هو رب كافة هذه الظواهر الطبيعية، والفعل في كل ذلك لله وتدبيره. من هنا فإن غضب الطبيعة ليس أمراً عبثيّاً يستدعي الافتتان والانبهار كما في الشعر، بل هو عقابٌ من الله على الكفر والإثم، والآيات في هذا المعنى متعددة ووافرة ومنها على سبيل المثال: {وأمطرنا عليهم مطراً فانظر كيف كان عاقبة المجرمين} و {ويرسل الصواعق فيصيب منها من يشاء} و{إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً من السماء} و {هو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينشئ السحاب الثقال} وغيرها الكثير.
***
الخاتمة
نحن لا نزعم هنا ان القرآن لا ينقبض ويشمئز إلا من الشعر فحسب، فغنيٌّ عن القول انه ينفر ايضاً من طيفٍ واسعٍ من الكفر والضلال والإثم كالتثليث وجحد البعث والنبوّة والاستكبار والتخايل والعصيان والغدر وغيرها كثير، وقد اتينا على ذكر بعضها أعلاه. لكن شعر الجاهلية هو في واقع الأمر ديوان العرب قبل الإسلام، فهو كل ما تبقى لنا من تراث أدبي قبل نزول القرآن. ومن الواضح أن نفور القرآن من الشعر لم ينل ما يستحقه من تأملٍ وبحث.
لا يصح لنا بالطبع أن نهمل ما جاء في البيان والتبيين للجاحظ على لسان عبد الصمد ابن الفضل الرقاشي (ت. حوالي ٨١٥ م.): “وما تكلمت به العرب من جيّد المنثور اكثرُ مما تكلمت به من جيّد الموزون فلم يُحفظ من المنثور عُشرُه ولا ضاع من الموزون عُشره”، وهو قولٌ يردده ابن رشيق في العُمدة. لكن كيف لنا ان نحكم على تراث ضائع؟ نقع في تراثنا الأدبي على بضعِ عشراتٍ من الخُطب والوصايا في العصر الجاهلي بالإضافة إلى أيام العرب في الجاهلية. لكن إذا كان مارغوليوث وطه حسين قد شكّكا في الشعر فالشك في هذا المنثور أولى لما فيه من التكلّف والصُنعة والفخر بالأنساب المُختَرَعة وإلى ما هنالك من دواعي الشك.
***
نعود اخيراً إلى شعراء الجاهلية، فهم وبرغم الاختلاف والتباين العميقين فيما بينهم في الأسلوب والنظرة إلى الكون والمسلك الأخلاقي وغيرها، إلا انه كان لديهم في رأينا ما يشبه المنظومة من الآراء والأفعال التي لربما جعلت منهم أعتى أعداء النظام الديني الجديد حنكةً وسحراً، وأوسعهم شهرةً وأفحشهم كلاماً وأنفذهم بلاغةً وأقربهم إلى ثقافة مجتمعهم، فلا غرابة في ان خطابهم اللاهوتي والأخلاقي كان من اكثر ما أثار نفور القرآن واشمئزازه من التشابه بهم أو من الخلط بين مفاهيمهم المعرفية والمفاهيم القرآنية. وإذا كان لهذا المفهوم، أعني رهاب المشابهة، أن ينال القبول فقد يشكّل إضاءةً تُضاف إلى التحاليل الأدبية وخصوصاً تلك التي تُعنى بمسألة التأثير الأدبي بين نص وآخر. وهذا ما حاولنا تبيانه أعلاه.