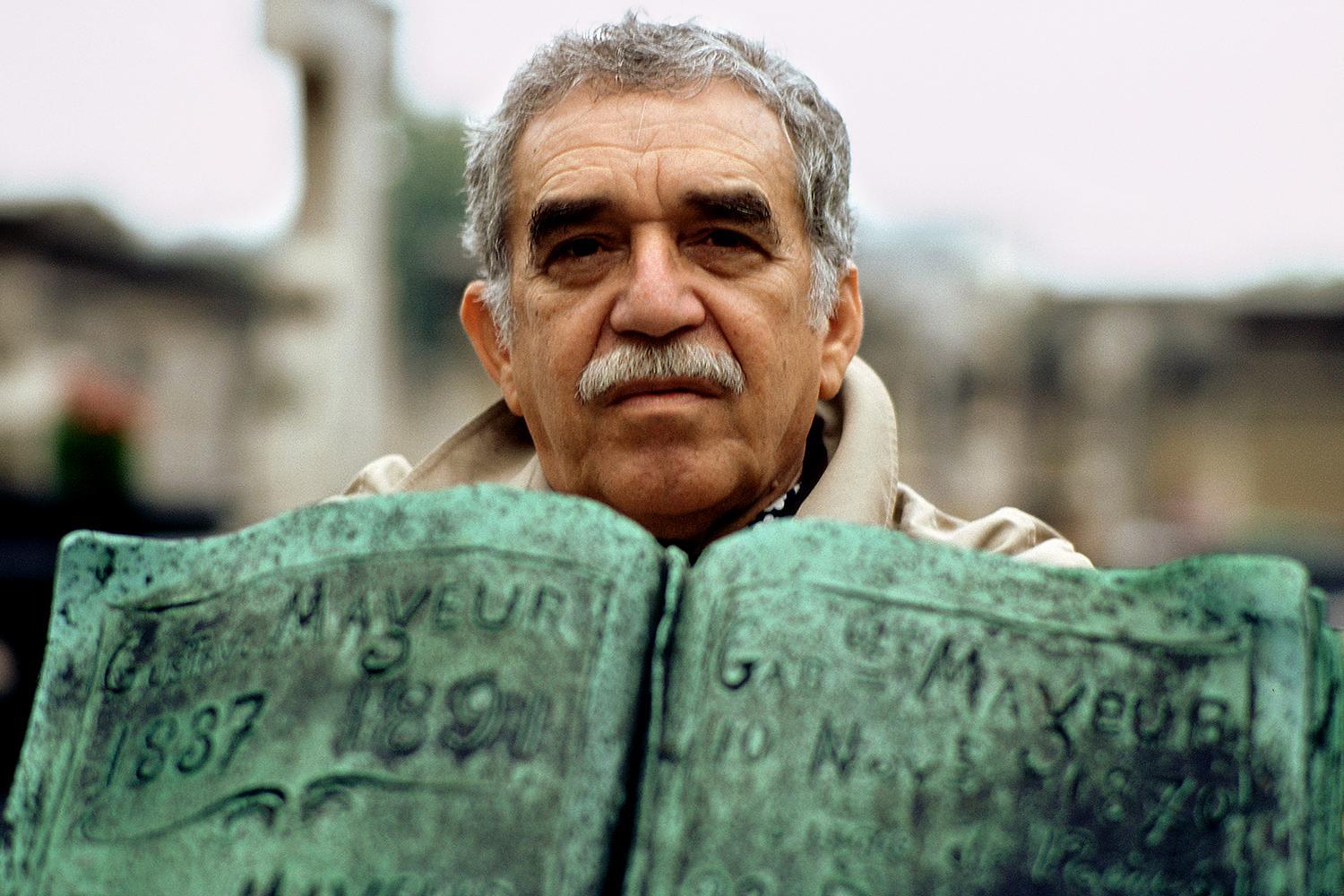طوال سنواتٍ عديدة راودتني رغبةٌ بكتابة قصّة الرَجل الذي ضاع في أحلامه إلى الأبد. يَحلُم الرجل بأنّه نائمٌ في غرفةٍ مماثلةٍ للغرفة التي ينامُ فيها في الواقع، وفي ذلك الحُلم الثاني كان يحلم أنّه نائمٌ أيًضًا ويحلم الحلم ذاته في غرفةٍ ثالثة مشابهةٍ للغرفتين السّابقتين. في تلك اللحظة رنّ جرس المنبه على طاولة “الواقع” الليليّة، وبدأ النائم بالاستيقاظ. للقيام بذلك، بالطبع، كان عليه أن يستيقظ من الحُلم الثالث إلى الثاني، على أنّه فعل ذلك بحذرٍ شديدٍ لدرجة أنه عندما استيقظ في غرفة الواقع، توقّف المنبّه عن الرنين. ثمّ، مستيقظًا تمامًا، راودته لحظة شكّ في ضياعه: كانت الغرفة مشابهة جدًا لتلك التي في الأحلام الأخرى المتراكبة، لدرجة أنّه لم يجد أيّ سببٍ لعدم الشّك في أنّ هذا كان أيضًا حلمًا يحلمه. لسوء حظّه الشّديد، ارتكب خطأ النّوم مرةً أخرى، متقصّدًا استكشاف الغرفة من الحلم الثاني لمعرفة ما إذا كان بإمكانه العثور على مؤشرٍ أكثر تأكيدًا للواقع، وبما أنّه لم يجده، فقد نام في الحلم الثاني للبحث عن الواقع في الثالث ثم في الرابع والخامس. من هناك – وبالفعل مع نبضات الرّعب الأولى، بدأ يستيقظ عكسيًّا، من الحلم الخامس إلى الرابع، ومن الرابع إلى الثالث، ومن الثالث إلى الثاني، وفي اندفاع هذيانيّ فقد عدد الأحلام المتراكبة ومرّ بالواقع دون أن يدري. لذلك استمرّ في الاستيقاظ للخلف، في أحلام غرفٍ أخرى لم تعد أمام الواقع إنّما خلفه. ضائعًا في معرض لا نهاية له من الغرف المتشابهة، نام إلى الأبد، متخبّطًا من طرفٍ إلى آخر في أحلامٍ لا حصر لها دون العثور على باب الخروج إلى الحياة الواقعية، وأخيرًا كان الموت راحته في غرفةٍ لم يعرف رقمها على وجه التحديد.
اعتقدتُ لوقتٍ طويل أنني لم أكتب قصّة الرّعب هذه لأنّ لها تشابهًا واضحًا مع قصصِ خورخي لويس بورخيس، بالإضافة إلى أنّها أقل شأنا من كل قصصه. ومع ذلك، الآن، بعد أن تذكّرتها وكتبتها، أدركتُ أن الغرفة التي أقيم بها -مع الآلة الكاتبة أمام النّافذة التي يدخل من خلالها البحر الكاريبي بأكمله دون إذن- هي غرفة مشابهة للغرفة التي كنت دائمًا أرغب بها للحلم في القصة: غرفةٌ مربعةٌ بجدرانٍ ناعمة عديمة اللون، لها بابٌ وحيدٌ ونافذةٌ واحدة، مع عدم وجود أيّ أثاث آخر غير السّرير البسيط والطاولة الليليّة مع منبهٍ كان عليه أن يكرّر نفسه دون انقطاعٍ في كلّ غرفةٍ من الغرف التي حَلُم بها، ولكن كان على ذلك الشخص أن يحلم في الغرفة الحقيقية.
الآن بعد أن رأيتها في الواقع، أدركتُ أن هذه القصة لا تنتمي لما يكتبه بورخيس، بل هي من سلسلة قصص فرانز كافكا الأقدم والأكثر غموضًا. على أي حال، لم أكتبها أبدًا، وربما يكون هذا هو أعظم ميّزاتها.
ليست هذه القصة هي الوحيدة التي تُركت بلا كتابة، ولا هي استثناء في عالم الأدب. إن حياة الكتاب مليئةٌ بالأعمال التي لم يكتبوها أبدًا، وربما كان من الممكن في كثير من الحالات أن تكون أفضل من تلك التي تمت كتابتها. لكن الشيء المثير للفضول هو أنّ هذا المسار اللامتناهي تقريبًا من القصص التي لم تولد أبدًا تُشكل للكتّاب جزءًا مهمًا وغير مرئيّ من عملهم: الجزء الذي لن تروه أبدًا في أعمالهم الكاملة.
لسنواتٍ عديدة أيضًا، وفي فترة ما بعد قصّة الرجل الضّائع في أحلامه، حلمتُ بكتابة قصّةٍ وضعت عنوانها فقط: “الغريق الذي كان يجلبُ لنا الحلزونات”. أذكر أنّني أخبرتُ صديقي ألفارو سيبيدا سوموديو في إحدى الليالي العاصفة عنها، وقال لي: “هذا العنوان جيدٌ جدًا لدرجة أنّك لم تعد مضطرًا لكتابة القصة بعد الآن”. بعد أربعين عام تقريبًا، أنا مندهش لمعرفة مدى دقّة ردّه ذاك. وبالفعل، فإنّ صورة الرجل الضّخم والمُبلّل الذي كان من المفترض أن يصل ليلاً ومعه حفنةٌ من القواقع للأطفال بقي إلى الأبد في عليّة القصص غير المكتوبة. في المقابل، أضعتُ الكثير من الوقت مرّة بعد أخرى في محاولة كتابة قصّة الرجل الذي كسر الآلات، بطريقة ما، كان هذا تباينًا جديدًا يخصّ الموضوع الذي استحوذ عليّ أكثر من غيره بطريقةٍ لا مفرّ منها في تلك الفترة ألا وهي الآفات. وصل ذلك الرجل سيرًا على الأقدام إلى إحدى القرى التي يقطنها حِرفيون وسأل شخصًا يعمل على الجرّار عن أحدهم. وفجأةً ودون أي سبب واضح توقّف الجرّار عن العمل. حدث الشّيء ذاته لماكينة خياطة كان قد طرح على صاحبتها نفس السؤال بعد فترةٍ وجيزة، ولجميع الآلات المختلفة التي تواصل مع أصحابها. لقد قمتُ بعمل العديد من النسخ قبل أن أقنعني ملاكي الحارس، الذي يتعامل بشكلٍ سيءٍ مع الكتاب العنيدين، بعدم الإصرار بعد الآن، لسبب بسيط، الأبسط في العالم: كانت قصةً سيّئةً للغاية.
من ناحيةٍ أخرى، كنتُ على يقين بأنّ هناك من بين القصص التي لم أكتبها، قصّة جيدة جدًا. وهنا أشير إلى تلك التي تخيلتها في ظهيرةٍ عاصفة في بلدة كاداكيس، أجملُ وأفضل مدينةٍ محفوظة في كوستا برافا. بعد ثلاثة أيامٍ من تلك الرياح العاتية، ظهر لي فجأةً الوحي المبهر بأنّني لن أعود إلى تلك المدينة أبدًا لأنّ ذلك سيكلفني حياتي. شخصية القصّة الرئيسيّة رجلٌ عانى من نفس الهوس لسنواتٍ عديدة، إلى أن كشفه ذات ليلةٍ لمجموعة من الأصدقاء في برشلونة. أجبره أصدقاؤه، بنيّة حسنة، متّبعين طريقةً حمارية حمقاء لعلاج خوفه، على ركوب سيارةٍ واقتادوه في نفس الليلة إلى كاداكيس. قام الرجل بالرحلة شبه مشلولٍ بسبب الخرافات، وعندما رأى أخيرًا أضواء المدينة من المنحنى الأخير للجبل، تمكّن من الابتعاد عن أصدقائه وسقط في جرفٍ غير قادرٍ على تحمّل رهاب العودة.
على تلك الحالة كذلك ظلّتْ وإلى الأبد قصة الفتاة التي بحثت عن الغريب الذي اغتصبها في حديقةٍ طوال سنوات، حتى اكتشفت هي نفسها أنها تريد العثور عليه لأنّها لا تستطيع العيش بدونه. وقصة الأطفال الذين تآمروا لقتل الملك ونجحوا أخيرًا باستخدام حلوى مسمومة. وقصة الأطفال الذين قتلوا زميلهم الذي يعرف كلّ شيء لأنّهم لم يستطيعوا تحمّله لكونه يعرف الكثير.
كانت من بينها قصةٌ وحيدةٌ أنهيتها، تلك التي تتحدّث عن الرجل الذي ارتدى درعًا فولاذيًا لإخافة أصدقائه في حفلة ولم يتمكّن من الخروج منه مرّة أخرى، لذلك عاش فيه لسنواتٍ عديدة ومات بداخله في سنّ الشيخوخة.
كنت على وشك نشرها عندما قرأها صديق أثق برأيه، وجعلني أدرك أن درع المحاربين لم يكن هيكلًا واحدًا لا يتجزأ -كما كنت أعتقد حتى ذلك الحين- بل أجزاء يتم وضعهم على الجسد قطعة تلو الأخرى، على غرار أزياء مصارعي الثيران. لذا، شأنها شأن العديد من القصص الأخرى، غرقت هذه القصة وإلى الأبد، وبكل إنصاف، في بحر القصص الضائعة.
نُشرت أول مرة في جريدة البايس، في 24 أغسطس/أيلول عام 1982.