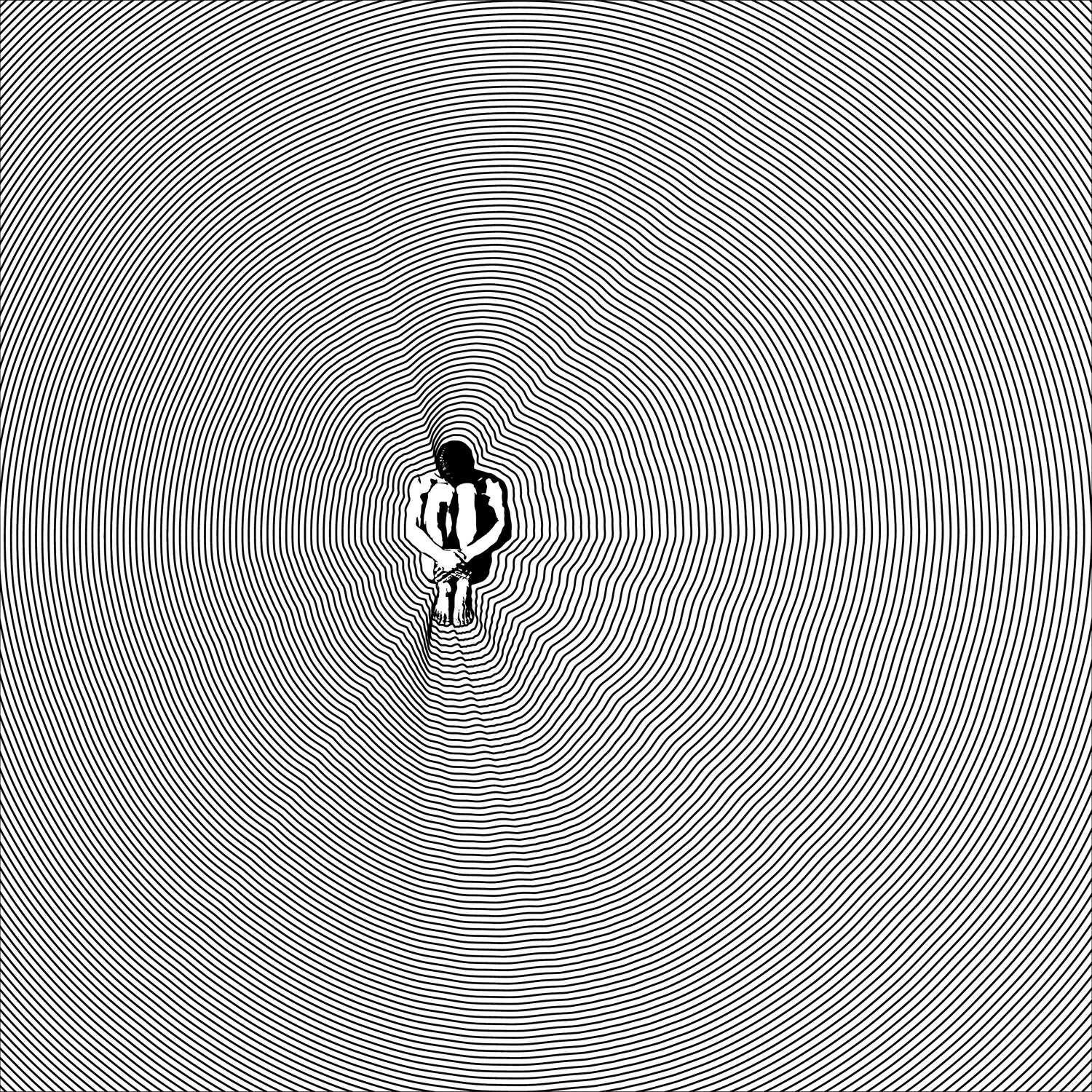منذ البدايات، تجاوزت الاحتجاجاتُ التوقعات منها، وشملت أرجاء الأراضي السورية، فما كان مظاهرات، أدى الى انتفاضة، أصبحت ثورة، حررت الكتابةَ من الكتمان، وما اختزنه الصمت طوال أربعين عاماً. فكان للقول امتدادات تجلت في شهادات وروايات وقصص وأشعار وموسيقا ومسرح وسينما ولوحات تشكيلية وكاريكاتير… ما شكّل لوحةً هائلة لعالم راحل، وعالم قادم يزخر بالمتغيرات، انبعثت مشهدياته من بلدان متباعدة جغرافياً، تبدأ من سورية إلى بلدان المهاجر.
في العقود السابقة، قبل الثورة، سلّطت الرقابة خطوطاً حمراء على الأدب والفكر والفن، خاضعة للمتغيرات السياسية، فما هو ممنوع اليوم، قد يسمح به غداً، وبالعكس. إضافة إلى خطوط من الأحمر الفاقع كانت من النوع الثابت، القابل للتضخم، تهدف إلى عدم المساس بشرعية النظام، أو التعرض لممارسات أجهزته الأمنية، فحُظر انتقاده لامتناع مساءلتها. كانت حصانتها من حصانة النظام المطلقة. ولا غرابة، كانت استمراريته تقوم على استمراريتها، وعدم التشكيك فيها.
لم تكن الرقابة تمنع وتسمح فقط، بل وتضع المثقف تحت الشبهة، وقد يتعرض للملاحقة والاعتقال والتحقيق والسجن. لو حاول انتقاد إجراءات القمع، أو المساس بمصداقية شعارات المقاومة والممانعة، أو المطالبة بالإصلاحات.
من العسير التطرق إلى تحولات جذرية في مجالات الأدب والفن التي تمخضت عنها سنوات الثورة. والأصح، الإشارة إلى تراجعات على مستوى التعبير الجمالي، ففي ظروف الثورة والحرب الدائرة والضحايا اليومية والنزوح والتمزق السوري على صعيد الأرض والمجتمع، والتطرف الديني والمذهبي، يصبح الأدب والفن أكثر مباشرة، يتميز بطابع الإنتاج السريع والاستهلاك الفوري، فالجهات المستقبلة متعطشة للجديد على مدار اليوم والساعة.
أسبغت وحشية القمع، وبشاعة الظلم، على التعبير قدراً كبيراً من الألم، ذهبت به إلى التفجع. فالأدب يتحسس المأساة، ولا ينحو إلى تفاديها، ما يجعل احتمالها ممكناً؛ الشعور بالتآخي في زحام الكراهية، ومواجهة الرعب. تصبح الكتابة حاجة ماسة في إثبات الصمود، نلاحظها في وسائل التواصل.
من داخل هذا المناخ الملتهب والحركة الناشطة، تتميز محاولات التعبير الأدبي والفني بالمعاناة الإنسانية والوجدانية المشبعة بالظلم، خصوصاً، وأن الثورة والحرب كانتا بين أبناء وطن واحد. ما يضخّ في الكتابة إحساساً مضاعفاً بالفجيعة، لا يخلو من إبداع نزق. لا يُستبعد أن تصبح في المستقبل أحد المراجع الأهم عن البشر في الثورة، تعكس قدرة الإنسان على التحدي، ومعايشة الموت والأمل معاً، واستمرار الحياة رغم الشظف والجوع والتعرض للنزوح والتشرد، تعتمل فيها حدة التجربة وطزاجتها، ما قد تفتقده الأعمال المشابهة في المستقبل، لا يكفي النظر إلى الخلف وتقصي الذكريات ومحاولات بعثها، بل معايشتها. لذلك لا يجب الاستهانة بالكتابة في أتون الثورة والحرب، هناك روايات كتبت في الخنادق خلال الحرب العالمية الأولى والثانية، ونشرت بعد انتهائها.
طبعاً، لا يمكن التنبؤ أي شأن سيكون لهذا الأدب. لكن مهما كان الحكم عليه، فسوف يشكل علامة فارقة بين أدب ما قبل وما بعد. شهد الأدب السوري طوال العقود السابقة طغيان الأدب الرديء، الخائف والمذعور، الملفّق والمختبئ وراء كليشيهات زائفة، ولا غرابة في أن الأعمال الجيدة كانت قليلة في سنوات القحط. إذا كانت هناك ميزة لهذا الذي يكتب في سنوات الثورة، فليس مواجهة النظام الشمولي فقط، بل وإعادة النظر في الذات.
هذا الأدب حسب موقعه، يمثل الوجه الآخر للتغيير من ناحية تمحور اهتماماته حول البشر والحرية والحياة والموت، ولا ننسى أن الثورة سبب وجوده. حالياً، لا يمكن القول إن الصورة متكاملة، ولا واضحة، فهذا الأدب المبعثر، مجاله خارج البلد، بينما المفترض أن يكون في الداخل، غير أن الظروف تمنع الداخل عن التعبير الأهم، وإن كنا نلحظ شذرات منه. ما يلفت الأنظار أنه ينطوي على نظرات أكثر واقعية تضطرم في الداخل السوري، وإن كان في الخفاء، لا سيما في مناطق النظام، فالكتابات في وسائل التواصل سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة تحيلنا إلى رؤى متبصرة، لديها من العمق والجرأة ما يخرق مناعة النظام وتحصيناته. بالتالي لا يمكن الحديث عن الأدب والفن من دون أخذ الداخل السوري كأولوية، مثلما أي حراك ديمقراطي لا يثبت جدواه إلا في معركة الداخل.
وإذا كان لم يصلنا من الحراك الأدبي في الداخل إلا النزر اليسير، فليس لأنه في حالة كمون فقط، وإنما لأنه بحاجة أيضاً إلى مجال حر. لكنه رغم الظروف الصعبة سيشق طريقه، وليس من قبيل المديح ولا المجاملة القول إن ما سيظهر من كتابات الداخل هو الأكثر تعبيراً عن سورية المنكوبة، الغارقة في الدماء، وملابس الحِداد.
مقابلة كنّا أجريناها مع فواز حداد… هنا