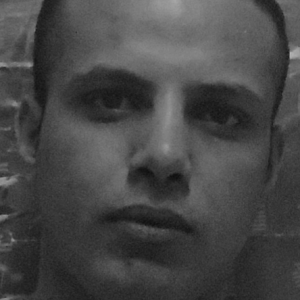كيف جمع في صفاته بين أحمد عبد الجواد وابنه ؟ وكيف حمّل سعيد مهران هواجسه؟ ولماذا اعتبر زهرة نموذجًا مثاليًا لـ”المرأة و الرجل”؟
فهم نجيب محفوظ كل شخصياته وتفهّم تناقضاتها، واعتز بالكثير منها حتى لو كان منحرفًا، ثم أحب البعض بشكل خاص، لأنها كانت تشبهه في سماته أو صراعه أو معتقداته.
من هنا نجد أن بين الشخصيات المحفوظية من كانت أقرب إليه من غيرها.

في روحه المحِبة للحياة، يميل نجيب محفوظ إلى جانب من شخصية أحمد عبد الجواد في ثلاثية القاهرة، 1956، أو “سي السيد” كما هو معروف كأيقونة اجتماعية بارزة.
ربما يبدو هذا غريبًا بالنظر إلى الصورة الذهنية التي رسخها “عبد الجواد” كشخصية ذكورية متسلطة في بيته، لكن محفوظ، الذي كان يحب الفن والسهر والنكتة وقد شهد مقتبل حياته انطلاقًا وتجارب، يعترف بأن فيه بعضاً مما كان يفعله الرجل في حياته بالفعل. يقول في حوار مع تشارلوت الشبراوي لـ”باريس ريفيو”، 1992، إنه يشعر بأنه قريب من “عبد الجواد، الأب، المنفتح على الحياة بجميع جوانبها، المحب لأصدقائه، الذي لم يؤذ أحدًا قط عامدًا متعمدًا”.
في مفتتح “قصر الشوق”، الجزء الأول من ثلاثية القاهرة، كتب واصفًا شخصيته الأشهر، بعد العودة مرة إلى المنزل فجرًا: “كثيراً ما يشعر بأن الدور الذي يلعبه في سهرته من الخطورة كأنه أمل الحياة المنشودة، وكأن حياته العملية بجملتها ضرورة يؤديها في سبيل الفوز بساعات مترعة بالشراب والضحك والغناء والعشق يقضيها بين صحبه وخلصائه”.
على المستوى العاطفي والوجداني، يأتي كمال عبد الجواد، بلا منازع، كمعبر عن صاحب نوبل إلى درجة تقترب من أنه يمثل سيرته الذاتية “الشبابية” في أعماله.
عندما سألته محررة “باريس ريفيو” بوضوح: هل بين شخصياتك شخصية تتطابق مع شخصيتك؟ رد على الفور: “كمال”. يرى محفوظ أن الابن الأوسط لأحمد عبد الجواد كان يمثل جيله: “أفكارنا واختياراتنا ومشكلاتنا وأزماتنا النفسية”. ثم يقولها واضحة: “شخصيته من ثم شخصية سيرية”، قبل أن يستدرك: “لكنها في الوقت نفسه شخصية إنسانية عامة”.
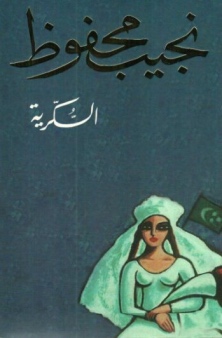
في “السكرية” يعبر عن صراع كمال الداخلي -وصراعه أيضًا- فيكتب عن الشاب الذي ذهب ليشارك في عيد “الجهاد الوطني” أمام بيت الأمة: “إن وجوده في مثل هذا الجمع الحاشد يطلق من أعماق ذاته الغارقة في الوحدة شخصاً جديداً ينتفض حياة وحماساً. هنا ينحبس العقل في قمقم إلى حين وتنطلق قوى النفس المكبوتة طامحة إلى حياة مفعمة بالعواطف والأحاسيس دافعة إلى الكفاح والأمل، وعند ذاك تتجدد حياته وتنبعث غرائزه وتتبدد وحشته ويتصل ما بينه وبن الناس فيشارك في حياتهم ويعتنق آمالهم وآلامهم. إنه بطبعه لا يطيق أن يتخذ من هذه الحياة حياة ثابته له ولكن لا بد منها بين حين وآخر حتى لا ينقطع ما بينه وبين الحياة اليومية، حياة الناس، فلتؤجل مشكلات المادة والروح والطبيعة وما وراء الطبيعة، ولتمتلئ اهتماماً بما يحب هؤلاء الناس وما يكرهون، بالدستور.. بالأزمة الاقتصادية.. بالموقف السياسي.. بالقضية الوطنية. لذلك لم يكن عجيبًا أن يهتف “الوفد عقيدة الأمة” غداة ليل قضاة في تأمل عبث الوجود وقبض الريح، والعقل يحرم صاحبه نعمة الراحة، فهو يعشق الحقيقة ويهوى النزاهة ويتطلع إلى التسامح ويرتطم بالشك ويشقى في نزاعه الدائم مع الغرائز والانفعالات”.
الثلاثية إذن ضمت شخصيتين هما الأقرب لنجيب محفوظ، إنه “يتذكر” في حواراته مع جمال الغيطاني فيقول: “هي العمل الوحيد الذي يحتوي جزءًا كبيرًا من عقلي وقلبي، فيها جزء كبير من نفسي”.
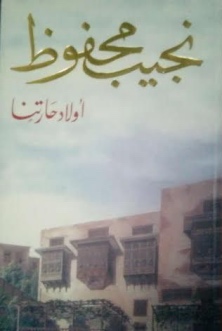
ويُجمل محفوظ كل هذا في حواره لـ”باريس ريفيو” قائلاً: “كلتا الشخصيتين تمثلان نصفي شخصيتي أنا. عبد الجواد الاجتماعي للغاية، والمحب للفن والموسيقى، وكمال الخجول، الجاد، المثالي، المنطوي”.
في أول عمل “منشور” له بعد ثورة يوليو، استوحى نجيب محفوظ من قصة سفاح الإسكندرية محمود أمين سليمان، الذي كان حديث مصر في ذلك الوقت، روايته “اللص والكلاب“، 1961، خلق ما هو أعمق من مجرد حكاية بوليسية لمطاردة لص.
يحكي الكاتب الذي كان قد أثار جدلاً واسعاً بروايته “أولاد حارتنا” 1959، لـ”باريس ريفيو”: “كنت في ذلك الوقت أعاني من إحساس ضاغط ومستمر بأني مطارد، وكنت على قناعة بأن حياتنا في ظل النظام البوليسي في تلك المرحلة كانت بلا معنى. وهكذا حينما كتبت القصة، كتبت معها قصتي أنا”.
بذكاء ومهارة شديدين، حمّل محفوظ قصة جريمة تأملات فلسفية عميقة، ووضع في “سعيد مهران” كل حيرته وهواجسه، يقول: “جعلته يمر بتجربة البحث عن إجابات لدى الشيخ، ولدى “الساقطة”، ولدى المثالي الذي خان أفكاره من أجل المال والشهرة”.
كانت “اللص والكلاب” تجسيدًا للنظرة الفنية لنجيب محفوظ في العلاقة بين الواقعي والروائي: “الكاتب ليس مجرد صحفي، فهو يضفر مع القصة شكوكه، وأسئلته، وقيمه. هذا هو الفن”.
ربما نلمس أجواء “المطاردة” لسعيد -ولنجيب نفسه- في هذا المقطع من الرواية: “الخمارات أغلقت أبوابها ولم يبق إلا الحواري التي تُحاك فيها المؤامرات، والقدم تعبر من آن لآن نقرة مستقرة في الطوار كالمكيدة، وضجيج عجلات الترام يكركر كالسب”.

من منظور أوسع قليلًا، عبّرت “اللص والكلاب” عن تطور فني هائل في أدب محفوظ، سُمي بـ”المرحلة الفلسفية”، في ذلك يقول رجاء النقاش في كتابه “في حب نجيب محفوظ”، عن شخصيات هذه الفترة: “إن البطل الجديد عند نجيب محفوظ واحد من الذين يولدون ويخرجون عن الطابور العادي، ويقفون على تل مرتفع من الذكاء والحساسية ثم يكتشفون أن حياة الإنسان ليست “مستوية” كما تبدو في النظرة العادية، بل إنها تطل على هوة كبيرة مجهولة”.
في المقابل، تتعد الشخصيات النسائية في أدب نجيب محفوظ، وتتراوح مكانتُها ما بين كونها بطلة قد ترمز للوطن كما في “زقاق المدق” أو منزوية في عالم رجالي خالص كما في “ملحمة الحرافيش”، لكن أغلبها مهمش منسحق تحت ضغط الظروف الاجتماعية، والأمثلة كثيرة ومنها “أمينة، نفيسة، حَميدة، إحسان، نور”.
عندما سأله الروائي محمد جبريل، حسبما كتب في مقال بـ”دورية نجيب محفوظ”، العدد الثالث، ديسمبر 2010: من منهن تعتز بها أكثر؟ شرح قبل أن يجيب: “أول أسباب الاعتزاز هو أن تكون الصفات إيجابية إنسانية، تجعل من الشخصيات كائنًا يستحق الاحترام”.
ثم استدرك واختار شخصية بعينها هي زُهرة في “ميرامار” 1967. يقول عن بطلته: “إنها تستحق ولا شك تقديراً خاصاً، ففيها تتمثل الإيجابية والمقاومة التي نرجو أن تكون مثالاً لا للمرأة وحدها في المجتمع العربي، ولكن للإنسان العربي بصفة عامة”.
في “ميرامار” رسم محفوظ شخصية زهرة كفتاة تقاوم الجهل والماضي والتسلط وتحلم بحياة أفضل، وعلى لسان أبطال الرواية وصف الفلاحة السمراء بكل ما يجسد ذلك: “مدهشة، ذكية وقوية، سيئة الحظ، طيبة وشريفة، تحلم بالحب والتعليم والعمل، لا تخاف، وإذا انكسرت تعود أقوى.