في مقالةٍ له بعنوان “الرشاقة الذهنيّة”، يقول المفكر والفيلسوف الرّاحل حسين البرغوثي: “الرّشاقة الذهنيّة بالنسبة لي فرع من فروع الرّقص الروحيّ، نوع من السيولة والفن”. وعن علاقة الجسد بالرّوح يشير ابن سينا إلى هذه الثنائيّة بالقول: “لقد هبطت النفس إلى هذا العالم وسكنت الجسد، فلا بدّ أن تحنّ وتضطرب وتخلع عنها سلطان البدن وتنسلخ عن الدنيا لتصعد إلى العالم الأعلى وتعرج إلى المحلّ الأرفع”.
فما بين الرّقص الرّوحي والصّعود إلى الأعلى وصولاً إلى المحلّ الأرفع، دشّن حسين البرغوثي سيرته الذّاتية على سطح أملس أسماه «الضوء الأزرق» (الدار الأهلية، عمّان، ٢٠١٨)، لا ليرسم شيئاً من خارطة المغامرة وحسب، ولكن ليخلق منظومته الصّوفية المشحونة بكلّ تعبيرات الجنون في قالب فلسفي يحاكي العقل، باعتباره أحشاء القلب كما يصفه نيتشه “إنّ العقل يجب أن يكون بمثابة أحشاء القلب”.
ولعلّ تعريف البرغوثي لماهيّة “الضوء الأزرق” في الصّفحات الأولى من سرديّته، بأنّه “لون النفس الأمّارة بالسوء” بحسب الطائفة الصوفيّة النقشبنديّة، و”لون طاقة الخلق فينا” لدى البوذيّة “التيبت”، قطع الطريق على القارئ كي لا يَحار كثيراً في تفسير المنطق الذي دفع الكاتب لاختيار هذا العنوان، إلاّ انّه أكمل شرح الأمر عبر توضيحه سرّ اهتمامه باللون الأزرق الذي رافقه منذ الطفولة دون غيره قائلاً: “عندي، الأزرق لون الغربة، والغيب، وسماء الطفولة” (ص17)، حدّ تأليفه للحن موسيقيّ، لم يكتشف سرّ تعلّقه به حتى قرأ أنّ لكلّ نوتة موسيقيّة لوناً خاصّاً بها، وعندما بحث عن لون النوتة التي سحرته وجده أزرق. وشغف الكاتب باللّون الأزرق دفعه للبحث عن معناه في الأساطير والحكايات القديمة. ما أكدّ له أنّه والأزرق ملمحان لقناع واحد.
ولأنّ الكاتب هو بطل سيرته، والحكاية حكاية معلّم مجنون ومريد كادت أن تنفصم شخصيّته، كان الجنون بوصلة التواصل المهيمنة على نصّ يروي حكاية مريد، عثر مصادفة على شيخ طريقته، ليكتشفا معاً أنّ الحياة لغة “خيال واسع في عالم ضيق”. واللغة أداة بناء فكريّ يمكنها أن ترتدي ما شاءت من الأقنعة إلى أن يجد الإنسان إجابة شافية لسؤال حائر: كيف يمكن للذِّهن أن يعيد تصميم نفسه؟ ليفرّق ما بين “الذّهن ومحتواه”؟ (ص101).
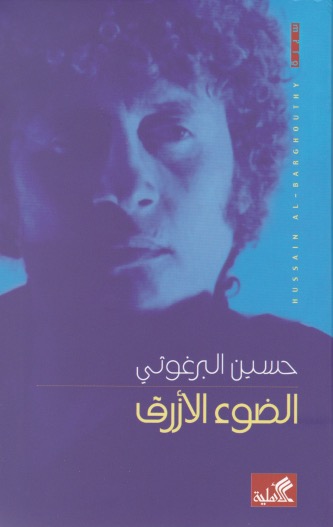
أما المريد في السرديّة فهو الكاتب السارد حسين البرغوثي، الباحث عن نفسه وهويّته في ظلّ ما تاه منه بوصفه إنساناً أولاً، وفلسطينياً ثانياً، وأما المعلّم أو شيخ الطريقة في سرديّة البرغوثي فكان شخصيّة “برّي” الصوفيّ، التركيّ، التاجر، الطبّاخ، الطالب المشرد المجنون، الذي تعرّف عليه من خلال صديقتهما المشتركة سوزان، حين أثارت فضوله بجملة واحدة: “عند برّي أبعد مما يبدو لك” (ص41)، ليدخلا وصديقه الجديد في حوار فلسفي دائريّ تغيب عنه البدايات، كما لا تُعرف له نهايات واضحة: “نحنُ لسنا من لحمٍ ودم، جئنا من الرّوايات وإلى الرّوايات نذهب!” (ص34)، هذه الجملة التي تشكّل إحدى أوضح انزياحات النصّ باتجاه المجاز الذي حوّل التراب إلى رواية، وكأنّنا بالكاتب يقبض على فكرة الخلود من خلال تأكيد البقاء ولو اسماً في رواية.
هكذا ومنذ الصّفحات الأولى، وكـ “نتيجة لتعدد عوالم المعنى” (ص51)، سنجد الكاتب كثيراً ما يوظف التناصّ مع النصّ الدينيّ لصالح تدوير طرح الفكرة بما يخدم سرديّته، متخذاً من قصة سيدنا موسى مع الخضر عليهما السلام، متكئاً مخفيّاً يقيم عليه جداله الفكريّ الفلسفيّ لتعريف ماهيّة الإنسان وصياغة تركيبته الذهنيّة؛ علماً بأنّ حُسيناً ليس موسى، وبرّي لم يكن الخضر، ولكنّهما كانا يحاولان عبور السّياج، سياج العقل وتصميماته الجاهزة وفق “سُلطة الذاكرة”.
فضاء السرد
يبدأ البرغوثي سرديّته الممتدّة على ثلاثة فصول، بضمير المتكلّم “التقيتُ به” معرفاً عن الشخصيّة الرئيسيّة في نصّه، بوصفه الدرويش الدوّار التابع لطريق مولانا جلال الدّين الرومي، معرجاً على التعريف عن نفسه ومحيطه المكانيّ والأكاديميّ الذي وجد نفسه فيه بعد وصوله إلى أمريكا، مشيراً إلى حياته الماضية وعلاقتها بما سيأتي من أحداث.
والمحيط المكانيّ أو البنية المكانيّة لدى البرغوثي، وهي سينماتك “الوَهم العظيم” وحانة “القمر الأزرق” ومقهى “المخرج الأخير”، شكّلت مع أحداث السرديّة علاقة ذهنيّة شكلانيّة، ربطت الحالة النفسيّة للسارد بشخوصه على هيئة ثنائيّة ضديّة مليئة بالترميز ومنتجة للشذرات والأفكار. فنجده يقول: “غريب كم يبدو المكان كمصيدة، أحياناً.. وجدتني أتنقّل بين هذه المقاهي الثلاثة، وأبحث عن نفسي، ليس في الكتب. سئمت كل الكتب، بل في المقاهي، وبين المشبوهين بالجنون، والشواذّ، والصعاليك، حيث الخرائط أكثر دقّة ووضوحاً وإثارة” (ص21).
ومهما يكنْ من أمر هذه الأمكنة وعلاقتها بالمكان الأوّل للسّارد، قريته كوبر شمال غرب مدينة رام الله، فإنّ الثابت في سرديّة “الضوء الأزرق” أنّ حسين البرغوثي، حاول من خلال المقاربة السيميائية للفضاء المكانيّ، أن يرصد التحوّلات التي يمرّ بها الإنسان خلال تنقّله من مكان إلى آخر، وتأثيراتها على شكل الهويّة الفرديّة، وهو ما نلاحظه بوضوح في قوله: “العقل دولاب، وكلّما دار الدولاب تغيرت طريقتنا في النّظر إلى الدّنيا والحياة وأنفسنا، وتغيّرنا..” (ص36).
المعرفة وفلسفة البحر
لم يكن البرغوثي في سيرته يبحث عن ماهيّة المعرفة أو عن حاجتنا لها، وإنما عن كيف نعرف؟ وكيف نفهم؟ والأهمّ أن نتأمل أنفسنا.
“أن تتأمل نفسك يعني أن تفهم ما كنت تعرفه دائما من غير أن تفهمه” (ص72)، هذا النّهج العرفاني هو ما دفع حسين للمرور في نفق الإحساس الدّائم بالذنب، والخوف من مجهول الانفصام والجنون، وصولاً إلى الغوص في أعماق النفس البشريّة مستدعياً الضوء الأزرق بوصفه لون السّماء مرّة، والبحر مرّة أخرى.
“هذا هو الفهم: سمكتك الذهبيّة، من طبيعتها أن تسبح في كل نظريّة، كل تجربة، كل رأي، كل نوع من المعرفة، كل ماء، وتبقى هي هي: سمكة ذهبيّة. إن من طبيعة الذّهن أن يفهم نفسه، كما أن من طبيعة السّمكة أن تسبح. وأين يسبح العقل؟ في نفسه: إنه الشلاّل والسّمكة التي تسبح في الشلاّل. هل فهمت معنى قولك: كن شلالاّ وكن سمكة؟” (ص72).
ولأنّ للبحر فلسفته الخاصّة، تناقض الفلسفة العامّة تماماً وفق المفكّر الألماني “غونتر شولتس” صاحب كتاب «فلسفة البحر»، كونها تتمحور حول سؤال أساسيّ، بشأن علاقة التفكير الفلسفيّ بالبحر؟ إذ يمكن للمرء استخدام شيء واضح دليلاً للسير عبر التضاريس الجافّة للمفاهيم، كان للبحر حضوره الفلسفيّ الواضح
في سرديّة البرغوثي، خاصّة وهو يقود المعنى بسحر لغويّ بديع يوظّف الصوفيّة في أبهى تجلّياتها عكس قوانين الطبيعة، لنراه بحراً يلاحق طفلاً وهو يقول: “عمق البحر لا يعرف شيئاً عن شواطئه.. وجهك شاطئ… هزّتني جملة وجهك شاطئ. تخيّلتني في مكانه، في عمق البحر وأنظر نحو الشاطئ: وجهي. وصعقتني فكرة أخرى: كانت تبدأ مطاردة البّحر لي في حلمي في بيروت، وأنا طفل صغير جالس على حجر (…) كنت أرى البحر بعيني الطفل دائماً، ولا مرّة جرّبت فيها أن أرى الطفل بعيون البحر. (…) لم أرَ أبداً كيف كان البحر يراني. وجهك شاطئ، جعلتني أرى الطفل بعين البحر. (ص124).
أخيراً، إنّ مقاربة نصّ لشخص بقامة حسين البرغوثي، لهو عمل بحاجة للكثير من البحث والتأمّل، لما يحمله هذا الجنس من النّصوص من أبعاد فلسفيّة وصوفيّة مركبة ومعقّدة وغامضة إلى حدّ بعيد، يجعلها نصوصاً تستعصي على التفكيك، وإن كانت قابلة بمساحات واسعة للتّأويل، خاصّة وهي عادة ما تقيم علاقة ذهنيّة مثيرة وعجائبيّة ما بين مفهوميّ العقل والقلب، تتداخل فيها الرّموز مع التّراث إلى جوار الفلسفة والتخييل، في نسيج لغويّ متحرّك ما بين الشعر والنثر، الرّواية والسيرة، وهو ما أشار إليه محمود درويش في تقديمه لنصّ «الضوء الأزرق» بالقول: “تحقّقت شَاعريّة حسين البرغوثي الحقيقيّة في “الضوء الأزرق” كما لم تتحقق في محاولاته الشّعريّة. إنه نصّ لا يُصنف في جنس أدبيّ واحد، وهو ليس سيرة ذاتيّة، بالمعنى المتعارف عليه. ولا هو رواية، إنه يذكّرنا بسرديّات الرواية وبحميميّة السيرة (…) فهو خليط غريب من البوح الشّخصيّ والتّأمُّلات الذهنيّة.”
وعلى الرغم من ذلك، فنحن دائما بحاجة لقراءة نصوص حسين البرغوثي، أولاً كي نحاول أن نفهم أنفسنا، وتالياً لأن نحاول إعادة ترتيب أذهاننا، وربّما لنشعل فتيل الحريق: “إنها حاجة البحر للأمان، والبحر رغبة الشمعة في تحويل الكون إلى حطب وبدء الحريق الأعظم” (ص126).






