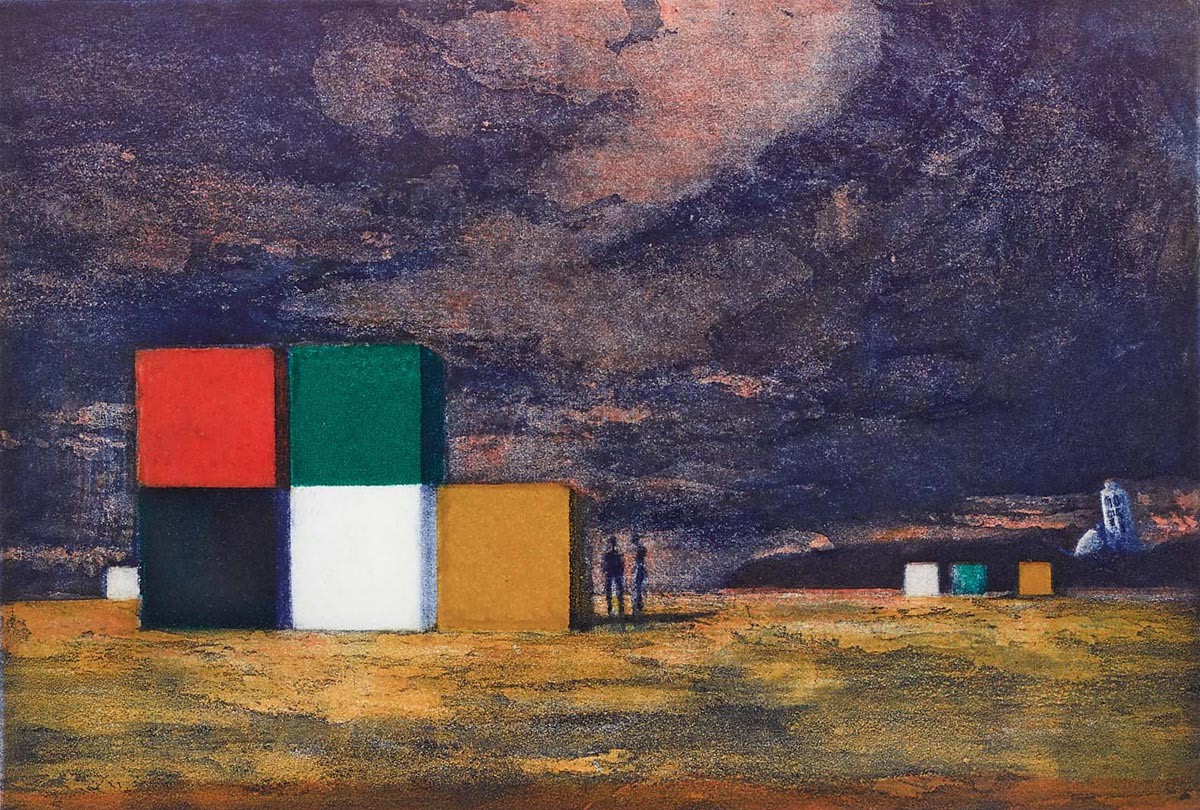ضعت في المطار استوكهولم العملاق، وفقدت طائرتي، مع إني حرصت على إحكام ربط خيط الطائرة الحديدية بيدي كما كنت أفعل صغيرا، لكن سيلا من الناس، بل الصواب أن سيلا من الأفكار جرفني إلى ميناء آخر، وعندما انتبهت، كان الوقت قد فات ولات ساعة مندم، وفرت الطائرة، كما كانت الطيور تفر من فخاخي، قال لي صديق نازح أنه لم يعد يغادر البيت، خوفا من الضياع. أنه رهين محبسي؛ الخوف والغرفة، ويعني طفولة ثانية، ووجدت نفسي مع سيدة سورية أمية، في السبعين من العمر، لا تعرف حتى الأرقام، استغاثت بي وسط أولئك الشقران، فأسرعت إليها وأنا أقول: المغيث أولى من المستغيث بالإغاثة، تلمست حقيبتي الصغيرة حقيبة الوثائق، فلم أجدها، فُقدت، لقد لقيت من سفري هذا نصبا.
صرنا أنا وهي سواء. نحتاج ثالثا.
أصبحت فجأة ذرة بين هذا الحشر البشري، المسجونون ارقامٌ في المعتقلات عادة، لسحقهم وتحويلهم إلى طحين، فكيف يكون خليقة الله على الأرض رقما وذرة سابحة في الكون. لم اعد حتى رقما، انا في حكم العدم، تلمست سلاحي وذخيرتي فوجدت أن الدماء قد جفت في خلايا هاتفي، وهذا يعني أني سقطت في قعر واد سحيق، وشرحت لأول موظفة سويدية وجدتها أمامي، اظن أني اخترتها من بين موظفتين، لأنها أحسن وجها، وأقرب ثمرا، وأورف ظلا، واستغثت بها، مرتين؛ مرة لنجدتي، ومرة لنجدة السيدة السورية التي فقدت طائرتها، فبادرت إلى اغاثتي، وأحضرت لي شاحنا فبدأت الدماء تعود إلى الهاتف، لكني نسيت كلمة السر، وكنت أنوي أن أنقذ من قاعه السحيق بعض المعلومات: صورة هوية، صورة جواز سفر، صورة تذكرة السفر.
المطار يعج بالبشر من كل الأعراق والأزياء، لكني نسيتهم جميعا ورأيت أنني آدم المطار وموظفة المطار الحسناء حواؤها. كأني آدم وهي حواء، هي وحدها التي تعرفني، كأن ليس من أحدنا سوانا في المطار، كأنها نبتت من ضلعي السابع، فتحت عيني فوجدتها إلى جواري. البرهان على أننا في الجنة هو أني وحدي بلا وثائق ومعي حواء!
حال السيدة السورية كان أحسن مني فهي تحتفظ بكل وثائقها، ما فقدته هي الطائرة، أنا فقدت كل شيء، وليس بجانبي سوى حواء. في الجنة لا يحتاج آدم وحواء إلى وثائق فليس فيها حواجز ولا دوائر حكومية ولا مربعات أمنية ولا مثلثات جبنة البقرة الضاحة، وقد أشفق عليها الموظفون بعد جدال، ومنحوها بطاقة طائرة، جديدة مجانا، وكان ذلك من حسن حظها، وستذهب إلى مالمو في السويد، لماً للشمل المشتت، وستنتظر، وترجمت لها كلامهم، ستجلس وتنتظر هنا، وربطوا ورقة على يدها مكتوب بالإنكليزية: لا أعرف القراءة، دلوني على الطائرة رقم كذا، البوابة رقم كذا. عليها أن تلزم هذه البوابة، وستأتي طائرة، وتركب فيها، وتمضي إلى أبنائها حقبا.
أما أنا فضعت، رفعت بصري إلى الموظفة الحسناء التي لعبت دور البطولة في قصة الجنة العظيمة، فوجدت ابتسامتها تبعث في الأمل، فتشبثت بها مثل غريق، كأنها تقول لي: خطأ مطبعي بسيط، وكأنها تقول لي: والله ما يخزيك الله أبدًا؛ إنك لتصل الرحم، وتصدُقُ الحديثَ، وتَحمِل الكَلَّ، وتَكسِبُ المعدومَ، وتَقري الضيف، وتعين على نوائب الحق”.
وكانت من أجمل ما رأت عيني من النساء، وكدت أنسى مصيبتي، وكانت مصيبة حقيقية، أوشكت أن أقول لها، وقد نسيت نفسي، ماذا تفعلين هنا؟ لم لا تعملين في السينما فأنت أجمل من الذئبة ساندرا بلوك، ومن الظبية سكارليت جوهانسون، ومن المفحوصة ميجانا فوكس، ومن هي جينيفر لوبيز حتى تقارن بك، ولتذهب ميلا كونش إلى دار التقاعد، ومن هي العليقة كيرا ناتلي التي إذا رأيتك قالت: من أجل الورد يسقى العليق. إنها ما تصلح ان تكون وصيفة لك، وكانت تبتسم وكأنها تفهم كلامي ونجواي من غير نطق، فنحن في الجنة، إنها ترى قلبي من وراء زجاج لحمي، صديق لي اسمه عبد السلام كتب أول قصيدة في حياته قال فيها: لماذا تحبو امرأة على ورق القصائد ولا تأتي منارة للقلب؟
والله هذه التي تحبو على ورق القصائد امرأة عظيمة يا عبد السلام، أين عقلك يا عبد السلام؟ هذه ليس عليها عتاب او عذل لأنها تحب الشاعر من أجل شعر ومشاعره ولأنها تحبو على ورق القصائد، لا تحبو على ورقد النقد والبنكنوت! لقد جاءت منارة عالية وصافية ومضيئة القلب.
وعجزت هذه الحسناء عن تفسير ولهها بي فقلت لنفسي لعلها رؤيا، رأتني في الحلم وأحبتني، أو أنها تشبهني بأحد ما. بنجم ما، فليكن، لست مثل عبد السلام الذي يريد أن تحبه امرأة من أجل عينيه الجميلتين.
وكأنها قالت: شكرا على إطرائي لها، وكأنها قالت لي: الأمريكيات في السينما موهبة وجمال، وليست كما عندكم: جمال فقط.
شممت رائحة إهانة في شتيمتها، ربما يكون مديحا، فنحن نقدر الجميلات وليس سواهن، نحن غير منصفين، وزهدت في هويتي وجوازي وقد عثرت على هويتي الجديدة، واستسلمت، فهم هنا لا يؤذون المجرمين، قد يعتقلونني، والسجون هنا أكرم من العيش في بلادي، وشككت في أنها تعرفني أو انها وقعت في غرامي، فهي تكرمني وتخلص لي، وستزورونني في السجن، وتسعى إلى خدمتي وتواسيني، وقد يكون اسمها أنجلينا، وتخاطبني بالطريقة الشامية: تشكل آسي ابن عمي، تقبرني ابن عمي، وأنا أريد أن أقبرها في فؤادي.. لقد جعلها الله لي سكنا في هذه المصيبة، ثم تذكرت اعترافا طريفا للمفكر المصري عبد الوهاب المسيري، وكان مثلي يمشي في المطار باتجاه طائرته، وكلما مر بجانب امرأة صاحت من الدهشة مثل ارخميدس وتقول يا إلهي، وجدتها وجدتها.. أوريكا أوريكا.. وتكاد تخرُّ على الأرض من الحب والوله، فانتفخ سحر المسيري؛ صبايا، حسناوات أمريكيات يسقطن صرعى وهو يمر بهن، وهذا لم يقع سوى لنبي كريم هو يوسف عليه السلام. الداعية بسام الجرار له اجتهادات جديدة وباسلة في تفسير القرآن، واقترح تفسيرا جديدا لآية “وقطعن ايديهن” في سورة يوسف، غير التفسير الشائع بأن صواحب امرأة العزيز جرحن ايديهن وهن يأكلن الفواكه ويقشرنها بالسكين ويرى أن قصة الفواكه مختلقة، وإن مزج الدماء عادة شائعة في ذلك الزمان بالتعاهد بجرح اليد والمؤاخاة كما لدى البدو، وما تزال عادة سائرة عندهم، وأجرى المسيري تحقيقا عقليا، واستخدم علوم النظر ثم سأل احدى معجباته: سيدتي استحلفك بالله ما الذي أعجبك فيّ؟ قالت: عطرك اولد سبايس. وكان عطرا قديما، لم يكن سواه في أمريكا الستينيات، ولم يستعمل المسيري سواه، وكل المعجبات به فوق الأربعين وقد ذكّر عطر المسيري اتلك السيدات بعطر ابائهن، فثارت لديهن عاطفة الشوق والاكبار والحنين.
عطري زيتي، من العود والعطور والعنبر وهو عطر ثقيل، لا يضعه الناس في بلادي سوى للجثث والموتى، يصنعه صديق لي يطلق على نفسه اسم غرنوي، تأسيا بجان باتيسيت غرنوي، بطل رواية العطر لباتريك زوسكيند، لكني أحب عطره، واسكبه على رأسي سكبا، وفكرت في سؤالها، وهي ما تزال تجري في خدمتي وكأنها جارية وأنا الخليفة هارون الرشيد الذي كان يخاطب السحاب، قائلا: ارقصي لي رقصة السماح أيتها السحابة.
وتثب السحابة، عفوا، اقصد أنجلينا بين المكاتب والوثائق وتبحث بين أدغال المعلومات في غابات الحاسب ، وتحاول مساعدتي في فتح حسابي، فهو مكتوب بالعربية، والأزرار تعاند، كأن عبد الرحمن الغافقي على أعتاب بواتييه، وتضحك لي كأنها أغرمت بي، وتغمرني بنظرات حب وحنان لم تغمرني بها أمي التي ولدتني، ولم يحدث أن أغرمت بي امرأة قط هذا الغرام، وتفقدت ريشة سحري سقطت من طائرة على رأسي فلم أجد ، وجاءت الحسناء أخيرا منارة للقلب، وليس حبرا على ورق القصائد، استطاعت الحسناء أخيرا العثور على طرف خيط يقود الى شخصيتي وقرأت بعض المعلومات فابتسمت وصاحت مثل ارخميدس: فعلناها أخيرا، ورفعت قبضتها في الهواء وظننت انها سترمي بنفسها في حضني كما يرمي الطفل في حضن أمه من غياب، ثم تغرق في البحر، سألتها مولاتي ومولاة روحي، لقد لوعت قلبي و جرحت كبدي ، قولي لي لمَ تجتهدين كل هذا الاجتهاد في إغاثتي؟! أنا أريد أن أشكرك، لقد ولدت من جديد على يديك يا قابلتي وقاتلتي وأمي و… ابنة عمي.
وكنت انتظر من حواء أن تقول: ما هذا السؤال، ليس من أحدنا سوانا في الجنة يا غشيم، حيث لا هويات، ولا وثائق، فقط انا وانت، وولدت من ضلعك السابع، وتسألني هذا السؤال السخيف؟ وليس من سبيل سوى حبك، وليس حماة تنافسي على قلبك وتنغض على عيشي، لكنها قالت بعد صمت: سأجيبك، وراحت تحاول البحث عن وصف مناسب فتمهلت، كأنها ستبوح لي بحبها أخيرا وسأعرف سبب تعلقها بي، وأرجو ألا يكون عطري القاتل، وان تكون منارة القلب، وقلت لنفسي: صحيح أن فيَّ ألف علة وعيب لكن فيَّ بعض خصائل حميدة، فأنا أصل الرحم، وأصدُقُ الحديثَ، وأحمل الكَلَّ، وأكسِبُ المعدومَ، وأقري الضيف، وأعين على نوائب الحق”، وأكره حافظ الأسد. وأخرى: أن الله يحبني، وليس من دليل على حب الله سوى حب هذا الغزالة لي.
قالت: بصراحة أنا لا أحبُّ الأجانب (وهذه تخفيف الاعتراف بأنها عنصرية).
وأردفت وفي عينيها ابتسامة أم مشتاقة إلى ولدها العائد من الجبهة بجروح عميقة لا تشفى: لكني أقوم بواجبي يا سيدي!