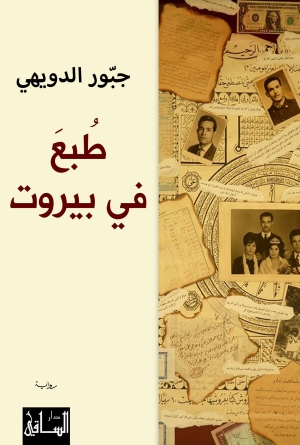صدرت مؤخراً رواية «طبع في بيروت» للكاتب اللبناني جبور الدويهي، عن دار الساقي للنشر، في بيروت. تقع الرواية في 224 صفحة من القطع المتوسط. وللدويهي روايات سابقة منها «اعتدال الخريف» التي حازت على جائزة أفضل عمل مترجم من جامعة أركنساس في الولايات المتحدة، و«ريا النهر» و«مطر حزيران» التي اختيرت ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية عام 2008، و«شريد المنازل» التي اختيرت كذلك ضمن القائمة القصيرة للجائزة ذاتها عام 2012.
عن روايته الأخيرة أخبر الدويهي رمّان بأن فكرة الرواية "بدأت معي يوم قرأت خبراً في إحدى الصحف عن إقدام صاحب مطبعة في بيروت على الانتحار. لم أتعمّق في الواقع بالأسباب التي دفعت هذا الرجل لوضع حدّ لحياته فاكتفيت بفكرة انتحاره ومهنته ورحت أنسخ سيناريو متخيّل حول احتمالات انهيار الطباعة ما قادني إلى مشاكل الكتابة."
وإن كان للرجل المصير ذاته في الرواية قال "بالطبع لم ينتحر صاحب المطبعة في روايتي لأن الأحداث تتقدم وفق تراكم غير متوقع أحياناً، وبرزت معي شخصية صاحب المسوّدة يدور بها على الناشرين من دون جدوى لينتهي به الأمر مصححاً للغة العربية في إحدى مطابع العاصمة اللبنانية." وأضاف "تتحول المطبعة إلى مسرح أحداث أقرب إلى المسرح ليلاً ونهاراً مع استرجاع لتاريخ هذه المؤسسة التي هي من عمر لبنان الكبير وعايشت أهم محطات تاريخه طوال قرن من الزمن. كتبت رواية في النهاية حول الكتابة واللغة والحرف والحبر والحبّ و... تزوير العملة. استمتعت بكتابتها وآمل إمتاع القارئ بعيداً عن أي درس سياسي أو اجتماعي ولو أنه لا مفر من هذا النوع من الإيحاءات في رواية تتماهى غالباً مع الواقع التاريخي والمعيوش."
تنشر رمّان فصلاً من الرواية، وهو الفصل ٢٠:
يكتب فريد أبو شَعر واقفاً. سمع يوماً أن الواقف يبقى متيقّظاً فوقف. لا يكتب من خمول بل من اتّقاد حواسه. يحلو له تصوّر نفسه يشتعل وهو يخطّ بقلمه المفضّل بالحبر السائل، "المون بلان" الفضّي. ورثه عن والده الذي تلقّاه بدوره هديّة من سليمان أبو شَعر تشجيعاً لنسيبه حليم بعد أن أظهر في شبابه فضولاً عابراً تجاه الكتب والكتّاب. لكن والد فريد كان يهيم في عالم آخر فلم يُخرج هذا القلم الثمين من علبته إلّا عندما وقّع به على سجلّ الكنيسة هو وعروسه وشاهداه يوم زفافه، وعلى كمبيالات المرابين وفوائدهم المقتطعة سلفاً عندما داهمته حاجة ماسّة للمال كي يستأجر صالونه، "شي حليم"، في فرن الشبّاك، ويؤثّثه بكرسيّي حلاقة دوّارَين ومرايا كبيرة. مات شابّاً وترك القلم لأصغر أبنائه.
ألّف فريد، التلميذ الابتدائي، أوّل كلام على هواه في الصف الرابع في حصّة مدرّس العربية الذي كان يكثر من تمارين "تركيب الجمل" حول كلمات من أيّ صنف. بدأ بكلمة تفّاحة وكان جلّ ما يبتغيه من الصغار أن يركّبوا فعلاً وفاعلاً ومفعولاً به حول هذه الثمرة المألوفة، "أكل الولد التفاحة"، أو للمتجلّين من بينهم صياغة أطول، "خرج آدم من الفردوس لأنّه أكل التفاحة"، فإذا بفريد يفاجئه ويفاجئ رفاق صفّه عندما وقف وقال بنبرة شاعرية:
- الأرض تفّاحة حمراء تمشي الهوينا!
رفع المدرّس يده مشيراً على التلامذة بالصمت كأن حدثاً جللاً وقع للتوّ في قاعة الصفّ لا يجوز التعكير عليه، ليسأل الصغير عن عمره وعمّا إن كان تلقّى دروساً خصوصية من قبل، وعندما وصل في استجوابه إلى اسم عائلته تنفّس المدرّس الصعداء وهزّ رأسه مطمئناً إلى أنه وجد في انتساب الصبيّ إلى آل أبو شَعر تفسيراً جينيّاً كافياً لتمكّنه من اللغة العربية ولشاعريته المبكرة.
يكتب فوق، في ضيعته حيث تصله وهو مبحر في البحث عن عباراته أصوات انفجار قذائف مدفعية خلف سلسلة الجبال، معركة في الداخل السوري تحتدم ليلاً ويبقى قتلاها مرميّين أيّاماً في العراء كما تنقل وسائل الإعلام في اليوم التالي. يكتب واقفاً ويضع أوراقه وقلمه فوق مقرأة كنيسة القرية التي وافق الكاهن على إعارته إيّاها خارج أيّام الآحاد والصيف، نفسها المنضدة التي يوضع عليها كتاب القدّاس أو السنكسار، سيَر القدّيسين الشهداء، مفتوحاً حتى عندما لا يقترب منها قارئ. يُخرجها فريد إلى الشرفة ويقف خلفها قبالة غابة العرعر الصغيرة على السفح المقابل حيث تُسمع طلقات متفرقة من بنادق الصيد عندما يستريح فيها رفّ من طيور الفرّي أو التدرّج المسافرة. يقصد القرية لهذا الغرض، ينصرف فيها يومين أو ثلاثة إلى الكتابة صبحاً وقبل أن يأكل وغروباً حتى يخذله ضوء النهار. جاء إلى هنا عندما فشل في إيجاد ناشر لكتابه ولم تُعرض عليه سوى وظيفة مصحّح، وقف قبالة معبد باخوس البعيد وغابة العرعر، ومن أجل استعادة بعض ثقته بنفسه ألقى مقاطع من نصوصه في الفراغ بصوت عالٍ أثار نباح كلب في الجوار واستعاد فريد في مداواته لمعنويّاته كيف أجلسه جدّه يوماً في حضنه على هذه الشرفة نفسها التي كانت غارقة بأزهار الغاردينيا كما يذكرها في طفولته، وراح يرقّصه فوق فخذه معلناً أن الدنيا "تربّي" نابغة كلّ مئة عام، أخرجت جبران خليل جبران في مطلع القرن العشرين "وسيأتي قريباً دور هذا الصبيّ".
يكتب باللون الأزرق، لا يتخلّى عن "المون بلان"، يملأه حبراً مرتين في اليوم، يشعر بأن القلم يحتفظ بأثر من الذين توالوا على الكتابة به، وبقدر ما كان يصرّ على فرادته وخصوصية أسلوبه وأنّه غير مدين لأحد، كان متشبثّاً بهذا القلم الذي أمسكت به أكثر من يد من آل أبو شَعر. يحتفظ بمخزون لا بأس به من محابر "باركر" التي لم تعد متوفرة في المكتبات وريشتين احتياطيتين لرأس القلم وجدهما صدفة. يكتب بخطّ جميل مائل، يرخي الريشة صعوداً ويشدّها نزولاً. وكان الصغار من أبناء أشقّائه إذا صودف وجودهم في القرية يتلصّصون عليه ضاحكين ويتابعونه كيف يمرّر نشّافة الحبر عدّة مرّات بعد كلّ سطر يكتبه. لا يشطب، ينتظر أن تحضره الكلمات، يغربلها وينتقيها، يعيد الجملة في ذهنه ويعيد ثمّ يغمض عينيه ويغوص في أعماق نفسه، يلقيها عالياً قبل أن يدوّنها بتمهّل وانضباط. يتفادى الخطأ قدر الإمكان لكنه إذا ارتكب واحداً أو سالت من "المون بلان" نقاط حبر زائدة بقّعت الورقة كان يمزّقها ويعيد الكتابة.
يكتب واقفاً ويقرأ واقفاً، قرأ الكتاب المقدس بترجمة الشيخ إبراهيم اليازجي من سفر التكوين إلى رؤيا يوحنّا، صمّم على التهام كلّ ما أرسله إليه قبل وفاته يوسف أبو شَعر الذي سدّد عنه أقساط المدرسة، صندوق من الكتب التي كان لديه منها أكثر من نسخة أحضرها زوج المرأة التي خدمته طوال حياته. الجاحظ، المحاسن والأضداد، كتاب أخبار الأعيان في جبل لبنان، ولمّا وضع أمامه على المنضدة كتاب المواقف ويليه كتاب المخاطبات لمحمّد بن عبد الجبّار بن حسن النفري وقرأ المقدّمة التي تعرّف به، "إنه القبض على تفتّح الذات على الوجود الداخلي الصرف الذي تكتنزه منذ الأزل، إنّه انكشاف مخبوءات الذات والوجود وعوالمها أمام الذات نفسها"، أطربه الوجود الداخلي الأزلي الصرف هذا. تحمّس للقراءة، فتح صفحة كيفما اتفق: "يقول الله لعبده خلقتك على صورتي واحداً فرداً سميعاً بصيراً متكلماً وجعلتك لتجليات أسمائي ومحلّاً لعنايتي، أنت منظري لا ستور مسدلة بيني وبينك، أنت جليسي لا حدود بيني وبينك، يا عبد ليس بيني وبينك بين، أنت أقرب إليّ من نفسك، أنا أقرب إليك من نطقك ..." فشعر بالحاجة الملحّة إلى الكتابة من دون أن تحضره فكرة بعينها، رغبة لا تقاوم سيطرت عليه فأحسّ بأنّه ممتلئ ويكاد يفيض. يشعر بأن الكلام مخزون في داخله، وُلد معه أو كان موجوداً قبله، على الدوام، ينتظر فقط الالتقاء به وليس عليه هو سوى الاهتداء إلى هذا الكلام وعدم خيانته، أن يصبر فقط حتى يخرج إلى العلن في مخاض يكون عسيراً في بعض الأحيان. وكانت نوبات من الوحي تأتيه ليلاً، يجلس في سريره ويتلمّس قلماً من حواليه ويدوّن أينما كان، على منديل ورقيّ أو على كفّ يده عندما لا يجد ما يكتب عليه، في عتمة غرفة نومه، العبارة التي كانت تلحّ عليه وتؤرّقه على أن ينزلها بشكلها النهائي في ضوء النهار.
وصل إلى النهاية عندما تضاءلت هبّات الكتابة، أفرغ جلّ ما عنده كأنه بلّغ واستراح فبدأ يراجع ما أنجزه، يقرأ عالياً كي يضبط إيقاع الجمل، يوزّع ارتفاعها وسقوطها، يتردّد طويلاً أمام نعتَين متتاليين، يسمح لنفسه بافتتاح بعض الجمل بالفاعل بدل الفعل ويركّب جملاً اسمية وباعتماد عبارات من كلمة واحدة قبل أن يعيد الخاتمة ويعيد حتى يصل إلى إيقاع يطربه. جمع الأوراق المتفرّقة التي كتب عليها على شكل دفتر وجلّدها بالأحمر. حمله معه إلى بيروت، دار به على دور النشر واحدةً واحدةً بعد أن استرشد للعثور عليها بدليل نقابة الطابعين والناشرين التي تأسّست عام 1934. وصار يضع مسوّدته فوق الطاولة الصغيرة بجانب سريره ليلاً ولا يخرج إلاّ وقد تأبّطها حتى حصل له ما حصل.
لكن في ليلة مضطربة عاد فيها من "لوس لاتينوس" وقد أفرط في الشرب على غير عادته رأى فريد نفسه في الحلم يقصد القرية وحده ويجمع بعض أغصان اللزّاب اليابسة فيصنع بها محرقة كتلك التي كان يرقص حولها صغيراً مع رفاق قريته في يوم عيد الربّ، ويرمي كتابه الأحمر فيها وينتظر حتى يتحوّل رماداً، يرتاح منه كأنّه لم يكتبه، كأنّه لم يكن، يحرقه وهو يسمع صوتاً أليفاً يقول "والله ما أحرقتك حتى كدت أحترق بك".
لكنه استفاق صباح اليوم التالي هادئاً ولم يبق له من حلمه هذا سوى ذكرى غامضة.