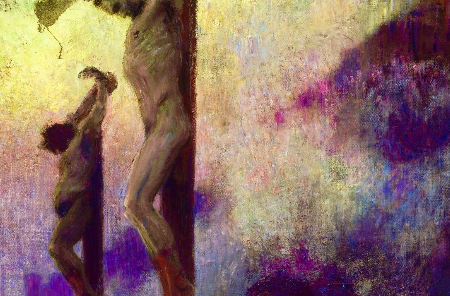كان إميل حبيبي صادقاً في أدبه وذلك تحديداً لأنّه كتب عن أبي النّحس ولم يكتب عن أم سعد. لأنّه كتب عن فلسطيني آخر لم نكن، كفلسطينيي اللجوء والشتات، نعرفه، لم نكن (ليس أنا فلم أكن قد وُلدت بعد) نعرف من الأدب الفلسطيني القادم من الداخل إلا ”أدب المقاومة“ الذي عرّف القراءَ العرب بهم غسّان كنفاني، لكنه كان شعراً، وكان راهناً، وكان ردّ فعل فورياً على احتلال وحكم عسكري. لاحقاً أتى إميل حبيبي بالرواية التي تحتاج وقتاً كي تُكتب، كي تستوعب ما حصل وكي تفيه حقّه.
كالعديد من المسائل الفلسطينية هو إميل حبيبي، إشكالي مُختلَف عليه لاعتبارات لا تكون عادة في مكانها، هل كان لا بدّ أن يُغتال كي يخرج من المساحة الإشكالية؟ لدينا مشكلة نحن الفلسطينيين فلنعترف بها، هي أنّ الاستشهاد ”يجبّ ما قبله“، مثالان بارزان هنا هو محمود درويش (هو كذلك مسألة إشكالية) وياسر عرفات الذي صار، وقد اغتيل بالسّم كما تبيّن، شهيداً وبطلاً ”قومياً“ فلسطينياً، أمّا درويش فبقي مسألة إشكالية لدى الكثيرين، وذلك لقربه من عرفات!
حسناً، كي لا تدخل المسائل في بعضها وكي لا تكون هذه المقالة هي الأخرى إشكالية (دون أي حرص منّي على أن لا تكون، بالمناسبة): لستُ هنا في وارد طرح رأي ”مزاودٍ“ لا في درويش ولا في عرفات ولا في حبيبي. ولا أقول بأنّ عرفات ليس بطلاً بل صاره لأنّه في عُرفنا شهيد، ولا أقول بأنّ درويش لدى الكثيرين من المتحفّظين على مواقفه السياسية، كان حتماً سيُتوّج كشاعر ”قومي“ لو أنّه اغتيل قبل وفاته، أو قبل إجراء العمليّة الجراحيّة بساعة. بل أقول بأنّي سعيدٌ أن ذلك لم يحصل وأنّي لا أرى في درويش أقلّ من شاعر وطني (دون حاجته ليكون شهيداً). هو أوّل من أحكي عنه كلّما عرّفت عن نفسي هنا في فرنسا، كفلسطيني (ربّما لأني كذلك أعرف أين تقع كتبه في مكتبات المدينة). أمّا عرفات الذي تخلّصتُ من ”كراهيتي“ الفصائليّة له منذ سنوات، فهو مسألة أخرى.
ماذا لو استُشهد إميل حبيبي إذن؟ هل سيكون في حينها بطلاً قومياً، روائياً قومياً؟ اعذروني على تكرار هذه الكلمة الغليظة: قومياً، لكنّها الأنسب في إظهار مدى فداحة التقييمات الوطنية/السياسية التي نحترفها/نقترفها نحن الفلسطينيون. أنا واثق بأنّ حبيبي سيكون في حينها (كشهيد) مجاوراً لغسان كنفاني كلّما أتى الحديث عنه فلسطينياً، وما عاد الرّجل إشكالياً. لماذا؟ لأنّ حديثنا عن أدبائنا هو حديث وطني سياسي وهذا غلط (غلط غلط)، وكذلك لأنّ تاريخ أدبائنا يتغيّر إن مات الأديب اغتيالاً. هل هذا يعني أنّ إدراكنا لغسان كنفاني هو في جزء منه إدراك سياسي لكونه شهيداً بل وقائداً سياسياً قبلها؟ نعم، للأسف نعم. المسألة بسيطة: أعطني أدباء شهداء أعطيك حديثاً عظيماً عنهم، سيكون حتماً حديثاً سياسياً!
لكن ما الذي بقي من كنفاني المناضل مقابل كنفاني الروائي؟ لمَ نقدّم تقييماً سياسياً لهذا وذاك في وقت يكون فيه أعظم ما قدّمه هؤلاء لفلسطين والإنسانية، وهو الباقي، هو تراثهم الأدبي؟ لنأخذ المسألة معكوسةً: ليس لاستشهاد كنفاني أي قيمة تُضاف إلى أدبه، لم يختر هو أن يتم تفخيخ سيارته، وما كان ليفضّله إن خُيّر (طبعاً!) وما قبِل يوماً أن يحمل مسدّساً، أمّا ما يُضاف إلى أدبه فهو المصداقية، هو الصدق فيه، هو اختياره بأن يكون هو بذاته جزءاً عضوياً من أدبه الذي تناول فيه المخيمات واللاجئين قبل غيرهم، دون أن يحتاج، بالمناسبة، لأن يعيش هو ذاته في المخيّم.
وهذا هو إميل حبيبي الذي لسوء حظّه لم يُستشهد، لسوء حظّه ولحسن حظّنا (تماماً كما أنّه لسوء حظّنا أن كنفاني استُشهد، بل وباكراً جداً)، وهذا ما أعطاه، لحبيبي، عمراً مديداً (نسبياً، فقد توفي بسبب المرض) ليكتب أكثر، ليكون، عندي وعند كثيرين، قامة أدبية فلسطينية راسخة نحكي بها كذلك كلّما أتينا على حديث فلسطيني.
كان إميل حبيبي صادقاً في أدبه وذلك تحديداً لأنّه كتب عن أبي النّحس ولم يكتب عن أم سعد. لأنّه كتب عن فلسطيني آخر لم نكن، كفلسطينيي اللجوء والشتات، نعرفه، لم نكن (ليس أنا فلم أكن قد وُلدت بعد) نعرف من الأدب الفلسطيني القادم من الداخل إلا ”أدب المقاومة“ الذي عرّف القراءَ العرب بهم غسّان كنفاني، لكنه كان شعراً، وكان راهناً، وكان ردّ فعل فورياً على احتلال وحكم عسكري. لاحقاً أتى إميل حبيبي بالرواية التي تحتاج وقتاً كي تُكتب، كي تستوعب ما حصل وكي تفيه حقّه. لا يمكن للرواية أن تكون راهناً كما قال مرّة (وهذا كذلك إشكالي) فكتب لاحقاً عن الفلسطيني الآخر، مَن يبحث عن هويته مِن بين الرّكام الذي أحدثته النّكبة، يبحث عن هويّته في أرضه، عمّا بقي فيه ممّن رحلوا، فلم يكن متفائلاً تفاؤل المناضلين، ولم يكن متشائماً تشاؤم المنهزمين (ولم يكن بطلاً غرامشياً ولا دونكيشوتياً)، كان ببساطة إنسانياً، كان حقيقياً وهشّاً، وكان المتشائل نسبةً عالية من أهلنا ممن بقوا في فلسطين ومن عاشوا تحت الحكم العسكري الإسرائيلي لسنوات. مصداقية حبيبي كانت في كتابة هؤلاء، لا كتابة الفدائيين في المعسكرات خارج فلسطين، في كتابة أصحاب الأرض المخذولين المتروكين لا اللاجئين في المخيمات الذين ثاروا وحملوا البندقيّة.
إميل حبيبي يشبه الجزء القادم هو منه من الفلسطينيين، تماماً كما يشبه غسان كنفاني الجزء القادم هو منه من الفلسطينيين. الأوّل روى لنا عن البقاء في حيفا والثاني عن العودة إلى حيفا. الأوّل روى لنا عن فلسطينيي الداخل والثاني عن الخارج. وليكون لكل منهما مصداقية كان لا بد أن يكتب كل منهما عن الناس الذين انتمى إليهم، بهمومهم ويومياتهم وتحديداً بأساليب المقاومة المناسبة لهم، ليكون مجرّد البقاء في حيفا والناصرة وعكا والقرى وغيرها، عام النكبة، وهو ما حكى عنه حبيبي كثيراً، الفعلَ الفلسطيني الأكثر جذريةً في تاريخنا، اسألونا نحن أبناء الأجيال اللاحقة من اللاجئين ونحن نكمل، مجبورين، مشوار اللجوء الذي بدؤوه منذ سبعين عاماً.
إن كان لا بدّ من حديث أساسيّ عن إميل حبيبي فليكن عن تراثه الأدبي وعن فكرة البقاء وعن الهوية الوطنية الفلسطينية لأهلنا الباقين في البلاد، وعن القيمة التي أضافها أدبه إلى فلسطين كتاريخ وثقافة ومجتمع، أمّا الحديث السياسي كمعيار أساسي فأجدر به أن يكون لشخصيات كياسر عرفات، دون أن يعني ذلك وجوب تجاهل المواقف السياسية الإشكالية (والتي لا أتفق معه عليها) لحبيبي، وهي اجتهادات لا تقلّل من قيمته الأدبية، اجتهادات أنا واثق أنّها ستُنسى إن صار ومات مستشهداً، اجتهادات أنا واثق على الأقل من أنّ حبيبي أراد منها الأفضل للفلسطينيين هناك (وللفلسطينيين في كل مكان)، أراد لهم البقاء.
الفكرة الأساس لدى إميل حبيبي كانت البقاء في حيفا، البقاء في كل الوطن، وهذا ما نقرأه في أدبه كما نقرأه في كتاباته السياسية ومقابلاته، وهذا الوعي ”الحبيبيّ“ لو كان لدى أجدادنا عام النّكبة لما وُجد اليوم ما يقارب ٦ ملايين لاجئ فلسطيني في كل العالم، أحدهم أنا هنا، لا أعرف ما الذي أفعله في فرنسا.
حسناً، كي لا تدخل المسائل في بعضها وكي لا تكون هذه المقالة هي الأخرى إشكالية (دون أي حرص منّي على أن لا تكون، بالمناسبة): لستُ هنا في وارد طرح رأي ”مزاودٍ“ لا في درويش ولا في عرفات ولا في حبيبي. ولا أقول بأنّ عرفات ليس بطلاً بل صاره لأنّه في عُرفنا شهيد، ولا أقول بأنّ درويش لدى الكثيرين من المتحفّظين على مواقفه السياسية، كان حتماً سيُتوّج كشاعر ”قومي“ لو أنّه اغتيل قبل وفاته، أو قبل إجراء العمليّة الجراحيّة بساعة. بل أقول بأنّي سعيدٌ أن ذلك لم يحصل وأنّي لا أرى في درويش أقلّ من شاعر وطني (دون حاجته ليكون شهيداً). هو أوّل من أحكي عنه كلّما عرّفت عن نفسي هنا في فرنسا، كفلسطيني (ربّما لأني كذلك أعرف أين تقع كتبه في مكتبات المدينة). أمّا عرفات الذي تخلّصتُ من ”كراهيتي“ الفصائليّة له منذ سنوات، فهو مسألة أخرى.
ماذا لو استُشهد إميل حبيبي إذن؟ هل سيكون في حينها بطلاً قومياً، روائياً قومياً؟ اعذروني على تكرار هذه الكلمة الغليظة: قومياً، لكنّها الأنسب في إظهار مدى فداحة التقييمات الوطنية/السياسية التي نحترفها/نقترفها نحن الفلسطينيون. أنا واثق بأنّ حبيبي سيكون في حينها (كشهيد) مجاوراً لغسان كنفاني كلّما أتى الحديث عنه فلسطينياً، وما عاد الرّجل إشكالياً. لماذا؟ لأنّ حديثنا عن أدبائنا هو حديث وطني سياسي وهذا غلط (غلط غلط)، وكذلك لأنّ تاريخ أدبائنا يتغيّر إن مات الأديب اغتيالاً. هل هذا يعني أنّ إدراكنا لغسان كنفاني هو في جزء منه إدراك سياسي لكونه شهيداً بل وقائداً سياسياً قبلها؟ نعم، للأسف نعم. المسألة بسيطة: أعطني أدباء شهداء أعطيك حديثاً عظيماً عنهم، سيكون حتماً حديثاً سياسياً!
لكن ما الذي بقي من كنفاني المناضل مقابل كنفاني الروائي؟ لمَ نقدّم تقييماً سياسياً لهذا وذاك في وقت يكون فيه أعظم ما قدّمه هؤلاء لفلسطين والإنسانية، وهو الباقي، هو تراثهم الأدبي؟ لنأخذ المسألة معكوسةً: ليس لاستشهاد كنفاني أي قيمة تُضاف إلى أدبه، لم يختر هو أن يتم تفخيخ سيارته، وما كان ليفضّله إن خُيّر (طبعاً!) وما قبِل يوماً أن يحمل مسدّساً، أمّا ما يُضاف إلى أدبه فهو المصداقية، هو الصدق فيه، هو اختياره بأن يكون هو بذاته جزءاً عضوياً من أدبه الذي تناول فيه المخيمات واللاجئين قبل غيرهم، دون أن يحتاج، بالمناسبة، لأن يعيش هو ذاته في المخيّم.
وهذا هو إميل حبيبي الذي لسوء حظّه لم يُستشهد، لسوء حظّه ولحسن حظّنا (تماماً كما أنّه لسوء حظّنا أن كنفاني استُشهد، بل وباكراً جداً)، وهذا ما أعطاه، لحبيبي، عمراً مديداً (نسبياً، فقد توفي بسبب المرض) ليكتب أكثر، ليكون، عندي وعند كثيرين، قامة أدبية فلسطينية راسخة نحكي بها كذلك كلّما أتينا على حديث فلسطيني.
كان إميل حبيبي صادقاً في أدبه وذلك تحديداً لأنّه كتب عن أبي النّحس ولم يكتب عن أم سعد. لأنّه كتب عن فلسطيني آخر لم نكن، كفلسطينيي اللجوء والشتات، نعرفه، لم نكن (ليس أنا فلم أكن قد وُلدت بعد) نعرف من الأدب الفلسطيني القادم من الداخل إلا ”أدب المقاومة“ الذي عرّف القراءَ العرب بهم غسّان كنفاني، لكنه كان شعراً، وكان راهناً، وكان ردّ فعل فورياً على احتلال وحكم عسكري. لاحقاً أتى إميل حبيبي بالرواية التي تحتاج وقتاً كي تُكتب، كي تستوعب ما حصل وكي تفيه حقّه. لا يمكن للرواية أن تكون راهناً كما قال مرّة (وهذا كذلك إشكالي) فكتب لاحقاً عن الفلسطيني الآخر، مَن يبحث عن هويته مِن بين الرّكام الذي أحدثته النّكبة، يبحث عن هويّته في أرضه، عمّا بقي فيه ممّن رحلوا، فلم يكن متفائلاً تفاؤل المناضلين، ولم يكن متشائماً تشاؤم المنهزمين (ولم يكن بطلاً غرامشياً ولا دونكيشوتياً)، كان ببساطة إنسانياً، كان حقيقياً وهشّاً، وكان المتشائل نسبةً عالية من أهلنا ممن بقوا في فلسطين ومن عاشوا تحت الحكم العسكري الإسرائيلي لسنوات. مصداقية حبيبي كانت في كتابة هؤلاء، لا كتابة الفدائيين في المعسكرات خارج فلسطين، في كتابة أصحاب الأرض المخذولين المتروكين لا اللاجئين في المخيمات الذين ثاروا وحملوا البندقيّة.
إميل حبيبي يشبه الجزء القادم هو منه من الفلسطينيين، تماماً كما يشبه غسان كنفاني الجزء القادم هو منه من الفلسطينيين. الأوّل روى لنا عن البقاء في حيفا والثاني عن العودة إلى حيفا. الأوّل روى لنا عن فلسطينيي الداخل والثاني عن الخارج. وليكون لكل منهما مصداقية كان لا بد أن يكتب كل منهما عن الناس الذين انتمى إليهم، بهمومهم ويومياتهم وتحديداً بأساليب المقاومة المناسبة لهم، ليكون مجرّد البقاء في حيفا والناصرة وعكا والقرى وغيرها، عام النكبة، وهو ما حكى عنه حبيبي كثيراً، الفعلَ الفلسطيني الأكثر جذريةً في تاريخنا، اسألونا نحن أبناء الأجيال اللاحقة من اللاجئين ونحن نكمل، مجبورين، مشوار اللجوء الذي بدؤوه منذ سبعين عاماً.
إن كان لا بدّ من حديث أساسيّ عن إميل حبيبي فليكن عن تراثه الأدبي وعن فكرة البقاء وعن الهوية الوطنية الفلسطينية لأهلنا الباقين في البلاد، وعن القيمة التي أضافها أدبه إلى فلسطين كتاريخ وثقافة ومجتمع، أمّا الحديث السياسي كمعيار أساسي فأجدر به أن يكون لشخصيات كياسر عرفات، دون أن يعني ذلك وجوب تجاهل المواقف السياسية الإشكالية (والتي لا أتفق معه عليها) لحبيبي، وهي اجتهادات لا تقلّل من قيمته الأدبية، اجتهادات أنا واثق أنّها ستُنسى إن صار ومات مستشهداً، اجتهادات أنا واثق على الأقل من أنّ حبيبي أراد منها الأفضل للفلسطينيين هناك (وللفلسطينيين في كل مكان)، أراد لهم البقاء.
الفكرة الأساس لدى إميل حبيبي كانت البقاء في حيفا، البقاء في كل الوطن، وهذا ما نقرأه في أدبه كما نقرأه في كتاباته السياسية ومقابلاته، وهذا الوعي ”الحبيبيّ“ لو كان لدى أجدادنا عام النّكبة لما وُجد اليوم ما يقارب ٦ ملايين لاجئ فلسطيني في كل العالم، أحدهم أنا هنا، لا أعرف ما الذي أفعله في فرنسا.