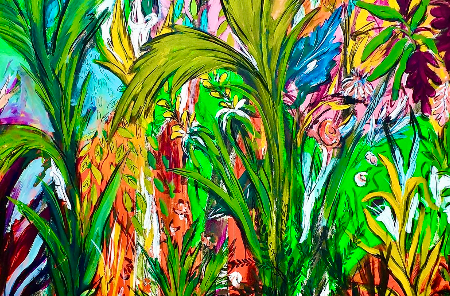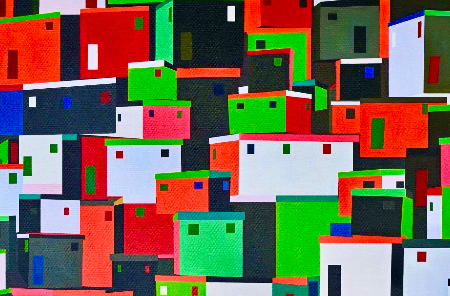Roy Krenke, Ancient Alexandria, ink & watercolor
مع هذا الحضور، سطع نجم شيخ جامع القائد ابراهيم في "الأزاريطة"، في قلب الاسكندريّة. وهو الوسط الذي طالما شكّل موئلاً للتعدديّة والتسامح الديني والعرقي الذي وسم المدينة وشكّل مركزاً لوجود الطليان واليونانيين والانجليز والفرنسيين.. وربما غبرهم. وعلت ميكروفونات الجامع، ليُشكّل مكاناً لتفريخ الأيدولوجيا الدينيّة وانتشارها.
في سنوات السبعينيات من القرن الماضي، وربما مع دعم السادات للقوى الدينيّة الأصوليّة، هادفاً إلى ضرب تنظيمات اليسار المصري، التي كانت تحتفظ حتّى ذلك الوقت بقدرٍ من التأثير بين الناس، بدأ زحف التنظيمات الإسلاميّة الأصوليّة، وظهرت هيمنتها على منابر الجوامع. وشيئاً فشيئاً، بدا حضورها جلياً في الشارع، ساعدها في ذلك القوة الاقتصاديّة الفاعلة للإخوان المسلمين، واستثمارهم الانتهازي الذكيّ لحادث الزلزال الذي ضرب مصر أوائل التسعينيات، ومسارعتهم إلى مدّ يد العون للمتضررين من المحتاجين، في حين غابت مؤسسات الدولة تماماً، الأمر الذي واصله التنظيم الإخواني، بعد ذلك، في الأحياء الفقيرة والمناطق النائية المنسيّة، مستغلاً تحالف الجهل والفقر هناك، ما منح وجوداً مكثفاً وحقيقياً للجماعات الإسلاميّة في أحياء الاسكندريّة الأكثر فقراً وجهلاً.
مع هذا الحضور، سطع نجم شيخ جامع القائد ابراهيم في "الأزاريطة"، في قلب الاسكندريّة. وهو الوسط الذي طالما شكّل موئلاً للتعدديّة والتسامح الديني والعرقي الذي وسم المدينة وشكّل مركزاً لوجود الطليان واليونانيين والانجليز والفرنسيين.. وربما غبرهم. وعلت ميكروفونات الجامع، ليُشكّل مكاناً لتفريخ الأيدولوجيا الدينيّة وانتشارها.
لقد تمدّدت الحركة الدينيّة الأصوليّة، دون ضوابط، حتّى أنه لم يعد من المبالغة القول، أن الاسكندريّة، التي طالما عُرفت بالتعدديّة التي تحترم وجود الآخر، ومعتقداته الدينيّة، وثقافته المختلفة، وبالليبراليّة الفكريّة والسياسيّة، باتت تُعرف بأنها مركز ثقل التنظيماتّ الأكثر أصوليّة وتطرفاً في مصر.
***
يجذبنا الحنين إلى الزمن الكوزموبولوتاني للاسكندريّة، حين نتأمّل أسماء أحياء المدينة، التي ما زالت صامدة كما هي حتّى الأن، منذ سنوات بعيدة تعود إلى أزمنة التعدديّة وتقبّل الآخر، وهي أسماء من الملاحظ أنها لم تتغيّر، رغم تغيّر طبيعة الأنظمة التي مرّت على مصر على مدى السنوات الماضية.
ولسنا في حاجة إلى جهد لنكتشف أن هذه الأسماء هي أجنبيّة في الأساس، تعود في معظمها إلى أشخاص كانوا فاعلين ومؤثرين في المدينة. وإذا ما استعرضنا بعضها، المتداول بثبات حتى الآن، فإننا سوف نتأكد من ذلك.
ربما تكون المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت، هي المصدر الوحيد المتوافر لنا حول هذه المسألة، وهو المصدر الذي سنعتمده إلى حين العثور على مصادر أخرى أكثر وثوقيّة.
فاسم "زيزينيا" جاء من اسم الكونت زيزينيا، تاجر القطن الإيطالي الشهير في زمنه، والذي عاش طويلاً في الاسكندريّة؛ فيما جاء اسم "لوران" من اسم الخواجا لوران صاحب شركة سجائر كان معروفاً خلال سنوات القرن الثامن عشر، ويشغل قصره الآن مدرسة لوران الثانويّة للبنات. أمّا "بولكلي" (الذي طالما حسبتُ أنه جاء من اسم الفنان التشكيلي العالمي الشهير)، ومعه أسماء "فلمنج" و"شوتس" و"ستانلي"، فهي أسماء لشخصيّات إنجليزيّة من مؤسسي مجلس إدارة ترام الرّمل. وأمّا "جليم" فقد جاء من اسم جليموبولو"، وهو يوناني وأحد أعضاء المجلس البلدي للاسكندريّة في إحدى حقبها التاريخيّة الحديثة. وأمّا "بكوس" (الذي يوحي بأنه مشتق من اسم الآلهة اليونانيّة باخوس)، فهو نسبة إلى الخواجا اليوناني باكوس، الذي كان شخصيّة مؤثّرة في بورصة تجارة القطن في المدينة؛ في حين تُنسب "جناكليس" إلى خواجا يوناني آخر يحمل هذا الإسم، وكان صاحب مزارع عتب ومصانع تقطير الكروم (النبيذ)، وما زالت تحمل اسمه إحدى كبريات شركات إنتاج وتجارة الخمور في مصر. وأمّا منطقة "سابا باشا"، فهي نسبة إلى شخص يحمل الاسم ذاته، وهو مصري من أصول لبنانيّة، كان أوّل مصريّ يُعيّن لشركة البوستة الخديويّة (شركة ملاحة بحريّة)، ثمّ عُيّن وزيراً للماليّة في مصر. أمّا "سموحة" فهو يهودي عراقي وفد إلى الاسكندريّة، وقد تولّى عمليّة تجفيف بحيرة "الحضرة". في حين تُنسب "محرّم بيه" إلى محرّم بك زوج تفيدة هانم بنت محمد علي باشا، وكان خلال سنوات من حياته حاكماً للاسكندريّة؛ في حين تُنسب "مريوط" إلى ماريوت باشا، أحد الأثريين الفرنسيين المشهورين، الذين قدموا الاسكندريّة أواخر القرن التاسع عشر. وأما "أبو قير" فهي محوّرة عن اسم الأب كير، وهو راهب مسيحي ولد في الاسكندريّة في القرن الثاني الميلادي، واستشهد فيها، ودفن في ترابها.
***
في الاسكندريّة، ليس من غرائب الأمور أن تعثر على جامع يحمل اسم أحد أنبياء بني إسرائيل (جامع النبي دانيال). ولا نعلم متى وأين ومن الذي اجتهد وأشاع أن الإسم يعود إلى شيخ جليل، مسلم، اسمه "محمد دانيال الموصلي"، وأن لقب الشيخ تطوّر مع الزمن إلى "النبي دانيال" (كيف ومتى ومن الذي منحه شرف النبوّة؟!). ومن المعروف أن المعبد اليهودي بالاسكندريّة يقع في شارع النبي دانيال نفسه. فهل اختار اليهود شارع الشيخ/النبي محمد دانيال ليقيموا فيه كنيسهم؟!
مهما يكن، فإن الاسكندريّة المتسامحة، عرفت منذ زمن كان لمّا يزل يحتفظ بشيء من الليبراليّة الاجتماعيّة والانفتاح، باراً مشهوراً من باراتها الواقعه في الوسط التجاري يعود تأسيسه إلى مطلع القرن العشرين، في شارع صغير متفرّع من سعد زغلول من جهة، وشارع شريف (صلاح سالم) من الجهة الأخرى، وسط المدينة، عُرف باسم "بار الشيخ علي". ولا شكّ في أن البحث عن حقيقة "الشيخ" الذي يملك باراً يشتهر باسمه ويجعل الناس ينسون الاسم المعلّق على بابه (الكاب دور) ظلّت تؤرقني، مثلما أرّقت غيري. فهل جاء الاسم في إحدى موجات الانفتاح الليبرالي، أم أن الصدفة لعبت دوراً في ذلك؟
الحيرة، ظلّت ترافق السؤال، الذي لم يُجب عنه أحد كتّاب الاسكندريّة الجادين (علاء خالد)، أكثر المعنيين بقراءة الـ"أمكنة" (اسم مجلّة متخصصة أصدرها في الاسكندريّة لهذه الغاية)، والذي كتب حول البار مقالة بالغة الجديّة والتميز، اكتفى فيها بالقول: "كيف يجتمع اسم الشيخ والبار في جملة واحدة؟ هناك روايات كثيرة عن اسم الشهرة هذا، ولكنني لم أصدّق أياً منها، أو بمعنى أصح، لم أعرها أذناً مفتوحة“.
لكن يبدو أن كاتباً سكندرياً آخر يتميّز بأعماله الروائية التي تحرص على أن تكون الاسكندريّة مسرح أحداثها، وهو "إبراهيم عبد المجيد"، شاء أن يُصدّق، أو يتبنى، قصّة لم تخل من جماليّات سرديّة، دون أن يغيب عنها المنطق القابل للإقناع، حتّى لو لم تتأكّد حقيقتها.
فقد روى عبد المجيد (في روايته «الاسكندريّة في غيمة») أن شخصاً يُدعى "علي"، هو الذي اشترى البار من خواجا يونانيّ كان يتهيّأ للمغادرة، وقد أصبح المدعو علي حريصاً على إغلاق البار يوم الجمعة، لما يعنيه اليوم بالنسبة للمسلمين، ما جعل الزبائن الذين يترددون على المكان، يتندرون، مستثمرين خفّة الظلّ المصريّة، ومشيعين أن البار أصبح اسمه بعد قرار الإغلاق في ذلك اليوم، "بار الشيخ علي"!
لقد نسي الناس الاسم القديم الذي حلّ مكانه اسم "بار الشيخ علي". وتجدر الإشارة أن المخرج المتميّز داود عبد السيّد، استثمر المكان في مشاهد من فيلمه «رسائل البحر»، الذي تدور أحداثه في الاسكندريّة.
***
سيرة شيوخ الاسكندريّة، لا تمضي دون الحديث عن شيخ روى عنه "حسام تمام"، الباحث السكندري الراحل، الذي تخضّض في تاريخ الحركات الإسلاميّة. فهو يحكي عن الشيخ "عبّاس السيسي"، أحد المفكرين الإسلاميين المؤثرين في المجتمع دون تعصّب، وإمام جامع سيدي جابر في فترة سابقة، وأحد أعضاء مكتب الإرشاد للإخوان المسلمين…
يقول تمام، أن الشيخ السيسي كان منفتحاً ويحمل تقديراً عالياً للفن، وأنه عندما كان يتردد على القاهرة من الاسكندريّة لحضور اجتماعات مكتب الإرشاد للإخوان، كان يحرص، قبل الاجتماع، أن يطوف على دور السينما القاهريّة. يستعرض الأفلام المعروضة، لينتقي أحدها. يحجز تذكرة سينما قبل توجهه للاجتماع. ولا يغادر العاصمة قبل مشاهدة الفيلم الذي توسّم فيه الخير. ولم يكن الشيخ السيسي مدمناً حضور الأفلام السينمائيّة فحسب، بل ظلّ يحلم طويلاً بتبني التنظيم إنتاج فيلم يتناول شخصيّة وحياة مؤسس الحركة، الشيخ حسن البنّا.
***
بعد التطورات التي شهدتها العقود الأخيرة، لم يعد من النادر، مع تسلل الزّمن التكفيري وطغيانه، أن ترى الجلابيات تغزو ماء البحر وزمانه على شواطئ المعمورة والمنتزه، وترى الحجاب وهو يغزو محطة الرّمل، موئل الأجانب حتّى منتصف القرن المنصرم، ومسرح أحداث رواية لورنس داريل «الرباعيّة الاسكندرانيّة»، والذي سرعان ما تجاوز نفسه ليحلّ مكانه غزو النقاب.
وتتذكّر أنك، منذ عقودٍ قليلة، كنت ترى الصبايا على كورنيش البحر، عند شاطئ "ميامي"، حتّى لا نقول في مناطق أكثر انفتاحاً اجتماعياً، وهنّ يتجوّلن بملابس البحر، يقطعن شارع الكورنيش، من البحر إلى الناحية الأخرى.. ليشترين ”الجيلاتي"!
مع هذا الحضور، سطع نجم شيخ جامع القائد ابراهيم في "الأزاريطة"، في قلب الاسكندريّة. وهو الوسط الذي طالما شكّل موئلاً للتعدديّة والتسامح الديني والعرقي الذي وسم المدينة وشكّل مركزاً لوجود الطليان واليونانيين والانجليز والفرنسيين.. وربما غبرهم. وعلت ميكروفونات الجامع، ليُشكّل مكاناً لتفريخ الأيدولوجيا الدينيّة وانتشارها.
لقد تمدّدت الحركة الدينيّة الأصوليّة، دون ضوابط، حتّى أنه لم يعد من المبالغة القول، أن الاسكندريّة، التي طالما عُرفت بالتعدديّة التي تحترم وجود الآخر، ومعتقداته الدينيّة، وثقافته المختلفة، وبالليبراليّة الفكريّة والسياسيّة، باتت تُعرف بأنها مركز ثقل التنظيماتّ الأكثر أصوليّة وتطرفاً في مصر.
***
يجذبنا الحنين إلى الزمن الكوزموبولوتاني للاسكندريّة، حين نتأمّل أسماء أحياء المدينة، التي ما زالت صامدة كما هي حتّى الأن، منذ سنوات بعيدة تعود إلى أزمنة التعدديّة وتقبّل الآخر، وهي أسماء من الملاحظ أنها لم تتغيّر، رغم تغيّر طبيعة الأنظمة التي مرّت على مصر على مدى السنوات الماضية.
ولسنا في حاجة إلى جهد لنكتشف أن هذه الأسماء هي أجنبيّة في الأساس، تعود في معظمها إلى أشخاص كانوا فاعلين ومؤثرين في المدينة. وإذا ما استعرضنا بعضها، المتداول بثبات حتى الآن، فإننا سوف نتأكد من ذلك.
ربما تكون المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت، هي المصدر الوحيد المتوافر لنا حول هذه المسألة، وهو المصدر الذي سنعتمده إلى حين العثور على مصادر أخرى أكثر وثوقيّة.
فاسم "زيزينيا" جاء من اسم الكونت زيزينيا، تاجر القطن الإيطالي الشهير في زمنه، والذي عاش طويلاً في الاسكندريّة؛ فيما جاء اسم "لوران" من اسم الخواجا لوران صاحب شركة سجائر كان معروفاً خلال سنوات القرن الثامن عشر، ويشغل قصره الآن مدرسة لوران الثانويّة للبنات. أمّا "بولكلي" (الذي طالما حسبتُ أنه جاء من اسم الفنان التشكيلي العالمي الشهير)، ومعه أسماء "فلمنج" و"شوتس" و"ستانلي"، فهي أسماء لشخصيّات إنجليزيّة من مؤسسي مجلس إدارة ترام الرّمل. وأمّا "جليم" فقد جاء من اسم جليموبولو"، وهو يوناني وأحد أعضاء المجلس البلدي للاسكندريّة في إحدى حقبها التاريخيّة الحديثة. وأمّا "بكوس" (الذي يوحي بأنه مشتق من اسم الآلهة اليونانيّة باخوس)، فهو نسبة إلى الخواجا اليوناني باكوس، الذي كان شخصيّة مؤثّرة في بورصة تجارة القطن في المدينة؛ في حين تُنسب "جناكليس" إلى خواجا يوناني آخر يحمل هذا الإسم، وكان صاحب مزارع عتب ومصانع تقطير الكروم (النبيذ)، وما زالت تحمل اسمه إحدى كبريات شركات إنتاج وتجارة الخمور في مصر. وأمّا منطقة "سابا باشا"، فهي نسبة إلى شخص يحمل الاسم ذاته، وهو مصري من أصول لبنانيّة، كان أوّل مصريّ يُعيّن لشركة البوستة الخديويّة (شركة ملاحة بحريّة)، ثمّ عُيّن وزيراً للماليّة في مصر. أمّا "سموحة" فهو يهودي عراقي وفد إلى الاسكندريّة، وقد تولّى عمليّة تجفيف بحيرة "الحضرة". في حين تُنسب "محرّم بيه" إلى محرّم بك زوج تفيدة هانم بنت محمد علي باشا، وكان خلال سنوات من حياته حاكماً للاسكندريّة؛ في حين تُنسب "مريوط" إلى ماريوت باشا، أحد الأثريين الفرنسيين المشهورين، الذين قدموا الاسكندريّة أواخر القرن التاسع عشر. وأما "أبو قير" فهي محوّرة عن اسم الأب كير، وهو راهب مسيحي ولد في الاسكندريّة في القرن الثاني الميلادي، واستشهد فيها، ودفن في ترابها.
***
في الاسكندريّة، ليس من غرائب الأمور أن تعثر على جامع يحمل اسم أحد أنبياء بني إسرائيل (جامع النبي دانيال). ولا نعلم متى وأين ومن الذي اجتهد وأشاع أن الإسم يعود إلى شيخ جليل، مسلم، اسمه "محمد دانيال الموصلي"، وأن لقب الشيخ تطوّر مع الزمن إلى "النبي دانيال" (كيف ومتى ومن الذي منحه شرف النبوّة؟!). ومن المعروف أن المعبد اليهودي بالاسكندريّة يقع في شارع النبي دانيال نفسه. فهل اختار اليهود شارع الشيخ/النبي محمد دانيال ليقيموا فيه كنيسهم؟!
مهما يكن، فإن الاسكندريّة المتسامحة، عرفت منذ زمن كان لمّا يزل يحتفظ بشيء من الليبراليّة الاجتماعيّة والانفتاح، باراً مشهوراً من باراتها الواقعه في الوسط التجاري يعود تأسيسه إلى مطلع القرن العشرين، في شارع صغير متفرّع من سعد زغلول من جهة، وشارع شريف (صلاح سالم) من الجهة الأخرى، وسط المدينة، عُرف باسم "بار الشيخ علي". ولا شكّ في أن البحث عن حقيقة "الشيخ" الذي يملك باراً يشتهر باسمه ويجعل الناس ينسون الاسم المعلّق على بابه (الكاب دور) ظلّت تؤرقني، مثلما أرّقت غيري. فهل جاء الاسم في إحدى موجات الانفتاح الليبرالي، أم أن الصدفة لعبت دوراً في ذلك؟
الحيرة، ظلّت ترافق السؤال، الذي لم يُجب عنه أحد كتّاب الاسكندريّة الجادين (علاء خالد)، أكثر المعنيين بقراءة الـ"أمكنة" (اسم مجلّة متخصصة أصدرها في الاسكندريّة لهذه الغاية)، والذي كتب حول البار مقالة بالغة الجديّة والتميز، اكتفى فيها بالقول: "كيف يجتمع اسم الشيخ والبار في جملة واحدة؟ هناك روايات كثيرة عن اسم الشهرة هذا، ولكنني لم أصدّق أياً منها، أو بمعنى أصح، لم أعرها أذناً مفتوحة“.
لكن يبدو أن كاتباً سكندرياً آخر يتميّز بأعماله الروائية التي تحرص على أن تكون الاسكندريّة مسرح أحداثها، وهو "إبراهيم عبد المجيد"، شاء أن يُصدّق، أو يتبنى، قصّة لم تخل من جماليّات سرديّة، دون أن يغيب عنها المنطق القابل للإقناع، حتّى لو لم تتأكّد حقيقتها.
فقد روى عبد المجيد (في روايته «الاسكندريّة في غيمة») أن شخصاً يُدعى "علي"، هو الذي اشترى البار من خواجا يونانيّ كان يتهيّأ للمغادرة، وقد أصبح المدعو علي حريصاً على إغلاق البار يوم الجمعة، لما يعنيه اليوم بالنسبة للمسلمين، ما جعل الزبائن الذين يترددون على المكان، يتندرون، مستثمرين خفّة الظلّ المصريّة، ومشيعين أن البار أصبح اسمه بعد قرار الإغلاق في ذلك اليوم، "بار الشيخ علي"!
لقد نسي الناس الاسم القديم الذي حلّ مكانه اسم "بار الشيخ علي". وتجدر الإشارة أن المخرج المتميّز داود عبد السيّد، استثمر المكان في مشاهد من فيلمه «رسائل البحر»، الذي تدور أحداثه في الاسكندريّة.
***
سيرة شيوخ الاسكندريّة، لا تمضي دون الحديث عن شيخ روى عنه "حسام تمام"، الباحث السكندري الراحل، الذي تخضّض في تاريخ الحركات الإسلاميّة. فهو يحكي عن الشيخ "عبّاس السيسي"، أحد المفكرين الإسلاميين المؤثرين في المجتمع دون تعصّب، وإمام جامع سيدي جابر في فترة سابقة، وأحد أعضاء مكتب الإرشاد للإخوان المسلمين…
يقول تمام، أن الشيخ السيسي كان منفتحاً ويحمل تقديراً عالياً للفن، وأنه عندما كان يتردد على القاهرة من الاسكندريّة لحضور اجتماعات مكتب الإرشاد للإخوان، كان يحرص، قبل الاجتماع، أن يطوف على دور السينما القاهريّة. يستعرض الأفلام المعروضة، لينتقي أحدها. يحجز تذكرة سينما قبل توجهه للاجتماع. ولا يغادر العاصمة قبل مشاهدة الفيلم الذي توسّم فيه الخير. ولم يكن الشيخ السيسي مدمناً حضور الأفلام السينمائيّة فحسب، بل ظلّ يحلم طويلاً بتبني التنظيم إنتاج فيلم يتناول شخصيّة وحياة مؤسس الحركة، الشيخ حسن البنّا.
***
بعد التطورات التي شهدتها العقود الأخيرة، لم يعد من النادر، مع تسلل الزّمن التكفيري وطغيانه، أن ترى الجلابيات تغزو ماء البحر وزمانه على شواطئ المعمورة والمنتزه، وترى الحجاب وهو يغزو محطة الرّمل، موئل الأجانب حتّى منتصف القرن المنصرم، ومسرح أحداث رواية لورنس داريل «الرباعيّة الاسكندرانيّة»، والذي سرعان ما تجاوز نفسه ليحلّ مكانه غزو النقاب.
وتتذكّر أنك، منذ عقودٍ قليلة، كنت ترى الصبايا على كورنيش البحر، عند شاطئ "ميامي"، حتّى لا نقول في مناطق أكثر انفتاحاً اجتماعياً، وهنّ يتجوّلن بملابس البحر، يقطعن شارع الكورنيش، من البحر إلى الناحية الأخرى.. ليشترين ”الجيلاتي"!