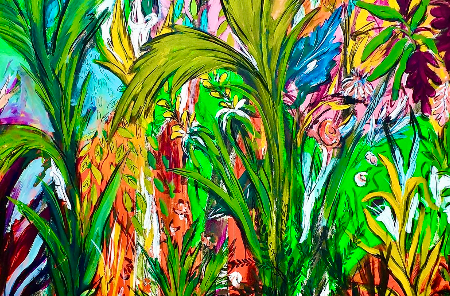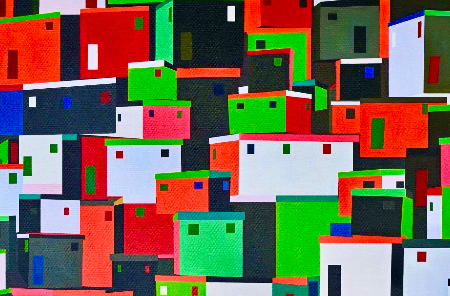تكرر الأمر معي في كل مدينة مررت بها، في برلين وفرانكفورت وديجون وبيروت ودمشق ، وغيرها. في كل مدينة وفي كل كتاب كان لي مسٌ من جدي. أتذكر أنني وجدت بضع كتب احتوت على كتابة عربية على صفحاتها، لكنني لم أعثر بعد على جدي، بعد!
جدي لأمي كان يقرأ بأكثر من لغة، ومكتبته - كما قيل لي ضمن مواريث الحكاية الفقد - ضمت عدداً كبيراً ومتنوعاً من الكتب بلغاتها الفرنسية والعربية والإنكليزية. لم أعرف الرجل كثيراً، مات قبل أن أعرفه حق المعرفة، كنت طفلاً حينها، لكنني في خضم رحلتي لاكتشاف نفسي وجذوري وهوياتي التي له نصيب منها على غير اتفاق، كان لي أن ألتقيه في أكثر من محطة؛ إذ عشت ممسوساً بظله في الحكاية بكثافة صمته.
انتهت مكتبته بعد وفاته إلى أن بيعت، وبأغلبيها مُنحت لتجار الخردة "الروبابيكيا" الجوالين، معبأة بأكياس بلاستيكية بالكيلو، مقابل القليل جداً من المال، أو على الأرجح مقابل "خردة" أخرى. علمت بهذا المصير عندما بدأت علاقتي مع الكتب والكتابة تتعمق، كشكلٍ من أشكال وحدتي في الجامعة أدرس الطبّ، لا أملك مشتركاً – تقريباً - بيني وبين زملائي وزميلاتي الذين كانت تثيرهم مهارتي ودقة يدي كطبيب، برغم كرهي للطب، تلك الوحدة التي يمدحها تاركوفسكي بالقول إنها مصدر للغنى والفرادة والفكر، لا بد أني كنت أقول ذلك كثيراً لنفسي من باب المواساة، لهذا أحببت تاركوفسكي وأفلامه. كنت أهجس طيلة الوقت أنني يوماً ما سأجد كتاباً من مكتبته تلك التي فقدتها، وأنني سأجد ورقة بخط يده الذي لا أعرفه، أو ملاحظة هنا على هامش صفحة ما، لكن ذلك لم يحدث إلى الآن، حتى وإن لم أفقد الأمل.
كان للقاهرة نصيب من هذه الوحدة وتلك العلاقة والحكاية وذاك الفقد؛ فالقاهرة تلك المدينة المهولة، بكل ما تحمله من حكايات، لا تتوقف عن تحدي مخيلتي بما تملكه، والمخيلة صديقة الوحدة الأثيرة. لذا كانت علاقتي معها علاقة منهكة لكلينا، أو على الأقل لي أنا أكثر. كنت أتمشى بين أحياء القاهرة باحثاً عن باعة الكتب القديمة وباعة الأثريات و"الروبابيكيا" (لم يعد الكثير من هؤلاء موجوداً بشكله السابق - على عربة يجرها حمار - وفعلاً أعرف الكثير منهم في أحياء مثل: المعادي ومصر الجديدة ووسط البلد ومصر القديمة والسيدة والبحر الأعظم والحسين وغيرها، لكنني أعلم أيضاً أنني لا أعرف إلا القدر اليسير جداً من هؤلاء. وهنا كانت علاقتي بالقاهرة في شقها المنهك، فقد كانت كمن يتحداني أولاً بالفقد، وثانياً بغواية كتاب واحد من تلك المكتبة المفقودة.
كنت أبحث عن أي علامة في أي كتاب أجهد دون أي دليل لتلمس آثار جدي عليه. فأنا لم أعرف جدي، ولم أعرف عن ذائقته في الكتب شيئاً، كل ما أعلمه من الحكاية الفقد هو أنه متعدد القراءات واللغات، وحتى تلك المعلومة، بات الخيال يعتريها متواطئاً مع الذاكرة برسم الوجع، لا أعلم، ولا أعتقد أنني مضطر لتلك المواجهة، الآن على الأقل.
وجدت الكثير جداً من العلامات على كتب كثيرة ومتعددة المواضيع، حينها أحسست أن الأمر لم يكن ببساطة علامات لجدي أبحث عنها لأستعيده وأستعيدها. هنا أيقنت أن بحثي لم يكن عن العلامات كدلالات على الطريق، بل كانت تلك العلامات هي بمثابة حوارٍ ما معه، حتى دون أن أضطر للاسترشاد بتاريخي معه؛ كان ثمة أمر ما مغاير في هذا المسار أعادني للرواية الأولى لكارلوس زافون من رباعيته الشهيرة عن "مقبرة الكتب المنسية"، وهي "ظل الريح"، ومنها:
"هذا المكان سر يا دانيال، إنه معبد، حرم خفي. كل كتاب أو مجلد هنا تعيش فيه روحٌ ما. روح من ألّفه وأرواح من قرؤوه وأرواح من عاشوا وحلموا بفضله. وفي كل مرة يغير الكتاب صاحبه، أو تلمس نظرات جديدة صفحاته تستحوذ الروح على قوة إضافية".
في باريس، بعد أكثر من خمسة عشر عاماً على وفاة جدي. أسير في جادة سان ميشيل على ضفاف السين، أتأمل أكشاك الكتب القديمة على الرصيف، أهجس لنفسي: بعد كل البحث في القاهرة، هل يُعقل أن أجد هنا كتاباً من مكتبة جدي؟. كنت أعلم تماماً أن الأمر شبه مستحيل، فلا فرصة لذلك، حتى وإن كان هناك كتاب من مكتبته فعلاً هنا، فلا يمكن بحال من الأحوال أن أعرفه. لكن ثمة غواية ما في الفكرة، ومسٌ ما قادر على الوخز عميقاً في مسام روحي؛ سرعان ما استجبت له؛ أنزلت حقيبتي الجلدية الكبيرة عن كتفي وأمسكت بها بين قدمي، وبدأت البحث، ثمة أمر ما يدفعني لا منطق فيه ولا له، صوت داخلي يهتف وحيداً في تلك الساحة داخلي: ابحث ستجد شيئاً ما.
كنت أبحث عن جدي فيّ، أحاول تجميعه كألعاب الأطفال المكونة من آلاف القطع الصغيرة، بحثت داخلي وداخل الحكاية الفقد، بحثت في ذاكرتي الطفولية عنه وعن غرفته المطلة على حديقة في حي مصر الجديدة بالقاهرة. استبدّت بي شهوة المعرفة والبحث، فبدأت أجمع أصغر التفاصيل التي أعرفها عنه؛ أتذكر صورة السادات في صالون البيت، وخزانته الخشبية الحمراء من الأبانوس، وأستعيد مشهد الكتب وجهاز التسجيل عليها، أستعيد مساره في الحي وأصدقاءه، وحتى اسم سيجارته.
تزاحمت فيّ الذكريات واتسعت لها في الوقت عينه التي تمر فيها عيناي على الكتب القديمة، أبحث وأمر على الصفحات كلها، في كل كتاب، بتمعن وتفحص، مع أن لغتي الفرنسية لم تكن قوية جداً لتتناسب مع موضوعات الكتب التي انتقيتها للبحث. استمر الأمر لأيام وأيام، وكان ذلك كافياً لأثير لدى بائع كتب ما فضوله، فسألني: أتبحث عن شيء ما معين؟ فأخبرته قصة جدي، ضحك وقال لي: إذا كان الأمر كذلك، فلا أعتقد أنني قادر على مساعدتك في رحلتك، لكنني أتمنى لك التوفيق. كانت تلك الحادثة كافية لتتطور علاقتي مع الرجل لدرجة أنه كان يترك لي مسؤولية البيع ليقطع إلى الضفة الثالثة ليقف ليدخن سيجارة مع صديق أو صديقة.
تكرر الأمر معي في كل مدينة مررت بها، في برلين وفرانكفورت وديجون وبيروت ودمشق ، وغيرها. في كل مدينة وفي كل كتاب كان لي مسٌ من جدي. أتذكر أنني وجدت بضع كتب احتوت على كتابة عربية على صفحاتها، لكنني لم أعثر بعد على جدي، بعد!
اليوم، بعد عشرة أعوام من عودتي من باريس، وتركي للطب، أنا الآن بائع كتب في مكتبة في عمّان، عمّان ليست القاهرة ولا باريس، لكنني لا زلت ممسوساً بالمس السحري ذاته، لكنه الآن لم يعد على ضفة واحدة من الكتاب، بل على الضفتين؛ فأنا هنا بائع الكتب ولست مشتريها فحسب. صحيح أن المكتبة التي أعمل بها تبيع كتباً جديدة غير مستعملة، لكنني أنظر في وجه كل من يشتري كتاباً وأبحث فيه عني، أو عن قصة مشابهة، عمن يبحث هذا الشاب أو تلك الفتاة، أي روح تلك التي مسته ولمَ؟ ثم أنظر إلى الكتاب بين يدي قبل أن أبيعه إياه، فأهجس نفس ذلك الهاجس الباريسي: أيعقل أن يكون كتاب فرح أنطون هذا الذي بين يدي، هو طبعة جديدة من كتاب أنطون الذي قد يكون جدي قرأه يوماً؟