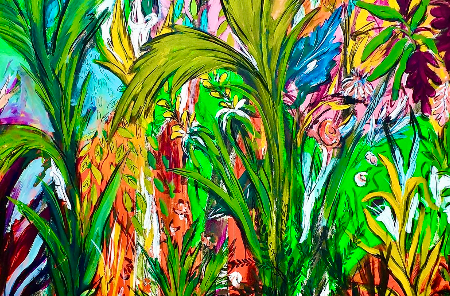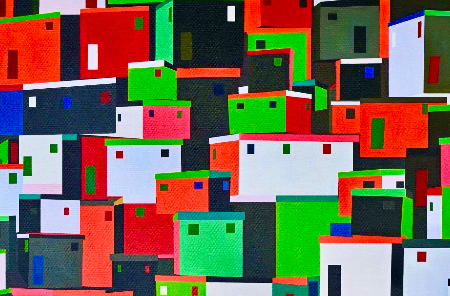إن اللحظة التي أنظر فيها إلى ابنتي في ساحة مدرستها، لا يميزها صراخ أو فرط حركة أو حتى حركة معينة، فهي هادئة لا تبرز من بين أقرانها في الساحة والقاعة الصفية، تظل هي وأقرانها أقدر مني على التصارح مع الأبوة والطفولة والحرب والعدل والحب والله، وكل قضايا البالغين التي أفسدناها.
صدرت في الشهر الأول من عام الحرب هذا 2024، قصة للأطفال واليافعين، بعنوان Under the Rockets' Glow : "تحت أضواء الصواريخ" (هذه ترجمة حرفية، كنت سأترجمها "تحت لهيب النيران"). قُدمت القصة باعتبارها محاولة المؤلف رومان ساندلر للإجابة على أسئلة ابنته الصغيرة بشأن ما حدث في السابع من أكتوبر من العام الماضي، وما تلا ذلك، وما معنى أن نكون يهودًا.
لو قدر لنا أن نصف القصة، فهي ببساطة تبرير يقدم للأطفال عن قتل أطفال آخرين وذويهم، وأن هذه المذبحة هي فعل بطولة وقيمة أخلاقية عالية، يشهد لها التاريخ. الأمر يشبه كثيرًا قصة الأطفال النازية؛ "الفطر المسموم" (بالألمانية Der Giftpilz) (الصورة الأولى) التي كتبها إرنست هايمر ورسم مشاهدها فيليب روبريكت (المعروف بفليب)، في العام 1938، ودعا فيها إلى قتل اليهود كبارًا وصغارًا، حتى أن فيها مشهد لأم ألمانية بيضاء وأطفالها بصحبتها قرب صليب عليه جثة مصلوبة (صورة 2)، كتب تحت الصورة: "علينا أن نتذكر على الدوام ما فعله اليهود بسيدنا المسيح"(1)، كتبرير لقتل غيرهم وترويض للنفس أمام المقتلة.

ما معنى أن تكون أبًا في هذه الحرب؟ لتحمل عبء أشكال وأداءات من الأبوة، تراكمت -خلال المائة عام الماضية تقريبًا- دون فعل نقدي وقيمي وتأملي بشأن الحياة اليومية، وكل ذلك بتأثير من أشكال الإنتاج المتمركز حول ذاته أوروبيًا/غربيًا، في عصر الحداثة المتأخرة؟ هل يمكن أن نكون آباءً على صورة مغايرة لما ورثناه في تلك المائة عام (على الأقل) المنصرمة؟
في خضم هذه الحرب التي أعادت وتعيد ترتيب وتصنيف وتسمية هذا العالم الذي نحياه/نحيا فيه، وأشكال ومضامين ومحمولات وجودنا فيه، بشكل لا نملك رفاهية التأمل الصامت، لابد للأبوة أيضًا كمفهوم وأداء وعلاقة أن تتغير، شأنها في ذلك شأن كل المقولات التي درجنا على ظنها كبرى ومتجاوزة وممتدة وميتا تاريخية، إن شئنا للتسمية أن تكون؟
لعل الإجابة الفادحة والتي لها أن تنتفض على تأويلات الجغرافيا الثقافية والقيمية للبشر، في هذه اللحظة. أن الأبوة هنا والآن، أصبحت تلك المعرفة العميقة والأكيدة المتلبسة بلبوس الوجع والصدق في آن:
أننا لن نستطيع حماية أبنائنا وبناتنا إلى الأبد ومن كل شيء!
لكن ما معنى ذلك؟ وكيف لنا أن نتأمل هذا الأمر، في هذه اللحظة التاريخية بالذات؟ ما الحماية التي نقصدها؟
.jpg)
في حديث لي مع ابنتي ذات السنوات الست، عن "الله"، ذلك الذي يشبه البشر في ظنها، لكنه ليس بشريًا، ويشبه الهواء من حيث وجوده حولنا في كل مكان، لكنه "هواء" يمكنه أن يوجد في الفضاء، دون أن يتقيد بترسيمات الكيمياء والبيولوجيا في منح الحياة وتراسيم الوجود. وهو أيضًا في داخلنا ينادينا ويهتف بنا، ونحاوره ويحاورنا، والأهم بقولها "نحميه ويحمينا"، في تعليقها على مقطع وصفته بأنه "جميل" بعد أن كان بادئ الأمر "بيخوّف"، من رباعيات الخيام، بصوت أم كلثوم ووائل الفشني، ونصّه:
سمعتُ صوتاً هاتفاً في السحر
نادى من الغيب غفاة البشر
هبوا املأوا كأس المنى
قبل أن تملأ كأسَ العمر كفُّ الَقَدر.
يافا ابنتي لها ممارسة معرفية مع العالم تقوم على فكرة التخيل، هي تتخيل أن الله ينادينا من خلال تلك العبارات من مكان حدوده المادية غير مادية، ولكنها مدركة بماديتها بوجه ما. إن الخيال هو الأداة الأقدر على فهم هذه الحرب والطفولة والأبوة معًا، حتى وإن كانت الحرب تقوم بالأساس ضد التخيل، وتهدمه (بول فيريليو). هي أقرب ما تكون للنار، التي تلتهم كل ما هو حولها أيًا يكن شكله الفيزيائي (صلب، سال ، غاز) لتغذي خيالنا بشأنها كونها لا هي صلبة ولا سائلة ولا غازية. يتضح الأمر في أسئلة يافا بشأن الحرب:
لماذا، ما هي الحرب، ما الاضطرار لها، كيف نواجهها، ما تعريف الضحية

(أتذكر أنها سألتني من هم ضحايا الحرب من الأطفال، هل هم فقط الغزيون؟ وهل لو قتلنا ابنة رومان ساندلر، هل نكون مثلهم قتلة ومجرمين؟ وكيف أنها اجترحت اجابتها بنفسها، حين قالت أن أطفال الإسرائيلين هم أيضًا ضحايا هذه الحرب، كيف يمكنهم رؤية طفل يموت دون أن يتوجعوا لموته، ولكنهم أيضًا قتلة لو سكتوا على تلك المقتلة ولم يلوموا أهلهم، ويرفضوا حكاياتهم وقصصهم عن الحرب)
***
لا تدعي هذه المداخلة، على هامش الحرب، أي فهم للأبوة في الحرب، ولا للحرب في الأبوة، وبالذات أنها لا تقوى على الحديث عن هذين الأمرين مجتمعين، أو حتى منفصلين، فلا أنا ممن خاضوا حربًا، ولا أجرؤ أن أمتحن أبوتي أمام أي أبٍ غزي في هذه الحرب التي جعلت ما يزيد عن ستة عشر ألف طفل غزي بلا أب أو أم أو أهل. هي كلمات برسم المونولوغ، تسجل رؤيتها لمكون إنساني اختطفته الحداثة من خلال سلاح الدولة القومية الحديثة، لتحمي آليات ترسيم حدودها معنا أجسادًا وكيانات.
أحاول من خلال هذه المداخلة أن أتأمل ذاتي أبًا في هذه الحرب، أب يقع على مسافة من الألم والفرح والوجع والخوف من هذه الحرب وقطاع غزة، فلا معنى لأي حديث بهذا الشأن ما لم تتوقف الحرب، ويزول الاحتلال عن كامل فلسطين التي ورثناها في الحكاية، وانتهشتها الجغرافيا، ولعل هذا هو معنى تجربة التحرر الأعمق، والتي وإن كان ظاهرها التخلص من القمع والعنف والاحتلال، أن فعل التحرر فيها يجب أن يمتد بشكل أعمق إلى كل ما هو إنساني وقيمي في وجودنا كبشر، وليس أن يبقى محصورًا في السؤال السياسي والاجتماعي والخطابي فقط.
يدور ببالي التساؤل وأنا أفكر في شكل أبوتي لابنتيّ، يافا ووجد، أو أشكالها بالمعنى الأدق، وما هو أثر هذه الحرب عليها، وبالذات أنها، لكثافتها وثقلها، باتت جزءًا أساسيًا من حوار الأبوة والبنوة اليومي تقريبًا. سواءً في دواخلنا أو بيني وبين ابنتيّ.
بدايةً، في مرحلة الأبوة يتنبه المرء أكثر إلى طفولته ولعلاقتها ببناء أبوته ودورها فيه، ولطبيعة كون تلك الأبوة متوارثة ومتغلغلة دون تفكير ناقد متأمل له شجاعة التنازل والاكتساب معًا، بكل طفولتنا ورؤيتنا لآبائنا، وهو ما ندفعه من ثمن في علاقتنا بطفولة أبنائنا وبناتنا. ففي ثقافة مجدت الذكر، وموضعته في المقدمة بما هو نموذج الشكل الإلهي، لمحتجب يحيط نفسه بالذكور والفحول في اللغة، فيُراكم فوق هذا الذكر ذكورًا آخرين، تحولت الأبوة إلى ممارسة مقابلة ومضادة للأمومة، على مستوى الجسد المادي والجنسي والرمزي والاجتماعي وصولًا إلى السياسي الإجرائي (وليست موضوعة الجنسية والحق في التجنس سوا ممارسات ذكورية أبوية، تقوم على تصنيف الجسد جندريًا، وترتيبه من حيث محمولاته وإشاراته الخطابية، إلا شكلًا واحدًا)، ومن ناحية أخرى تحولت الأبوة إلى معبر لتمرير الأشكال الرأسمالية للحميمية والعنصرية المبنية على الجندر والجنس، بشكل يمنعنا من تأمل تلك الطفولة مقدار ما تستحق من أبوتنا.
لعل لهذه الحرب أن تعلمنا كآباء أن نعي ونستوعب مسؤوليتنا تجاه العالم، وتجاه وجودنا فيه، وأن القول بخفة اللغة ونقائها وبساطة الظواهر الوجودية هو أمر يساهم في تحويل هذا العالم إلى مساحة أبشع وأقسى، وأننا نغفل في فعلنا ذلك ولو بطمأنينة الواثق للمسافة بين الطفولة والنضج في النظر إلى العالم، أننا نزيد من وطأة الأشياء على أطفالنا، وبالتالي علينا إذا استوعبنا العلاقة بين أبوتنا وطفولتنا.
ما أحاول قوله هنا، أننا كبالغين إذا لم نستوعب ما لمخيلة الأطفال من قدرات معرفية مشتبكة. وإذ منحت الحرب على غزة، لأشكال العصيان المعرفي موضعًا هامًا في فهم دور المعرفة في قمع الفلسطينيين وإنتاج منظومات العسف المعرفي التي تستند إليها المنظومات الكولونيالية والحداثية(2). فهي أيضًا نبهتنا إلى "سياسات الحياة اليومية"، و"مفهمة المقاومة في الحياة اليومية"، تلك الحياة اليومية التي نستثني منها أطفالنا، بحجة حمايتهم من عالم البالغين، والذي لو لم يكن محصورًا بالبالغين لكان في وضع أفضل مما هو الآن. إن جزءًا من تواطؤنا من خوفنا على أبنائنا وبناتنا وظننا أننا سنحميهم من كل شيء، هو تعقيم اللغة المستخدمة معهم، وتحييدها، وهو ما كبرنا نحن به (الجيل الثاني للنكبة)، فلم نحدق فيها كما يجب، لم نتوارث مشاهدها اللغوية كما يجب، كتبنا عنها، لكننا لم نكتبها. اختطفتنا سياسات الحداثة الدولانية وسياسات الذاكرة، فارتأينا أن نكون فصائل وسياسيين وفي مرحلة أخرى تطورنا إلى دولانيين أوسلويين، وأنتجت تلك الدولانية ثقافة ومثقفين كتبوا عن كل شيء لكن لم يكتبوا بلغة الأطفال عما يحدث وعما حدث.
يتساءل الأطفال: أليست حربًا؟ هل الحرب فقط أن نشاهدها من التلفاز؟ أليست الحرب تقتضي الدفاع والمواجهة، هل نحن المستهدفون بها؟ لماذا لا نواجهها؟
شهدت بعضًا من إجابات الأطفال وأسئلتهم بشأن هذه الحرب، وتنبهت لإجابات الآباء بشأنها، والتي انطوت على سياسات للألم، تظن نفسها قادرة على حجب ما يحدث عن أبنائنا وبناتنا، وهو ما أظنه غير صحيح. بالنهاية تتساقط تلك اللغة وعوالمها أمام واقع يتجاوز كل لغة، ويصيبها بخرس تام، فتتهاوى قدرتها الاعتياديّة على القول وإنتاج المعنى، وحينئذ يحلّ الصمت بديلًا عن الكلام، وفي الصمت يعاد ترتيب العالم بطرق مختلفة، لا باعتباره عالمًا لغويًا فقط، لكنه عالم واقعي أيضًا.
إن فشل أبوتنا المعاصرة من فشل لغتنا، وفشل لغتنا هو فشل دولنا، فمثلما لا تعود الدولة هي الإجابة عن الهوية، لا تصبح اللغة إجابة عما يحدث. في هذه اللحظة تحديدًا وبخيال سجناه خارج لغة البالغين، يمكننا تحرير هذا العالم.
لغة البالغين هنا تلعب بشكل مثير للانبهار دور السجن، وللسجن في الحالة الفلسطينية خصوصية شديدة، فهو مجاز شارح لموقع الفلسطيني في هذا العالم ومنه. السجن أهم مساحات الضبط والمراقبة والمعاقبة والنفي الواقعة على الوجود الفلسطيني، ليس في فلسطين فحسب، إنما في داخل أي مونولوغ ذاتي فلسطيني.
السجن هو مساحة الحضور والغياب، وثنائية الحضور والغياب هنا هي ثنائية ضبطية تنتج تعادلاً صفرياً يجعل الواقعين تحت سلطتها أصفاراً منضبطة، أي لا فاعلية لهم في العلاقة مع أي شكل آخر من الوجود / التداول، أو حتى التفاوض، خارج هذا السجن أو داخله. فالنظام يقبل تداولهم باعتبارهم أصفاراً لا حقوق / وجود / خطاب لهم بشأن ما يحدث في عالمنا مما نعتبره شأنا "للبالغين" وبلغتهم فقط.
إلا أن هذا النظام، مثلما يقول فوكو: "يعكس مبدأ الزنزانة [....] وظائفها الثلاث: الحبس والحرمان من الضوء والإخفاء – ولا يُحتفظ إلّا بالوظيفة الأولى وتُلغى الوظيفتان الأُخريان. فالضوء القوي ونظرة المراقب تأسر أكثر ممّا يأسر الظل الذي يحمي في النهاية. إن الرؤية هي شرك"(3). ونحن المحبوسون فيه، دون لغة يمكنها أن تكسر تلك العقدة، بمخيال طفولي مغاير.
هنا تأتي ميلاد، ابنة الأسير الفلسطيني الشهيد وليد دقة وتحريرها لكامل الجسد الاجتماعي والرمزي والمادي الفلسطيني(4)، والتي تعري كامل منظومة الحداثة تلك، والتي أخرستنا جميعًا، برضانا وبتواطؤ منا. لكن ميلاد، وبفرادتها التي لا تبدأ فقط من الإسم، وخلافا لما قد نظنه جميعًا، لم تأتي إلى هذا العالم وكأنها الاستثناء، فلوالدها ووالدتها قصة، خيالية بقدر ما هي واقعية، هددت دولًا صُنفت عالمًا أولًا، فكان من المنطقي أن تتوج تلك القصة بميلاد وطفولتها.
إن منطق ميلاد في فهم الدولة الحديثة، والطفولة والأمومة والأبوة، وقيم مثل العدل والحرية والجمال والحق، لهو منطق قادر على تفكيك كل منظومات العنف والعسف الاستعماري والرأسمال والامبريالي والجندري واللغوي، لهو أقدر على بناء وطرح ودمقرطة مفهمة للمقاومة والتحرر بما هما حياة يومية طفولية، لكننا كبالغين لا نستطيع فهمها لأننا محبوسون في لغتنا الباغلة، عن عالم البالغين، الذي ندفع ثمنه كل يوم من أطفالنا وأجسادهم وأحلامهم وأشلائهم ولغتهم وأوجاعهم.
إن اللحظة التي أنظر فيها إلى ابنتي في ساحة مدرستها، لا يميزها صراخ أو فرط حركة أو حتى حركة معينة، فهي هادئة لا تبرز من بين أقرانها في الساحة والقاعة الصفية، تظل هي وأقرانها أقدر مني على التصارح مع الأبوة والطفولة والحرب والعدل والحب والله، وكل قضايا البالغين التي أفسدناها.
فلنحدث أبنائنا وبناتنا عن هذه الحرب، ولنورثهم/ن غضبنا وعجزنا، ولندعهم يفتحون تلك السجون التي سجنّا أنفسنا فيها.
علهم يصلحون ما قد أفسدناه، ويعلموننا أبوة مختلفة عن تلك التي أفسدناها!
ولتسامحونا يا أطفال غزة!
هوامش:
-
ينظر:
-
ينظر كتابات والتر مغنولو، ومنها:
The Darker Side of Western Modernity, Walter Mignolo, Duke University Press, 2011
-
ميشيل فوكو، "المراقبة والمعاقبة: ولادة السجن"، ترجمة علي مقلد ومطاع صفدي (بيروت: مركز الإنماء القومي، 1990)، ص 210.
-
ينظر مادة للكاتب ، بعنوان "ميلاد تعيد ترسيم حدود الجسد الفلسطيني"، نُشرت سابقًا:
https://www.alaraby.co.uk/%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A