«سأكونُ بين اللوز»، سيرةُ الطبيعة والحكايات الجبالِ والبشر والحجر والتلال، يرويها رجلٌ أجبرهُ السرطان على التفكير في بداياته، فعادَ طفلًا، يرى الأشياء بعينِ الطفلِ ويحكيها ببراءة الأطفال، وبمخيّلةِ الأطفالِ القادرة على اجتراحِ السحر من أبسط الأشياء. لكنّها، بالإضافةِ إلى ذلك كلّهِ، سيرة مُلهِمةٌ للتفكير في العودة إلى الجمال الذي تمّت خيانته.
قدّمَ الأدبُ العربيّ خلال تاريخِهِ نماذجَ كثيرة لمواجهةِ الكُتّابِ للموت، بوصفهِ مصيرًا محتومًا لهم، وللأحياءِ عمومًا. في القرنِ العشرين كتبَ نديم محمّد ديوانَهُ الشهير "آلام" وقد ضمّ اثنين وعشرين نشيدًا تفوحُ منها رائحةُ الألم الذي خلّفهُ مرضُ السلِّ إلى أن فتكَ بصاحبهِ نهايةً في العام ١٩٩٤. وكتبَ بدر شاكر السيّاب في رائعتهُ "الوصيّة": مِن مرضي
مِن السريرِ الأبيضِ. بعد ذلكَ بأعوام، وصفَ أمل دنقل ببراعةٍ وصدقٍ حالهُ في صراعهِ مع المرضِ الخبيث، والألوان التي رآها في غرف العمليّات، والإحالات التي فكّرت فيها مخيّلتهُ للونِ الأبيض:
أربطةُ الشاشِ والقُطْن،
قرصُ المنوِّمِ، أُنبوبةُ المَصْلِ،
كوبُ اللَّبن
كلُّ هذا يُشيعُ بِقَلْبي الوَهَنْ.
كلُّ هذا البياضِ يذكِّرني بالكَفَنْ!
لكنّ سيرةَ إياب الراحل حسين البرغوثي "سأكونُ بين اللوز" إلى قريتِهِ كوبر في قضاء رام الله، لا تنحصرُ في ثيمةِ مواجهةِ المرض، ولا يجعلُ منها كون هذا المرض سرطانًا بكائيّة البتّة، كما لا تحتوي على ما يجعلُها كتابةً لتوثيقِ الألم، أو الهلوسات التي يراها المرضى في أيامهم الأخيرة، كتلك التي قرأناها في مُذكّرات جهاد هديب مع المرض، أو في مرثيّة أمجد ناصر لنفسه (وقد عاد كلٌّ من أمجد ناصر وجهاد هديب إلى بيوتهم الأولى في الأردن في أيامهما الأخيرة). عودةُ حسين البرغوثي "ليكون بين اللوز" عودةٌ أخذت بُعدًا فكريًا يُحصِّنُها من السقوطِ في شركِ العاطفة. في الصفحةِ الأولى من الكتاب الذي أصدرتهُ المؤسسة العربية للدراسات والنشر في العام ٢٠٠٤ (وصدر بطبعة جديدة عن الدار الأهلية في عمّان، ٢٠١٧)، بعد عامين على وفاةِ صاحبهِ، يقولُ البرغوثي: "بعد ثلاثين عامًا أعودُ إلى السكنِ في ريف رام الله، إلى هذا الجمال الذي تمّت خيانته."
وعلى الرغم من إدراكِ الكاتبِ لطبيعةِ هذه العودة، لجهةِ أنّها أخيرة ونهائية، إذ يقولُ في الجملةِ التي تلي: "نفيتُ نفسي طوعًا عن بدايتي فيه، واخترتُ المنفى، وأنا ممّن يُتقنون البدايات، وعودتي، بالتالي، نهاية غير متقنة."
غير أنّ هذا الإدراك لم يكن يعني بالنسبة لهُ تسليمًا بإحصاءِ الأيامِ المتبقّية.
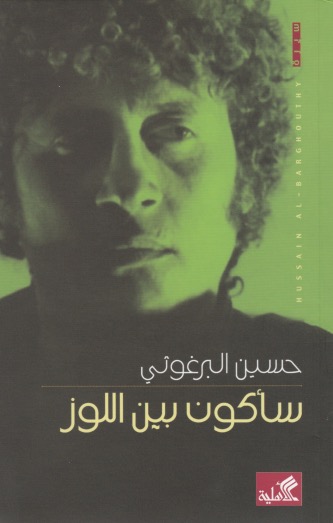
حسين البرغوثي لم يعُد إلى قريتِهِ "ليكونَ بين اللوز" فحسب، كما يقولُ عنوانُ الكتاب. كانَ كمن تنبّهَ، وإن بسببِ السرطان، إلى أنّ ثمّة ما نسيَ فعلهُ في صباهُ الأول. في بدايةِ شبابه يكونُ الإنسان أكثر قابلية لخوضِ المعارك، أكثر حيويةً واحتمالًا للمشاق التي تحملُها هذه المعارك، وأقلّ انتباهًا للوقتِ المهدورِ، ولتفاصيلِ الجمال الذي يُمكنُ أن تلتقطها العين، تحديدًا في المكانِ الأول، حيثُ يكونُ الارتحالُ هاجسًا طبيعيًا، يستتبعُ الرغبةَ بالاستقلالية. غيرَ أنّ الحياةَ تصقلُ التجربة، تضفي عليها شيبًا كالذي تُضفيهِ على مفارق الإنسان وروحه. وحياةُ حسين البرغوثي التي لم تمتدَّ لأكثر من ثمانية وأربعين عامًا (١٩٥٤ – ٢٠٠٢) حظيتْ بتجاربَ مهمّة وثريّة صقلتْ أفكارَ الرجلِ وموهبتهُ على حدٍّ سواء، فكانَ أن اختارَ العودةَ لأنّهُ: "لا يعودُ أحدٌ إلى أوَّلهِ، ولو لِمامًا، إلّا إن عادَ إلى تاريخِه، إلى نفسهِ في تاريخه." أرادَ الراحلُ في إيابهِ وفي سيرتهِ الأخيرة أن يعودَ إلى نفسِهِ إذن، فليست بودابيست المجرية وسياتل الأمريكية، وقد قضى زمنًا في كلٍّ منهما للدراسة، أماكنُ يتمكّنُ الإنسانُ من الرجوعِ إلى نفسهِ فيها، فتاريخ الشخص، على ذلك، وفق البرغوثي، لا يعني وجودهُ الماديّ الملموس فحسب، بقدرِ كونهِ امتدادًا لتاريخِ أشخاصٍ آخرينَ ورثَ ملامحهم وأماكنَهم. وهو بهذا المعنى تاريخ ليسَ شخصيًا تمامًا. وأرضُ بداياتِهِ بالتالي هي الأقدر على تقريبهِ من نفسه.
وعلى الرغم من أنّ كتابة هذا النصّ السرديّ الذي وصفهُ محمود درويش بقولهِ: "لعلّهُ أجمل إنجازات النثر في الأدب الفلسطيني"، كانت متزامنةً مع أحداث الانتفاضةِ الثانية، ومزاولةِ فلسطين والفلسطينيين مهمّتهم التاريخية القدَريّة بالحياةِ على صفيحٍ ساخنٍ، إلّا أنّ النازعَ الذاتيّ لكتابةِ هذا النصّ النثريّ ظلّ طاغيًا، بحيثُ لا تُذكرُ الانتفاضةُ فيهِ إلّا مرةً واحدة، وبشكلٍ عرضيّ لا يبتغي تسليطَ الضوء عليها، ليحتفظَ النصُّ لنفسهِ بميزةٍ نادرةٍ في ظروفٍ كهذه، وهي أن يظلّ وفيًا لأسبابِ كتابته. لم نرَ الاحتلالَ بمعناهُ السياسي، من خلال الثورة أو الكفاح الفلسطينيّ، إنما من خلال سياجِ المستوطنات حولَ مرابعِ تاريخِه، أو حرائق الجبالِ والتلال. الأماكن التي قرّر أن يعودَ البرغوثي إليها ليفهمها، وليفهمَ نفسهُ فيها.
لم تكن سيرةُ "سأكون بين اللوز" سيرةً كفاحٍ عام، رغمَ التقاطعات الكبيرة بين الشخصيّ والعام فيها، لكنها لم تنتمِ للأدبِ السياسيّ، إذ لطالما حاولَ الكاتبُ التخفّفَ من ثِقلِ السياسة، والسخريةَ منها أحيانًا، كما في أحدِ مقاطعِ كتابهِ "الضفّة الثالثة لنهر الأردن": "عملتُ في تعبيد الطرق و حرضتُ العمال على المطالبة بجزمٍ مطاطية وكفوفٍ ضد البرد، ونظمتُ إضراباً عاماً لهم . حصلوا على مطالبهم و طردتُ أنا". سخريةٌ تشي بملمحٍ من ملامح شخصيّة حسين البرغوثي، المُنطلقة، المنفلتة مما قد يجعلها حبيسةً لفكرةٍ أو مذهب، أو قابِلة بالمسلّمات دونَ تفكير.
نرى الكفاحَ من زاويةٍ أخرى، زاوية الشخص الذي لم يعد قادرًا على القيام بما هو أكثر من التردّد على قسم الأورام في المستشفى، واكتشاف أنّ وجوده زائد عن الحاجة في ظرفٍ كانت المستشفيات مشغولةً بالجرحى والشهداء، بما لا يتركُ فرصةً للاهتمام بالمرضى العاديين! وحسين طوال حياتِهِ كان يريدُ أن يكون عاديًا، شخصًا يحظى بحياةٍ عاديّةٍ، يقطفُ من مساكبِ حديقةِ المنزلِ خضراواتٍ تكفي لصنعِ صحنِ سلطة لهُ ولزوجتهِ وابنهِ الوحيد، ويتناوله في فيء شجرة زيتون. ويبدو أنّ هذه الرغبةَ امتدّت أكثرَ مما ينبغي، فيكون حتى في مرضهِ، مريضًا عاديًا لا يثيرُ اهتمام أحد.
يُذكّرُنا الشاعر الراحل أحمد دحبور في إحدى مقارباتهِ لكتاب "سأكون بين اللوز" وقد كان هو من قدّمَ له، بما قالهُ الدكتور عبد الرحمن بدوي بشأن الفيلسوف الدانماركي الوجودي سورين كيركغراد: "خليطٌ غريب من الاعترافات العاطفية الشخصية والتأملات الفلسفية والمقالات الأدبية، وفي الكتاب تتعاقبُ الأجناسُ الأدبية: يوميات، عرض منظم، مناجيات، صور أدبية، تفسير أحلام.. إلخ".
«سأكونُ بين اللوز»، سيرةُ الطبيعة والحكايات الجبالِ والبشر والحجر والتلال، يرويها رجلٌ أجبرهُ السرطان على التفكير في بداياته، فعادَ طفلًا، يرى الأشياء بعينِ الطفلِ ويحكيها ببراءة الأطفال، وبمخيّلةِ الأطفالِ القادرة على اجتراحِ السحر من أبسط الأشياء. لكنّها، بالإضافةِ إلى ذلك كلّهِ، سيرة مُلهِمةٌ للتفكير في العودة إلى الجمال الذي تمّت خيانته.





















