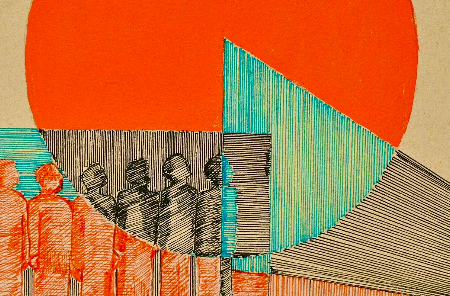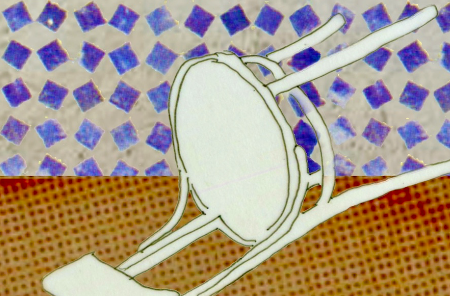على مدار الأعوام السبعة الماضية خُضت معارك كثيرة لم أختر أي منها. انهزمت كثيرا وانتصرت قليلا وتعبت جدا جدا. لم أعد أفهم لماذا أخوض كل تلك المعارك أصلا، ولماذا عليّ التعامل وحدي مع وطأة تلك الهزائم. هزائمي الصغيرة تنضم لهزيمتنا الكبرى لتصير حملا دائما يُثقل نفسي وأشعر بوطأته فوق كتفي.
ذكرني تطبيق فيسبوك أنني انتقلت إلى هنا في مثل هذا اليوم قبل ثلاثة أعوام. يومها كنت أظن أني أطوي صفحة أصعب فصول حياتي. كنت أظن أن رحلة الهروب من الألم قد انتهت، وأني أخيرا وصلت… وصلت مكانا مريحا آمنا من الألم فحسب.
ثم اتضح أني لم أصل بعد... بل أن رحلة الهروب سرعان ما أتت بالجائحة وبما لا يخطر على قلب بشر. صار الألم حرفيا يبتلع حياتي. هناك أيام كاملة لا أشعر بأي شيء سوى الألم… ألم منتشر في رأسي وظهري دوما دون سبب عضوي مفهوم.
ثلاثة أعوام.
ذكرني تطبيق فيسبوك أيضا أنه في يومي الأخير قبل الانتقال إلى هنا، كنتُ هناك بصحبتك نستمع إلي صوت دينا الوديدي وهي تشدو: "واحدة… دي ليلة واحدة...وبعدها عرفت ايه معنى الغياب." أتذكر ليلتنا الأخيرة معا كلما استمعت إلى تلك الأغنية. ليلة واحدة فرقت ما قبلها عما بعدها... إلى الأبد؟ ربما. صار الغياب -غيابك- يلقى بظلاله على كل ما أتى بعدك… وعلى كل من أتى بعدك.
أحببت بعدك؟ نعم. مرة؟ مرتين؟ ثلاث مرات؟ أنصاف مرات كلها. دائما ينقصها شيء. كانت هناك أوقات طيبة بالطبع. كان هناك شيء من السحر أحيانا. وكان هناك من غمرني حنانا حتى كادت جراحي تُشفى… لكن الجراح بعدها ما شُفيت.
صباح الأمس وجهت شارة الراديو على إذاعة الأغاني بالقاهرة للمرة الأولى منذ وقت طويل. كانت دقات فرقة حسب الله السادس عشر تعطي إشارة البدء لصوت عبد الحليم يغني "أبو عيون جريئة"، لتذكرني بليلتنا الأولى معا. استمعنا ذلك المساء ل "يا مسهرني" بصوت الست، ثم للكثير من الأغاني… كنتُ أهم بالرحيل فاستبقيتني لأغنية واحدة أخرى، ثم عبثت بهاتفك لتأتي بدقات حسب الله السادس عشر التي أعرفها جيدا: "قولوله الحقيقة"... هل كانت تلك فعلا هي الحقيقة؟ كان كل شيء لنا معا أشبه بالحلم.
كم أفتقد الأحلام.
صارت كوابيسي بشكل عام أوضح كثيرا من أحلامي.
في كابوس الأمس رأيتني جالسة على شاطئ ما… ألهو بالرمال لأحفر أنفاقا بقدميّ أحب عادات الشاطئ إلى قلبي. فجأة يعلو موج البحر ويغمرني… أظن أن الموج سيهد الأنفاق الصغيرة تحت قدمي فحسب، لكن يحدث العكس تماما... تعلو الأنفاق الصغيرة وتصير نفقا كبيرا يبتلعني. أصحو.
الأعوام السبعة الماضية كانت ركضا لا ينتهي في الأنفاق الصغيرة. تتوالى الكوابيس نفقا بعد الآخر. تخفت الأحلام وتتباعد حلما تلو الآخر. وأواصل الركض دون أن أفهم ما الهدف وأين المنتهى. مرهق جدا الركض المستمر في سباق مبهم دون خط نهاية في الأفق.
"مقاتلة رغم أنفك" يقول صديق.
على مدار الأعوام السبعة الماضية خُضت معارك كثيرة لم أختر أي منها. انهزمت كثيرا وانتصرت قليلا وتعبت جدا جدا. لم أعد أفهم لماذا أخوض كل تلك المعارك أصلا، ولماذا عليّ التعامل وحدي مع وطأة تلك الهزائم. هزائمي الصغيرة تنضم لهزيمتنا الكبرى لتصير حملا دائما يُثقل نفسي وأشعر بوطأته فوق كتفي. هل الهزائم هي ذلك الألم المنتشر في رأسي وظهري دوما دون سبب عضوي مفهوم؟ ربما. المهم أني الآن لا طاقة لي بأي معارك جديدة أبدا.
هل كانت وطأة المعارك ستخف لو خُضناها معا؟ لا أعرف. أفكر في ذلك كثيرا. أفكر في كل الأغاني التي كان يمكن أن نسمعها معا على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، في الضحك المهدر لأننا لم نتشاركه، في كل الحكايات التي لم نتبادلها، في كل أكواب الشاي المُفضل لدينا التي كان يمكن أن نتقاسمها في الليالي الممطرة، بعد أن نجوب الطرق والحدائق وشاطئ المحيط الأطلنطي بلا هدف. أفكر أيضا كيف كانت آلامي تصير دموعا بين ذراعيك فأهدأ. هل أخبرتك من قبل أني لم أطلق سراح دموعي في حصن أي حبيب سواك؟ ربما أخبرتك. ربما لا. لا أتذكر الآن. غريب ما حملته ذاكرتي من أثرك خلال تلك السنوات. غريب ما نسيته أيضا. لا أعرف لو عاد بنا الزمن هل كنا سنفعل أي شيء بشكل مختلف؟ هل كنتُ سأبوح لك أكثر؟ هل كنتَ ستضمني أطول؟ هل كنتُ سأتشبث بك أقل وأثق بك أكثر؟ هل كنتَ ستتشبث بي أكثر وتثق بالقدر أقل؟ هل لنا أن نلوم القدر والزمن والتوقيت الخطأ عوضا عن لوم أنفسنا وقراراتنا؟ قلتَ يومها: "أريدكِ أن تكوني سعيدة... أريدكِ أن تكوني حرّة."
ها أنا حرّة جدا-بلا أي مَرسى. أنا والألم ورحلة الهروب المستمرة. هل أنا سعيدة؟ لا أعتقد. هل كان صعبا حقا أن نبقى سعداء معا؟ لا أعرف.
كل ما أعرفه أني طوال تلك الأعوام لازلت أركض بين هذه الأنفاق الصغيرة التي تبدو بلا نهاية. أركض لأطفو فوق الحياة بينما يطاردني كابوس الموج العالي والنفق الكبير الذي يبتلعني.