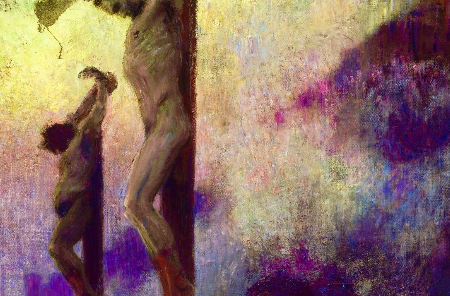مقاربة ملاهي الستينات والسبعينات اليوم، بعد انحسار هذا العالم، يضيف بعدًا آخرًا لي، ويساعدني على تتبّع الممارسات الثقافية الهامشية، وأذواق مجتمعات الطبقة العاملة، والطرق التي ساهموا بها في الحياة الثقافية للمدينة على هامش ما يسمى 'العصر الذهبي' أو 'الزمن الجميل' لبيروت وأدبائها ومثقفيها.
في ظل الحرب التي تعصف بغزة، والأصداء الموجعة للإبادة والمعاناة والدمار، قد تبدو الكتابة عن ذاكرة المدن وتفاصيل الحياة اليومية التي تسربت إلى تاريخ منطقتنا أمراً غير ملح، تحديدًا فيما يتعلق بالعودة إلى عالم يُعد 'هامشي ' كعالم الترفيه والكباريهات. ومع ذلك، هناك أهمية راسخة لهذه الذاكرة، خصوصًا في هذه اللحظات الحرجة التي نعيشها. تشبه المدن كائنات حية تتنفس عبر ذاكرتها، وتتشكل هويتها من خلال القصص المتجذرة في شوارعها وأبنيتها وناسها، حتى تلك التي طُمست تحت وطأة النسيان.
كُتب هذا النص قبل أكثر من سنة، وكان من المقرر نشره في أكتوبر الماضي، لكن تأجل نشره بعد بدء الإبادة على غزة، لحين وجود ظروف أفضل لنشره. لم تأت تلك الظروف بعد، لكن نشرْ هذا النص اليوم يُشكل محاولة للحفاظ على ذاكرة بلاد ومدن لطالما تخبطت حول تاريخها وحداثتها وتطورها وصور نسائها، ليؤكد على أهمية ذاكرة مددنا، التي تعد ملاذًا لنا للأمل والمقاومة والاستمرارية، رغم تعقيداتها.
"كانت لوحة للبؤس البشري، والعذاب من أجل اللقمة… وكان المكان كله عالم من الأحزان والإرهاق… العرق طعمه مثل السبيرتو… والمازة عدة حبات من القضامة 'المعفنة'… والتمييز بين الجرسون والزبون والمطرب أمر صعب هنا… الكل متشابه، والكل حزين وفقير، والسعال هو النغمة الأساسية لسيمفونية البؤس التي يشكّل كل جالس في المكان لوحة من لوحاته"(١).
عبر هذه الكلمات، عثرتُ على وصف دقيق لداخل إحدى كباريهات بيروت خلال ستينات القرن الماضي. إنه أدق وصف يقع بين يدي لهذه الملاهي من الداخل، أنا التي أبحث عن ومضات من هذا العالم منذ سنين. فخلال بحث بدأ منذ أكثر من عشر سنوات، وجدت العديد من المقالات التي تنتقد العالم "السفلي" للمدينة، لكن نادرًا ما وصلتني تفاصيل دقيقة عن شكل هذا العالم من الداخل ومشاكله الفعلية، فقط أدباء وصحفيون ينتقدون فساد ومجون الكباريهات التي تمنع تقدم البلاد وتطورها، ويطالبون بإقفالها…
وها أنا اليوم أجد صدفة نص كتبته امرأة عن هذا العالم… وليس أي امرأة، بل غادة السمان، الروائية السورية التي كانت من أبرز الأديبات والنساء التي طبعت شخصيتي وساهمت في تشكيل أفكاري ومواقفي. أذكر كيف قرأت كل كتبها خلال تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية الجديدة، ونسجتُ أولى صداقاتي حولها وحول رواياتها وكوابيس المدينة التي تركتها لنا. ففي روايات غادة السمان، استكشفت تجارب النساء في مجتمعاتنا المتزعزعة، وأبحرت في أوجه بيروت المختلفة. أُعجبتُ بكاتبة أسقطت يومها العديد من المحرمات وتحدّت الأدوار والتوقعات التقليدية للجنسين. إذ غالبًا ما سعت في كتاباتها إلى التعبير عن تحرر المرأة ورغباتها واحتياجاتها.
أذكر أنّ أكثر ما كان يلفتني هو سرديّتها عن المدينة والحرب التي عرفتها. وقد ساعد تصويرها للموضوعات المثيرة للجدل والمحظورة في تحطيم الكثير من المحظورات والقوالب النمطية التي عرفتها آنذاك، رغم نقدي اللاحق لمقاربتها وللكثير من هذه الأفكار وابتعادي عن كتاباتها لسنين، أمام عجزها عن ملامسة التغييرات التي عرفتها المنطقة وبُعدها عن مواضيع تمسّنا، من ضمنها الثورات العربية.
أذكر كل هذا اليوم، وأسعد بالعودة إليها بعد كل هذه السنوات، فأنا حتمًا قرأت كتاب غادة السمان "الرغيف ينبض كالقلب" منذ أكثر من عشرين عامًا، لم أكن قد بدأت بعد أبحاثي، أو مهتمة في عالم الترفيه، بل كنت شابة تحاول جاهدة فهم موقعها كامرأة في مدينة تخرج من حرب أهلية طاحنة. واليوم، قد عدت من جديد لغادة السمان، من مدخل آخر، وزمن آخر، ليتلاقى بحثي مع موضوع كتبته هي منذ أكثر من أربع عقود.
هو موضوع هامشي في كتاباتها، لكنه يخصني اليوم ويمسني كثيرًا. وأجدني في لحظة، أبحث فيها عن علاقتي مع ماضيي الشخصي وماضي مدينتي ومنطقتي، أعود إلى غادة السمان وأشتبك معها ومع جيلها ومع مدينتي… تحمست كثيرًا لفكرة العودة إلى السمان، فهي عودة إلى من كنت في التسعينات، يوم تعرفت عليها واعتبرتها المثال النسوي الذي أطمح إليه في زمن كانت مدينتي تشهد 'إعادة ' إعمارها. هي إبحار في الستينات والسبعينات حين كتبت غادة السمان الروايات التي طبعت شخصيتي ونُسجت خلالها صورة بيروت 'الحديثة' المنتجة للأفكار والتصورات الحداثية والتحررية واليسارية. وهي رجوع إلى مدينة الأربعينات والخمسينات وما قبلها حيث تشكلت أهم ملاهي المدينة، بالتزامن مع المساعي لبناء دولة ومجتمع حداثي في زمن ما بعد الاستعمار. هي إذًا رحلة تجمع أزمنة وأماكن مختلفة، أكتبها اليوم وأنا بعيدة عنها، لكن هناك خيط خفي يربطني بها وفيما بينها، خيط مجبول ببعض الحنين والرغبة بالعودة إلى الماضي لاستعادته، أو لنقده والاشتباك معه، أو لرثائه. لست متأكدة.

"الرغيف ينبض كالقلب"
في كتابها "الرغيف ينبض كالقلب" (1980)، جمعت غادة السمان مجموعة تحقيقات صحفية لها نُشرت في مستهل حياتها كأديبة وصحافية في مجلة "الأسبوع العربي' والحوادث خلال الستينات والسبعينات. ورصدت فيها آلام ومشاكل عالم المهمشين من الصيادين والفلاحين والمشردين والمهجرين في القرى والمدن اللبنانية المهمشة، بعيدًا عن سحر صورة لبنان سويسرا الشرق، التي كانت في أوّجها آنذاك. غاصت السمان في أحد النصوص في كواليس المدينة وكوابيس ليلها المظلم من عام 1969، وعنوته "قاع المدينة"(٢).
كتبت فيه عن الكباريهات، في مدينة تفككها الصراعات الطبقية والاجتماعية والسياسية، مدينة تفترس مهمشيها وتحطّم أحلام الوافدين إليها أملًا بالشهرة والعز والأوهام. لم تقدّم غادة السمان نظرة تقليدية أخلاقوية عن عالم الكباريهات، بل على العكس، استعملته كمدخل لانتقاد المدينة المشحونة والمجنونة، والمجتمع و'تخلفه'، والشرخ الطبقي، لترسم صورة عن عالمين نقيضين لكن متكاملين بنظرها: المجتمع التقليدي "لسيدات المجتمع المخملي المبجلة"، والهامش الذي يتكون من "نساء قاع بيروت وعاهراته"(٣)"!
لطالما أبهر عالم الكباريهات المجتمع الذي لم يتوانَ يومًا عن نقده ورفضه، وفي نفس الوقت اشتهائه… من جهتي، أحب العودة دائمًا إلى الملاهي الليلية في بيروت خلال فترات مختلفة، لأنها تسمح لي باستكشاف المدينة وتشكيلات الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية فيها عبر الزمن، وتساعدني على تتبّع وفهم ديناميكيات المدينة المعقدة(٤).
فمنذ انتهاء الحرب العالمية الأولى، وتحوّل بيروت إلى عاصمة دولة لبنان الكبير وواجهة الانتداب الفرنسي الثقافية والسياسية، انتشرت العديد من الملاهي في قلب المدينة في ساحة البرج، مثل مسرح الكريستال والمطعم الفرنسي وملهى عويس وكوكب الشرق. أمّا ملاهي الزيتونة على الواجهة البحرية، فقد كانت تُعتبر 'لاس فيغاس لبنان' خلال الثلاثينات والأربعينات، وكانت مقصدًا للطبقات العليا 'العصرية ' و'المتفرنجة '، كالليدو والكيت كات والالفونس ولاحقًا الكاف دي روي(٥).
تأثرت هذه الملاهي المختلفة، التي ازدهرت ما بين الثلاثينات والخمسينات، بالتغييرات الاجتماعية والثقافية التي حدثت في منتصف القرن. مع انتشار الراديو ودخول التلفزيون في أواخر الخمسينات، تغيرت الذائقة الترفيهية العامة، مما أدّى إلى تراجع أهمية الملاهي. تزامن ذلك مع انتشار فكرة ما يسمى 'الفن الراقي' المنفصل عن عالم الكباريهات، والمرتبط بالرغبة في صنع موسيقى وفن قوميين يعكسان صورة البلاد المتحضرة والهوية اللبنانية، والمتمثل بجيل الرحابنة وفيروز(٦). خلال السبعينات، ظهر 'الفن السياسي ' الملتزم بالقضايا السياسية والاجتماعية، وأصبحت الكباريهات أماكن مهملة 'سيئة السمعة'، يُنظر اليها على أنها رموز للانحلال الغربي والاستهلاك الثقافي الإمبريالي. وبالطبع، أثّرت الحرب الأهلية اللبنانية لاحقًا بشكل كبير على الكباريهات القديمة، حيث دُمرت تمامًا واختفت معالمها من وسط المدينة، مما أدى إلى تغيير نسيج المدينة الحضري.
مقاربة ملاهي الستينات والسبعينات اليوم، بعد انحسار هذا العالم، يضيف بعدًا آخرًا لي، ويساعدني على تتبّع الممارسات الثقافية الهامشية، وأذواق مجتمعات الطبقة العاملة، والطرق التي ساهموا بها في الحياة الثقافية للمدينة على هامش ما يسمى 'العصر الذهبي' أو 'الزمن الجميل' لبيروت وأدبائها ومثقفيها.
أقول كل ذلك لغادة السمان، وأنا ألحق بها في رحلتها في مدينة لم تعد هنا. أحاول جمع أي تفاصيل أخرى تدور في رأسي عن الملاهي، لأكمل صورة وجه المدينة الماجن في مخيلتي. لكنها لا تسمعني. بل تهمس لي أنّها تبحث في رحلتها عن قاع المدينة، عن "سوهو بيروت"، بمقارنة مع حي "سوهو" في لندن، المشهور "بالجنس والعنف والمخدر والجريمة... وبالفقر أولًا"(٧). تخبرني أن المجتمع يعتبر "ساحة البرج بعد منتصف الليل وبعض الأزقة المتفرعة عنها" هي "سوهو بيروت"، في حين أن "سوهو" الحقيقية موجودة في مكان آخر في المدينة، وستوجّهني إليها إذا رافقتها.
المحطة الأولى، مسرح فاروق
تصل السمان أولًا إلى مسرح التحرير… هو ملهى "الكاريون" سابقًا، الذي استثمره الفنان علي العريس لزوجته المونولوجيست ناديا شمعون أوائل الأربعينات، وسُمي على اسمها، "تياترو ناديا" شمعون. أصبح مسرح "فاروق" تيمنًا بالملك فاروق بعد أن اشتراه عفيف كريدية في أواخر الأربعينات، ومن ثمة مسرح "التحرير" بعد إطاحة الملكية في مصر. غالبًا ما كانت الملاهي والمسارح والسينمات تُشترى أو تُضَّمن لمستثمرين جدد كانوا يغيّرون اسمائها حين يستثمرونها. تعكس اختيارات كريدية بتغيير اسم المسرح تأثره وتأثر المدينة بمصر وسطوتها الترفيهية والثقافية والسياسية، وتداخل التغييرات السياسية الإقليمية مع الحياة اليومية في المدينة.
أدخل مع غادة السمان مسرح فاروق أواخر الستينات، بعد أن فقد بريقه وصيته كمسرح استقطب أهم المطربين والفرق المسرحية والغنائية المحلية والعربية، مثل فرقة كشكش بك لأمين عطاالله ومحمد عبد المطلب وثريا حلمي ونورهان ومحمد سلمان ونجاح سلام وفريال كريم. أستحضر ذكريات أحد الممثلين الذي عمل كومبرس في مسرح فاروق، واسمه علي بيضون، كان قد جمعها الكاتب رياض جركس في كتابه بيروت في البال، مع قصص أخرى عن ملاهي المدينة غداة الحرب الأهلية، وذلك في محاولة منه للملمة ذاكرة أماكن منسية، وأصوات من مروا فيها.
كان المسرح عبارة عن "معهد فني كبير"، حيث كان البرنامج يقسّم إلى فصل مسرحي وفصل غنائي، مدة كلّ منهما ساعة ونصف، وثمن تذكرة الدخول للصالة ليرة واحدة وليرة ونصف للوج(٨). عرف المسرح أيام عزّه خلال الخمسينات روادًا من كبار ضباط الشرطة والصحافيين والسياسيين ورجال الأعمال. ومع ذلك، كما هو الحال في مختلف أماكن الترفيه، لم يكن يخلو المسرح من المشاكل بين الممثلين والمطربين والجمهور، وغالبًا ما كان يتدخل مدير المسرح عفيف كريدية إمّا لحل المشاكل، ومصالحة المتعاركين، أو للتوسط عند الشرطة لحل النزاعات(٩).
يوم زارت غادة السمان مسرح فاروق، كان الوضع قد تغيّر، وخفتَ صدى تلك الأصوات والذكريات. فقَدَ المسرح تجهيزاته وضيافته. فلا تبريد أو تدفئة، ولا نساء بين الجمهور، أقصى ما يقدمه من ضيافة هو النارجيلة أو الليموناضة. مسرحياته وعروضه أضحت فقيرة و"مثيرة للحزن"، رغم إعلانات اللوحات الزيتية، وصور الراقصات، ونجوم المسرح وكواكبه التي تزين الباب. أمّا سعر تذكرة الدخول، فكان ما يزال ليرة واحدة للشخص، إذ تتساءل غادة السمان عن قدرة المسرح على تقديم عروض وحشد فني بليرة واحدة في زمنها.
أغار منها، فهي قد أُُتيحت لها فرصة الدخول إلى هذه الملاهي ورؤيتها من الداخل والتحدّث مع عفيف كريدية، صاحب مسرح التحرير ومديره منذ عام 1949. هو وريث سلالة عائلة كريدية التي لعبت دورًا محوريًا في حياة بيروت الليلية منذ بداية القرن العشرين، وأسست أهم ملاهي ومسارح المدينة. فعفيف كريدية تأثّر بجده سليم آغا كريدية، مؤسس مسرح الكريستال، وقبله مسرح زهرة سوريا. امتلك واستثمر العديد من الملاهي الليلية في بيروت.
ليتها كانت تعرف، ليتني كنت معها، كم من سؤال واستفسار كنت لأطرح على ذلك الرجل الملقب بـ "ملك الليل"، الذي كان "مزاجيًا مُغرمًا بتدخين النارجيلة"، له صداقات مع العديد من الشخصيات النافذة في البلد، و"صاحب إمبراطورية الليل في لبنان"، على حد قول علي بيضون "لدرجة أن وديع الصافي، وعبر الغني السيد، وعبد العزيز محمود كانوا ينتظرونه ثلاثة أو أربعة أيام ليلتقيهم"(١٠).
أغوص في رحلة غادة السمان… أدخل إلى عالمها وعالم سوهو بيروت، وأتنقل ما بين الخمسينات والستينات… أحاول أن أشتم رائحة البار من خلال كلماتها ووصفها… يُعيقني أحيانًا وصفها ونظرتها … لماذا أدخل دائمًا إلى مدينتي من أعين الآخرين، من صوتهم، ونظراتهم؟ لماذا أصل دائمًا متأخرة وأرث إرثًا لم أساهم في تكوينه أو اختباره، لكنه شكّل مدينتي، بماضيها وحاضرها، وطبع أحاسيسي ونظرتي وتجربتي…
أستمع إلى حوار السمان مع كريدية، حيث تسأله عن خبرته خلال عشرين عامًا في سوهو البيروتية، في مسرح يقدم عروضًا بخسة الثمن. تبحث عن الشقاء والحزن والفقر في إجاباته، لكّنه لا يُشبع غليلها بالكامل… "هي أعوام حافلة بالتجارب والخبرة" يقول لها، لم تعرف فقط الظلام، بل مرّت بمسرحه أسماء لامعة كانت يومها مجهولة وفقيرة، ثم عرفت النجاح، كفايزة أحمد وكارم محمود واسماعيل ياسين وقوت القلوب وجاكلين، و"كلاهما منولوجيست بدأتا هناك".
تعيد وتسأله السمان، "يوم نجحوا هجروا هذا المكان إلى الأبد"؟ "طبعًا"، يجاوبها، "صارت أجورهم فوق القدرة المادية لزبائن مسرحي". لم يكن راضيًا عن مستوى الفن في مسرحه، فالمضاربة مع كبار أصحاب المال في ملاهي الزيتونة أفسدت مسرحه، "مسرح أيام زمان". تسخر غادة السمان من فكرة أنّ "مسرح أيام زمان" كان أحسن حالًا، لكنها تسأل كريدية مجبرة عن أسباب انحدار "مسرح أيام زمان"، ليؤكد لها مسؤولية أخلاق السمسرة التي تسربت إلى الفن والمسارح.
أفكّر، يا لهذه المدينة التي لا تتعظ. كغيرها من المدن، تركض بلا هوادة خلف 'تمدّنها'، وحداثتها، وتطورها، تبكي باستمرار على ماضيها، ليسحق الآتون الجدد من سبقوهم، وتُطوى الصفحات، صفحة تلو الأخرى … فالزيتونة 'ذات الوجه الغربي'، نافست خلال الثلاثينات والأربعينات ساحة البرج 'ذات الوجه الشرقي' على الترفيه والرأسمال الاقتصادي والثقافي، قبل أن 'ينحدر' مستوى منطقة البرج خلال الستينات، أمام صعود شارع الحمراء الجديد ومثقفيه ومراكز الترفيه فيه. إذ لم يعد وسط المدينة 'البلدي' يتناسب تمامًا مع الصورة 'الحديثة' للمدينة. في حين كانت الزيتونة رمزًا للازدهار الاقتصادي والسياحي لبيروت سويسرا الشرق وبرجوازيتها، قبل أن تنافسها الروشة التي أخذت من وهج الزيتونة.(١١)
قد يكون عفيف كريدية مُخطئًا بتركيزه فقط على أخلاق السماسرة الجدد الذين يجتاحون المدينة وأماكن الترفيه فيها، والتغاضي عن دوره ودور العديد من الرجال، في المتاجرة بالنساء وأجسادهنً في مسارح وملاهي المدينة. فهو يترّحم فقط على زمن عرف نجاحات فردية لرجال بدأوا برأس مال صغير مقارنة بالسماسرة الجدد، ورسموا معالم الترفيه في المدينة، كمنصور قرم صاحب صالة ومطعم منصور، وأحمد الجاك صاحب ملهى كوكب الشرق، وطانيوس الشمالي صاحب أوتيلات طانيوس في صيدا وعاليه. لكنّهم أيضًا سيطروا على هذه الأماكن ونسائها، قبل أن يتراجع سوق الكباريهات التقليدي، مع تغيّر الذوق العام ودخول رؤوس أموال كبيرة، أدّت إلى نبذ هذه الأماكن وانحدارها.
لكن بالتأكيد أن غادة السمان مخطئة أيضًا باستخفافها "بمسرح أيام زمان"، وعدم اهتمامها بتاريخه. فقد شكلت هذه الملاهي تاريخيًا، للعديد من الفنانات والمغنيات، مساحات سمحت لهن بعرض مواهبهن وبناء شبكات عمل ودعم. وتحدَّين الأعراف وتفاوضنَ على أدوارهن في المجتمع، وساهمن في حياة المدينة الثقافية. فالراقصة والمغنية التركية بلانش التي جاءت إلى بيروت خلال العشرينات، وفتحت أول صالة تحمل اسم صاحبتها في المدينة، كانت رائدة أعمال تتمتع بشخصية قوية، تدير ملهى لها والمسيرة المهنية للعديد من المطربات. وقد نجحت في غضون سنوات قليلة في الارتقاء إلى صدارة الحياة الترفيهية في المدينة، كمغنية وراقصة، وكمالكة ومديرة صالة، وهو مجال سيطر عليه عادة الرجال(١٢).
كما استطاعت العديد من المطربات إثبات حضورهن في هذا العالم خلال الأربعينات والخمسينات، كزكية حمدان ووداد وسهام رفقي ونجاح سلام وغيرهنَ. فتحدّين النظرة "السيئة" لهذا المهنة، رغم العلاقات المعقدة والصعبة في عالمهن، وتحديدًا مع الرجال الذين كانوا يديرون أو يعملون في هذه الصناعة، ورغم تعرّضْ حياتهن الشخصية وأجسادهن للعديد من الملاحظات والانتقادات(١٣).
أمّا الملاهي، فقد شكلت مواقع مهمة للقاءات، حيث اجتمع أشخاص من خلفيات اجتماعية ودينية مختلفة في مساحات مشتركة للترفيه. ولعبت دورًا مهمًا في تشكيل الثقافة الشعبية والذائقة الموسيقية منذ بداية القرن الماضي حتى منتصفه، إلى جانب تأثيرها على جغرافيا وعمارة وسط المدينة. إذ كان لها أثر أساسي على أحياء المدينة من خلال إنشاء مشاهد ثقافية نابضة بالحياة والديناميكية اجتذبت الناس من مختلف أنحاء المدينة وخارجها، حتى اختفائها بعد تدمير وسط المدينة.
لماذا لا تعلن راقصات الباريزيانا الإضراب؟
وأنا غارقة في تلك الأفكار، يقاطعني إصرار كريدية على غادة السمان أن يقوم "بواجب الضيافة كاملًا" لها وللمصور زهير سعادة والصديقين الذين رافقاها قبل مغادرة المسرح. لكنّهم اعتذروا لإكمال جولتهم. ولم أتمكن من معرفة ما هي الضيافة التي كانت تنتظرهم، إذ سرعان ما توجّهوا إلى المحطة الثانية، إلى أعز كباريه على قلبي… الباريزيانا، ذلك الكباريه الذي يزيّن معظم صور ساحة البرج خلال الخمسينات والستينات. أحب الباريزيانا. ألقّبه بالكباريه الخاص بي، حيث لم يفارقني منذ أن بدأت أبحاثي عن بيروت. اَفتُتح خلال عشرينات القرن الماضي على أنقاض مسرح زهرة سوريا، أهم ملهى في بيروت قبل الحرب الأولى، الذي شيّده سليم آغا كريدية مع شريكه سليم بدر، أواخر القرن التاسع عشر(١٤). كان الباريزيانا أيضًا من أكثر ملاهي المدينة نجاحًا، ولم يكن بحاجة لإعلانات، بحكم تصدره ساحة البرج. له قسم صيفي وشتوي، وعلى خشبته غنّت أهم المطربات المصريات والشاميات خلال ثلاثة عقود، قبل أن يبدأ انحداره خلال الخمسينات(١٥).
لطالما تخيّلت ليالي الباريزيانا، حين لم يكن للملهى رسم دخول، لكن تكلفة السهر فيه أيام عزه كانت بحدود العشر ليرات(١٦). أرى الجمهور الذي يتناول الطعام ويستمتع بالبرامج حتى الثالثة صباحًا. هو عبارة عن قسم من "السميعة أغلبهم من حلب [...]، وقسم آخر يدور في فلك الرقص"، على حسب ما يذكر آخر مالك للملهى، عبد الحميد سلام(١٧).
كان سلام يأمل بعد الحرب أن يُعيد افتتاح الباريزيانا كمطعم. طبعًا لم يتحقق مبتغاه، وجُرف الملهى مع ما جرف في التسعينات خلال إعادة 'إعمار' وسط البلد، التي سلخت المدينة عن تاريخها وناسها. لا أعرف تفاصيل هدم الباريزيانا، لكنني وعدت سلام في مخيلتي بتقصّي أخباره، وقصصه، وصوره. منذ سنين وأنا أرسم له صورًا ومعالمَ في رأسي، أتقفى أي أثر له، أجمع صورًا له منشورة على وسائل التواصل، خلال أيام عزه أو من خلف المتاريس التي وُضعت من أمامه. فكيفما بحثت، كنت أقع على أثر منه.
لكن الآن، تصلني أخيرًا بعضًا من رائحته، حين ثقبت غادة السمان "جدار السجائر والأنفاس المحمومة"، لحظة دخولها الملهى، قبل الجلوس على إحدى الطاولات. وجودنا، وتحديدًا وجود الكاميرا المرافقة، أثار نفور الزبائن. تريد السمان أن تسألهم عما دفعهم إلى هذا المكان، لكنها سرعان ما تجيب بنفسها: "الكبت ... والحرمان من ممارسة علاقات إنسانية مع الجنس الآخر في ضوء الشمس".
أعاتبها قليلًا، فعلى الرغم من التعاطف الذي تظهره مع وضع نساء الكباريه العام، أو على الأقل مع ظروفهنَ الصعبة وحاجتهن للعمل، لا تتوانى عن إسقاط التوصيفات القاسية على أشكالهنَ وأصواتهنَ. "على المسرح امرأة تغني، صوتها ليس قبيحًا ولا جميلًا، ولكن جسدها جميل بقدر بشاعة وجهها…". تنظر إلي السمان، وتسألني، "لماذا لا تقدّم نمرة صامتة كأن تروح وتجيء بجسدها عدة مرات على المسرح وهي مغلقة الفم"؟
أحاول التدخل، "ولو يا غادة، أأنت التي تقولين هذا الكلام؟ كيف لامرأة علمتني الكثير عن المرأة ودورها، والمجتمع وتخبطاته، وتحدّت النظرة التقليدية للمرأة، أن تُعيد إنتاج صور نمطية كهذه"؟ لكنها تشيح بنظرها نحو امرأتين جالستين بين الزبائن. فما يسترعي كامل اهتمامها لسن نساء المسرح، بل ما يحدث في الصالة، الذي هو "المسرح الحقيقي الجدير بالمراقبة".
الأولى، هدى، صبية لبنانية في مقتبل العمر، طموحها أن تصبح مطربة، وتنتظر فحصًا في الإذاعة يخوّلها أن تصبح مطربة "محترمة" معترفًا بها. والأخرى عراقية، أسمها أيضًا هدى، "شارفت على الكهولة، على آخر الطريق". امرأة منهكة، لا عائلة لها، تعمل منذ أكثر منذ عشرين عامًا في هذه المهنة، وتقدم وصلات مونولوجات ورقص في الباريزيانا. معًا تمثلان في نظر السمان نموذجًا لامرأة واحدة، امرأة الكباريه "في مطلع صباها ثم في خريفه…"
تحزن السمان على حياة ومصير هاتين المرأتين، فالأولى تأمل بمستقبل أفضل من زميلاتها، والثانية تبحث عن خلاص فردي. في حين لا تؤمن السمان بالخيار الفردي المتجذر بالمجتمع غير المبني على فكرة الجماعة، بل تؤكّد أنّ "لا خلاص للفرد وحده [...]، لا أحد يستطيع أن يكون حرًا في مجتمع يستعبده التخلف".
تستغرب السمان مواصلتهما الجلوس في الصالة بعد انتهاء وصلتهما، لكنّهما مجبرتان بمجالسة الزبائن حسب العقد. تستنكر عبودية الفنانات هذه، وتسألهنَ (بسذاجة) عن نقابات ورابطات تدافع عن حقوقهنَ وحريتهنَ، وعدم إضرابهن ضد هذا الاستغلال. لكنّهن بنظرها أسيرات الفقر والحاجة. فهدى العراقية التي ملّت هذا "الجو الإرهابي" والعرض الجسماني، لا تستطيع الثورة على واقعها لأنّها بحاجة إلى العمل. وتمنت أن "يتوب ربها عنها لتصبح زوجة وست بيت". لم تسمع السمان عمق صرختها، ولم تحاول الغوص فعلًا في ظروف العمل والفقر التي تجبر النساء على العمل في هذه البيئات، والنظر إلى التفاعلات بين الجندر والطبقة التي تساهم في تشكيل تجارب النساء، وتدفعهن لاتخاذ قرارات صعبة بسبب الحاجة الاقتصادية، ممّا يُعزز استغلالهن الاقتصادي والجنسي. بل اكتفت بتوجيه سهامها في هذه اللحظة نحو نساء المجتمع "المحترم".
انتقدت السمان "نجمات المجتمع المخملي"، أي الشخصيات البارزة في العالم الثقافي والاجتماعي والفني آنذاك، اللواتي كنّ جزءًا من الطبقة الثرية أو النخبة السياسية، واصفتهنّ ب "مدللاتِ طبقةٍ أفرزها مجتمع فاسد. ورَبطتْ الاحترام الذي يَحظيْنَ به بحماية أزواجهن النافذين أو بعض ذوي النفوذ، أو باستقلالهن المادي، بعلاقاتهن ومكانتهن الاجتماعية وثروتهن. في حين أن نساء قاع المدينة لا يتمتّعنَ بهذه المزايا. ليشدد خطابها فقط على هذه الفروقات الطبقية، لكنّه لا يتوانى عن نقد الارتباط المادي لتلك النساء "المخمليات" بالرجل. فحرية المرأة واستقلالها يكمنان بنظرها في اكتساب المرأة مزايا الرجل، وهي العمل والاستقلال والقدرة على إعالة أنفسهن. وعلى عكس المغنيتين، فإن دافع "سيدات المجتمع" ليس الحاجة او "سراب الفن" والانجراف وراء "تجارة الفن" بحسب السمان، بل بسبب الجشع الذي يسيطر على هذا العالم. لتُدين بذلك المجتمع وعالم الترفيه المهيمن آنذاك ونفاقه، وتحديدًا الفن الاستهلاكي والمبتذل، الذي يغرّ بالنساء ويتاجر بأحلامهن وأجسادهن.
تنهي السمان حوارها مع المرأتين، وتغادر الباريزيانا من دوني. لم يعجبها امتعاضي، أنا التي كنت أتبعها دون سؤال. تدخل كباريه ثالث، تسجّل انطباعاتها، ومن ثمة تذهب إلى شارع المتنبي، شارع البغاء "الطويل الحزين" الذي كان يمتد من خلف مبنى الشرطة (السرايا الصغيرة) في ساحة الشهداء إلى المرفأ. تنتقد هناك الدولة ورعايتها للدعارة في هذا شارع، وتصوّر النساء العموميات كبائسات وضائعات "فريسات الانهيار العصبي"، غير مثقفات أو معلمات لتعرفن مدى مأساتهن، أو لتثرنَ على وضعهنَ. لا أحد يكترث لهنً، خصوصًا الجمعيات الخيرية لسيدات المجتمع المخملي، اللواتي ترفضنَ حتى النزول إلى عالمهنً. و"هذا أفضل".
فبالنسبة للسمّان، الجمعيات الخيرية هي "تخدير للثورة، والوضع بأكمله في حاجة إلى نسف!" وسوهو الحقيقية في نظرها ليست في ملاهي البرج الخلفية وأحيائها الفقيرة، بل في أعماق المجتمع ومفاهيمه الخاطئة وتصرفاته، في تخلفه وقسوته ولامبالاته. لذا تطالب السمان بالثورة على هذه المفاهيم والمجتمع والطبقات المخملية، لتحرير كل أعضاء المجتمع وإنقاذ المهمشين، من دون أن تُحدد أطر هذه الثورة، أو تقدّم حلول فعلية لتغيير جذري في الهياكل الاجتماعية والاقتصادية، ومعالجة المشاكل التي تواجهها النساء في الكباريهات.
الكباريه في أعين "الأدباء"
أعود من رحلتي خلف غادة السمان منهكة، أفكر بمقاربتها لعالم الكباريه في بيروت. من جهة، تركت لي مادة تاريخية تساعدني على رسم بعض ملامح هذا العالم الماجن، ومن جهة أخرى طبعته بانشغالاتها كأديبة نسوية حاولت إطاحة أوجه مختلفة من مجتمع ذلك الزمن، فقدمت لي نظرتها، ممّا يعطي أبعادًا مختلفة لهذا النص الذي أعود إليه اليوم.
صوّرت غادة السمان عالم الكباريه على أنه عالم سفلي مهمل وقذر، حيث تُشَيَّء النساء وتُستغلْ لتسلية الرجال. وأرادت تحدي المجتمع آنذاك وأدباءه بزيارة هذا المكان غير اللائق لامرأة وأديبة، والكتابة عنه، خصوصًا كونها تعتبره مكانًا متخلّفًا، يقدّم فنًا شعبيًا "ينزف فقرًا {...} في الخبرة {...} وفي الثقافة". لذا شكّل عالم الكباريه بالنسبة للسمان مساحة للنقد الاجتماعي والسياسي والثقافي، واستكشاف موضوعات الفقر والطبقية. وكتبت عن الأثر الاجتماعي والثقافي لعالم الكباريه، وصورته على أنه فضاء للتهميش والاستغلال والتخلف، حيث تُكرّس قيم المجتمع التقليدية و"البالية" و"الرجعية"، وتظهر الفروقات الاجتماعية بشكل صارخ، وتضيع حقوق النساء والعاملات.
لكن في نفس الوقت، كرّست غادة السمان الصور النمطية لنساء الكباريه عبر النقد الذي كتبته. لا بل ساهمت بتعزيز تشييء المرأة والقوالب النمطية بين الجنسين، عبر التركيز على أجساد النساء والإيحاءات الجنسية التي تقدمنها. فتارة وصفت راقصة بأنها "تتلوى على خشبة كما لو كانت مصابة بمغص حاد"، وطورًا بأنها "تستعرض جسدها تحت ستار مطربة". في أحد الكباريهات، أشارت السمان نحو آلة "الجوك بوكس" الموجودة في الصالة إلى جانب المسرح والمطربات، واستغربت عدم استعانة أي من الزبائن بها للاستماع الى الأسطوانات، والاكتفاء بتأمل أجساد المطربات الصامتات…
صحيح أن السمان حاورت النساء العاملات في عالم الكباريه، لكنها لم تحاول فعلًا سماع أصواتهن. بل أتت بخطابها الحداثي الجاهز حول مشاكل قاع المدينة وعجز نسائه، وحاجتهن لضمان اجتماعي ونقابات! وأرادت إسقاط خطابها على هذا العالم، مُنتقِدة المجتمع الذي أفرزه ومطالبة بالثورة عليه، مع تكريس نظرتها لنساء عالم الكباريهات كضحايا، لا قدرة لهن على تحدي ظروفهن والتأثير على محيطهن، من دون النظر إلى الكباريهات كفضاءات حداثية تعكس وتعيد إنتاج الأدوار الجندرية السائدة في المجتمع، أو تقفي مدى تأثير الأعراف والقيم الثقافية على تجارب تلك النساء. لكن الأهم من ذلك، لم تهتم السمان بوجهة نظر تلك النساء وأفكارهن ومشاعرهن، والطرق التي تتنقلن بها في عالم الكباريهات، وترسمن حياتهن واختياراتهن، وتقاومن الأعراف والتوقعات الأبوية. حتى وصفها لحياة الليل في الكباريهات كان مليئًا بالتصوير النمطي ولا يخلو من الإثارة.
وعلى ما يبدو لم تكن غادة السمان البرجوازية "اليسارية" الوحيدة التي جذبها هذا العالم، الذي شكّل موضوعًا للدراسة والاستكشاف للعديد، خصوصًا بعد دراسة سمير خلف عن السوق العمومية (1965)(١٨)، فالكاتبة والفنانة اللبنانية مي غصوب، أرادت هي أيضًا البحث عن الطبقات الاجتماعية الأكثر حرمانًا والعاملين الكادحين. فزارت مسرح فاروق، أشهرٍ قبيل احتراقه عام 1971(١٩). ورسمت صورة قاسية عن "المسرح المنحط" و"السيئ السمعة"، الذي لا تدخله أي امرأة محترمة، بل يرتاده رجالٌ "تعلو أفواههم شوارب طويلة"، أتوا "ليرفهّوا عن أنفسهم، ولينسوا همومهم".
على عكس مي غصوب، انتقدت السمان الهياكل الثقافية والاقتصادية الأكبر التي تحمي الملاهي وأصحابها النافذين، وتسعى إلى الربح المادي على حساب النساء، واعترفت بمسؤولية النظام الثقافي السائد آنذاك. مع ذلك بقي تصور السمان وغصوب للكباريه من منظار ضيق يعتمد بشكل أساسي على تجارب أو نظرة النخبة الثقافية والاقتصادية، من دون أن تُمثِّل أو تصغي بشكل كاف لتجارب نساء ذلك العالم واختلافاتهن. مما جعل مقاربتهما اختزالية ومبسطة، لا تقتفي بدقة التجارب الفردية للنساء العاملات في صناعة الملاهي الليلية، بل تبقيها ضمن الصور النمطية كضحية ومضطهدة تتعرض للاستغلال وسوء المعاملة. لا بل أنّ السمان استحوذت في نهاية رحلتها على لغة وهوية الطبقة العاملة، فقدمت نفسها كامرأة عاملة وفرد من الطبقة العاملة كباقي نساء ورجال قاع المدينة، دون أن تأخذ بعين الاعتبار المزايا والامتيازات التي تأتي من وضعها البرجوازي. ممْا خلق عندها إحساس زائف بالتكافؤ، يمحي تجارب ومعاناة النساء اللواتي تواجهن حقًا صعوبات اقتصادية وتهميشًا اجتماعيًا.
مع ذلك، أحببت عودتي إلى نص غادة السمان الذي سمح لي بالعودة إلى أماكن منسية اليوم، رغم أنّها شكلت هوية المدينة والصورة التي بنيت من حولها لفترة طويلة. فالمدينة فقدت أي ارتباط بهذه الأماكن وذاكرتها، واستعادتها اليوم تسمح بتتبّع الصراعات الثقافية التي عرفتها المدينة بين نخبة اقتصادية ليبرالية مهيمنة، كانت تريد أن تبني مدينة حديثة على صورتها، بمعزل عن مهمشيها، ونخبة ثقافية يسارية لم تتواصل فعلًا مع مهمّشي المدينة، رغم ادعائها التكلم باسمهم. فسُحقت المدينة ومهمّشيها في وسط هذا الصراع.
كما أتاحت لي هذه الرحلة بالعودة إلى جيل غادة السمان ونسويّاته، ومقاربة نظرتهن للعالم والمجتمع من حولهن من خلال عالم الكباريه، لإعادة ارتباطنا معهن والبناء على استمرارية أو تراكمية نسوية تاريخية رغم النقد والاختلافات التي تتّسع. أحببت عودتي لأن، تاريخيًا، كان هذا عالم يهيمن عليه خطاب الرجال ووجهات نظرهم، ولم يُكتب عنه من وجهة نظر نسائية. فقدمت السمان وجهة نظر وصوت بديل يتحدى، رغم كل شيء، فهمنا لتاريخ هذا العالم، ويوّسعه، ويعطي صوتًا لتجارب النساء، ولو غير مكتمل. فالسمان انتقدت الهياكل السلطوية البطريركية، وسعت إلى تغيير اجتماعي وثقافي أكبر. لكنّها لم تتعامل بشمولية مع هذا الفضاء كموقع للنقد النسوي والطبقي يتخطى نظرة الطبقات الوسطى والمثقفة. فلم تهتم بدراسة وانتقاد الطرق التي يتقاطع بها الجندر مع الطبقة والسلطة في هذا العالم، واستكشاف فعلًا تجارب النساء اللواتي همّشت والصعوبات التي واجهنها.
لكن رغم النقد الذي يمكن أن أوّجهه لغادة السمان اليوم، تبقى نظرتها أكثر تحررية من العديد من المقالات التي تناولت العالم السفلي للمدينة إلى يومنا هذا، وأقل وطأة مثلًا من مقال كتبه صحافي اسمه أمين يموت، عام 1968، في مجلة الكاميرا الفنية التي حاولت آنذاك منافسة مجلة الشبكة والموعد في تتبّعها للأخبار والنمائم الفنية والاجتماعية(٢٠). حمل المقال عنوان "الوجه الآخر للملاهي الشرقية"، وتناول فيه الصحافي ملاهي ساحة البرج الشرقية التي "لا يؤمّها إلا فئة المعذبون على الأرض"، وذلك "رغبة بتعريف القراء عليها". قدم يموت نقدًا لاذعًا لنساء عالم الكباريه. فاستهزأ على سبيل المثال، بمطربة في كباريه شهرزاد، اسمها "محبوبة لبنان"، معقّبًا حين غنت: "أقسم بربي لو سمعها بيار الجميل لعاف لبنان وأرز لبنان وكل ما يمت إلى لبنان بصلة". وحين انتهت من وصلتها، اعتلت المسرح من بعدها امرأة وصفها أمين بأنها "تضاهي الثور بضخامته ..."
ما بين مقاربة يموت وغصوب والسمان اختلاف بين منظور وهدف كل منهم. في حين ترى غادة السمان أن عالم الكباريهات هو مرآة فساد المجتمع، وانحطاطه، والكبت الذي يسوده، نساؤه ضحايا نفاق المجتمع، ويجب إصلاح المجتمع لإصلاح قاع المدينة. يصوّر أمين يموت ومي غصوب من جهتهما عالم الكباريه على أنه مكان خلاعي يذهب إليه الرجال للانغماس في رغباتهم الشهوانية، وينظران باحتقار تام إلى نسائه، مساهمان في تنميط صورتهن. لكنهم يشتركون جميعًا، وكذلك العديد في مجتمعاتنا اليوم، في تبني خطاب الحداثة الذي يحثّ على التقدم والتطور من خلال تنمية الثقافة وتحسين الفن وترشيد الترفيه، من دون التركيز على البنى التي تعزز الحداثة، مثل الأسواق الحرة والاستهلاك الثقافي والترفيهي، التي تساهم في استغلال نساء الكباريهات جنسيًا واقتصاديًا، وتفاقم التفاوت الطبقي، وتعمق الفروق الجندرية.
رحلة لا تنتهي
بأي حال، أفرح اليوم كيف أجد نفسي ما بين هذه النصوص، أتلصص على أفكار ونظرات غادة السمان ومي غصوب وأمين يموت، ومن عبرهم أحاول استعادة هذه الأماكن والدخول اليها. أترك غادة السمان، لأصعد مع أمين يموت إلى بعض هذه الكباريهات التي كانت في الطوابق الأولى من البنايات. أرتقي بضع درجات من السلم وكأنها دهاليز، للدخول إلى الملهى.
هناك يستقبلني الكرسون بابتسامة عريضة. "المسرح عبارة عن "دكة" عالية من الخشب، تجلس عليه الفرقة الموسيقية المؤلفة من عود وكمنجة ورق... يبدأ البروغرام بقطعة موسيقية اسمها "بشرف طاطيوس"، يبحث حامل الرق عن كرسي يجلس عليها.. فلا يجد.. فيصاحب الفرقة الموسيقية "على الواقف"..."(٢١).
المعلمة تراقبني وتراقب الجميع. كرسون وحيد يخدم بين الطاولات. يصرخ به أحد الزبائن "ثلج.. ثلج يا ابن ال…" تلتفت المعلمة نحو المسرح، وتصيح "بأعلى صوتها لكي تغطي على أصوات الموسيقى: هات ثلج للريس يا أحمد…" أرى أحمد الرقاق ينزل عن المسرح، يجلب الثلج، يعود مسرعًا ليطبل للفرقة، وثم يذيع بين الفواصل الموسيقية. يقدم "الراقصة الخيزرانية نجمة التلفزيون والاذاعة [...] راقصة الجيل وكل جيل زهور". يسخر منه يموت قائلًا بأنه "سها عن باله أن الإذاعة لا علاقة لها بالرقص".
لا أكترث بما يقول، أتابع ليلتي التي تطول مع الفنانتين منتهى أحمد وسعاد حموي التي تجاوزت الستين من عمرها، ولم تتعب من الغناء. فغنت لي أغاني أم كلثوم "سلوا قلبي" وشمس الأصيل"، وقفلت بموال من أيام عبد الحامولي وسلامة حجازي أعادني إلى ملاهي بداية القرن العشرين. أغمض عيني لثواني لأستمتع بهذه اللحظات، التي نسيت فيها أين أنا وفي أي زمن أعيش، وكّل ما حلّ بالمدينة.
هوامش: